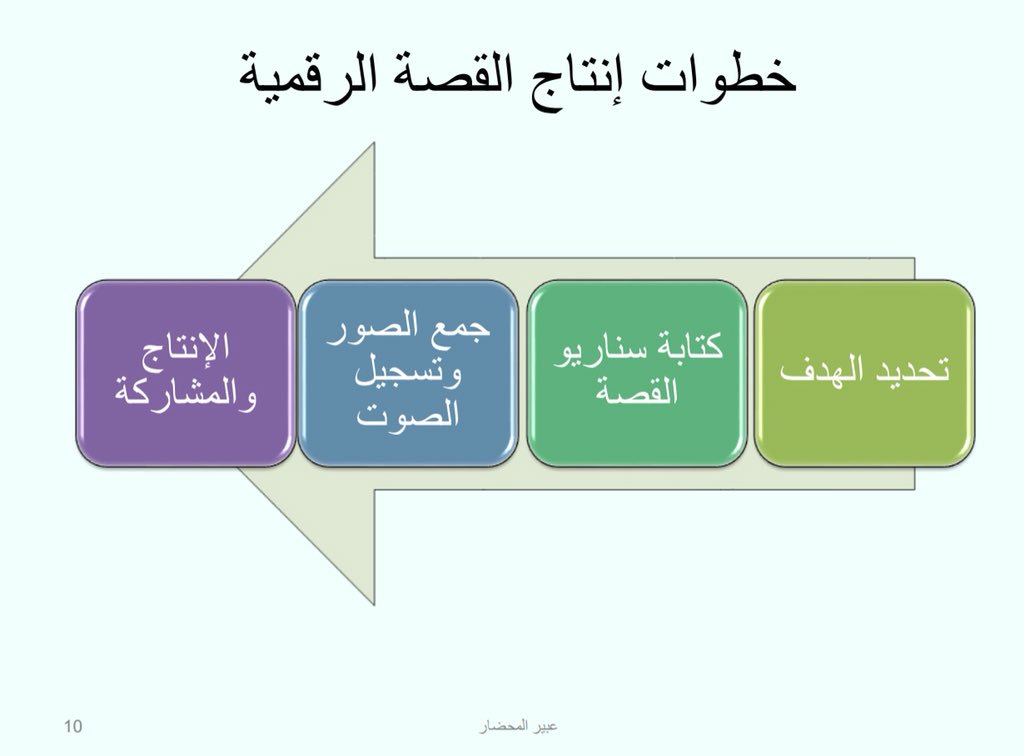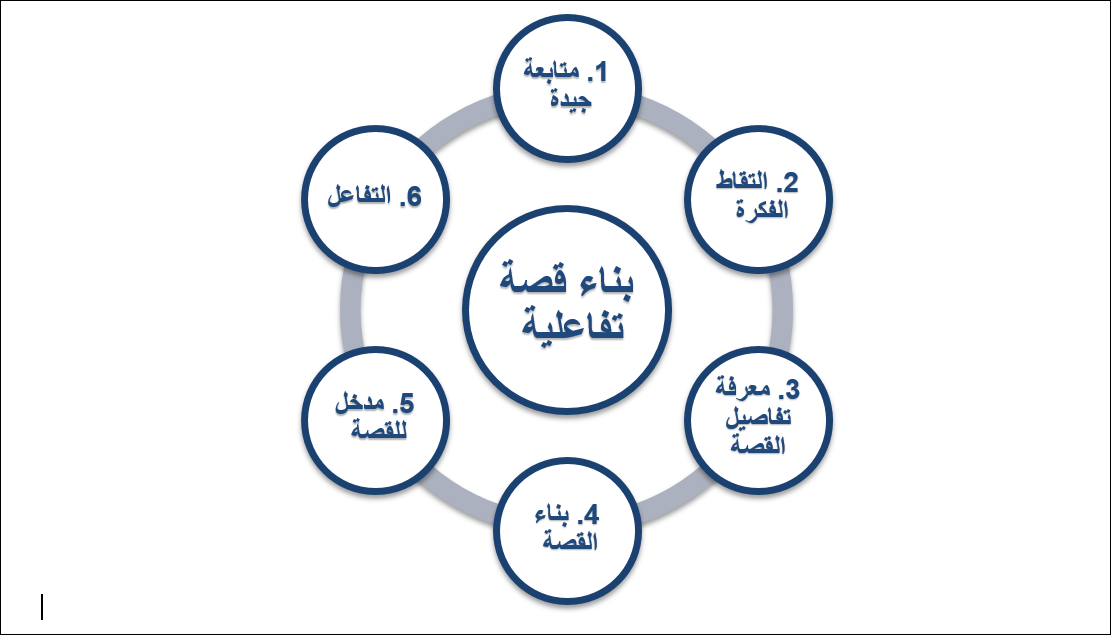أدب تفاعلي
Section outline
-
لا يخفى على أحد من الدارسين أن كل تطور في العملية التاريخية والحضارية إلا وله أثره على الحركة الإبداعية ، فما إن دخل الإنسان عصرا جديدا هو عصر الرقمية، ومست التكنولوجيا مختلف المجالات الفكرية والثقافية حتى اتصل الأدب هو الآخر بالثقافة الرقمية، فتولد لنا ما يسمى اليوم بالأدب الرقمي أو الأدب التفاعلي، وتزايد حوله عدد المهتمين به أدباء ونقادا.
عرف الأدب كيف يستفيد من التقانة الرقمية، وما توفره من معطيات ووسائط متعددة سمعية وبصرية، مما أحدث تغيرات شاملة في بنية النص الأدبي وفي مكونات العملية التواصلية، فقد استطاع هذا الأدب أن يجمع بين ما هو لغوي وغير لغوي حيث تكاتفت فيه مختلف عناصر التواصل كالإلقاء واللغة الإشارية ولغة الجسد ونبرات الصوت، وللإفادة فإن هذه العناصر كان لها الأثر البليغ في تحويل الملتقي من متلق سلبي إلى متلقي إيجابي يمتلك السلطة الكافية التي تجعله فاعلا ومشاركا في إنتاج النص، وهذا الأمر هو ما يبرر تسمية هذا النمط من الأدب بالأدب التفاعلي وهي كلمة تحمل في مدلولها التشارك بين طرفين أو أكثر .
يطرح الأدب التفاعلي العديد من القضايا والإشكالات كونه نمطا كتابيا مستحدثا فرضته الثورة التكنولوجية بمختلف معطياتها الرقمية، ولعل من أهم هذه الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع هو إشكالية المصطلح، إشكالية الاعتراف بأحقية وجود هذا الأدب في الساحة الأدبية والثقافية، إشكالية تجنيس الأدب التفاعلي، إشكالية الملكية الفكرية، ومرد هذه الإشكاليات جميعا أن النقد في بيئتيه الغربية والعربية لم يكن مسايرا لظهور هذا الأدب المستحدث مما خلق نوعا من الارتباك والتشويش والضبابية في أذهان متلقيه نقادا كانوا أم قراء عاديين.
تحاول هذا المحاضرات في مجملها البحث في هذه الإشكاليات المطروحة اليوم في الساحة الأدبية والنقدية، بالإضافة إلى معرفة الخصائص التي جعلته يؤسس لنفسه كيانا خاصا مستقلا عن نظيره الورقي دون أن نغفل عن الكشف عن المكونات البنائية لهذا الثوب الجديد الذي لبسه الأدب بمجرد تزاوجه مع التكنولوجيا، ومن ثم الوقوف على الجديد الذي أضافة الأدب التفاعلي إلى العملية الإبداعية، وما إذا كان يعد حقا مساهمة فعالة في المجال الثقافي والإبداعي، وهل يحتاج فعلا إلى نمط جديد في التعامل سواء في إنتاجه أو تلقيه.

-
اسم المقياس: أدب تفاعلي
الأستاذة المحاضرة: ريمة لعواس
المستوى: موجه لطلبة السنة الثاثلة ليسانس:
التخصص: ادب عربي
نوع المقياس: محاضرة
المعامل: 01
الرصيد: 01
جامعة: الجيلالي بونعامة بخميس مليانة
أيام التدريس:الاثنين والأربعاء
الإيمايل المهني: rima.laoues@univ-dbkm.dz
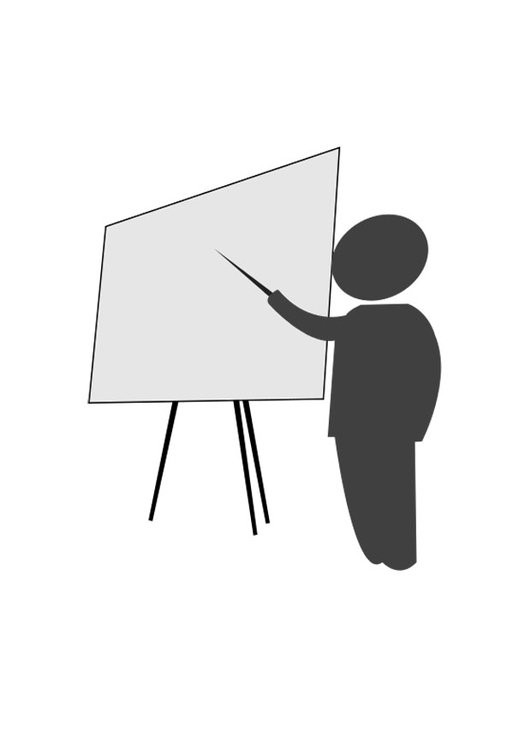
-
تهدف هذه المحاضرات في مجملها إلى تسجيل محاضرات مهمة منها:
تعريف الطالب بالادب التفاعلي
تحديد الفروق بين الادب الورقي والادب التفاعلي
تحديد اهم خصائص الادب التفاعلي وأهم اجناسه
التعرف على آليات التلقي الرقمي واهم إشكالاتها
الاطلاع على نصوص رقمية روائي، شعرية، مسرحية...إلخ

-
لا يخفى على أحد أن العصر الذي نعيش فيه يسمى العصر الرقمي، حيث أصبحت كل مجالات الحياة خاضعة للتقانة الرقمية بما في ذلك الأدب، من وجهة نظرك وبناء على مكتسباتك المعرفية؟ كيف أثرت هذه التقانة الرقمية على الأدب وما الفرق بين هذا الأخير وبين الأدب الورقي؟؟

-

عنوان المحاضرة
الرقم
مفاهيم العصر الرقمي
01
الأدب الرقمي
02
الكتابة الأدبية التفاعلية
03
مظاهر الأدب الرقمي ومجالات التفاعلي
04
الرواية التفاعلية
05
القصيدة التفاعلية
06
المسرح التفاعلي
07
القصة التفاعلية
08
المقال التفاعلي
09
قضايا الأدب التفاعلي
10
بين الأدب الورقي والأدب الرقمي/التفاعلي
11
الملكية الفكرية والمرجعية
12
المؤثرات الصوتية والبصرية في الأدب التفاعلي
13
الأدب التفاعلي في البيئة العربية(تجارب)
14
-
المحاضرة الأولى :
مفاهيم العصر الرقمي
ارتبط ظهور الأدب التفاعلي (الرقمي) بالمفاهيم الطارئة والمستحدثة في العالم كمفهوم العولمة التي تعني في حد ذاتها التواصل العالمي، حيث تعرفها معظم الدراسات على أنها "إكساب نمط ثقافي أو اقتصادي أو سياسي صبغة العالمية، أي نقلة من بويتقة المحدود إلى اللامحدود والعالم المتناهي، فيما يتجاوز إطار الحدود الإقليمية الضيقة... وتهدف إلى ربط التطور التكنولوجي والاقتصادي وما ينجم عنها لبناء حضارة كونية جديدة قوامها توحيد الثقافة والفنون والنظم الاجتماعية، وتأسيس حضارة جديدة لصالح المركز العالمي الذي ينتج التكنولوجيا ويقود ظاهرة العولمة"[1].

وعليه فإن الهدف الأساس للعولمة هو إزالة الحدود الفاصلة بين مختلف المجالات المعرفية وجعل العالم كتلة واحدة وموحدة لذا "كثيرا ما يصار التأكيد إلى أن الغاية الأساسية لنزعة العولمة (الكونية) هي تركيب عالم متجانس يحل فيه وحدة القيم والتصورات والغايات والرؤى والأهداف محل التشتت والتمزق والفرقة وتقاطع الأنساق الثقافية"[2]، ومن ثمة تعطيل مبدأ التفرقة بين الأجناس البشرية وتوحيدها تحت مبدأ الشمولية أو ما يعرف بالكونية، ذلك لأن الفكرة الأساس التي تشتغل عليها العولمة هي "ازدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال، أو في انتشار المعلومات والأفكار وسرعة تدفقها، أو تأثر أمة بقيم أمة أخرى وعاداتها وتقاليدها"[3].
ولقد كان من النتائج المبهرة للعولمة بكل حمولاتها المعلوماتية المستحدثة أن أعطت "الاتصال والإعلام دفعا لحركة الثقافة نحو التداخل في العالم كله، إذ مما يساعد على تعميق الرابطة الثقافية أن كل الروابط بين الأمم والشعوب محكوم اليوم بالمعيار التكنولوجي"[4]، ذلك لأن الاتصال التكنولوجي بعد تمكن كل البشرية في العالم منه كان العامل الأساس الذي ساعد وبشكل مباشر في جمع شمل البشرية وتوحيد أـفكارها ورؤاها على الرغم من بعض الاختلافات الحاصلة بين الشعوب.
في ذات السياق يرى نبيل علي في ثنايا كتابه (الثقافة العربية وعصر المعلومات) أن "العولمة باتت واقعا لا مفر من التعامل معه فليست هي بالفجر البازغ ولا بالفخ الخادع وعلى عاتقنا تقع مسؤولية العيش في ظل ما تفرضه من قيود وما تتيحه من فرص، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا تفهمنا بعمق شديد علاقة منظومة الثقافة بمنظومة تكنولوجيا المعلومات خاصة ظاهرة الانترنيت"[5]، وفي هذا الرأي الذي ذهب إليه نبيل علي دعوة صريحة إلى الوقوف موقف الوسطية من العولمة، أي الاعتدال في تعاطيها وفي التعايش معها وذلك وفق ما تفرضه الحاجة حتى لا يكون ذلك على حساب هويتنا الثقافية، ذلك لأنه لا يمكننا أن ننطر البتة الدور الذي تلعبه العولمة في حياتنا العلمية والثقافية فها هو الأدب مثلا قد "فتحت له العولمة الأبواب واسعة للخروج من النطاق الضيق إلى العوالم الفسيحة وتلغى بذلك الحدودية والمحلية، وهذه المقومات يسعى إليها كل أديب حتى يوصل أدبه إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين، وإلى أقصى نقطة من هذا الكون، فأوجدت العولمة للأدب مكانا رحبا ونقلته من المحلية المغلقة إلى العالمية اللامحدودة"[6]
من مفاهيم العصر الرقمي أيضا نجد التواصل العالمي الذي يشكل النشر الإلكتروني(الرقمي) أحد أوجهه، حيث " لم تجعل الرقمية النشر في متناول الجميع فحسب، بل وكذلك أتاحت له التحقق بمنتهى السرعة وبكلفة زهيدة لا مجال للمقارنة بينها وبين الاعتمادات المادية التي يتطلبها النشر الورقي، والإجراءات الكثيرة والمعقدة، فإرسال كتاب بكامله إلى أي موقع وجعله في متناول المبحرين في كافة أرجاء المعمورة عملية بسطة لا تتطلب أكثر من بضع ثوان إلى بضع دقائق(حسب سرعة الاتصال)"[7]
وفي هذا الصدد يعرض لنا محمد سناجلة في كتابه النقدي (رواية الواقعية الرقمية) جملة من المزايا التي يتفرد بها النشر الإلكتروني حيث يقول: "إن النشر الإلكتروني يقدم حلولا لكل المشاكل فلا يوجد هناك ناشر لا تهمه كتابتك وإبداعك بقدر ما يهمه الكسب المادي من ورائك أو أمامك، ولا رقيب يخنقك ويعد عليك كلماتك بل وحتى أنفاسك، ولا حاجز بينك وبين قرائك وجمهورك، فكتابك قادر على الوصول إلى كافة أرجاء المعمورة من غير دور نشر قومية أو وطنية، كما يتيح لك الكتاب الإلكتروني استخدام كافة الأدوات في العملية الإبداعية بسهولة ويسر ومن غير تقييد ولا حصر، فحدك خيالك المعرفي والخيال المعرفي لا حد له"[8]
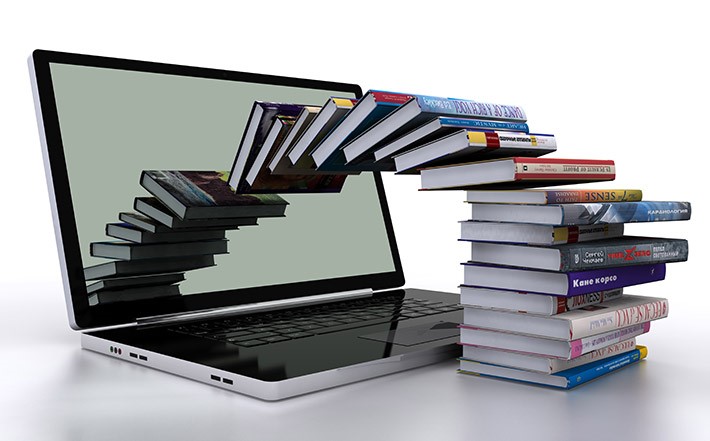
في ذات السياق يسوق لنا السيد نجم هو الآخر عددا من المزايا المتوخاة من النشر الإلكتروني نوردها كما يلي[9]:
ü إتاحة فرصة أكبر لحرية الكاتب في التعبير عن وجهة نظره
ü إتاحة فرصة العدالة والمساواة بين المتصفحين في الحصول على المعرفة واكتسابها
ü إمكانية إتمام الحوار والتواصل بين الكاتب والقراء
ü إمكانية الانتشار للعمل الأدبي وزيادة عدد القراء وكذا المادة الرقمية
ü حفظ المعلومات في حوافظ متنوعة
ü تجاوز الأمية بأشكالها المختلفة في مجال الأدب والثقافة والعلوم
ü ملاحقة الجديد في الإبداع والثقافة
ü القضاء على جانب من سلبيات الفجوة الرقمية في الوطن العربي
ü قلة تكلفة المنتج الثقافي في مقابل المنتج الورقي المماثل(الكتاب الرقمي أقل تكلفة بحيث تصبح 25% من تكلفة الورقي... أسرع في الانتشار... أفضل من ناحية الإخراج الفني)
ü إتاحة الفرصة لمولد (فورم) جديد من الإبداع القصصي والشعري، وهناك عدد من التجارب التي خاضها محمد سناجلة في الرواية والقصة القصيرة، بالإضافة إلى بعض المحاولات الأخرى لعباس العيد، وأحمد العايدي
ü إتاحة الفرصة أكبر للمواهب الشابة، وتساعد على نشر أعمالهم المبكرة
إلى جانب ما سبق ذكره قدمت بعض الدراسات مزايا أخرى لا تقل شأنا عن تلك التي قدمها كل من محمد سناجلة والسيد نجم، نذكر منها: السرعة: فعملية النشر الإلكتروني تتم في وقت قصير مقارنة بالوقت الذي يتطلبه النشر الورقي وبالتالي توفير الزن واختصاره
ü السهولة: تتم عملية النشر الرقمي بسهولة ويسر
ü اختصار المسافات، وتوفير الجهد
ü إتاحة الفرص أمام أكبر عدد ممكن من القراء مهما تباعدت إقاماتهم، وتباينت وجهاتهم وانتماءاتهم القومية والعقدية والثقافية...إلخ
ü دمج النص بالنقود الموجهة له، الأمر الذي يعطي بعدا آخر لعملية الفهم والقراءة
ü التفاعل المباشر بين الكاتب/ المستخدم والقارئ والنص
عوامل ظهور الأدب التفاعلي:
أ- الثورة الرقمية:
ظهر الادب التفاعلي (الرقمي) بداية في العالم الغربي نتيجة لتظافر عدة عوامل من بينها الثورة الرقمية التي حملت "بين طياتها تأثيرات حاسمة على شكل الكتابة، ومن ثم على جوهر الكتاب، ليس من جانب الشكل فقط وإنما من جانب المضمون أيضا، فطرأت بعض التغييرات على طبيعة العملية الإبداعية، وعلى عناصرها، فكان لتأثير هذه الثورة صدى أوسع من تأثير آلة الطباعة التي اعتبرت ثورة ثقافية شملت الكون بأسره، فاتسعت دائرة تناقل الفكر والثقافة، غير أن ما أحدثه الحاسوب وشبكة الأنترنيت أكبر من أن يوصف، من بين تحديات هذه الثورة المعلوماتية الانقلاب الكبير في طرائق تلقي العلم والمعرفة التي تنوعت وأصبحت أكثر إثارة"[10]
والنص الرقمي على اختلاف مضامينه لم يتسن له أن يرى النور "لولا عدة عوامل مهدت لهذا الميلاد، فالرقمية لم تنشأ من العدم، فقد كانت وليدة عصر اتجه العالم فيه إلى العولمة، والتكنولوجيا والانفتاح اللامحدود بفضل شبكة الانترنيت، هذه المستجدات المفروضة شكلت مرتكزا للنص الرقمي وحفزت على ظهوره وأمدته بالوسائل اللازمة، كما كانت جزءا منه إن على مستوى البناء أو الموضوع"[11]
ب- التكنولوجيا:
تجمع الدراسات على أن التكنولوجيا هي ذلك "التفاعل الحي بين الإنسان والأدوات اللازمة لتطبيق المعرفة بهدف حل المشكلات، وإيجاد نمط من البهجة والمتعة وتنمية الوعي بما ينفعه شر والتوزيع، في الحياة"[12]، فالتكنولوجيا في عصرنا الحالي هي الرابط الحقيقي بين الإنسان والمادة المعرفية، فهذه المادة لن تصبح في متناول الإنسان إلا من خلال امتلاكه للأجهزة والوسائل التكنولوجيا المعرفة اليوم بالحاسوب وشاشات العرض وإيصالها بما يسمى بالأنترنيت.
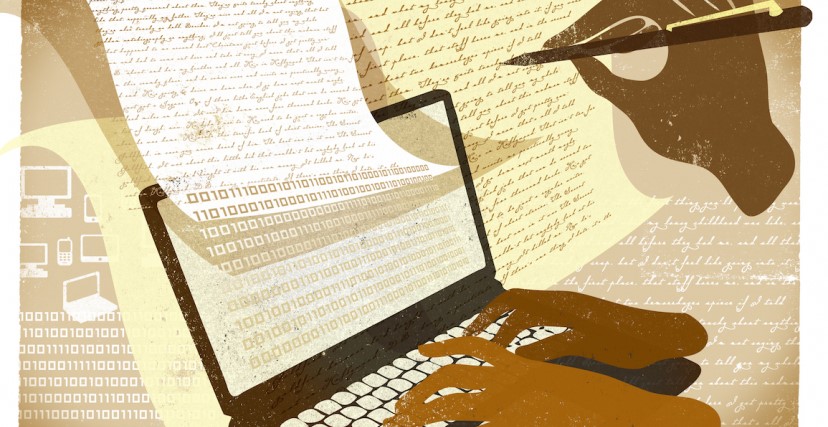
تبرز أهمية التكنولوجيا في المجال الثقافي من خلال الإضافة التي تقدمها للعمل الأدبي، حيث أنها " لم تعد ترفا بل هي طرف فيه، إذ إنها فعل مؤثر في أدائه وتكوينه"[13]، فالنص الأدبي استفاد من كل المعطيات والوسائط التكنولوجية، ففي ضوء ذلك لم يقتصر دور التكنولوجيا في نقل الادب إلى القارئ، بل أصبحت عنصرا فاعلا في إنتاج النص الأدبي وتوسيع نطاق تلقيه، وهذا الواقع فرض على أهل الأدب أن يمتلكوا الثقافة التكنولوجية الكافية التي تؤهلهم لنشر نصوصهم عبر هذه التقنية، على الرغم من أن تحقق هذا الأمر في ساحتنا العربية يبدو أمرا مستعصيا نوعا ما، وذلك راجع على حد رأي سعيد يقطين إلى العجز وعدم القدرة على الاستجابة لضرورات العصر ومواكبته إلى عوائق مادية وفكرية "ويبدو العائق المادي في هيمنة الأمية... أما العائق الفكري فيتمثل في هيمنة التقليد وخشية الذوبان في الفكر الآخر، ويبدو ذلك بجلاء في كون بعض التصورات الثقافية السائدة ما تزال تربط الإنجازات الثقافية والتكنولوجية ذات البعد الإنساني بالغرب، وخاصة أمريكا، وترى في ذلك مبررا لاتخاذ موقف معارض لها"[14]، فنبذ كل ما هو غربي المنشأ أحدث قطيعة معرفية مع متطلبات العصر الرقمي صارفين النظر عن كل الامتيازات التي يمكن أن تقدمها هذه التكنولوجيا للأدب وللحياة الثقافية بشكل عام.
هذا ويرى آخرون أن التحجج بالعائق الفكري ما هو إلا إضمار للعجز المادي والماثل أساسا في الأمية بمعطيات التكنولوجيا وعتادها ومن ثم عدم القدرة على مسارة التطور الحاصل في العالم برمته "فالمشكلة التي يتوقف عندها عدد من المهتمين بفحص العلاقة بين الكتابة الأدبية والوسائل التكنولوجية هي أن عددا قليلا فقط من جملة الكتاب العرب حتى الآن على الأقل يجيدون استخدام الحاسوب، أو يلمون بمهاراته الأساسية، بالإضافة إلى ما يمتلكونه من موهبة الكتابة الأدبية"[15]، والبعض الآخر لجأ إلى الاستعانة بخبراء الحواسيب في إخراج نصوصهم رقميا على الرغم من بعد هؤلاء التقنيين عن مجال الأدب إلا أنهم يساهمون في بناء هذه النصوص الأدبية.
ج- الأنترنيت:
تعتبر الأنترنيت INTERNET الوسيلة الأساس في لسيرورة العصر الرقمي وهي اختصار ل INTERNETWORK التي تعني شبكة للاتصالات حول العالم أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 لغرض عسكري وبعد انتهاء الحرب الباردة تحولت إلى شبكة مدنية واسعة الانتشار وعلى نطاق عالمي "حيث تتدفق أنهار المعلومات والبيانات دون انقطاع في حركة بالغة السرعة تقاس بأجزاء من الثانية وتساعد المرء على الانتقال إلى مكان ما والعيش فيه بكل تفاصيله وأبعاده دون أن يبرح مكانه"[16]، فالأنترنيت قلصت جهود مستعمليها واختصرت عليهم الزمن من خلال التوصل بالمعلومة في ظرف وجيز "فالبيانات الخام يمكن تحويلها إلى معلومات ثم بعد ذلك يمكن أن تصل إلى مستوى المعرفة عن طريق جهد وقيمة مضافة، هذه المعرفة هي أساس الحكمة"[17] إلا أن الأنترنيت جعلت الوصول إليها فائق السرعة.
وللإفادة فإن جهاز الحاسوب لوحده وعلى الرغم من قدرته الفائقة في حفظ المعلومات وتخزينها إلا أنه يبقى قاصرا على التفعيل والتجديد في حال عدم اتصاله بشبكة الأنترنيت، فقد "ظلت العلاقة بين الكمبيوتر ومصادر المعلومات وشبكات الاتصالات ذات طابع تبادلي مع ضمان الاستقلال الذاتي، أو شبه الذاتي لكل هذه العناصر الثلاثة، حتى جاءت الانترنيت لتدمج بينها بصورة مذهلة أحدثت ثورات حقيقية على جميع الأصعدة"[18]، لذا توصف الأنترنيت اليوم بأنها العنصر المفعل للمعلومات في جهاز الكمبيوتر من جهة، ومن جهة أخرى العنصر الناقل للمعلومات بين البشرية جمعاء من جهة أخرى، "والواقع أن شبكة العنكبوت التي انفرد الانترنيت(دون سواه من مستجدات تكنولوجيا سابقة) بتوسيعها لدرجة تغطيتها شتى أنحاء المعمورة لا تتميز فقط بكونها وفرت شروطا تقنية لربط ملايين الحواسيب ببعضها البعض أو بكونها كانت وراء بروز بروتوكولات في الاتصال جديدة،ـ ولكن أيضا وبالأساس لأنها نجحت في دمج مختلف شبكات الإعلام والاتصال التي كانت إلى وقت قريب مستقلة وإلى حدا ما متنافرة"[19].
إشكالية وجود أدب تفاعلي:
عرفت مسألة الاعتراف بوجود أدب رقمي الكثير من الأخذ والرد وفي هذا السياق تدافع زهور كرام عن أحقية وجود هذا النوع الكتابي الجديد في الساحة الأدبية، حيث ترى أن لكل زمان تصوره الخاص وأن الأدب الرقمي ما هو إلا نتيجة للتطور الذي وصله الإنسان في عصره الحال وأن هذا الأدب لم يأتي من فراغ بل هو امتداد لما سبقه "فما يحدث في المجال التخييلي الرقمي ليس قطيعة بقدر ما هو عبارة عن تغير سؤال الأدب من منتجه المباشر المؤلف/ الكاتب إلى قارئه"[20]، باعتبار أن الأدب الرقمي هو "انتقال سياقي وبنيوي ولغوي وأسلوبي في الظاهرة الأدبية"[21]، ويتحقق هذا الطرح أكثر منذ "أول متغير يصادفنا عند تأملنا لهذه التجربة الأدبية هو الرقمي باعتباره وسائط تكنولوجية وإلكترونية بها يتشكل النص الأدبي"[22]
انقسم القارئ العربي إلى فريقين،" ليس على مستوى العامة فقط بل تعداه إلى المثقفين، فمنهم من ركب القاطرة وساير الركب تأليفا أو تنظيرا، ومنهم من أبدى تحفظات حول هذا القادم الجديد، لأن كل جديد غري مستهدف، وأن كل مشروع إبداعي جديد لابد وأن يتعرض للرفض والاستنكار في بدايته، ولكل فريق مبرراته"[23]، من مبررات الفريق الأول أن "هذا الأدب يعبر تعبيرا حقيقيا وصادقا عن العصر الحالي، حيث انه يتخطى النمطية ويتجاوز الجمود من خلال فتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار، تتصل بمجالات عديدة بوسائل متنوعة خاصة ما يعرف بالوسائط المتعددة، كما أنه يبوئ القارئ مكانة مرموقة تماثل مكانة المبدع بل ربما تتعداها، مما يخلق قدرا كبيرا من الحيوية والتفاعل بين أطراف العملية الإبداعية[24]
كما يؤكد هذا الفريق على ضرورة الاندماج في الحركة العالمية الجديدة وإلا اتسعت الفجوة الرقمية الحاصلة وبقينا على هامش الحضارة، ففي هذا الصدد ترى زهور كرام أن: "الانخراط في الأدب الرقمي هو مطلب حضاري بامتياز، وليس نزوة، او موضة أو شيء من هذا القبيل، والمسألة محسومة معرفيا وثقافيا وأنثروبولوجيا، فبالعودة إلى مختلف الأشكال التعبيرية القديمة والحديثة أيضا، سنلاحظ انها وحددها التي عبرت عن قدرتها على احتضان معنى وجود الإنسان في كل مرحلة تاريخية"[25].
يقول السيد نجم في حديثه حول قضايا ومفاهيم الإبداع الرقمي الجديد: "لقد أثارت الثورة الرقمية ومازالت تثير عددا من القضايا والمفاهيم، ولا حيلة أمامنا نحن العرب إلا أن نتفاعل معها ومحاولة فهمها، بل والسعي نحو الإضافة إليها، لقد جاوزتنا الثورة الصناعية ولم نشارك إلا كطرف مستهلك فقط، أما الثورة الرقمية بما تتضمنه من مفاهيم وعناصر، فيمكننا اللحاق بها، لنصبح ضمن الدول المشاركة والمنتجة لعناصرها ومعطياتها، وإن سبقنا في ذلك بعض البلدان التي ظننا أنها لا تقدر عليها، فقط ليس أكثر من الفهم لمعطياتها، والصبر على العمل بها، بل والإضافة إليها"[26]
أما مبررات الفريق المشكك في نجاعة هذا اللون الإبداعي الجديد، الذي هو بحسب آرائهم جنس هجين لا يمكن تصنيفه، فهو غريب عن العملية الإبداعية، وأن فكرة مشاركة المتلقي المبدع في إبداعه هو سلب لحق المبدع، كما انه يعتبر تعديا صارخا على حقوق الملكية الفكرية، فمثلا يقول سعيد الوكيل: "النوايا الطيبة لا تكفي لان تصنع نوعا أدبيا جديدا، أقوول هذا ليكون تعقيبا مبدئيا-لا يخلو من مرارة- على ما دأبت عليه الصحافة العربية (المطبوعة والإلكترونية) في الفترة الأخيرة، من مطالعتنا بالتبشير بميلاد أدب عربي جديد وبداية عصر الواقعية الإلكترونية ، وبأن بعض أدباءنا اخترع في إبداعه الادبي تقنية رواية الواقعية الرقمية بل وصل الامر إلى حد الإعلان عن الحاجة إلى مدرسة نقدية توائم بين أبجديات النقد التقليدي وتقنيات الكتابة الرقمية بأدواتها الحديثة والتي تشكل الكلمة احد عناصرها فحسب، وهذه كلها لعمري أضغاث احلام"
يقول الأديب السوري حسين سليمان عن تجربة الواقعية الرقمية: "لقد غمرني إحساس حين قرأت عن التجربة حوالي سنتين مرفقا بأحد المقاطع من الرواية الرقمية التي كتبها الكاتب، ان هناك قصورا في إدراك ماهية الادب باعتباره يقوم على الكلمة المكتوبة فقط، عن كانت على الشاشة ام على الورق، فالكلمة المقروءة وفي اضعف حالاتها (المسموعة منها) هي ما يقوم عليها الادب، الادب ابن الميثولوجيا، السحر، الذي قام بالأصل على الكلمة، وليس على الكلمة والصورة، كما في كتب الاطفال التي تساعد على فهم الكلمة عن طريق استخدام الصورة"[27]
كما يشكك حنا جريس من فائدة الكتاب الإلكتروني ومن ثمة النص المترابطـ، حيث يعدد بعض عيوبه، فيقول: "الكتاب الإلكتروني ليس أكثر من مجموعة من العلاقات والروابط الكامنة بين نصوص مختلفة، والتي تحيل القارئ إلى علاقات اخرى، مما يقلل من عمل الذاكرة إلى حد بعيد، إلا انه في الوقت نفسه يشتتها، وهذا هو الخطر الحقيقي للهيبرتكست، كما أن الكتاب الإلكتروني يظل كيانا افتراضيا لا يستطيع القارئ الإمساك به لأنه ليس كتابا حقيقيا"[28]
[1] محمد يوسف الهزايمة، العولمة الثقافية واللغة العربية(التحديات والآثار)، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2012، ص33.
[2] عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة(تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة)، المركز الثقافي العربي، لبنا ن، المغرب، ط1، 2012، ص33.
[3] جوزف طانيوس لبس، المعلوماتية واللغة والأدب والحضارة(الرقم والحرف)، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط1، 2012، ص63.
[4] أمجد حميد التميمي، مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي، كتاب ناشرون، لبنان، ط1، 2010، ص24.
[5] نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ع265، 2001، ص44.
[6] منال بن حميميد، النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي، رسالة دكتوراه، إشراف: د/ نور الدين سيليني، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 2017/2018، ص19
[7] جمال قالم، النص الادبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، رسالة ماجستير، إشراف: أحمد حيدوش، معهد اللغات والادب العربي، المركز الجامعي البويرة، 2008/2009، ص45.
[8] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، (كتاب إلكتروني)، ص116، رابط التحميل: http://www.arab-ewriters.com/booksFiles/5.pdf
[9] السيد نجم، النقد الرقمي ومواصفات الناقد الرقمي، نشر بتاريخ: 20 مارس2019، اطلع عليه بتاريخ: 15 فيفري2023، http://www.ech-chaab.com/ar
[10] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص35.
[11] منال بن حميميد، النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي، ص17
[12] إبراهيم أحمد ملحم، الرقمية وتحولات الكتابة(النظرية والتطبيق)، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2015، ص28.
[13] عبد الرحمان بن حسن المحسني، توظيف التقنية في العمل الشعري السعودي منطقة الباحة نموذجا، النادي الأدبي الباحة، السعودية، دط، 2012، ص13.
[14] سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2005، ص24.
[15] فاطمة البريكي، الكتابة والتكنولوجيا، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، لبنان، ط1، 2008، ص35.
[16] أحمد فضل شبلول، أدباء الأنترنيت أدباء المستقبل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، ط2، دت، ص23.
[17] جووست سمايرز، الفنون والآداب تحت ضغط العولمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط1، 2005، ص109
[18] نبيل علي، نادية الحجازي، الفجوة الرقمية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ع318، 2005، ص170
[19] فاطمة كدو، أدب COM، (مقاربة للدرس الأدبي الرقمي بالجامعة، دار الأمان، الرباط، دط، دت، ص17.
[20] زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط1، 2009، ص27.
[21] المرجع نفسه، ص34.
[22] م نفسه، ص34.
[23] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2006، ص129- 133
[24] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص87
[25] حسن سلمان، الأدب الرقمي يشاهد ويسمع ويقرأ معا مجلة اتحاد كتاب الأمنترنيت، لوحظ بتاريخ : 12 أفريل2023، على الساعة 12:23 https://ueimarocains.wordpress.com/
[26] السيد نجم، الثقافة والإبداع الرقمي.. قضايا ومفاهيم، نشر بتاريخ: 22 أكتوبر2008، لوحظ بتاريخ12أفريل2023 على الساعة 16:45، http://www.alkalimah.net/Articles/Read/1584
[27]حسين سليمان، محمد سناجلة والكتابة الرقمية وتغييب مفهوم الأدب، صحيفة القدس العربي، نشر بتاريخ 23 نوفمبر 2006، لوحظ بتاريخ: 13 أفريل 2023، على الساعة 10:19، https://www.alquds.co.uk/
[28] حنا جريس وآخرون، مستقبل الثورة الرقمية، سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي الكويتية، الكويت، 15 كانون أول- يناير 2004، ص128.
-
العصر الرقمي، التكنولوجيا، الأنترنيت، الثورة الرقمية، الرقمنة
-
منتدى خاص بالمحاضرة الأولى
-
المحاضرة الثانية:
الأدب الرقمي
تمهيد:
عرف الأدب الرقمي(التفاعلي) العديد من الإشكالات في الساحة النقدية والأدبية إن على المستوى المصطلحي أو على المستوى المفاهيمي، كون هذا الادب يجمع بين ثلاثة عوالم(العالم الواقعي، العالم التخييلي، العالم الافتراضي)، بالإضافة إلى كونه أحد مفرزات الحداثة والعولة وما نتج عنها من ثورة إلكترونية أذهلت العالم، وقد استطاع هذا الأدب أن يجمع بين ما هو لغوي وغير لغوي حيث تكاتفت فيه مختلف عناصر التواصل كالإلقاء واللغة الإشارية ولغة الجسد ونبرات الصوت، وللإفادة فإن هذه العناصر كان لها الأثر البليغ في تحويل الملتقي من متلق سلبي إلى متلقي إيجابي يمتلك السلطة الكافية التي تجعله فاعلا ومشاركا في إنتاج النص، وهذا الأمر هو ما يبرر تسمية هذا النمط من الأدب بالأدب التفاعلي وهي كلمة تحمل في مدلولها التشارك بين طرفين أو أكثر .
مصطلح الرقمية:
عرف النص الادبي أشكالا مختلفة للتعبير عنه بدءا من المشافهة إلى الكتابة فالرقمية، كما "رافقت ظهور النص خلال سيرورته الزمنية حوامل عديدة كالحجارة المنقوشة، الرقع، الدفاتر، الآلة الكاتبة، آلات الطباعة، وأخيرا معالجة النصوص، فبعد أن كان المبدع كاتبا أضحى مهندسا فنيا ومؤسسا فعليا لخطاطة النص بأبعادها الثلاثية فيما يشابه الصناعات السينمائية أو الإخراج المسرحي، وبين هذا النص الفاعل والنص المنقول إلينا عبر قنوات التكنولوجيا الناقلة له في صيغها الإلكترونية جسر بين الثبات والتحول وبين السكون والحركة، بل بين الهدوء والفاعلية"[1].
قد يتراءى للقارئ في البدء أم مصطلح الرقمية هو نفسه مصطلح الرقمنة غير أن هذا المصطلحان وإن كان ينتميان إلى مجال معرفي واحد إلا أن " الرقمية هي صناعة نصية، تمنح النص حق الحياة في ديمومة من التفاعل بين مكنوناته ومتلقيه، وفي هالة من حالات الإنتاجية اللامتناهية بينما الرقمية هي نقل وتحويل مصادر المعلومات في متونها من صيغها الورقية إلى التكنولوجية"[2]
وللإفادة فإن الرقمية تعتبر النص الأدبي بمثابة "أرضية خصبة لتشيده بناءات وهندسات مختلفة يبنيها المبدعون ويهدمها المتلقون ليبنوها كما يبتغون، فعصر العولمة بحاجة إليها في تحدي مساراته الإبداعية والتكنولوجية اللامحدودة"[3]
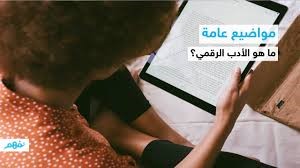
مفهوم الأدب التفاعلي:
اختلف الدارسون للأدب التفاعلي(الرقمي) في ضبط مفهوم موحد له وذلك راجع إلى اختلاف الترجمات باعتباد أن هذا الأدب هو وافد غربي النشأة، ففي دراسة قدمها فيليب بوطز عرف الأدب الرقمي على أنه "كل شكل سردي او شعري يستعمل الجهاز المعلوماتي وسيطا ويوظف واحدة او اكثر من خصائص هذا الوسيط"[4]
أما سعيد يقطين فيعرف الأدب الرقمي بأنه الأدب الذي "لا يختلق إبداعا ولا تلقيا إلا من خلال الحاسوب الذي تحقق نتيجة التطور الحاصل على مستوى التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل"[5]، وفي كتابه (النص المترابط ومستقبل الثقافية العربية نحو كتابة عربية رقمية) اصطلح عليه (الأدب الجديد)، حيث يقول عنه: "أدب جديد يشق طريقه الخاص مقدما بذلك ممارسة جديدة هي الآن بصدد تشكيل تاريخها المتميز"[6]
كما ترى فاطمة البريكي وهي أحد أهم المهتمين نقديا بهذا النوع الأدبي الجديد أن هذا الأخير هو محصلة تزاوج الأدب بالتكنولوجيا حيث تقول عنه: هو "الأدب الذي يوظف معطيات التكنولوجيا الحديثة في تقديم جنس أدبي جديد يجمع بين الأدبية والإلكترونية ولا يمكن أن يتأتى لمتلقيه إلا عبر الوسيط الإلكتروني أي من خلال الشاشة الزرقاء"[7]، غير أن صفة التفاعل التي ألحقت بهذا النوع من الأدب لا تتحقق إلا من خلال شرط أساسي قد سبق أن حددته فاطمة البريكي من خلال قولها "ولا يكون هذا الأدب تفاعليا إلا إذا أعطي المتلقي مساحة تعادل أو تزيد عن مساحة المبدع الأصلي للنص"[8].
وللإفادة فإن "العلاقة التفاعلية لم تعد ثنائية، زوجية محصورة بين العمل الفني والجمهور بل إنها تمتد إلى عدد كبير من المتلقين، هنا يؤاخي الإبداع الفني بين العديد من (الشركاء المؤلفين) حيث أن كل فاعل أمام حد التواصل يغزل خيطه داخل نسيج الشبكة العنكبوتية الهائلة التي يقوم كل إنسان رقمي بنسجها"[9]
ولا يختلف هذا الطرح عما قاله جميل حمداوي حيث يرى أن هذا النوع من الأدب "يهتم بالعلاقة التفاعلية التي تنشأ بين الراصد والنص على مستوى التصفح والتلقي والتقبل وتخضع هذه العلاقة لمجموعة من العناصر التفاعلية الأساسية هي النص والصوت، والصورة، والحركة، والمتلقي، والحاسوب، مع التشديد على العلاقة التفاعلية الداخلية( العلاقة بين الروابط النصية)، والعلاقة التفاعلية الخارجية (الجمع بين المبدع والمتلقي)[10] ، مع العلم أن جميل حمداوي يفرق بين مصطلحي الأدب التفاعلي والأدب الرقمي الذي يميل لتبنيه لكونه أكثر ارتباطا بالوسيط الإعلام وعليه فإن الأدب التفاعلي يركز على استخدام وسائل التكنولوجيا ويفيد مما توفره من معطيات التواصل ويرتبط بالمتلقي ارتباطا تفاعليا، يختلف عما كان سائدا في النصوص الورقية الكلاسيكية، مكتسبا خصائص جديدة .
وفي دراسة قدمها سعيد علوش بعنوان "تنظير النظرية الأدبية من الوضعية إلى الرقمية) قدم مهادا نظريا حول هذا النمط الكتابي الجديد(الأدب الرقمي) وأشار إلى أنه "يرصد حقله انطلاقا من علاقته بالتقنية المستعملة"[11] وفي ذلك إشارة صريحة إلى أن هذا الأدب يستمد خصوصيته المميزة انطلاقا من ارتباطه الوثيق بالحاسوب وملحقاته.

إن أفضل تعريف جامع مانع لما سبق قوله يعود لسعيد يقطين يقول فيه: "هو الإبداع الذي يعتمد أولا اللغة أساسا في التعبير الجمالي، وهو بهذه الصفة يلحق بمجمل الخطابات الأدبية التي يسير في نطاقها" فهو ينطلق في تعريفه هذا من الركيزة الأولى لهذا النوع من الأدب ألا وهي اللغة، ثم يربط وجود هذا الأدب بالتقانة الرقمية التي يتيحها الحاسوب حيث يقول: "وبما أنه يوظف على مستوى إنتاجه وتلقيه ما يقدمه الحاسوب كوسيط وفضاء أيضا من عتاد وبرمجيات ومن إمكانيات، فإنه يعتمد إلى جانب اللغة علامات أخرى غير لغوية صورية أو صوتية أو حركية"[12] تتفاعل وتترابط فيما بينها .
وبالتالي يمكن القول أن الأدب الرقمي هو علامات متعددة تنسجم فيما بينها اعتمادا على الترابط الذي يعتبر "عنصرا جوهريا لوصل وربط العلاقات بين مختلف هذه العلامات والمكونات التي يتشكل منها هذا النص الرقمي ربطا يقوم على الانسجام والتفاعل"، حيث تتداخل في النص الأدبي الرقمي العلامات اللغوية مع العلامات غير اللغوية(الصورة، الموسيقى، الحركة...إلخ) إلى درجة تصبح فيها هذه العلامات " قابلة لأن تندرج في بنيته التنظيمية الكبرى وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها مشكلا نصا متعدد العلامات"[13]
وعليه يمكن القول إن "النص الأدبي في طوره الإلكتروني عبارة عن لوحة فسيفسائية تجمع بين النصوص في كافة أحوالها، المكتوب منها، والمسموع والمرئي، في حالاته الثابتة والمتحركة، وتتسم هذه اللوحة الفسيفسائية الإلكترونية بقدرتها على إقامة علاقات التداخل والتشابك بين النصوص المختلفة المتضمنة فيها، على ما تنطوي عليه من تنوع وتعدد، بالإضافة إلى المرونة في الانتقال بين المواد النصية وغير النصية"[14]
أما عمر الزرفاوي في كتابه الموسوم بـ: مدخل إلى الأدب التفاعلي فيعرفه كالآتي: "هو الجنس المتخلق من رحم التقنية قوامه التفاعل والترابط، مستثمرا إمكانات التكنولوجيا الحديثة ويشتغل على تقنية النص المترابط ويوظف مختلف الأشكال المتعددة"[15].
وفي ذات السياق يعرف العيد جلولي الأدب التفاعلي في مقال له بعنوان (نحو أدب تفاعلي للأطفال) بأنه "جنس أدبي جديد له خصائصه الكتابية والقرائية وله أشكاله الأدبية، فهو أدب مختلف في إنتاجه وتقديمه عن الأدب التقليدي، وهو لم يكن ليظهر لولا التطورات التي شهدتها وسائط تكنولوجيا الاتصال وخاصة الحاسوب الإلكتروني، وفي هذا الأدب لا يكتفي المؤلف باللغة وحدها بل يسعى إلى تقديمه عبر وسائط تعبيرية كالصوت والصورة والحركة وغيرها"[16]
ولعل أقرب التعريفات إلى الدقة والوضوح هو التعريف الذي قدمه جميل حمداوي في دراسته الموسومة( الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق ، نحو المقاربة الوسائطية) يقول فيه: "الأدب الرقمي هو أدب آلي حسي مرئي وبصري أكثر مما هو أدب تجريدي... يمتح وجوده من عالم الوسائط السمعية والبصرية ما دام يقوم على الصوت والنص والصورة والحركة"[17]
وللإفادة فإن الكثير من الباحثين يصنفون كل أدب ينشر عبر صفحات الويب ضمن الأدب الرقمي من بينهم سيد نجم حيث يرى أنه ينتمي إلى الأدب الرقمي "كل نص ينشر نشرا إلكترونيا سواء كان على شبكة الأنترنيت أو على أقراص مدمجة أو في كتاب إلكتروني أو غيره، متشكلا على نظرية الاتصال في تحليله وعلى فكرة التشعب في بنياته"[18]، فهو يجمع بين خصائص النص الكلاسيكي والمعطى الوسائطي وبالتالي يجمع بين الوظيفتين الجمالية والرقمية
إشكالية المصطلح:
عرف الأدب التفاعلي العديد من المصطلحات، وتختلف هذه المصطلحات بحسب المرجعيات والترجمات التي استمد منها هذا الناقد أو ذاك مفاهيمه حول هذا الادب، لهذا عرف هذا الأدب على المستوى الاصطلاحي الكثير من الخلط واللبس ليس بين الناقدين فحسب، بل حتى عند الناقد الواحد حيث نجد ناقدا مثلا يستعمل جملة من المصطلحات التي تدلل على هذا الأدب على سبيل الترادف وتارة أخرى نجده يفرق بينها كما هو الحال عند زهور كرام حيث جاء في كتابها(الادب الرقمي، أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية) "أن الأدب الرقمي أو المترابط أو التفاعلي الذي يتم في علاقة وظيفية مع التكنولوجيا الحديثة لاشك أنه يقترح رؤى جديدة في إدراك العالم"[19].
ومن جهة أخرى تستعمل الناقدة نفسها مصطلح (الرقمية) فقط، في توصيفها لهذا النوع الكتابي الجديد إيمانا منها بأن النص فيه "يصبح نسيجا من العلامات التي لا تجعله يخضع لوضع قائم وثابت، وإنما نصيته تتحقق من حيويته"[20] ، في الحقيقة فإن الناقدة وإن استعملت مصطلح الرقمية فإن هذا لا ينفي تركيزها على أهم خصائص أو بالأحرى وظائف هذا النمط الكتابي الجديد متمثلة في وظيفتي التفاعل والترابط.
من المصطلحات الموظفة للتعبير عن هذا الأدب الجديد أيضا مصطلح الأدب التفاعلي وهو مصطلح يدل على المشاركة، وقد استعمل هذا المصطلح كل من إدريس بلمليح في دراسته الموسومة بـ: (القراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة)، وفاطمة البريكي في مؤلفها (مدخل إلى الأدب التفاعلي) هذه الأخيرة حاولت أن تقدم أهم خصائص هذا الأدب التي جمعتها في قولها: "يقدم الأدب التفاعلي نصا مفتوحا بلا حدود، إذ يمكن أن ينشأ المبدع أيا كان نوع إبداعه نصا ويلقي به في أحد المواقع على الشبكة ويترك للقراء والمستخدمين حرية إكمال النص كما يشاؤون" [21] ومن هنا تتضح لنا سبب تسمية هذا الأدب بالتفاعلي لأنه يسمح للملتقي بالمشاركة في إنتاج هذا النص، ومن هنا نستنتج أن المتلقي لهذا الأدب يمتلك حرية كافية تسمح له بالتفاعل مع روابط النص التي تتضمن شفرات النص تساعده في استكناه مكونات النص وغوامضه، وهذه العملية تحتاج بالضرورة إلى قارئ حصيف ومرن له دراية كافية بعالم الرقمنة والتكنولوجيا، ومن شروط تحقق مصطلح (الأدب التفاعلي)[22]:
- أن يتحرر مبدعه من الصورة النمطية التقليدية لعلاقة عناصر العملية الإبداعية ببعضها.
-أن يتجاوز الآلية الخطية التقليدية في تقديم النص الأدبي.
- أن يعترف بدور المتلقي في بناء النص، وقدرته على الإسهام فيه.
- أن يحرص على تقديم نص حيوي، تتحقق فيه روح التفاعل، لتنطبق عليه صفة (التفاعلية)لم يتوقف الأمر عند حدود استعمال مصطلح الأدب الرقمي والأدب التفاعلي بل تعداه إلى استحداث مصطلحات أخرى جديدة من بينها (الأدب المعلوماتي) الذي يعني به سعيد يقطين "الجامع لمختلف الممارسات التي تحققت من خلال علاقة الأدب بالحاسوب والمعلوميات"[23]
ومن جهة أخرى نجد من الدارسين من يوظف مصطلح الأدب الإلكتروني "الذي يشدد على عملية اشتغال الوحدة المركزية ومجمل العتاد المصاحب ذي التقنية المعلوماتية"[24]، وفي هذا الصدد يؤكد لنا سعيد يقطين أن هذا المصطلح هو الأقدم من حيث الاستعمال في فرنسا وبالحديد في الفترة الممتدة ما بين 1980- 1990 وقد أشار إلى أن الأدب سمي كذلك لأنه يؤكد على الطبيعة التكنولوجية واشتغال الوسيط"[25].
من المصطلحات التي دخلت حيز الاستعمال للتعبير عن هذا الأدب أيضا نذكر مصطلح الأدب السيبرنطيقي نسبة إلى السيبرنطيقا التي تعرف بأنها "العلم الذي يوجه البحث في قواعد التواصل والتطبيقات التقنية المرتبطة بها، كما ارتبطت السيبرنطيقا أحيانا بتعريف الذكاء وقياسه وشرح وظائف المخ وصناعة آلة التفكير وتتطابق السيبرنطيقا مع مشروع للمعرفة يتمحور حول المراقبة الفعالة والتطبيق الناجح مما جعلها ذات جانب تقني أساسا"[26]، وهي حين ترتبط بالأدب فإنما تعني "ذلك الترابط الحاصل بين مكونات العمل الإبداعي والوسائط المتعددة، التي تعمد إلى تنظيمه من خلال عمل الآلة ، هذه الأخيرة التي تعمل على دمج اللغة مع أنساق التعبير الرمزية الأخرى من أشكال وأصوات وفق لمسة ذكاء اصطناعي يجسدها تواصل الإنسان وحواره مع الآلة، وتواصل الآلة وتفاعلها مع غيرها من الآلات"[27]، وبهذا يصبح الأدب السيبرنطيقي هو ذلك النص الأدبي الذي يعالج عبر التقنية والوسائط الرقمية الحديثة التي تسمح بالتحكم في كل جزيئاته تحكما تاما.
إلى جانب هذه المصطلحات يوظف سعيد يقطين مصطلح الأدب المترابط، حيث يقول: "أما النص المترابط فأستعمله كتقابل HYPERTEXTE وهو النص الذي نجم عن استخدام الحاسوب ببرمجياته المتطورة والتي تمثلت في إنتاج النص وتلقيه بحيث تبنى على الربط بين البنى الداخلية والخارجية"[28]، أي أن سمة الترابط تتوسع لتشمل كل النصوص، الصور، الموسيقى، بل إن "الموسوعة البريطانية تؤكد أن الترابط النصي يسمى أيضا HYBERLINKING وفي هذا تأكيد أكبر على مدلول هذا المصطلح وما يحمله من معنى الربط والترابط"[29]، وعليه فإن النص المترابط هو ذلك النص الذي "يتحقق من خلال الحاسوب، ويسمح هذا النص بالانتقال من معلومة إلى أخرى عن طريق تنشيط الروابط التي تتجاوز البعد الخطي للقراءة"[30]
أما عبد الله الغذامي فمن جهته يفضل استعمال مصطلح النص المفرع(المتفرع)، وله في هذا التفضيل مبرراته، حيث يقول: "النص المفرع هو خاصية أسلوبية جديدة... حيث يتفرع المتن الأول للمؤلف الأول إلى متون فرعية تأتي على شاكلة الحواشي والشروحات على المتن"[31]، أي أن النص المفرع هو تسمية تطلق على المعلومات والنصوص والصور والربط فيما بينها.
على العموم إن هذا التعدد المصطلحي الذي أحدث إشكالية في الساحة النقدية كما أحدث خلطا في المفاهيم راجع بالدرجة الأولى إلى البيئة التي ولد فيها (الغرب) لأن كل هذه المصطلحات السابقة الذكر هي ذات أصل أجنبي، هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن إرجاع هذا الإشكالية إلى "غياب التنسيق بين الباحثين والدارسين العرب للمصطلحات في المجالات المعرفية المختلفة"[32] مما فتح المجال على مصراعيه "للاجتهادات الفردية وفسح المجال أمام المنطق الشخصي لكل ناقد لتوليد المصطلحات واختيار الألفاظ التي يرتئيها مما يفقد المصطلح حمولته الموضوعية" إذ أصبح لكل ناقد أو باحث مبرراته التي ينطلق منها في اختياره لمصطلح دون غيره للتعبير عن الأدب الرقمي(التفاعلي) .
مكونات العملية الإبداعية:
أنتجت علاقة التزاوج الحاصلة بين الأدب والتكنولوجيا تغيرات جديدة في طبيعة مكونات العملية الإبداعية او ما يسمى قديما بعناصر عملية(المبدع، النص، المتلقي)، فبمجرد الاستعانة بالتقانة الرقمية التي تتيحها وسائل التكنولوجيا أصبح لدينا ما يسمى بـ: (المبدع الرقمي، النص الرقمي، الملتقي الرقمي)

من المبدع الورقي إلى المبدع الرقمي:
إن المبدع في العرف النقدي هو أهم أطراف العملية التواصلية باعتباره المنتج الأول للنص الأدبي وإليه ينتسب ذا الأخير، وتحول هذا المبدع من الورقية إلى الرقمية أفضى إلى تحول باقي مكونات العملية الإبداعية، وفي هذا السياق تقول فاطمة البريكي: "ويبدو من هذا أن كون المبدع ورقيا أثر على العملية الإبداعية، وطبعها بملامح خاصة، لم نكن لنشعر بها أو نميزها دون أن يظهر شكل آخر يمكن أن تتجلى من خلاله عناصر العملية الإبداعية الثلاثـة، وهو الشكـــل الإلكتروني الذي اصطبغت به منذ حوالي ربـع قــرن مــن الزمــان أو يزيد"[33]
لخص الدارسون جملة من الفروقات بين المبدع الورقي والمبدع الرقمي نوجزها في النقاط التالية[34]
Ø لا يصل المبدع الورقي إلى جمهوره، إلا عبر مجموعة من المؤسسات تمثل دور السلطة والوسيط بينه وبين قرائه نحو: دور النشر، المؤسسات الأكاديمية والثقافية والنقاد.. في حين نجد المبدع الرقمي يصل إلى جمهوره دون أية سلطة من تلك السلطات التي يمر عبرها المبدع الورقي، نظرا للإمكانات الهائلة التي تتيحها شبكة الإنترنت، بحيث يمكن لأي شخص أن يصبح مبدعا رقميا ينشر أعماله، فيتفاعل معها القراء في أي مكان، مباشرة بعد اتصالها بشبكة الإنترنت.
Ø إن المساحة التي يتحرك فيها المبدع الورقي محصورة جدا، إذ تتسع فقط للأدباء والشعراء والروائيين المشهورين، الذين بإمكانهم إيصال إبداعاتهم للقراء بسهولة، في حين نلفي الأدباء والشعراء اللامشهورين يعانون من تجاهل دور النشر وغيرها لإبداعاتهم التي لا تصل إلى القرا، أما المبدع الرقمي، فإنه يتحرك في مساحة شاسعة يتيحها الفضاء الشبكي، ما دام يتعامل مع قراء افتراضيين، فالكل سواسية أمام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، نجد ما ينشره المبدع الرقمي يصل إلى مختلف أنحاء المعمور، متيحا الفرصة لأكبر عدد من القراء للتفاعل مع نصوصه.
Ø ومن جانب آخر، يتميز المبدع الرقمي بكونه يتعدد بتعدد المؤلفين الذين يساعدونه في الإخراج، وأيضا بتعدد القراء الذين يتفاعلون مع نصه، من خلال مشاركاتهم عبر المساحات التي يتركها لهم لبناء النص وإعادة إنتاجه من جديد، ويتضح هذا الأمر جليا مع أغلب نصوص الإبداع التفاعلي الرقمي، في المقابل نجد المبدع الورقي غير متعدد، لأنه هو صاحب النص وهو الذي يكتبه دون مساعـدة أو مشاركة أحد.
Ø إن التعددية التي يتسم بها المبدع الرقمي على مستوى الإنتاج والتلقي، جعلته يؤثر بشكل مباشر على طبيعة المتلقي، الذي أصبح بدوره مبدعا عبر مشاركته في بناء النص وإعادة إنتاجه.
2.1 من القارئ الورقي إلى القارئ الرقمي:
إن وجود مبدع رقمي يفرض بالضرورة وجود ملتقي رقمي يمتلك سلطة لا تقل عن السلطة التي يمتلكها المبدع في إنتاجية النص، حيث أن انتقاله من الورقية إلى الرقمية أتاح له فرصة التفاعل والمشاركة، وفي ما يلي عرض لأهم الفروقات بين الملتقي الورقي والمتلقي الرقمي:[35]
Ø تفرض على القارئ الورقي عدة قيود، تحد من خياراته القرائية تجاه النصوص الورقية التي تخضع مثلا لسلطة دور النشر والتوجه الديني والسياسي والثقافي السائد في بلد الجهة الناشرة، في حين، نجد القارئ الرقمي متحررا لا يخضع لأية قيود أو سلطة أثناء تفاعله مع النصوص الرقمية المتصلة بشبكة الإنترنت، إذ يختار منها ما يريد وبالطريقة التي يشاء، إما قراءة أو سماعا أو مشاهدة أو يجمع بين كل هذه العناصر، مثلما هو الحال مع رواية الواقعية الرقمية "شات" أو أدب الواقعية الرقمية "صقيع" لمحمد سناجلة، دون أن يجبر على التفاعل مع شيء لا يرغب فيه، حتى وإن كان هو الوحيد المتاح.
Ø يخضع القارئ الورقي في الغالب لنظام القراءة الخطية الثابتة التي تفرضها النصوص الورقية، عكس القارئ الرقمي الذي يكسر نمط القراءة الخطية، نظرا للإمكانات الهامة التي تتيحها النصوص الرقمية للقارئ الرقمي، حيث يمكن له التجول بحرية في فضاءاتها واختيار المسالك القرائية التي يريدها دون شروط، حيث "إن السمة الجوهرية التي يبنى بها النص المترابط تكمن في (لاخطيته)، إنه نص غير خطي لأن القارئ يختار المسارات التي يتعين عليه اتباعها وهو يتعامل مع النص الجديد (النص المترابط) الذي يقرأ، ومعنى ذلك أن هناك (تفاعلا) بين بنيات النص والقارئ الذي يختار وهو يقرر ما يقرأ"[36]
Ø جد القارئ الورقي مجموعة من الصعوبات للحصول مثلا على كتاب صدر حديثا في بلد أجنبي غير بلده الذي يقطن فيه، حيث يتطلب وصوله وقتا طويلا، ويمكن ألا يصل إليه لسبب أو لآخر، وبالتالي يصبح عامل الوقت خارج سيطرته، أما القارئ الرقمي، يصبح عامل الوقت ملكا له وتحت سيطرته، لأنه يجد عدة كتب متوفرة ومتاحة عبر شبكة الإنترنت التي يستطيع التجول في فضاءاتها وأخذ ما يريده في وقت سريع وقليل، علاوة على ذلك، هناك مكتبات رقمية تتوفر على كتب تراثية قد تكون طبعاتها نفذت. لكن مع ذلك يمكن للقارئ الرقمي الحصول عليها في تلك المكتبات بسهولة. في حين القارئ الورقي لا يستطيع الحصول بسهولة على كتاب ورقي قديم نفذت نسخته.

Ø ظل القارئ الورقي مستهلكا لزمن طويل. لكن بعد ذلك أصبح قادرا على التفاعل مع النصوص الورقية بقدر محدود لا يتجاوز الفهم والتأويل والنقد، أما القارئ الرقمي نجده أكثر تفاعلا مع النصوص الرقمية، نظرا للمساحات المهمة التي يتيحها له المبدع الرقمي في نصوصه، إذ يمكنه المشاركة في إنتاج النص من خلال تقديم اقتراحات أو القيام بتعديلات، في هذا الإطار تقول زهور كرام: "والذي يمنحه شرعية الشراكة في التأليف، هو طبيعة النص التخييلي الرقمي الذي باعتماده الروابط، وانفتاحه على تعددية اختيار البداية، مع احتمال الخروج من النص دون الانتهاء من قراءة كل تمظهراته، هي التي تجعل من فعل القراءة باعتبارها اختيارا لبداية معينة، وتنشيطا للروابط، وإمكانية تجديد قراءات/ زيارات الروابط بشكل مختلف، فعلا منتجا/ مؤلفا للنص"[37]
من النص الورقي إلى النص الرقمي:
يتجلى الفرق بين النص الورقي والنص الرقمي كالآتي:
Ø إن اعتماد التقانة الرقمية في النص الأدبي أحدث تغيرا كبيرا لم يعهده النص الورقي سابقا من بينها اللاخطية التي أصبحت سمة بارزة في النص الرقمي، وهذا من شانه ان اتاح للمتلقي الرقمي حرية اختيار نقطة البداية التي يريد الانطلاق منها لقراءة النص الرقمي، على عكس النص الورقي الذي يفرض على الملتقي قراءة خطية يسلك فيها مسارا تعاقبيا في تتبع الأحداث من البداية إلى النهاية
Ø ينتهي النص الورقي بمجرد صدوره في هيئة كتاب، فلا يمكن إضافة أو تعديل أو تصحيح أو تنقيح أي شيء فيه، إلا بعد صدوره في طبعة أخرى، أما بالنسبة للنص الرقمي، فإنه قابل باستمرار للتعديل والإضافة من طرف القارئ الرقمي، لأن النص الرقمي معد سلفا لذلك من طرف المبدع الرقمي، مثلا نص "صقيع" الذي يفسح المجال للقارئ الرقمي للمشاركة والتفاعل معه.
Ø يتميز النص الورقي بوصفه أحادي العلامة، حيث إن إنتاجه لا يتطلب سوى المعرفة بقواعد الكتابة وتقنياتها، عكس النص الرقمي الذي يتسم بتعدد العلامات، فهو يمزج بين الكتابة والصوت والحركة والصورة والمشهد السينمائي والرسم.. وتتطلب عملية إنتاجـه، إضافة إلـى المعرفـة بقواعد الكتابة وتقنياتها، معرفة بالمعلوميات وما يصاحبها من عتاد وبرمجيات، علاوة على ذلك نجد النص الرقمي معد سلفا للتلقي على جهاز الحاسوب عبر اتصاله بشبكة الإنترنت، أما النص الورقي فهو يعد للتلقي بواسطة الكتاب، حتى وإن تمت معاينته على شاشة الحاسوب، فإنه لا يعدو أن يكون سوى نص إلكتروني مرقم، تنتقل مادته من الورق المكتوب إلى مادة معاينة على شاشة الحاسوب فقـط، دون حدوث تغيير يذكر ما عدا تغير الوسيط الحامل للمادة المكتوبة وهذا ما يؤكده سعيد يقطين بقوله: "إن عملية الترقيم عملية تحويل النص المقروء (المطبوع) أو المسموع (الشفوي) ليصبح قابلا للمعاينة أو السماع من خلال شاشة الحاسوب. ومن ثمة في الفضاء الشبكي. فعندما أقدم على كتابة نص أو تسجيل صوت شاعر أو قطعة موسيقية، وأقوم بتحويل كل ذلك إلى الحاسوب بواسطة برامج خاصة أعدت لذلك، أكون عمليا أضطلع بعملية ترقيم لأجعل النص قابلا للتداول في الفضاء الشبكي أو من خلال أقراص محددة. أما عندما أنتج نصا ليتلقى على الشاشة موظفا كل الإمكانات التي تجعله مستجيبا للمعاينة، تكون أمام كتابة رقمية، لأنني منذ البداية، فكرت في إنتاج نص رقمي، ووفرت له كل الشروط الملائمة لذلك"[38]
Ø يتألف النص الورقي من بنيات وعلاقات تربط بين تلك البنيات، فتصبح بذلك قراءته قراءة خطية أفقية، في حين يتشكل النص الرقمي من عقد وروابط تربط بين تلك العقـد، فتصير قراءته قراءة لا خطية تعتمد عـلى اختيارات القارئ الرقمي للمسالك أو المسارات التي يريدها والتي تربط بين عقد النص وأجزائه وبنياته.
Ø يخضع النص الورقي إلى سلطة ورقابة دور النشر، فلا تجد جميع النصوص الورقية طريقها للنشر، لأن الأمر يرتبط بمدى شهرة مبدعيها أو عدم شهرتهم، في حين يجد النص الرقمي مجالا كبيرا للنشر، على اعتبار أن النص الرقمي في اتصاله بالفضـاء الشبكي يفتـح أبوابه لجميع المبدعين مهمـا تفاوتت درجـة شهرتهم، وهذا ما يوضحه محمد أسليم بقوله: "النص الالكتروني يتميز برحابة الفضاء المحيط به مقارنة بالنص الورقي، الذي قد يواجه الإقصاء، ظلما في أحيان كثيرة، بسبب وجود الرقيب، أو بيروقراطية جهاز النشر، أو سوء تقدير دار النشر.. إلخ، أما إلكترونيا، فتجد جميع الأعمال فضاء رحبا للتداول، وبالتالي، قد ينجح كاتب ما في إعلان نفسه كاتبا انطلاقا من الشبكة، فتجد أعماله طريقها للنشر الورقي بعد ذلك"[39]
[1] صفية علية، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، أطروحة دكتوراه، تخصص: أدب جزائري، إشراف: د. علي عالية، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة بسكرة، 2014/2015، ص237.
[2] المرجع نفسه، ص237.
[3] صفية علية، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، ص238.
[4] فيليب بوطز، ما الأدب الرقمي؟ ترجمة: محمد أسليم، مجلة علامات المغربية، ع35، ص108.
[5] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية(نحو كتابة عربية رقمية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، المغرب، لبنان، ط1، 2008، ص180.
[6] المرجع نفسه، ص180.
[7] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص49.
[8] المرجع نفسه، ص183.
[9] إدمون كوشو، أسئلة النقد في الإبداع الرقمي، ترجمة عبده حقي (2008). مجلة اتحاد كتاب الانترنت المغاربة، نشر بتاريخ 8 أكتوبر2008، أطلع عليه بتاريخ: 17 ماي 2023 على الشاعة 14:23 https://ueimag.blogspot.com/2018/10/blog-post_99.html
[10] جميل حمداوي: الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق (نحو المقاربة الوسائطية) كتاب إلكتروني صدر عن شبكة الألوكة، ط1، 2016، ص14.
[11] سعيد علوش، تنظير النظرية الأدبية من الوضعية إلى الرقمية، مطبعة البيضاوي، الرباط، المغرب، ط1، 2013، ص 335.
[12] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية، ص190.
[13] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية، ص149.
[14] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص183.
[15] عمر الزرفاوي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، مجلة الرافد دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ع56، ط1، 2013، ص194.
[16] العيد جلولي، نحو أدب تفاعلي للأطفال، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع10، 2011، ص184.
[17] جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق ، نحو المقاربة الوسائطية، ص 15.
[18] السيد نجم، النشر الإلكتروني والإبداع الرقمي، الهيئة العامة لقصور الثقافة،ـ القاهرة، مصر، ط1، 2010، ص40.
[19] زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، ص22.
[20] زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، ص50.
[21] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص50.
[22] سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، ص9-10
[23] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية، ص183.
[24] المرجع نفسه، ص184.
[25] فيليب بوطز، ما الأدب الرقمي؟ ص108.
[26] محمد مريني، النص الرقمي وإبدالات النقل المعرفي، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، ط1، 2015، ص38.
[27] نبيل علي، نادية حجازي، الفجوة الرقمية (رؤية عربية لمجتمع المعرفة)، ص309.
[28] سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، ص19
[29] ستي جباري، الأدب الجزائري وفضاء الأنترنيت (آليات الإبداع وتفاعلية القراءة)، فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2018، ص74.
[30] جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق، ص12.
[31] حسام الخطيب، الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع، دار الثقافة والفنون، الدوحة، ط2، 2011، ص118.
[32] إيمان يونس، مفهوم مصطلح(هايبر تكست)، في النقد الأدبي الرقمي المعاصر، مجلة المجمع، مجمع اللغة العربية، الأردن، ع6، 2012، ص36.
[34] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص137-138.
[35] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص139-140.
[36] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، ص60.
[38] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، نحو كتابة عربية رقمية، ص141.
[39] محمد أسليم، المشهد الثقافي العربي في الانترنت (قراءة أولية)، نشر بتاريخ: 12/12/2003، اطلع عليه بتاريخ: 23/01/2023، على الساعة 12:19 http://www.addoubaba.com/aslim.htm
-
التفاعل، التكنولوجيا، المتلقي الرقمي، النص الرقمي، المبدع الرقمي، الحاسوب، الوسائط
-
منتدى خاص بالمحاضرة الثانية
-
الكتابة الأدبية التفاعلية
يعتبر العالم تيد نلسون t. nelson أول من وظف مصطلح النص المترابطhypertexres عام 1968 ، وقد سبق أن عرفه بأنه: "توليفة من النص اللغوي الطبيعي مع قدرات الحاسب الآلي للتشعيب التفاعلي أو العرض الديناميكي"[1]
كما نجد من الدارسين من يعود بالفكرة إلى بداية الثلاثينيات من القرن الماضي عندما استخدم فانيفارش حاسبات تناظرية وروابط بين الوثائق وأطلق على هذه الآلة تسمية ميمكس (memex)، كما يرجع آخرون فكرة النص المترابط إلى أوائل الستينات في القرن الماضي عندما قامت جماعة (دوجلاس انجلبارت douglas engilbert)، ببناء نظام حاسب آلي يتيح للمستفيدين التصفح بين أجزاء النص[2]
أما عند العرب فإن فكرة النص المترابط موجودة في نصوص تراثية كثيرة، تجسده تلك الحواشي والهوامش في المخطوطات، كذلك أخذت بعض القصائد التراثية العربية صيغة الترابط في شكل شجرة أو ساعة أو سمكة...إلخ، فقدن بعض الشعراء نصوصا وسمت بـ(الشعر الهندسي)، وهو مصطلح واحد يحاول به واضعه أن يشمل في كنفه عددا من المصطلحات السابقة التي رأى أنها جزئية وتفتقد إلى الشمولية مثل (الشعر الشجري)، (الشعر الدائري)، وغير ذلك، في هذا النمط من النصوص الشعرية (الأدبية) يقوم الشاعر بالرسم بالكلمات، فينتج قصيدة على شكل مربع، أو دائرة، او وردة، أو شجرة أو خاتم أو غير ذلك... وهو ما يعرف بالاشتغال الفضائي الدال، والذي يعني "تلك الأشكال التي لا تقف عند مجرد العرض البصري التجسيمي الذي تتحكم فيه مقتضيات صوتية ونظمية، بل تتجاوز ذلك إلى توظيف الاشتغال الفضائي للنص، من أجل خلق إمكانات متعددة للقراءة"[3]
وهو بهذا أيضا يستثمر الورق كأداة لينتج نصا لا يقدم الكلمة فقط، بل الكلمة والشكل أيضا، سواء كان دور الشكل جوهريا في النص أو شكليا فقط، وقد واجه هذا النوع من النصوص الكثير من النقد واتهم بالتصنع والتكلف، وغياب الإبداع الفطري، وهذا الرأي لا يخلو من الإجحاف"[4]
وفي هذا السياق يرى عبد الله الغذامي في تقديمه لكتاب مدخل إلى الأدب التفاعلي لفاطمة البريكي أن "النص المتفرع خاصية أسلوبية جديدة ربما كان لها شواهد قديمة في الشروح على المتون والحواشي المتفرعة، وما كان يسمى حاشية الحاشية، مما هو من الممارسات الشائعة لدى علمائنا الأوائل حيث يتفرع المتن الأول للمؤلف الأول إلى متون فرعية تأتي على شاكلة الحواشي والشروح على المتن"[5]
لكن هذا الترابط هو شكل مبسط جدا إذا ما قورن بالنص الرقمي المترابط الذي يجمع اللغة المطبوعة السائلة مع الصوت والصورة والملمس وحتى الشم والذوق والحدس في كتلة مادية مجازية يحركها الخيال"[6].
واجه الأدب التفاعلي العديد من التحديات لا سيما في الوطن العربي بعضها داخلية متعلق بخصائص الأدب التفاعلي في حد ذاته، وبعضها له علاقة ببعض العوامل الخارجية، وعلى العموم يمكن إيجاز هذه التحديات في ما يلي:
التحديات الداخلية
إن الفارق الحاصل بين الكتابات الأدبية الرقمية ونظيرتها الورقية المطبوعة يشكل عقبة أمام ذيوع الأدب الرقمي واتساع مساحة تلقيه في العالم العربي، وعليه فإن هذا النمط الكتابي الجديد يحتاج إلى متسع زمني كافي حتى يستسيغه القارئ العربي ويترسخ في ذهنيته خاصة أنه يمتلك خصائص مستحدثة غير معهودة في الأدب الورقي، وعلى أي حال فإنه ليس غريبًا أن "يواجه الأدب الرقمي، خاصة وأنه لا يوال في طور التبلور، الكثير من الهجوم والتصدي وحتى الرفض، لدرجة جعلت بعض المتعصبين للقلم والورقة يشونون هجومًا حادًّا على الأدب الرقمي مدّعين بأن الكلمة هي العمود الفقري للنص الأدبي وأن الوسائط المتعددة تؤدي إلى تراجع القيمة الفنية للنص وتفقده الكثير من غوايته كما تسلبه أحد أهم أركانه وهو عنصر التخييل"[7]
عوامل ثقافية اجتماعية
شكل العامل الثقافي والاجتماعي هو الآخر حجرة عثرة أمام اتساع رقعة الأدب الرقمي في الساحة العربية، ذلك لأن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي هي في الأصل احتشاد سنوات من الأفكار والعادات والقناعات، الأمر الذي يجعل عملة اقتلاعها من جذورها أو العبث فيها أو إجراء تعديلات أو تغييرات فيها أمرا بالغ الصعوبة، لا سيما إذا كان ذلك على أيادي أجنبية (العالم الغربي)، وبما أن الأدب الرقمي جاء بمفاهيم ومعطيات مغايرة في أشكال الكتابة والتلقي لما هو ماثل في الذهنية العربية فإن مسألة تقبله ستأخذ حيزا زمنيا طويلا، لأنه في نظر الإنسان العربي مجرد سلعة مستوردة لا تتناسب مع معطياته الثقافية التي لا تستند أساسا على الأسس التكنولوجية المعروفة في العالم الغربي، لهذا فإن الإنسان العربي يعتبر كل تجديد هو مساس بتراثه الأدبي وعاداته الكتابية والقرائية على حد سواء ومن ثم فإن هذا التجديد هو تهديد لهويته الثقافية.
إن استجابة العالم العربي لهذا النمط الكتابي الجديد يتطلب دون شك إجراء تغييرات فعالة في ثقافة المجتمع العربي، وفي آليات التفكير، لأن التحدي الكبير الذي وقع فيه الأدب الرقمي في العالم العربي يكمن في أن الإنسان إن لم يكن تكنولوجيا فإنه من الصعب أن يفكر تكنولوجيا، وفي هذا الصدد يصرح سعيد يقطين بأنه: "لا يعقل أن ندخل عصرًا جديدًا بأفكار قديمة وبلغة قديمة … لقد بدأت علاقتنا بتكنولوجيا الإعلام والتواصل عن طريق استيراد هذه التكنولوجيا، وبدأنا نتعامل معها وكأنها فقط قطع غيار أو وسائل نعوض بها غيرها، لكنّنا بمنأى عن استيعاب حركية هذه التكنولوجيا في نمط التفكير والحياة ونتجاوز كونها وسيلة جديدة، فلم نفكر فيها بالصورة التي تحدث تحولا على مستوى تعليمنا وتربيتنا وإنتاجنا الأدبي والفني ونقدنا الأدبي والفني وثقافاتنا والعلوم التي ما نزال لم نعمل على ترسيخها وتجذيرها في تربيتنا العربية[8].
عوامل بحثية نقدية
إن اختلاف الخصائص بين الأدب الرقمي المستورد من الغرب وبين الأدب الورقي في العالم العربي على اختلاف أجناسه وأنواعه الأدبية أصاب الممارسة النقدية بشيء من الإرباك لأنه لا يمكن إخضاع كلا الأدبين إلى نفس القراءة النقدية وأي محاولة دون ذلك هي ممارسات نقدية تعسفية لن تغني النص الأدبي الرقمي في الشيء وتسيء له أكثر مما تحسن إليه، وحتى إذا حاولنا بناء نظرية نقدية تتواءم وهذا النمط الكتابي الجديد فإن هذا يتطلب تراكما في النصوص الادبية الرقمية وهذا ما تفتقر إليه الساحة العربية خاصة وأننا نوقن تماما أن النقد هو رديف الإبداع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سابقا له.
وعلى العموم فإن وضع النقد الرقمي الغربي مازال يعاني تأزما صريحا كونه حقلا غضا على الرغم من كل التطورات الحاصلة في العالم الغربي لذا قدم إدموند كوشو (Edmond Kyushu) دعوة صريحة إلى وجوب تأسيس نظرية للنقد الرقمي تواكب الإبداع الرقمي وتنطلق من الإعدادات المنهجية التقنية بغية تأسيس نقد مختلف لم يوضع بعد[9]
يسنده في هذا الرأي ميموت تالان( (Talan (Memmottالذي صرح بأننّا "بتنا بالفعل في أمس الحاجة إلى مدارس ومذاهب نقدية جديدة تلائم خصائص النص الرقمي، لأن الأدب الرقمي آخذ بالانتشار والتطور يومًا بعد يوم، لكن لا توجد حتى الآن نظريات ومدارس نقدية تعنى به، وتحدد أصوله ومفاهيمه ومصطلحاته. ويضيف تالان أن من يرغب أن يقدم نقدًا كهذا، عليه أن يشارك بشكل فعال في الثقافة الرقمية، ويسهم فيها، إذ لا يستطيع من هو خارج هذه الثقافة أن يقدم نقدًا لها[10] ولعل ما ذهب إليه ميموت تالان يلخص الأزمة التي يعيشها الأدب الرقمي في العالم العربي أيضا.
وحتى في العالم العرب هناك من النقاد من يتفق مع ما ذهب إليه إيدموند كوشو وميموت تالان من بينهم محمد رمضان بسطاويس إذ يدعو هو الآخر إلى ضرورة إلمام الناقد بتفاصيل التقنية، لأن التكنولوجيا المعاصرة أضافت إمكانيات جديدة أدت إلى استحداث قيم جمالية جديدة لم تكن موجودة ولم تتطرق لها المذاهب والنظريات الكلاسيكية القديمة[11]، ويضيف بسطاويس: "إن الناقد اليوم مطالب بالاستعانة بكل العلوم والأدوات البحثية المتاحة في فهم النص الأدبي المركب الذي يقدم عبر أدوات الاتصال"[12]، فالنص الأدبي الرقمي في نظر الناقد أصبح كائنًا في العلاقات الداخلية للوسيط الجمالي المستخدم، فهو يتمثل في العلاقة بين الألفاظ والصور والأخيلة المستخدمة في القصيدة، ويتمثل في العلاقة بين الألوان ودرجاتها وأبعادها، ومستويات التشكيل البصري أو السمعي[13].
وإلى جانب هذا كله نلحظ غيابا تاما للمؤسسات الأكاديمية في العالم العربي التي تهتم بهذا الأدب الجديد وتشتغل عليه نظريا وتطبيقيا مقارنة بنظيره الغربي الذي خصص له مواقع ومجلات الكترونية أجنبية متخصصة بالرعاية النقدية للأدب الرقمي وكذا نشر الأعمال الأدبية والدراسات العلمية الخاصة به فقط.
خصائص الأدب التفاعلي:
يتشابه الأدب الرقمي مع الأدب الورقي في أن كلاهما يتكونان من نفس عناصر العملية التواصلية (المبدع، المتلقي، النص)، غير أن للنص الرقمي خصائص تميزه عن نظيره الورقي، ويمكن إجمال هذه الخصائص في مايلي:
أولا- سرعة الانتشار:
إن آليات توصيل الكتاب الورقي إلى قارئه هي آليات بطيئة تعرف الكثير من المعوقات مقارنة بالآليات المعتمدة مع الأدب الرقمي لأن ذلك تعتمد أساسا على قدرة الناشر على طبع أكبر عدد من النسخ وتوزيعها إلى كافة انحاء العالم مع مراعاة الحيز الزمني الذي يمكن أن تستهلكه لهذه العملية، في حين أن توصيل الكتاب الرقمي إلى قارئه يعتبر عملية هينة تتطلب ظرفا زمنيا وجيزا وقياسيا كونه يعتمد على الحاسوب والأنترنيت كوسيط بين المبدع والمتلقي، وفي هذا الصدد يقول أحمد فضل شبلول: "إنني كأديب عربي بعد امتلاكي لجهاز الحاسب الآلي واشتراكي في شبكة الإنترنت العربية(العالمية) أستطيع أن أرسل نصوصي الأدبيّة... إلى المهتمين بالأدب وعالمه وقضاياه، وذلك عبر ما يسمى بالبريد الإلكتروني داخل جهازي، وعبر الشبكة، وفي ثوان معدودة يصل النص الإبداعي إلى كل هؤلاء المهتمين[14].

" وفوق هذا استثمر النص إمكانات البرامج الرقمية من روابط وصور ثنائية وثلاثية الأبعاد وعقد وأزرار مختلفة الملامح تجعل من النص الادبي الرقمي جسدا متشعبا متمردا على كل الانماط الخطية التقليدية بمعنى لم تعد للنص بداية ولا نهاية بل هناك مفاصل ومفاتيح متعددة لولوج فضاءات مفتوحة، فهو يُقرأ ويُسمع ويُشاهد وتمتزج فيه مختلف الأشكال التعبيرية، فأصبحت من أهم خصائصه الترابط، فوسم بالنص المترابط"[15]
ثانيا- التفاعل:
إن التفاعل مع النص الورقي يكاد يكون محصورا في الأعمال النقدية المنجزة حوله ، أو في تلك الحوارات الصحفية التي تجرى مع الأديب نفسه، أو في اللقاءات التي يمكن أن تحدث بين المبدع وفئة متلقيه صدفة، أو في جلسات البيع بالتوقيع في المعارض والصالونات الأدبية، وهي أشكال تفاعلية ضئيلة جدا ما قورن الأمر مع النص الرقمي، حيث يحظى هذا الأخير بتفاعل مباشر مع متلقيه، وفي هذا الصدد أعرب الكثير من الأدباء من إعجابهم بهذه العملية لأن نصوصهم الأدبية شهدت نسب تفاعل مثمرة وغير معهودة من خلال إبداء الرأي فيها، من بينهم روبرت كاندل وبوبي ربيد، هذا الأخير الذي أشار إلى أنَّه وجد تجاوباً وتفاعلاً مع نصوصه الرقميَّة بالنقد والتعليق والمراجعة، وذلك إلى درجة يعجز فيها عن الردِّ على كلِّ هذه التعليقات التي تصل إليه عبر البريد الإلكتروني، وقد تبلغ أحياناً آلاف من الرسائل أسبوعيَّا[16]، وللإفادة فإن سعة التداول هذه وما ينجر عنها من تفاعل من شأنها إثراء النص، وتحفيز المبدع على المزيد من الإنتاج.

ثالثاً- إمكانيَّة المشاركة:
يفسح الادب الرقمي لمتلقي مساحة كافية للمشاركة والتفاعل مع النصِّ بدء من طريقة كتابة بعض النصوص المترابطة، والتي تمكِّن المتلقيِّ من التلاعب بترتيب النصِّ وفقاً للطريقة التي تعجبه، إذ لا تُحدِّد له موضعاً للبدء وآخر للنهاية، فالمتلقِّي وحده من يحدد بداية النصِّ ونهايته وترتيب أرجائه الداخليَّة، وهذا ما يُخلِّص الكتابة التفاعليَّة من خطِّيَّة النصِّ الكتابيِّ، كما أنَّ بعض النصوص التفاعليَّة تتيح إمكانيَّة واسعة للمتلقِّي في المشاركة في تشكيل النصِّ بالحذف والإضافة والتعديل، وكلُّ هذا بدعوة من المؤلف الذي ينتهي دوره بنشر النصِّ التفاعليِّ، وللجمهور-بعد ذلك- مطلق الحريَّة في الطريقة التي يتلقَّى بها النصَّ.[17]

وفي هذا الصدد يصرح نبيل علي أن النص الرقمي التفاعلي يتيح للقارئ وسائل عملية عديدة لتتبع مسارات العلاقات الداخلية بين ألفاظ النص وفقراته ويخلصه من قيود خطية النص، حيث يمكنه من التفرع في أي موضع داخله، إلى أي موضع لاحق أو سابق، بل ويسمح أيضا للقارئ عبر تقنية النص الفائق أن يمهر النص بملاحظاته واستخلاصاته وأن يقوم بفهرسة النص وفقا لهواه بأن يربط بين عدة مواضيع في النص ربما لا يراها مترادفة أو مرتبطة تحت كلمة أو عدة كلمات مفتاحية[18]
رابعا- تقديم عرض مصاحب:
إن النص التفاعلي دائما يأتي مصاحبا لمؤثرات رقمية سمعية منها وبصرية تسهم بشكل في فعال في عملية تلقيه، نظرا للأثر الذي تتركه في المتلقي، "فالرواية التفاعليَّة مثلاً قد تستخدم في بنائها الرسوم والجداول والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى، وكلُّ هذه المواد تكون مقحمة في النصِّ التفاعليِّ، لتصبح جزء مهمَّا في بنائه، وبذلك يصبح كاتب النصِّ التفاعليِّ متعدِّد المهام، فلا يكفي أن يكون روائيَّا مثلاً ليكتب رواية تفاعليَّة بل عليه الإلمام بمهارات أخرى كالإلمام بتقنيات الحاسوب والإخراج السينمائي وغيره من المهارات التي تمكِّنه من كتابة رواية تفاعليَّة، وإلا فعليه أن يستعين بمن يمتلك تلك المهارات[19] وقد استطاع محمد سناجلة في أعماله التفاعليَّة الاستفادة من تصميمات الجرافيك، والمونتاج، والموسيقي وتقنيات الميتاميديا الجديدة.[20] ومعه بالتحدي "أصبحت الرواية التفاعلية العربية تستقبل في طبقات مختلفة مؤسسة للمعنى في كل مستوى فالمتلقي لا يحاور مستوى دون آخر، ولا يؤسس للمعنى في مستوى بشكل مستقل إلا ويجد نفسه في محاورة مستوى آخر، فهو يغوص في النص عموديا متلقيا العلامات غير اللغوية (الألوان، الحركة، ...) واللغة وما تحمل"[21]
[1] ناريمان إسماعيل متولي، تكنولوجيا النص التكويني(الهيبرتكست) وتنمية الابتكار لدى الطلاب والباحثين، مجلة كلية التربية، جامعة الإمارات، 1996، ص309.
[2] المرجع نفسه، ص309.
[3] محمد الماكري، الشكل والخطاب، (مدخل لتحليل ظاهراتي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 1991، ص156.
[4] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص91/92.
[5] المرجع نفسه، ص10.
[6] ينظر، عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن(نحو منهج عنكبوتي تفاعلي)، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2006، ص429.
[7] إيمان يونس، تأثير الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحديث، ص 113
[8] سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية(نحو كتابة عربية رقمية)، ص 96-97
[9] إدمون كوشو، أسئلة النقد في الابداع الرقمي، ص99
[10]Voir, Memmott, Beyond Taxonomy: Digital Poetics and the Problem of Reading, New Media Poetics, Contexts, Technotexts, and Theories, London:Cambridge, Massachusetts Talan (2006) .p. 305
[11] محمد بسطاويس، النص الأدبي بين المعلوماتية والتوظيف، آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر العولمة، دار الفكر، دمشق، 2001، ص 157-158
[12] المرجع نفسه، ص 157-158
[13] م نفسه، ص 105.
[14] أحمد فضل شبلول، أدباء الإنترنت أدباء المستقبل، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، ط2، دت، ص27.
[15] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص52.
[16] فايزة يخلف، الأدب الإلكتروني وسجالات النقد المعاصر، الجزائر، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، ع 9، 2013م، ص108- 109.
[17] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص24.
[18] نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ص49.
[19] فايزة يخلف، الأدب الإلكتروني وسجالات النقد المعاصر، ص103.
[20] جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظريَّة والتطبيق، ص 100.
[21] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، مجلة العلامة، م5، ع2، 2020، ص98.
-
المشاركة، التفاعل، الوسائط الرقمية، الأنترنيت، الشعر الرقمي، المشرحية الرقمية
-
منتدى خاص بالمحاضرة الثالثة
-
مظاهر الأدب الرقمي ومجالات التفاعلي
أتاحت التكنولوجيا عبر مختلف وسائطها فرصا لا حصر لها تمكن الأدب من استثمارها والاستفادة منها، حيث تتجلى النصوص الأدبية الرقمية(التفاعلية) في مظاهر عدة حددتها فاطمة البريكي في كتابها مدخل إلى الأدب التفاعلي في ما يلي:
المنتديات الأدبية الإلكترونية:
تفتح المنتديات الأدبية الإلكترونية نافذة للمتلقي تمكنه من تصفح مختلف النصوص الأدبية الرقمية وما يقدم حولها من قراءات نقدية، وهذا من شأنه أن يغني الأديب والمتلقي على حد سواء ويوسع من ذائقة المتلقي ويرفع من مستويات الإبداع وتحسين التجارب الإبداعية، فصلا عن كونها تختزل الزمان والمكان مع حفظ المادة الأدبية المعروضة مادام المنتدى قائما، كما أنها "تخلق فضاء للحوار والإبداع وتداول القضايا، كما تمنح فرصة للتعبير بحرية، والإحساس بالثقة بالنفس، فهي متنفس لدى فئات واسعة رغم بعض النقائص، من حيث المستوى واللغة المتداولة، التي تنحط أحيانا إلى مستويات دنيا[1].

وللإفادة فإن "هذه المنتديات ليست حكرا على الإنترنت، ولا هي نتاج جديد ارتبط ظهوره بظهور هذه الشبكة، بل كانت المنتديات الأدبية معروفة من قبل منذ عرف الأدب، وبعد تطورها مع الزمن أصبحت متاحة للجميع ممن يهتمون بالأدب ، وهي أكثر من أن تحصى، ويتخذ كل منها طريقة وأسلوبا مختلفا في التواصل وتبادل الأدب بفنونه المختلفة، شعرا ونثرا، ويفتح فيها باب النقاش حول النصوص كتابة من خلال المداخلات والتعليقات والنقد البناء."[2]، ومن المنتديات الأدبية العربية نذكر:
- نادي رشف المعاني الأدبية: http://rashf-alm3any.com/rashf
-منتدى القلعة العربي: http://www.al-qal3ah.net/vb/forumdisplay.php?f=21
الصالونات الأدبية الإلكترونية "الحوارية:
الصالونات الأدبية ليست ابتكارا جديدا، بل عرفها الأدب في مختلف الثقافات سواء تحت اسم الصالون الأدبي أو السوق الأدبية... وتتيح شبكة الأنترنت للأدباء والمثقفين والمهتمين بالأدب لأن ينشئوا صالونات يمارسون فيها الحوار الأدبي الحر، بعيدا عن أي قيود قد تفرضها الصالونات الأدبية الواقعية والتي كانت موجودة في عصر ما قبل الأنترنت، كقيد المكان مثلا، الذي يعد أهم فرق بين هين النمطين المختلفين للصالون الأدبي؛ فهو يتم إلكترونيا ويسمح بحضور الأفراد من مختلف أنحاء العالم للجلسات التي تعقد في مكان واحد هو فضاء الشبكة[3].

تعمل هذه الصالونات الأدبية على عقد التواصل بين الشعراء والأدباء وبين متلقيهم بالصوت والصورة من خلال استخدام الكاميرات، كما هو معمول به في الملتقيات والمؤتمرات العلمية التي تعقد عن بعد، وبهذا فإن هذه الصالونات توفر على مستخدميها الوقت والجهد والمال، ومن أمثلة هذه الصالونات نذكر صالون نزال الكعبي النجفي، الذي خصصه لتباذل الشعر صوتيا، ويصرح صاحب الصالون أن يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها أن يكون هذا الصالون مكانا يلتقي فيه الشعراء ومحبو الشعر باختلاف ضروبه لكي يسمعوا النصوص الشعرية مباشرة من أصحابها، وبهذا يجمع شتات الشعراء وجمهورهم، كما يرى أن هذا الصالون يمكن أن يكون مكانا لتعلم العروض بالنسبة للشعراء حديثي العهد بالكتابة الشعرية والذين يجهلون علم العروض وكيفية ضبط الأوزان الشعرية مع امتلاكهم لموهبة شعرية حقيقية، فضلا عن تعرف القراء على الشعراء المغمورين والذين لا يملكون دواوين شعرية[4]
المواقع الأدبية الإلكترونية:
تشير فاطمة البريكي في هذا الصدد إلى أن المواقع الأدبية الإلكترونية "تتنوع بتنوع توجهات مالكيها والقائمين عليها، فبعضها شخصي بشكل كلي، لا يقدم غير الإنتاج الأدبي لصاحب الموقع، وما كتب عنه سواء نشر على الإنترنت، أو غيره من الجرائد والمجلات، فيعاد تقديمه عبر الموقع، وبعضها مؤسساتي تنشئه مؤسسة ما حكومية أو خاصة، وتقدم فيه لإصداراتها إنتاجات أعضائها، وبعضها شخصي من حيث الملكية؛ وعام من حيث المضمون والمحتوى، إذ يقدم الإنتاج الأدبي دون أن يتقيد إلا بكونه أدب اً، وبذلك يمزج فيه بين نتاج مالك الموقع، والنتاج الأدبي الجديد لأي أديب"[5].
وعليه فإننا نلمس نوعين من المواقع، المواقع العامة، أو المؤسساتية، والمواقع الشخصية، "النوع الأول هو عبارة عن مواقع كتاب أدركوا أهمية هذه التكنولوجيا، فأنشؤوا مواقع تعرض إنتاجهم، مثل اتحاد كتاب الأنترنيت العرب، بادرة مهمة للم شتات الكتاب الأنترناتيين، ومن المواقع العربية الرائدة والجديرة بالذكر أيضا(الوراق)، وهو مكتبة رقمية، اختصت بشكل أساسي بكتب التراث العربي والإسلامي، قامت بإنشائها شركة (كوزموس للبرمجيات) وتضم أهم المصادر وأمهات الكتب، فيعتبر الوراق الناشر الوحيد على الانترنيت لكتب الأغاني والطبقات الكبرى والكامل في اللغة والأدب ومئات غيرها، وأهمية الوراق تكمن في أنه يتيح الوصول إلى مجموعة من أهم النسخ الورقية من هذه الكتب، أما المواقع الشخصية فهي مواقع باسم كتاب معينين، ينشر بها الكاتب نتاجه الأدبي والنقدي، كما له أن يختار ما يكتب ويسمح لمن يشاء بالتعليق وإبداء الآراء حول نصوصه، وربما يشركهم في كتابة ما بدأه بشكل تفاعلي، هذه المواقع العامة والشخصية من الكثرة بمكان فلا يمكن الإحاطة بها"[6]

يعتبر موقع مرايا الثقافي "المحاولة الجادة الأخرى التي تعتبر كنواة ممتازة لمكتبة رقمية أدبية هي، والذي قام بإنشائه الباحث اللبناني عدنان الحسيني والشاعر الإماراتي علي بن تميم ويسعى الموقع لجمع الإنتاج الأدبي العربي المعاصر من شعر وقصة ومسرح ضمن موقع واحد"[7]
كما نشير في هذا السياق إلى بعض المواقع المهتمة بالمجال الأدبي خاصة الشعر، منها "موقع جهة شعر" للشاعر البحريني قاسم حداد، وموقع موسوعة الشعر العربي الذي يصدره من مصر الدكتور علي محيلبة، ولعل من أهم المواقع الأدبية (موقع الموسوعة الشعرية) الذي قام بإنشائه (المجمع الثقافي) في أبو ظبي، هذا العمل يهدف إلى جمع كل ما قيل ف ي الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى عصرنا الحاضر، يضم الموقع أكثر من ثلاثة ملايين بيت من الشعر العمودي الفصيح"[8]
المجلات الأدبية الالكترونية:
تعتبر المجلات الادبية الإلكترونية " الشكل الذي يتمثل الأدب من خلاله إلكترونيا، بسيطا ولا يحتاج إلى الكثير من التكنولوجيا ليظهر إلى حيز الوجود، إن النسخة التي يقدمها موقع الجريدة أو المجلة هي عبارة عن نسخة إلكترونية للنسخة الورقية التي تصدر يوميا أو أسبوعيا أو شهرياً، ولا يبذل القائمون عليها غالبا أي جهد إضافي لتقديم النسخة الالكترونية عبر أثير شبكة الإنترنت، ومع هذا تنقسم المجلات المقدمة عبر الانترنت قسمين: قسم منها يقدم نسخة إلكترونية فقط، وقسم آخر يقدم نسخة إلكترونية بالإضافة إلى النسخة الورقية[9].

وهذا ما يؤكده جمال قالم حيث يقول: إننا "نجد الجرائد والمجلات الأدبية المتخصصة كما نجد الصفحات الأدبية في الجرائد والمجلات الإلكترونية، كما نجد بعضها نسخة إلكترونية لأخرى ورقية تصدر يوميا، أو أسبوعيا، أو شهريا، أو غير ذلك، وبعضها الآخر نسخة إلكترونية فقط دون أن يكون لها مقابل ورقي،[10] ومن أمثلة هذه الأخيرة نذكر:
مجلة أفق الثقافية:http://ofooq.com
مجلة ألواح: http://alwah.com
مجلة إيلاف: http://www.elaph.com
وهذه المجلات وغيرها لا تقدم إلى القارئ إلا عبر الوسيط الإلكتروني فقط، إذ لا توجد منها نسخ ورقية، أما المجلات الأدبية التي تصدر نسختين ورقية وإلكترونية، فمنها على سبيل المثال:
مجلة نزوى على الرابط: http://nezwa.com
مجلة الاغتراب الأدبي على الرابط: http://alightirab.cjb.net-
- الكتاب الإلكتروني:
يحتوي الكتاب الإلكتروني على جزأين مختلفين مكملين لبعضهما وهما: آلة القراءة hardware ، ومحتوى الكتاب الرقمي المحمل في الآلة software ؛ وما يجدر ذكره مبدئيا هو أن آلة القراءة، أو الجهاز المادي أصبح واقعا موجودا ومتوفرا في الأسواق بثمن زهيد إلى حد ما، بعد أن كان حلماً، أما المحتوى الرقمي أو المادة الرقمية فيمكن الحصول عليها من بعض المواقع الإلكترونية التي توفر هذا النوع من الكتب، والتي أخذت تشق طريقها في الواقع الافتراضي لتدخل به الواقع الحقيقي في فترة قريبة[11].
ولقد فصلت فاطمة البريكي الحديث عن هذان المكونان حيث نجدها تعرف آلة القراءة بأنها جهاز عرض إلكتروني بحجم الكتاب، تعرض النصوص فيه على شاشة الكريستال السائل، وقد نجح فريق ن الباحثين في شركة )هيولي تبا كارد( في تطوير نموذج أولي لكتاب إلكتروني لديه القدرة على حمل مكتبة بأكملها في جهاز لا يزيد حجمه عن حجم كتاب ورقي، وهو مزود بشاشة وأشرطة لمس حساسة تتيح للقارئ إمكانية التصفح، وتحميل الكتب الإلكترونية على ال جهاز الذي يمكن توصيله بالكومبيوتر العادي[12].
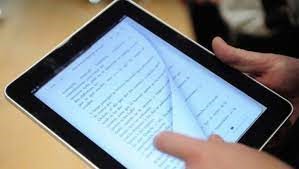
أما المحتوى الرقمي فتعرفه بأنه المادة المحملة من خلال أحد المواقع الإلكترونية، أو دور النشر الإلكترونية، والتي تتيح فرصة الحصول على نسخة رقمية من الكتاب، سواء أكانت له نسخة ورقية أم لا ، وهو أسلوب لقراءة الكتب والمجلات من خلال شاشة الحاسوب وأجهزة اليد المحمولة بطريقة سهلة ومريحة للقارئ، بحيث تحول دور النشر الإلكترونية أعمال الكتاب والأدباء من كتب ورقية إلى كتب إلكترونية يمكن قراءتها عبر برامج على غرار )أكروبات ريدر- Acrobat reader)[13]
[1] جمال قالم، النص الادبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص39.
[2] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص31/32.
[3] ينظر، فاطمة مختاري، خصائص الأدب التفاعلي في رواية ظلال الواحد لمحمد سناجلة، مجلة الباحث، ع14، 2019، ص30/36 .
[4] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص 33/34.
[5] المرجع نفسه، ص37.
[6] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص39.
[7] المكتبات الرقمية تبشر بإغناء محتوى الأنترنيت، أطلع عليه بتاريخ: 28/03/2023 على الساعة14:25، https://www.marefa.org/
[8] موقع الموسوعة الشعرية: https://poetry.dctabudhabi.ae/#/
[9] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص39
[10] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص39.
[11] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص41.
[12] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص41.
[13] ينظر، المرجع نفسه، ص43.
-
المنتديات، الصالونات الأدبية، المواقع الإلكترونية، المجلات الإلكترونية
-
منتدى خاص بالمحاضرة الرابعة
-
المحاضرة الخامسة:
الرواية التفاعلية
لا يخفى على أحد من الدارسين أن الرواية من أكثر الأجناس الأدبية انفتاحا، حيث تمتلك قابلية كبيرة في مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل كما تتيح الفرصة لكافة الإمكانات الرقمية أن تتداخل مع المتن السردي لهذا تعرف على أنها "نص متعدد العلاقات لا يقف فقط عند البعد اللفظي، بل يتجاوزه إلى أبعاد أخرى تتشابك معه وتتضامن في تشكيله، فهو نص الصوت والصورة واللون والحركة ولا يمكن أن تنتج هذه الرواية إلا من خلال الحاسوب"[1]
فمع إطلالة الألفية الثالثة بدأت الرواية العربية أولى محاولاتها في الخروج من جلباب الورقية متجهة نحو فضاء أرحب ومتلق متعدد، فدخلت عالم التكنولوجيا الحاسوبية والفضاء الحر الذي توفره الشبكة العنكبوتية، مستثمرة عددا من البرمجيات مكنتها من تقديم نصها في بنية مختلفة متداخلة الأجناس ومؤسسة لجماليات أخرى لم يعهدها المتلقي العربي[2] وفي هذا السياق يرى محمد سناجلة وهو رائد الرواية التفاعلية في العالم العربي أنها تقدم بناء سرديا مختلفا يعتمد على التقنيات الحاسوبية والوسائط المتعددة لتقديم متنها إلى المتلقي الذي يشارك في بنائها وتتيح له إمكانات مختلفة للقراءة فهي غير خطية، وتحمل أكثر من البعد الثنائي في القراءة، كما أنها غيّرت من مفهومي الزمن والمكان، وقد اقترح محمد سناجلة تصورا خاصا بهذا الجنس عبر مختلف مقوماته خصوصا الزمن والمكان، ويظهر ذلك في كتابه رواية الواقعية الرقمية[3]
وعليه فإن الرواية التفاعلية "تعبر عن عالم جديد، خليط بين مفهوم الخيال الرابط ووجهة النظر الخاصة بالروائي مع استخدام تقنيات أخرى تضيف المعنى وتبرز وجهة النظر للرواية والروائي، وهذه الإمكانات المتاحة سوف تخلق موضوعاتها غير تلك التي طرحتها الرواية الورقية، لذا يعتقد أن الزمن سوف يضيف للرواية الرقمية بجهد روادها ، حتى قد ننتهي إلى شكل جديد آخر، مزيج بين ما نعرفه عن الرواية التقليدية وما أتاحته التقنيات الجديدة والمضافة... خصوصا أننا في بداية الطريق"[4]
ويشار إليها بالتفاعلية لاحتوائها أكثر من مسار داخل بنية النص كما تحتوي على رسومات توضيحية وخرائط، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية و"الصوت والأشكال الجرافيكية فضلا عن النصوص الكتابية الأخرى، كل ذلك عبر منظومة الروابط hyperlink ذات اللون الأزرق، وهذه الروابط هي بمثابة هوامش على المتن وذلك توفيرا للعرض أمام المتلقي لاختيار طريفة التصفح والتحميل والإضافة وإعادة البرمجة"[5]
هذا وتعرفها فاطمة البريكي على أنها نمط من الفن الروائي يقوم فيه المؤلف بتوظيف الخصائص التي تتيحها تقنية النص المتفرع حيث يمكن الربط بين مختلف النصوص سواء أكان نصا كتابيا أو صورا ثابتة أم متحركة أم أصواتا موسيقية معتمدة في ذلك على وصلات لفهم النص"[6]
ظهور الرواية التفاعلية:
إن أول ظهور للرواية التفاعلية كان في العالم الغربي كونه أول من عايش عصر الرقمنة والثورة التكنولوجيا، فكان أول نص روائي تفاعلي بعنوان "قصة بعد الظهيرة" afternoon a story لميشيل جويسmichael joyce سنة 1986، قدم بناءها وفق مختلف التقنيات الحاسوبية والبرمجيات المبتكرة من بين ذلك "برنامج المسرد" storyspace، ثم توالت بعدها النصوص الروائية التفاعلية من بينها رواية "شروق شمس 69" لروبرت أرلانو"[7].
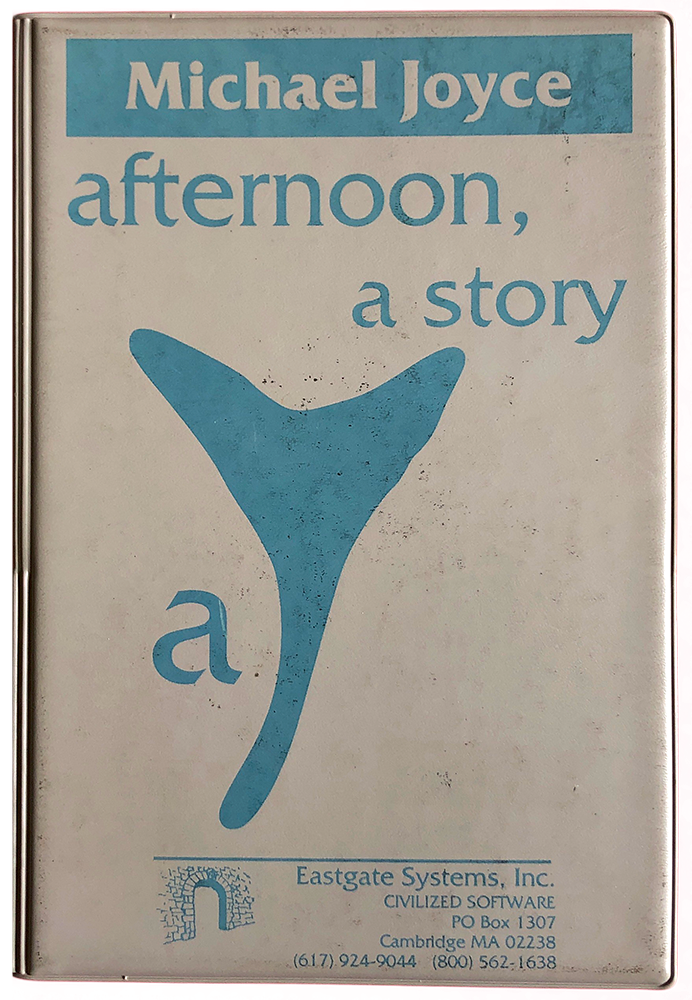
أما ريادة هذ الجنس في العالم العربي فتعود إلى محمد سناجلة من خلال روايته "ظلال الواحد" المنشورة سنة2001، اعتمد فيها مختلف البرامج ولغات البرمجة، والروابط التشعبية وتقديمها على طريقة بناء صفحات الويب[8]، حيث استخدم في بنائها ما يعرف بتقنية النص المترابط(hypertexte) وذلك في البنية السردية نفسها، حيث كان النص ينتقل من رابط إلى آخر في بنية شجرية دائرية، فقد بدأت الرواية على شكل جذر تتشابه اشتباكاته ثم ساق ثم أغصان ثم تكسو الأغصان أوراق لتكتمل الشجرة، وهذه التقنية في الكتابية هي نفسها المستخدمة في بناء صفحات الأنترنيت، كما استخدم فيها بعضا من المؤثرات السمعية والبصرية، هذا بالنسبة للشكل، أما المضمون فقد تمت صياغته بحسب نظرية رواية الواقعية الرقمية وفلسفتها، فالزمن ثابت يساوي واحد والمكان نهاية تقترب من الصفر"[9]
وبعد أربع سنوات أي في سنة 2005 قدم لنا رواية بعنوان "شات" التي لاقت جدلا كبيرا في الساعة العربية نظرا لتأسيسها البنائي وطرحها الجمالي كونها وظفت مختلف الوسائط الرقمية كالصورة، والصوت، والألوان، ناقش فيها المجتمع الرقمي نفسه، حيث أن بطل هذا المجتمع هو الإنسان الرقمي الافتراضي، كما يجلي طريقة عيشه داخل هذا المجتمع، كما يرصد الكاتب من خلال هذه الرواية لحظة تحول الإنسان من كينونته الواقعية إلى كينونته الرقمية الجديدة"[10]،
وفي هذا السياق نجده يعرف الرواية الواقعية الرقمية بأنها "تلك الكتابة التي تستخدم الأشكال الجديدة (اللغة الجديدة) التي أنتـجها العصر الرقمي، وبالذات تقنية النص المترابط ومؤثرات المالتي ميديا(multi midia) أي الوسائط المتعددة المختلفة من صورة وصوت وحركة وفن الجرافيك والأنيميشنز المختلفة، وتدخلها ضمن بنية الفعل الكتابي الإبداعي، وهي أيضا تلك الكتابة التي تعبر عن التحولات التي ترافق الإنسان بانتقاله من كينونته الأولى كإنسان واقعي إلى كينونته الجديدة كإنسان رقمي افتراضي"[11]

هذا وقد نشر سنة 2006 رواية ثالثة بعنوان "صقيع" تابع فيها مشروعه أدب الواقعية الرقمية "غير أن هذا العمل الجديد يختلف عن سابقيه في كون المؤلف يوظف جميع عناصر التكنولوجيا الرقمية لخدمة النص الأدبي الذي يبدو بأنه قصة قصيرة غير أنه يحمل في ثناياه قصيدتي شعر، مكا يجعل القارئ يحار في تحديد ماهية هذا الجنس الأدبي، أضف إلى ذلك أن سناجلة يستخدم تقنية (الوسائط المتعددة) مستعينا بعدد كبير من الصور المتحركة، والمؤثرات الصوتية التي تجعل النص مزيجا بين السرد الأدبي والموسيقى والسينما"[12]

ثم بعدها رواية "ظلال العاشق" وغيرها من الأعمال الروائية التفاعلية التي عمل فيها محمد سناجلة على تطوير تجربته على مستوى النص والبرمجة ودرجة التفاعل[13]
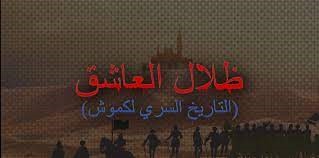
وعلى العموم فإن هذه الاعمال التي قدمها محمد سناجلة "رغم وجودها في البداية إلا أنها قدمت نماذج مهمة عن قدرة السرد العربي على اقتحام التكنولوجيا وتقديم جماليات مختلفة وتحقيق مقروئية معتبرة رغم ازمة البدايات، فلم تعد المسارات الخطية والثنائية البعد في القراءة من ركائزها بل تجاوزت ذلك إلى مسارات اكثر تشعبا تقوم بحكم البناء المتشعب على تداخل الفنون فصار للعلامات غير اللغوية دورا مهما في تقديم متن الرواية التفاعلية الرقمية، كما تمازجت اللغة بالحركة والصوت ولم يعد بالإمكان فصل مكونات السرد والنظر إلى حدود اللغة والبياض، وأصبحت الرواية بذلك عالما مختلفا على ما عهده المتلقي العربي الذي تحول غلى مشارك في البناء ومنتج آخر للنص الروائي التفاعلي"[14]
مقومات الرواية التفاعلية:
إن مقومات الرواية التفاعلية تختلف عن مقومات الرواية الورقية كونها متعددة تتخطى البعد اللغوي "ففي لغة رواية الواقعية الرقمية الكلمة هي جزء من كل، حيث تتشابك مع مختلف العلامات غير اللغوية الأخرى، كالصور والصوت والمشهد السينيمائي"[15]، وهذا التشابك من شأنه أن يضيف إلى النص الرقمي أبعادا دلالية أخرى، فالوسائط الرقمية التي هي أحد مقومات النص التفاعلي ليس مجرد زينة كما يظن البعض وإنما تدخل بصفتها جزء أساسي في بناء الرواية التفاعلية، ولهذا السبب يستحيل نشر الرواية التفاعلية ورقيا لأنها ستفقد جزءا مهما من بنيتها ومن قيمها الجمالية التي تتحقق من خلال ترابط هذه الوسائط مع المتن، وبالتالي فإن هذا البناء بأبعاده الجمالية لا يتحقق إلا من خلال الشاشة، التي بدورها تسمح للمتلقي بالتفاعل الإيجابي وتمكنه إثر ذلك من إثراء النص وإغنائه.
وهذا الأمر من شأنه أن "يطرح مسألة فلسفة البناء التفاعلي للرواية والرهانات الجمالية إبداعا وتلقيا، فالروائي العربي يجب ان يفهم الأبعاد التفاعلية التي تمكنه من تجاوز الورقية وعلى المتلقي في المقابل الانصهار في العملية وتقبل المنتج الجديد والتفاعل معه وتطوير أدوات قرائية جديدة مما يولد جمالية مختلفة تتطور بتطور النص، فالمسألة بهذا متشابكة وكل الاطراف لها وظيفة في تطوير هذا النص وتمكينه في العصر الرقمي الأكثر تشعبا[16]
وفي هذا السياق يرى حسام الخطيب أن بناء الرواية التفاعلية حسب رأيه يظهر مرتبطا بمتغيرات لابد للروائي أن يكون على دراية بها قبل اجتراح فعل الكتابة "أولها نوع البرمجيات التي تتيح له تقديم نصه بكل حمولته اللغوية وغير اللغوية وإمكانات انفتاحه على المتلقي عبر إشراكه في العملية الإبداعية، كذلك متغير التحول من الورقي إلى الإلكتروني، فالنص المفرع نص متعدد الأبعاد في حين أن هيكل النص العادي (الورقي) يكون وحيد البعد[17]
وهذا الطرح يؤكده حمزة قريرة حين يصرح بأن "طبيعة الكتابة المختلفة تجعل من نظام التصوير يختلف والأخيلة تتبدل بل جمالية النص ومعاييرها تتبدى بأشكال أخرى غير الورقية المسطحة والثنائية البعد، كذلك دخول العلامات غير اللغوية كفاعل رئيس في الرواية التفاعلية يضيف للنص الكثير بل يعد مقوما مهما كاللغة في بنائها"[18]
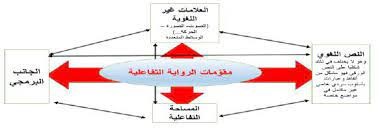
إن أهم عنصر يلفت الانتباه في هذا المخطط هو وجود مساحة تفاعلية تسمح للمتلقي بإعادة إنتاج الرواية التفاعلية ومن ثم قلب أطراف دورة الخطاب التي أقر بها رومان ياكبسون roman jakobson سابقا، ففي الرواية التفاعلية "نكون أمام تحول في العلاقات حيث يتم تحويل المرسل إلى مرسل إليه وبالعكس، بل يتم عكس حدود النص وقلب موازينه، بهذا فنحن أمام تحوير وتشذير للخطاطة مما يمنحنا كل الإمكانات والاحتمالات لكل عنصر منها... إذ يظهر عدم وجود حدود فاصلة بين المنتج والمتلقي فالعملية دائرية ثم تنتقل عموديا وشبكيا لبقية المتلقين فيكفي إنتاج نواة رواية من طرف مبدع ما وطرحها عبر البرمجيات حتى تنتقل إلى التلقي وإعادة الانتاج إضافة وتحويلا، وتستمر العملية في التوالد منتجة فضاءات نصية كثيرة عبر مشارب مختلفة، وهذا يظهر أنه لا وجود لصاحب النص النهائي كما في النصوص الورقية، فالملكية ملغاة في الرواية التفاعلية"[19] وفيما يلي مخطط يوضح كيفية تحول هذه العلاقات:
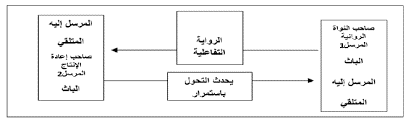
خصائص الرواية التفاعلية:
تتميز الرواية التفاعلية بجملة من الخصائص لعل أهمها "كتابتها الموجزة التي تعمل على مضاعفة طرق تقطيع الخطاب وابتكار طرق جديدة لكسره، كتابة ينكب فيها الروائي على لحظة معينة يقوم بتقديمها بشكل مفصل دون اللجوء إلى الإطناب، بل يركز على حدث معين لا يغادره حتى يفرغ منه، وهذا ما يجعلها تتقدم في شكلها البسيط كفقرات يمكن ولوجها بشكل اعتباطي"[20]، وهذا الطرح من شأنه أن يفتح المجال للروائي الرقمي أن تكون له مستقبلا "قدرة خارقة على اقتحام مجالات أخرى لم تتعود الرواية التقليدية في نسختها الورقية على توظيفها واستثمارها، وهذا هو الذي يؤكد أن الرواية تكذّب من ينظّر لموتها كل مرة، لأنها كائن عجائبي يخلق مرة بعد مرة أرواحا جديدة لكي يستمر"[21]، ومن جملة الخصائص أيضا التي تميز الرواية التفاعلية عن الرواية الورقية نذكر ما يلي:
الانغلاق والنهاية:
يعتبر الانغلاق والنهاية من أبرز خصائص النص الروائي التفاعلي "ولا يقصد بالانغلاق محدودية المعنى أو انحصار أفق التأويل، قدر ما نعني به انحصار النص بين دفتي الكتاب، انحصارا يشعر القارئ بموضع النهاية ويجعله يستشعرها أحيانا بمجرد اللمس، فيتلاشى جزئيا ضغط الأحداث بهذا الإدراك الحسي والمادي للكتاب، ومع النص المترابط تم التخلي عن هذه العكاز وتم استبدالها باللاخطية التي تمكن من قراءة الكتل السردية أو الشذرات بشكل انتقائي"[22]، وعليه أصبح النص الروائي الرقمي منبسطا "يتحرك أمام أعين القارئ، يتركب وينحل، عن طريق الرابط، الذي يقوم بدور كبير في هذا الانزلاق والتركيب والانحلال، لذلك لا يعد هذا الأخير مجرد إجراء معلوماتي يؤمن المرور من فضاء نصي إلى آخر، حال تنشيطه من قبل القارئ، ولا يعد كذلك مقابلا لعملية التوريق أو قلب الصفحات السائدة في الكتاب، بل إضافة سردية تجعل من الإبحار في حد ذاته سردا"[23]، فالرابط حسب هذا الطرح هو بمثابة الواصل المنطقي الضمني في النص الروائي الرقمي.
إخفاء أثر الأوالية التي أنتجت النص:
نقصد بالأوالية اللحظات الأولى لميلاد النص "والنص الكلاسيكي كان يحرص حرصا كبيرا على إخفاء ومحي كل أثر للأوالية التي أنتجته مما كان يسمح بالتمييز بين النص/ الكتاب والنص/ المسودة، لكن مع النص المترابط أصبح بالإمكان الاطلاع على لحظات خلق النص، وعلى المراحل الأولى التي سبقت عرض النص على الشاشة"[24]
تجاوز الإيضاح:
من بين العناصر الواضحة التي تجمع ما بين النص والنص المترابط هي "رغبتهما في تجاوز الإيضاح، لكن نقطة الاختلاف تكمن في كون النص المترابط يسمح بقلب مؤقت أو نهائي للوضع التلفظي، أي: من يتكلم ومن يتلقى، بلعبه على الحدود السردية ما بين الخارج سردي والداخل سردي، إذ يصبح بمقدور القارئ أن يقتحم داخل الرواية ويصبح شخصية من شخصيات عالمها"[25].
حدود تلقي الرواية التفاعلية عربيا:
لا يخفى على أحد أن الرواية التفاعلية عرفت كيف تستقطب أصنافا عديدة ومتباينة من المتلقين، مؤثرة على الأداء التفاعلي لكل صنف وفي هذا الشأن تقول فاطمة البريكي: " إن امتلاك أدوات العصر سيؤدي إلى تمكن المبدع من أداء دوره الخلاق بشكل أفضل منه في حال عدم امتلاكه لها، إذ يصبح قادرا على التفكير بطريقة تتناسب أيضا مع العصر الذي يعيشه، وأن يبتكر طرقا جديدة لتقديم إبداعه تتواءم أيضا مع عصره، ومن شأن هذا أن يؤثر في الطريقة التي سيتلقى بها الجمهور نصه وكيفية تفاعله معه"[26]
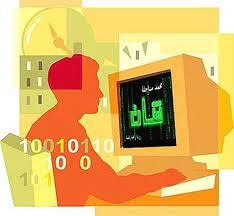
وفي ذات السياق تضيف زهور كرام رأيها حول ميكانيزمات تلقي الرواية التفاعلية، مشيرة إلى ضرورة امتلاك القارئ الوعي الثقافي والحضاري الكافي لتلقي هذه الظاهرة الأدبية، حيث تقول: "يأخذ النص الأدبي مع تطور الوسائط التكنولوجية أبعادا تجعله يتجلى ويعبر عن منطقه ورؤيته بشكل مختلف، ومن هذا المختلف يبدأ نوع من الاصطدام بين الوعي المألوف والذي عززته مواثيق القراءة التي تحدد النص في شكل معين من التلقي مما يؤمن أفق انتظار القارئ ، وبين وعي بدأ يتشكل أو على الأقل بدأت مظاهره تعلن عن تجربة مخاضه من خلال النقاش الحاد بين مؤيد لتجربة التجلي الأدبي رقميا، وبين معارض لهذا التجلي"[27]
وعلى العموم فإن "الملاحظ في التجارب العربية القلة وذلك لعدة أسباب أهمها ضعف تكوين الروائيين في المجال الرقمي وكذلك عزوف المتلقي العربي عن تقبل هذا النوع من الروايات، لعدم تعوده على هذا الشكل من النصوص الروائية ورهان الروائي العربي في مجال التفاعل هو الانتقال الحقيقي إلى فهم جديد للعملية التفاعلية في جميع مستوياتها"[28]
ومع مرور الزمن وأمام هذا التسارع الذي عرفه الإنتاج الأدبي التفاعلي "ظهرت عدة إشكالات فيما يخص الرواية التفاعلية، بعضها على مستوى البناء وبعضها على مستوى التلقي العربي الضعيف ورقيا، قبل أن يكون شبه غائب تفاعليا/ إلكترونيا، وإشكالات أخرى على مستوى المؤسسة الادبية العربية"[29]، فقد ظلت "بعيدة عما يجري من تطورات تقنية ومغامرات تكنولوجية إلا في استثناءات قليلة"[30]
وأمام هذا الوضع يشكو محمد سناجلة حال التلقي العربي وعدم استيعاب المتلقي التطور التكنولوجي وتوظيفه إبداعيا، حيث يقول: "بعد نشر روايتي الثانية في نسختها الرقمية على شبكة الانترنيت فوجئت بأن العديد أو الغالبية العظمى من المثقفين في وسطنا الأدبي لم يقرأ الرواية، واتضح لي أن هناك العديد منهم لا يعرف حتى التعامل مع جهاز الحاسوب، بينما قال البعض الآخر إنهم غير معتادين على القراءة عبر الانترنيت، وهو الشيء الذي دفعني إلى إعادة نشر الرواية في كتاب ورقي مطبوع، كما هي العادة، وقد كان خيارا صعبا ذلك أن الرواية مكتوبة باستخدام التقنيات الرقمية، وبالذات تقنية ال links المستخدمة في بناء صفحات ومواقع الانترنيت"[31
وعلى العموم يمكن القول أنه على مستوى الممارسة الفعلية العربية ظلت الرواية العربية أقل حضورا بشكلها التفاعلي الإيجابي النقي، هذا الوضع خلق أيضا متلقين بمختلف مستوياتهم "مما يجعلهم يقرؤون النص الروائي التفاعلي بناء على مرجعيات مختلفة أغلبها ورقي تقليدي مما يؤثر في جمالية تلقيهم لهذا النص"[32]
[1] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص 75.
[2] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة)، ص98.
[3] ينظر، محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص32، 33.
[4] السيد نجم، النشر الإلكتروني والإبداع الرقمي، ص 173
[5] عادل نذير، عصر الوسيط أبجدية الأيقونة، دراسة في الأدب التفاعلي، الرقمي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط1، 2010، ص83.
[6] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص112.
[7] ينظر، المرجع نفسه، ص115، 117.
[8] ينظر، فاطمة البريكي، مدخل غلى الأدب التفاعلي، ص120، 121.
[9] للمزيد ينظر، محمد سناجلة، رواية ظلال الواحد.
[10] للمزيد ينظر، محمد سناجلة، رواية شات
[11] ينظر، محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص67.
[12] حسن سلمان، الأدب الرقمي يطالب بحقوقه المهدورة، جريدة الشرق الأوسط، ع10627، 2يناير2008 ، ص184
[13] ينظر، سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط( مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، ص90.
[14] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية) العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، ص98.
[15] ينظر، محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص95
[16] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية) العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، ص101.
[17] ينظر، حسام الخطيب، الأدب والتكنولوجيا، وجسر النص المفرع ص125.
[18] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة)، ص100.
[19] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية) العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، ص102.
[20] لبيبة خمار، شعرية النص التفاعلي(آليات السرد وسحر القراءة)، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2014، ص36. ،
[21] كمال الرياحي، النشر الإلكتروني ورواية الواقعية الرقمية.. أسئلة لولادة شرعية ، نشر بتاريخ 16 جويلية2007، اطلع عليه بتاريخ: 24/03/2023، على الساعة: 18:49، https://www.turess.com/alwasat/1053
[22] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص 74.
[23] كمال الرياحي، النشر الإلكتروني ورواية الواقعية الرقمية.. أسئلة لولادة شرعية ،
[24] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص 74.
[25] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص75.
[26] فاطمة البريكي، مدخل إلى الادب التفاعلي، ص87.
[27] زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، ص73.
[28] سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، ص90.
[29] حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، ص100.
[30] ينظر، حسام الخطيب، الأدب والتكنولوجيا، وجسر النص المفرع، ص36.
[31] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص55.
[32] حمزة قريرة، الرواية التفاعليةالرقمية العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، ص103
-
الرواية التفاعلية، روتية شات، رواية الصقيع، محمد السناجلة،
-
منتدى خاص بالمحاضرة الخامسة
-
في ظل التطور الذي فرضته التكنولوجيا الحديثة حاول الشعر أن يؤسس لنفسه وجودا جديدا من خلال توظيف أدوات تواصلية جديدة ممثلة في الوسائط الرقمية المتعددة وسمي هذا الوجود الجديد بالشعر الرقمي digital poetry حيث "نسمي أدبا رقميا كل شكل سردي أو شعري يستعمل جهاز الحاسوب المعلوماتي وسيطا، ويوظف واحدة أو أكثر من خصائص الوسيط"[1] ، حيث لم يتوانى مبدعو هذا النمط الكتابي الجديد من "الاستفادة من كل المتاح لهم للخروج بالنص الشعري من دائرته التقليدية الضيقة، وتقديمه إلى عدد أكبر من الجمهور المنكب على شبكة الانترنيت يمخر عبابها، واجدا فيها كل شيء إلا الأدب والفن والشعر، لذلك عمدوا إلى تقديم الفن الشعري بأسلوب يناسب الطابع الرقمي المهيمن على معظم جوانب الحياة في هذا الوقت"[2]
حاول الشعراء المعاصرون أن يركبوا موجة التطور الحاصل في كل المجالات فبدأ الشعر مرحلة جديدة عرفت تجديدا كبيرا سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون، تجربة تنفتح على كل الوسائط الرقمية السمعية منها والبصرية، مما يسمح للمتلقي بالتفاعل معها والمشاركة في إنتاجها، لذلك يعرف على أنه النص الشعري الذي "يستعين بالتقنيات التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات الحاسب الإلكتروني ولصياغة هيكلته الداخلية والخارجية، والذي لا ينكم عرضه إلا من خلال الوسائط التفاعلية الإلكترونية"[3]، وفي هذا السياق أيضا تؤكد الناقدة فاطمة البريكي بأنه "ذلك النمط من الكتابة الشعرية الذي لا يتجلى إلا في الوسيط الإلكتروني، معتمدا على التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.. يتنوع في أسلوب عرضه وطريقة تقديمه للمتلقي المستخدم"[4].
يعرف الشعر الرقمي أو القصيدة التفاعلية أيضا على أنه "شكل جديد من أشكال الشعر الحديث الذي يعتمد على الآليات المتطورة في الحاسبة الإلكترونية، والتي تعتمد الصورة والموسيقى والاسترجاع، وهي عبارة عن بانوراما متحركة، في حدود الذات الخالقة المبدعة مع الذات الأخرى المتذوقة أو المتفحصة أو المشاركة في ذات الوقت، حيث تعتمد القصيدة على الكلمة المرادفة للصورة بأشكالها المعتمدة، المتحركة والثابتة، جنبا إلى جنب مع الموسيقى أو المؤثر الصوتي الفاعل والمتحرك هو الآخر، لدفع القصيدة باتجاه التناغم والاكتشاف"[5]
وعليه فإن هذه النمط الكتابي هو كل شعر نتج في وسط رقمي تتداخل فيه كل الوسائط التي يتيحها الحاسوب كالصوت والصورة، والحركة...إلخ، وللإفادة فإن "عشرات الشعراء لم يكن يعرف عنهم أي شيء ، ولا يملكون جمالية وأدبية مشتركة، جاؤوا من آفاق أخرى، مثل الفيديو، والفنون البصرية والتشكيلية"[6]، أي أن إمكانات اشتغالهم على الحاسوب هيأتهم لدخول غمار الكتابة الشعرية وتفجير طاقاتهم الإبداعية فزاوجوا بين الأدب والتكنولوجيا.
هذا ويعرفه محمد أسليم على أنه "شعر يستغل الوسائط المتعددة، ومجموعة من البرامج المعلوماتية، ولغة البرمجة، كالفلاش ماكروميديا والفوتوشوب، والسريتش والجافا سكريبت لصياغة نصوص لا تمتزج فيها اللغة بالصوت والصورة فحسب، بل تتحرر فتتحول الشاشة إلى ما يشبه فضاء حركيا حيث تكتب فيه الحروف والكلمات وترقص وتتحرك كأنها أسراب طائرات"[7]
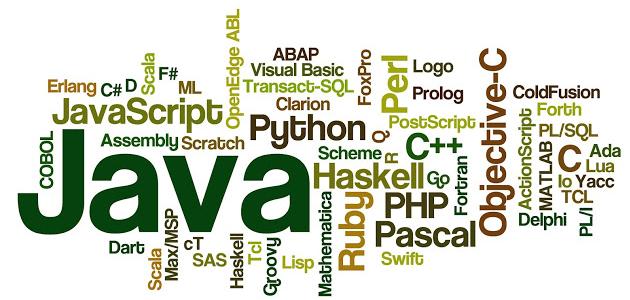
أما فيما يخص المصطلح فإن الشعر الرقمي مثله مثل باقي الأجناس الأدبية الرقمية عرفا تعددا مصطلحا واسعا مما خلق إشكالية في التلقي حيث عمل بعض النقاد على تداول مصطلحات في مقابلة تهميش أخرى، ونذكر منهم على سبيل المثال فاطمة البريكي التي تقول: " أما الشعر الرقمي، والشعر الإلكتروني فلا يختلفان عن بعضهما البعض في دلالتهما العامة... أما بسبب تسمية الشعر المقدم من خلال الشاشة الزرقاء بالشعر الرقمي مثلا فيعود إلى أنه يقدم رقميا على شاشة الحاسوب، أما سبب تسميته بالشعر الإلكتروني فقد يعود إلى طبيعة الوسيط الحامل له"[8]، وفي سياق التمييز بين هذان المصطلحان تفضل الناقدة استعمال مصطلح الشعر التفاعلي أو القصيدة التفاعلية بحجة أنها "تستخدم صورا ثابتة ومتحركة والأشكال الجرافيكية والأصوات الحية وغير الحية وكل ما من شأنه أن يبث شكلا جديدا من أشكال الحيوية والتفاعل في النص"[9]
إلى جانب هذا نجد ما يصطلح الشعر التشعيبي، وهو واحد من أشكال الشعر الرقمي تقول عنه الناقدة عبير سلامة: "هو شكل يستخدم ربط غير خطي، ينقل القارئ من دور المستهلك إلى دور الصانع المشترك في السيطرة على النص وتوجيهه، وسواء أكان الشعر التشعيبي بصريا، صوتيا، حركيا، أو كان نصا، يقتضي هذا الشكل اتخاذ قرارات جمالية كثيرة تنأى بالقصيدة عن أن يكون مجموعا، متماسكا يسهل الامساك بأطرافها"[10]
نشأة الشعر الرقمي:
لقد سبقت نشأة الشعر الرقمي في العالم الغربي قبل العالم العربي نظرا لظهور التكنولوجيا والحاسوب عند الغرب أولا، ففي عام 1959 "نجح ثيولرتز theo lutz في ألمانيا وبريان جيسين briab jesen في الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة أولى الأبيات الشعرية الحرة الإلكترونية باستخدام ما كان يسمى آنذاك آلات حاسبة"[11]، ثم توالت بعد ذلك التجارب في إنجاز شعر رقمي، ولقد تمثلت هذه التجارب في صدور العديد من المجلات الإلكترونية الشعرية منها "مجلة alire في عام 1989 ومجلة kaos ، وأخيرا مجلة elcarto التي أصدرت نسخا إلكترونية في قرص مضغوط"[12]
تعود البداية الحقيقة للشعر الرقمي إلى الشاعر الأمريكي روبرت كاندال robert kandell ، وقد سبق أن تحدث عن تجربته في نظم الشعر الرقمي فقال: "في عام 1990 عندما شرعت في كتابة القصيدة الإلكترونية لم أكن أعرف أي شخص يمارس الكتابة الإبداعية على الشبكة... وحدها طيوري كانت تحلق في الفضاء الالكتروني المطلق"[13]، وعليه يؤكد لنا روبرت كاندال أن الانطلاقة الحقيقية للشعر الرقمي كانت مع تجربته الأولى سنة 1990 ، وأنه لم يشهد قبل هذا التاريخ أن نص شعري على الأنترنيت.
وفي هذا الصدد يؤكد عمر زرفاوي أن "القصيدة التفاعلية ظهرت إلى الوجود ما يقارب الخمسة عشر عاما على يد الشاعر الأمريكي روبرت كاندال"[14] وهو نفس ما ذهب إليه رحمن غركان الذي أشار إلى أن ريادة الشعر الرقمي في العالم الغربي تعود إلى روبرت كاندال الذي حسب رأيه "اجتهد في الإفادة من تقنيات الحداثة الصناعية ومنها الشبكة الأنترنيتية، فقدم قصائد تفاعلية لم يكن ممكنا إجمالها للمتلقي أو تأثر الجمهور بها إلا من خلال هذا النمط من الاشتغال الشعري الإلكتروني"[15]
وفي سياق الحديث عن تجربة روبرت كاندال في الانتقال من كتابة الشعر الورقي إلى كتابة الشعر الرقمي يقول: "إنه عندما كان يقوم بنشر قصائده ورقيا في الصحف والمجلات لم تلق إقبالا يذكر من الجمهور... ولكنه بعد أن بدأ بنشر نصوصه إلكترونيا أصبح يلاحظ تزايد عدد الجمهور المتفاعل مع نصوصه، وأن هذا العدد يتزايد بعد أن غير من أدواته الإبداعية وأصبح يحسن توظيف الآلة التكنولوجية"[16]
أما في العالم العربي فقد تأخر ظهوره إلى غاية بداية الاحتكاك بالعالم الغربي والانفتاح على ثقافته، فظهرت بعدها تجارب محتشمة في الإبداع الشعري الرقمي، فكان الشاعر العراقي مشتاق عباس معن أول من اجترح هذا النوع لكتابي، وأنتج مجموعة شعرية رقمية سنة 2007 عنونها بـ: بتباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق"، تقول فاطمة البريكي عن هذه التجربة: "هي الأولى عربيا والتي طال انتظارها كثيرا من قبل جميع المهتمين بالأدب التفاعلي في العالم العربي، وقد أشهر هذا الانتظار مجموعة شعرية كاملة... إنها تجمع بين اهم عنصرين يجب ان يتوافرا في النصوص الأدبية التفاعلية وهما: الأداة الفنية، والأداة التقنية، وأقصد بالأولى الموهبة والملكة الأدبية الحقيقية، فيما أقصد بالثانية العناصر التكنولوجية التي تكسب النص صفة التفاعلية"[17]، وعليه نشير إلى أن عدة القصيدة الرقمية تتمثل في حسن استعمال الوسائط المتعددة وامتلاك الثقافة الرقمية التي بواسطتها يتحول الشعور من ملامسة الآلة الورقية إلى تحريك مفاتيح آلة خرساء/ ناطقة[18]
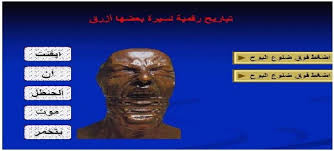
وعن هذه المجموعة الشعرية يقول جمال قالم: إن الشاعر قد "وظف في قصائده الصورة والصوت وخصائص أخرى يتميز بها الحاسوب والأنترنيت، النص مكون من شبكة مترابطة من النوافذ تتفرع إلى جملة نوافذ من خلال الانتقال بالضغط على مفاتيح النقل داخل الشبكة الإلكترونية، فكل نافذة متفرعة/ مترابطة تكون مكونة من ثلاثية الصياغة الرقمية: جرافيك ومؤثر صوتي وشيفرة كتابية"[19]
إن ظهور هذا المجموعة الشعرية في العالم العربي أثار الكثير من الجدل، مما أذكى فتيل الرغبة لدى العديد من الشعراء في خوض هذه التجربة ومن النماذج العربية التي ظهرت "قصيدة (غرف الدردشة) للسعودي عبد الرحمان ذيب، وقصيدة (سيدة الياهو) للمغربي إدريس عبد النور، وقصيدة (أسود ما يحيط بشقراء النعامة) لجمال محداني، وقصيدة (كونشرتو الذئاب) للعراقي عبد الله عقيل، وقصيدة (قصيدتان لبين واحد) لمنعم الأزرق"[20] كل هذه النماذج وأخرى انخرطت في رهان التجربة الشعرية الرقمية لتثبت أبداعيتها ومواكبتها لكل طارئ جديد في الساحة الثقافية.
خصائص الشعر الرقمي (القصيدة التفاعلية):
في سياق المقارنة بين القصيدة الورقية والقصيدة التفاعلية قدمت الناقدة فاطمة البريكي جملة من الخصائص التي تتميز بها القصيدة التفاعلية أوجزتها في ما يلي:
Ø تنوع جمهورها: فلم تعد القصيدة حكرا على قراء الشعر فقط، بل تعدتهم إلى المشتغلين في حقل الفنون البصرية، وكذا المتخصصين في مجال الإعلام والاتصال، وغيرهم.
Ø انفتاحها على كل الوسائل المتاحة، فتتضافر في عرضها كل الوسائل الصوتية والبصرية والحركية.
Ø تحرر لغتها من قيود الزمان والمكان والمادة، واكتسبت اللغة صفة التحرر من خلال الخاصية السابقة (الانفتاح) نظرا لتواجدها في الفضاء الشبكي.
أنواع الشعر الرقمي:
اجتهد حسام الخطيب في تحديد لأنواع الشعر الرقمي وقد ضبطها في نوعين: الشعر الرقمي ذو النسق السلبي، والشعر الرقمي ذو النسق الإيجابي، وفي ما يلي تفصيل لهذان النوعان:
أ/ الشعر الرقمي ذو النسق السلبي: ويقصد به النص الشعري "النغلق الذي لا يستفيد من تقنيات الثورى الرقمية التي وفرتها التقنيات الرقمية المختلفة، مثل تقنية النص المتفرع الهايبرتاكست hypertexte أو الملتيميديا multimedia المختلفة عن مؤثرات صوتية وبصرية وغيرها"[21]أي أنه نص خال من المؤثرات والوسائط الرقمية كالصوت والحركة، والألوان... إلخ، أو بمفهوم آخر هو نص لا يمتلك صفة التفاعلية
ب/ الشعر الرقمي ذو النسق الإيجابي: وهو عكس الشعر الرقمي ذو النسق السلبي، إذ "ينشر نشرا رقميا ويستخدم التقنيات التي أتاحتها الثورة المعلوماتية والرقمية من استخدام المؤثرات السمعية والبصرية والجرافيك، وغيرها من المؤثرات التي أتاحتها الثورة الرقمية"[22] أي أنه النص الشعري الذي يسمح بتفاعل الوسائط المتعددة فيما بينها، كما يسمح بتفاعل المتلقي مع هذا النص حيث "يقدم الشعر الرقمي للإبداع الأدبي حقلا نصيا جديدا ممتدا، ينقل الكتابة إلى ما وراء الكلمات، باتجاه العلاقات بين الإشارات، وأنظمة الاشارات، واتحادها واختراقها وتفاعلها مع بعض"[23].
تقنية الشعر القمي:
لقد حدد الدارسون تقنيات الشعر الرقمي باعتباره منجزا إبداعيا ذو مواصفات حضارية تخضع لمستجدات العصر التكنولوجية في نوعين هما:
أ/ تقنية الوسائط المتعددة: وهي التي تتوافر من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل الفيسبوك، الأنستغرام، التويتر، إلخ، فالنص الشعري المتوافر على هذه المواقع هو نص مفتوح مصاحب للصورة فقط، ولا يتم التفاعل معه إلا من خلال وضع التعليقات والإعجابات لا غير، وبالتالي فإن المعنى غير مكتمل على عكس اليوتيوب الذي يعتبر أكبر شكل معقد يتوفر على وسائط متعددة مركبة من مجموعة عناصر تتفاعل فيما بينها، منها ما يتصل "بالتشكيل الصوري من رسوم ولوحات وخطوط، ومنها ما يخص الصوت إلقاء وأداء تعبيريا... ومنها ما يخص اللون في حركته... ومنها ما يخص الحركة التي تتصف بها كل المكونات، فالكلمة فضاء الشاشة غير المستقرة وكذا الألوان والصور والأصوات"[24]، وهذا الشكل المعقد الذي تتداخل فيه كل هذا العناصر(المونتاج) هو الذي يجعل المتلقي عنصرا فاعلا في إنتاج النص من خلال ما تحققه هذه العناصر أو الوسائط المتعددة من متعة وإثارة.

ب/ تقنية الروابط المتشعبة(hyperlinks): هذه التقنية هي عبارة عن أيقونات " يقوم القارئ بتنشيطها وتسمح له بالانتقال السريع بين كل منها، والروابط التشعبية يمكن أن تتجلى من خلال زر، أو صورة، أو أيقونة، أو كلمة معينة تعيينا خاصا إما بواسطة لون، أو بخط تحتها"[25]، وهذه الروابط في الحقيقة تمنح المتلقي حرية أكبر في الانتقال بين المواد المتوفرة في النص، مما يزيد أيضا في انفتاحه ذهنيا وبالتالي التفاعل مع النص واكتشاف فنياته وجمالياته.

وبناء على ما سبق يمكن القول أن القصيدة الرقمية قد تكون نصية "قوامها كلمات فحسب، أو متعددة الوسائط تستخدم واحدا أو أكثر من العناصر البصرية، الصوتية، المتحركة، وقد تكون خطية البناء أو تشعبية، لكنها في جميع الحالات تمنح القارئ خيارات المشاركة في تشكيلها، وتنقسم خيارات التشكيل إلى: تشكيل النص، وتشكيل مسارات امتداد النص"[26]، وللإفادة فإن التفاعلية التي تتميز بها القصيدة الرقمية لا تخضع لشروط بعينها وإنما "تعتمد درجة تفاعلية القصيدة الرقمية على مقدار الحيز الذي يتركه المبدع للمتلقي، والحرية التي يمنحها إياه للتحرك في فضاء النص دون قيود أو إجبار بأي شيء أو توجيه له نحو معنى معين"[27].
كما لا تفوتنا الإشارة أيضا إلى أن "القصيدة الرقمية أو الإلكترونية ليست بالضرورة قصيدة تفاعلية، مع اشتراكهما في صفة الرقمية أو الإلكترونية، أي تجليهما عبر الوسيط الإلكتروني، إلا أنهما تختلفان في المساحة أو الحيز المخصص للمتلقي، من خلال مشاركته المبدع في إنتاج النص دون قيود، حيث ينعدم هذا الحيز في القصيدة الرقمية بينما يتسع في القصيدة ال
[1] فيليب بوتز وآخرون، الأدب الرقمي، ترجمة: محمد أسليم، الدار المغربية العربية، الرباط، ط1، 2016، ص29.
[2] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص75.
[3] حافظ محمد عباس الشمري، إياد إبراهيم فليح الباري، الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة وتغيير الوسيط، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، ط1، 2013، ص29.
[4] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص77.
[5] زيدان حمود، المرئي والمسموع وتداخلات الكلمة المتخطية في قصيدة (تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق للشاعر مشتاق عباس معن)،، نشر بتاريخ 24 أفريل2007، لوحظ بتاريخ: 13 ماي2023، على الساعة23:01، http//www:nasiriyeh.net/index.html
[6] فيليب بوتز وآخرون، الأدب الرقمي، ترجمة: محمد أسليم، ص237.
[7] ينظر، محمد أسليم، مفهوم الكاتب الرقمي، نشر بتاريخ 06 مارس2007، اطلع عليه بتاريخ: 13 ماي 2023 على الساعة 15:23، https://www.aslim.org/?p=1593
[8] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص75.
[9] المرجع نفسه، ص78.
[10] أحمد زهير الرحاحلة، نظرية الأدب الرقمي، ملامح التأسيس وآفاق التجريب، دار فضاءات، عمان، ط1، 2018، ص93.
[11] فيليب بوتز وآخرون، الأدب الرقمي، ص203.
[12] المرجع نفسه، ص203.
[13] أحمد زهير الرحاحلة، نظرية الأدب الرقمي، ملامح التأسيس وآفاق التجريب، ص89.
[14] عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط1، 2013، ص207.
[15] رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية، تنظير وإجراء، دار الينابيع، ط1، 2010، ص19.
[16] فايزة يخلف، الأدب في مهب التكنولوجيا، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط1، 2017، ص85.
[17] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص74.
[18] ينظر، مها خير بيك ناصر، القصيدة الرقمية، والبنية الفنية البراغماتية، شعر مشتاق عباس معن أنموذجا، نشر بتاريخ: 23 جوان 2017، لوحظ بتاريخ: 28 مارس 2023، على الساعة 11:00، http://www.anakhlahwaljram.com/
[19]جمال قالم، الأدب التفاعلي وإشكالية تداخل الأجناس، معارف، قسم2، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع11، ديسمبر2011، ص96.
[20] ستي جباري، الأدب الجزائري وفضاء الأنترنيت، آليات القراءة وتفاعلية الإبداع، ص150.
[21] حسام الخطيب، الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع، ص118.
[22] المرجع نفسه، ص119.
[23] عادل نذير، عصر الوسيط(أبجدية الأيقونة)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2010، ص100
[24] محمد غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية، ص83.
[25] ستي جباري، الأدب الجزائري وفضاء الأنترنيت، آليات الإبداع وتفاعلية القراءة، ص85.
[26] عبير سلامة، الشعر التفاعلي، طرق للعرض طرق للوجود، 22 جوان 2015 اطلع عليه بتاريخ 20 مارس2023 ، على الساعة 09:30 ،
http://www.sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&id=970
[27] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص75.
-
الشعر الرقمي، القصيدة التفاعلية، الروابط المتشعبة، الوسائط المتعددة، البرمجة، الفوتوشوب.
-
-
إن أول ما نستهل به هذه المحاضرة هو تساؤل مهم طرحه محمد حسين حبيب في مقال له بعنوان (نظرية المسرح الرقمي)، حيث يقول فيه: "أيمكن أن نتصور يوما أن تنتهي المسرحية نصا مطبوعا على الورق لتجد بديلا لها على هذه الشبكة العنكبوتية؟ وبعدها- وهو افتراض مستقبلي جائز الحدوث- أن يغيب العرض المسرحي هو الآخر موجدا بديله الإلكتروني وأن نفتقد إلى ذلك التلاقح الوجداني والفكري المباشر والمادي بين الممثل على خشبة المسرح بلحمه ودمه وبين المتلقي في الصالة بلحمه ودمه هو الآخر، ليتحول إلى تلاقح رقمي عبر الشاشة الإلكترونية"[1]

طبعا لا يخفى على أحد من الدارسين أن المسرح مثله مثل باقي الأجناس الأدبية التقليدية يقوم على قطبين هما: الممثل الذي يؤدي دوره الإبداعي على خشبة المسرح، والجمهور الذي يتلقى المشاهد المسرحية، ولقد "ظل الركن الأول يتخذ دائما الطابع الحركي، في حين يتخذ الركن الثاني الطابع السكوني... فاتسم سلوك الممثلين بالإيجابية، واتسم سلوك الجمهور بالسلبية، والعلاقة بينهما شبه معدومة"[2]، وبقي الحال على حاله إلى أن اقتحمت التكنولوجيا ميدان الأدب فازدهرت المسرحية كما ازدهرت باقي الأجناس الأدبية في ظل الخاصية التفاعلية التي تتيحها التقنية الرقمية، فأصبح لدينا ما يسمى بالمسرحية التفاعلية interactive drama/hyperfiction ، وانتقلت بذلك المسرحية من حيزها الضيق الممثل في خشبة المسرح وقاعات العرض، إلى مجال أوسع يسمع بتفاعل الجمهور المتلقي في إنتاج النص المسرحي.
عرفت المسرحية الرقمية (التفاعلية) على أنها " نمط جديد من الكتابة الأدبية، يتجاوز المفهوم التقليدي لفعل الإبداع الأدبي الذي يتمحور حول المبدع الواحد، إذ يشترك في تقديمه عدة كتاب، كما قد يدعى المتلقي/ المستخدم أيضا للمشاركة فيه، وهو مثال للعمل الجماعي المنتج، الذي يتخطى حدود الفردية وينفتح على آفاق الجماعية الرحبة"[3] مما يمنح العمل المسرحي صفة التفاعلية سواء بين المبدع وعمله المسرحي، أو بين العمل المسرحي والمتلقي، فيصبح العمل متسعا لمشاركة جميع أطراف العملية الإبداعية من خلال جهاز الحاسوب، وعليه يمكن القول أن اعتماد المسرحية على التقانة الرقمية أسكنها فضاء جديدا هو "الفضاء الافتراضي للشبكة الانترنيت، أو يكون على قرص مدمج أو كتاب إلكتروني، دون أن تلامس أجنحته فضاء الورق"[4]، وذلك بالاعتماد على خاصية النص المتفرع المترابط، ولأجل هذا يعرف عادل نذير المسرحية الرقمية بأنها "منجز إبداعي يحتمل التأليف الجماعي، ويعتمد تقنيات الحاسوب وشبكة الاتصالات ولا سيما تقنية النص المتفرع"[5]
من التعريفات المتداولة أيضا للمسرحية الرقمية ما يعود للسيد نجم يقول فيه عنها: إنها "شكل آخر اقتحمه الإبداع الرقمي، ولعله يعد اقتحاما مدهشا، نظرا لما هو معروف وراسخ من كون المسرح هو (الكلمة/ الحوار)، حسب القواعد الأرسطية، إلا أن محاولة محمد حبيب وأصدقائه في بلجيكا من العرب والبلجيك أعطى للتجربة أهمية مضافة، فلم تكن المسرحية على إطارها الشكلي المألوف من خشبة مسرح وجمهور، بل كانت مقهى في بلجيكا وأخرى في بغداد وعدد من الأجهزة(كمبيوتر، أجهزة إضاءة، ساحة مقهى هنا وهناك)، ثم فريق هنا للمشاركة والمتابعة، وفريق هناك كذلك"[6]
وللإفادة فإن فكرة المسرح الرقمي بدأت " بغرض الوصول إلى تأليف مسرحية مشتركة عبر الأنترنيت بين أفراد متباعدين من جنسيات وبلدان مختلفة، هذا التجريب في التأليف المسرحي يعد شكلا مغايرا، فهو يقوم أولا بإلغاء شخصية المؤلف الأساس ويمكن لأي قارئ أن يكون مؤلفا آخرا بمجرد الدخول لموقع أحداث المسرحية الإلكترونية ويساهم في تكملة الأحداث التي لا تنتهي، كأن يختار شخصية معينة ويهتم بها لغرض تفعيل مسيرتها الدرامية،ـ ثم يأتي شخص آخر ويختا شخصية أخرى في المسرحية نفسها ويحاول لأن يوسع مدّيات حركتها النصية وهكذا تستمر العملية بلا توقف"[7]
برزت كتابة المسرحية التفاعلية إلى الوجود على مستويين الأول منهما بين مجموعة من الكتاب، الذين يختار كل منهم شخصية من الشخصيات المسرحية ليكتب عنها، وينتقل معها من حدث إلى آخر، ليكتب موقفها من هذا الحدث، أو دورها فيه، وليسجل انفعالاتها وعواطفها وغير ذلك، ثم يأتي المستوى الآخر للتفاعل، الذي يظهر من خلال تفاعل المتلقي/ المستخدم مع ما يعرض أمامه، إذ سيختار كل واحد منهم خيطا مختلفا من خيوط النص المسرحي ليتبعه، مما يجعل النص المسرحي ينتهي بشكل مختلف من متلق/ مستخدم لآخر[8].
وبالإضافة إلى إمكانية التفاعل المتاحة في المسرحية الرقمية أصبح الملتقي أكثر تحررا من حدود المكان والزمان، فلم يعد المتلقي مجبرا على الجلوس في قاعة العرض، بل أصبح المسرح هو من يأتي إليه في المكان الذي يريد، وأن كل ما يحتاجه هو الحاسوب أو جهاز العرض، لأن ما يصبو إليه المسرح الرقمي هو "بث الحياة في الفعل المسرحي الذي اكتسب جمودا غير مرغوب فيه، وذلك من خلال بحثه عن أماكن جديدة لتقديم العرض المسرحي، في إعراض واضح عن الخشبة التقليدية العتيقة التي كانت تمثل نصف الظاهرة المسرحية في السابق"[9] .
وبناء على هذا الأمر استعاد المسرح الرقمي هيبته التي كاد أن يفقدها بعد أن عانى من كهولة التوصيل، فقد ظل الفن المباشر بين المبدع والمتلقي، والذي لا يعتمد في أدائه على وسيط رقمي يحمله لكونه مازال حبيس المسافة، ومن ثم أسيرا لجدران إبداعه، فقد كان لابد للمسرح أن يبحث له عن وسائل جديدة تمثلت في الرقمي وما تتيحها له من إمكانات"[10]
فضلا عن ذلك يمتلك المتلقي حرية التصرف في النصوص المسرحية ذلك لأن "وجود عقد نصية، وروابط تشعبية، خاصة بكل شخصية من شخصيات المسرحية التفاعلية، أو بكل حدث أو عقدة فيها، يساعد المتلقي/ المستخدم على تتبع خط سير الشخصية التي جذبته أكثر من غيرها، أو الحدث الذي شد انتباهه أكثر من غيره، دون أن يجد نفسه مضطرا لمعرفة ما حدث لبقية الشخصيات، وما أسفرت عنه كل الأحداث، وكيف انحلت عقد النص، كي يصل إلى مبتغاه بخصوص الشخصية التي تهمه"[11]، فبالنقر على الرابط الذي يهمه يتمكن من متابعة مسار الحدث أو الشخصية التي يفضل دون أن يكون ملزما بتتبع كل المسرحية، وفق تراتبية (خطية) مملة.
وفي سياق الحديث عن شخصيات المسرحية الرقمية نشير إلى أن هذه الشخصيات هي افتراضية وهي عبارة عن "وحدة رقمية لا تتضمن أية مظاهر لا عضوية ولا سيكولوجية، بل إنها تبدو كذلك للوهلة الأولى لكنها في الأصل شخصية وهمية تظهر وتختفي بمجرد كبسة زر على الحاسب الإلكتروني الذي صنعت فيه أصلا"[12]
وعليه فإن المتلقي من خلال خاصية الترابطية "يستطيع القفز من مكان لآخر تابعا لشخصيته التي يريد، ومتعمقا فيها، ومضيفا إليها بعض النصوص، من خلال التعليقات المباشرة، أو الرسائل البريدية التي يمكن أن يتركها للمبدع، أو لمجموعة المبدعين، وبسوى ذلك من الرسائل التي تسمح له بالمشاركة في تطوير الشخصية أو بنائها"[13]، وبالتالي تمكن المتلقي من إعطاء مساره الخاص، ورؤيته الخاصة في العرض المسرحي، وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة مفادها أن المسرحية التفاعلية قد ألغت أفق الانتظار أو أفق التوقع المعروف في الأدبيات الورقية الحديثة، لأن المتلقي هو السيد المتحكم بالقادم من الأحداث، فمن أين له أن ينتظر أو يتوقع، فما يريده يجعله واقعا مثلما يشاء[14]
وهذا الطرح يؤكده ناصر بن محمد العمري بقوله: "وهنا يظل بديهيا القول إن هذه الممارسة تقضي على مصطلح أفق الانتظار، وأن مسرحية بهذه المواصفات لا يمكن تقديمها على خشبة المسرح، ولا يمكن قراءتها أو التفاعل مع مجريات أحداثها الأولية والتكميلية التي قام الآخرون بتأليفها إلا عبر شاشة الأنترنيت الرقمية"[15]
في الحقيقة إن الخوض في هذا النمط المسرحي يعد "تجربة مختلفة تجعل من المسرحية دائمة التوالد لا تقبل البقاء في سكون، شأنها شأن الحياة التي تعبر عنها، كما تؤسس المسرحية التفاعلية من جهة أخرى لإشكالية تعدد الأصوات داخلها لمّا يتكفل عدة مبدعين بالكتابة، فكل مبدع سيسير مع شخصية بعينها، ويتكفل بتطورها دون تقيده بغيرها"[16]، وهذا التعدد في الأصوات من شأنه أن يبرز جمالية هذه التقنية الرقمية كونها لا تسير وفق تراتبية خطية، وإنما تكسر في كل مرة سيرورة الأحداث والزمن والمكان.
إن التأريخ لمسألة الريادة في إنتاج مسرحيات رقمية يعود بنا إلى بداية التسعينات حينما اجتمع بعض الفنانين والباحثين في جامعة كانساس الأمريكية وبدأوا في العمل على إنتاج عرض ينجحون فيه في دمج الفضاء والممثلين الفعليين مع أجواء الواقع الافتراضي، وقد تسببت فكرة إدخال إنتاج مماثل بداخل الملف الرسمي لجامعة المسرح في الكثير من الارتباك، حيث أن العلاقة بين المشهد الرقمي والمشهد المادي تبدو كعلاقة بعيدة الاحتمال وجريئة، وبعد تنفيذه نال العرض إعجابا شديدا وأصبح العرض الأول في هذه السلسلة، ومازال يعتبر حتى اليوم العرض الرائد في التجريب في هذا المجال[17]
تعتبر مسرحيات تشارلز ديمر charles deemer من أكثر المسرحيات التفاعلية شهرة في العالم الغربي لا سيما مسرحيته chateau de mort (1985) لاعتمادها على التكنولوجيا كمكون أساسي في بنائها، ولقد كانت بدايته مع برنامج (iris) الذي يعتبره ديمر بمثابة النص المتفرع لنظام التشغيل السَّبق (dos)، حيث أقام عليه بناء نصه، وهو ما يشبه ما يحدث الآن في النصوص التفاعلية الحديثة، حيث وظف خصائص النص المتفرع في نظام windows

كما أسس ديمر مدرسة لتعليم كتابة سيناريو المسرح التفاعلي screenplay في موقعه الخاص على الانترنيت عبر تقديمه دورات تعليمية متعددة، فيكون بمسرحه التفاعلي هذا يؤسس لنظرية مسرحية جديدة يمكن تسميتها بـ(نظرية المسرح الرقمي) وهي الآن قائمة فعلا عبر عدد من المسرحيات التي كتبها (ديمر) والمستخدمة حاليا في موقعه الإلكتروني ويتفاعل معها الكثير من المتلقين القراء منهم والقراء المبدعين ممن يهتمون بالكتابة الدرامية، ومن كافة أنحاء العالم لم يتوقفوا بعد على وضع نهاية واحدة لأي من تلك المسرحيات[18].
من جهود ديمر أيضا في هذا المجال هو تحويله لمسرحية النورس البحري seagull للكاتب الروسي تشيكوفchekhov "فبعد التعديلات التي أحدثها ديمر على النص الأصلي والذي كان بصيغة ورقية، أصبح من المستحيل قراءته قراءة كلاسيكية متبعين في ذلك الآليات المعهودة سابقا، فالملاحظ أن مسرحية تشيكوف الرقمية تتأتى لمتلقيها اليوم من خلال الشاشة الزرقاء باعتبارها وسيطا هاما وأول وسيلة للقراءة ، فعند فتح الحاسوب الموصول بالأنترنيت يصادف المتلقي شاشة ترحيبية تعرّف بالنص ويمكن منها التحول إلى قائمة رئيسية، تتضمن عددا من الخيارات، وعندما يختار المتلقي نقطة البداية يكون بعد ذلك في مواجهة أربعة فضول فيختار الفصل الذي يريد الانطلاق منه دون مراعاة الترتيب[19]
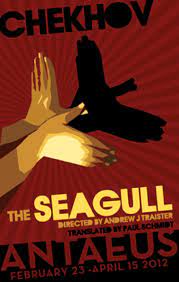
هذا وقد اعتمد فيها ديمر على الروابط التشعبية بعد إحداث تعديلات عليها ووضعها في موقع ليتفاعل معها المتلقون فزودها بمفاصل وعقد تمكن المتلقي أن يبحر في أي فصل من فصولها على الخيار، فينتهي بما لا ينتهي به متلق آخر، وهذا ما يمنح النص حيوية ويجعله أكثر تميزا عن النص التقليدي المائل إلى الثبات"[20]، وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة مفادها أن تقنية النص المتفرع(المتشعب) تعد "أفضل وسيلة في تقديم مسرحية من هذا النوع، فكتابة النص المسرحي التفاعلي عن طريقها هو ما يفتح أمامه أبواب التفاعلية، حيث يؤدي وجود عقد نصية، وروابط تشعبية خاصة بكل شخصية من شخصيات المسرحية التفاعلية أو بكل حدث يساعد المتلقي في تتبع ما أثار اهتمامه دون غيره"[21]

أما في العالم العربي فإن هذا الجنس الأدبي لم يساير نظيره الغربي بل بقية يتخبط في محاولات ضعيفة غير ناضجة، اللهم إلا مسرحية "مقهى بغداد" (2006) التي تعود إلى الأستاذين: حازم كمال الدين، وبيتر فيرهايسverhees pieter عرضت بالاعتماد على العالم الافتراضي، "وقد نفذها المعدان مع مجموعة من الممثلين العرب والأجانب، مقهى بغداد تتشظى بسبب تشظي بغداد، ولا تظهر متكاملة إلا عبر البعد الافتراضي، مقهى بغداد متوزعة في البيوت البغدادية، والبابلية، والموصلية، والبلجيكية، ويجمع أشلاءها الأنترنيت"[22].
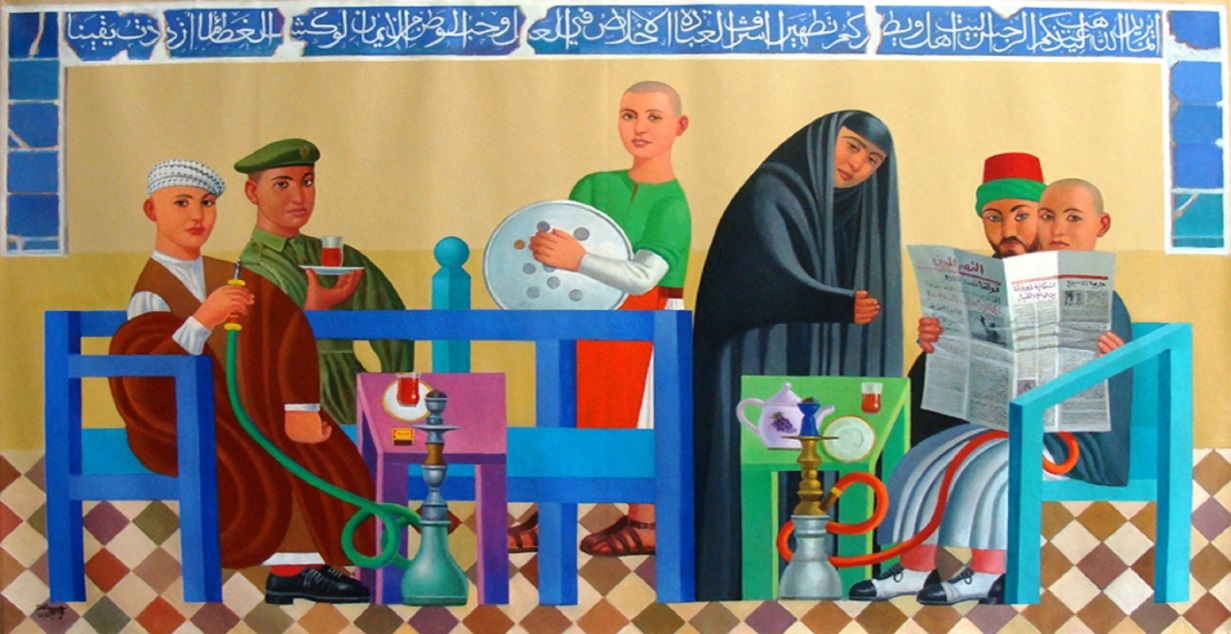
يقول محمد حسين حبيب عن هذه التجربة المسرحية باعتباره المنظر الحقيقي للمسرح الرقمي عربيا، ومشاركا في هذه المسرحية: "أنا أعترف بأننا سوف نفقد جزءا من حميمية اللقاء المادي والروحي والمباشر ما بين المشاهد والممثل المسرحي، لكننا في المقابل سوف نحقق حميمية من نوع آخر، ولقاء يمتلك روحية أخرى جديدة هي غير مادية، لكنه لقاء يكتسح الزمان والمكان... إنه أمر غريب حقا، شعوري الآن وكأني أقف خلف الستارة بانتظار العرض، الرجفة المشروعة ذاتها التي تحيطنا ونحن على الخشبة، أمرتهم في البيت أن لا يكلمني أحد، هكذا أحسست، سأكون في حالة استعداد أفضل على الرغم من أني لا أتقمص أي دور لكن شيئا ما يتقمصني... لقد تحولت شاشة الكومبيوتر إلى الجمهور الذي أواجهه، أراه ويراني، يا لها من لحظات جديدة وغريبة فعلا"[23]
في الأخير لابد من الاعتراف بأن "التجريب في التأليف المسرحي التفاعلي يعد شكلا مغايرا، فهو يقوم أولا بإلغاء شخصية المؤلف الأساس ويمكن لأي قارئ أن يكون مؤلفا آخرا بمجرد الدخول لموقع أحداث المسرحية الإلكترونية ويساهم في تكملة الأحداث التي لا تنتهي"[24]، وهنا مكمن تبرز صفة التفاعل المفترض تحققها في النص المسرحي، والتي ستحقق عددا لا نهائيا من النهايات للنص المسرحي الواحد.
خصائص المسرحية التفاعلية:
تتميز المسرحية التفاعلية بجملة من الخصائص نلخصها في ما يلي[25]:
Ø التركيز على الإضاءة لتجسيد رؤية المخرج
Ø المزج بين الآلية(جهاز/ أجهزة الحاسوب)، والعنصر البشري(الممثل/ الممثلون)
Ø تتواجد شخصيات المسرحية التفاعلية في فضاء العرض بكل الأوقات، وتمنح وجودا معنويا متناسبا وأساسيا.
Ø الشخصيات في المرح التفاعلي على قدر واحد من الأهمية فتواجدها في فضاء العرض المسرحي يكون في ذات الوقت[26]
Ø دفع الجمهور إلى المشاركة في رسم سيناريوهات المسرحية وأحداثها، بوضعه أمام مواقف مشهدية وفرضيات تتطلبي منه اتخاذ القرارات في كيفيات المشاهدة ومواصلتها
Ø تجري الأحداث في بيئات حقيقية كفضاءات مسرحية كالقصور، الأكواخ، المنتجعات السياحية،ـ المطاعم، المزارع،ـ مقاهي،... إلخ.
Ø الزمان والمكان في المسرحية التفاعلية غير محددين إلا افتراضا مما يمنح المؤلف/ المتلقي إمكانات هائلة في تحميل نصه/ عرضه بما يلزم من علامات لغوية وغير لغوية كالأصوات والصور والعروض الحية وغيرها من الأدوات التي تقدم دعما للمسرحية التفاعلية وتعطيها زخما جماليا متميزا وهو ما يجعل تلقيها يأخذ أبعادا كثيرة وهذا سر فنيتها وجماليتها المختلفة.
Ø يتحرر الجمهور من قيود المقاعد الثابتة في صالة العرض المسرحي التقليدي، ليتحرك على هواه ويختار المشهد الذي يهواه
Ø نص المسرحية التفاعلية نص لا نهائي ولا يملك نهاية واحدة
Ø نص المسرحية التفاعلية منص غير مكتمل يتشكل مع كل مشاهدة ويتسم بعدم الثبات
Ø يملك المشاهد حرية انتقاء واختيار مسار المسرحية وتوجيهها بناء على الشخصيات والأحداث التي تشده أكثر، كما يحق له إضافة شخصيات وأحداث أخرى للمسرحية، وفقا لرغباته ورؤيته الخاصة، وهو ما يجعل كل مشاهد مؤلف.
Ø تتحول السينوغرافيا المسرحية إلى سينوغرافيا واقعية بتوظيف الديكورات الطبيعية، الإضاءة الطبيعية،ـ الموسيقى، وغيرها.
Ø انخراط الجميع في العمل المسرحي، وتلاشي الحدود بين المؤلف والمتلقي ليصبح الكل مبدعا ومنتجا
Ø استثمار المعطيات الحاسوبية في التنفيس عن المكنونات البشرية وإيجاد بديل لها افتراضيا.
Ø تفعيل عنصر التواصل والمشاركة بين عناصر المسرحية التفاعلية وبين المستخدم والعالم الافتراضي
[1] محمد حسين حبيب، نظرية المسرح الرقمي، نشر بتاريخ30 أوت 2008، اطلع عليه بتاريخ: 18ماي2023، على الساعة: 11:23 https://www.startimes.com/f.aspx?t=11687477
[2] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص98.
[3] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص99.
[4] عادل نذير، عصر الوسيط أبجدية الأيقونة(دراسة في الأدب التفاعلي الرقمي)، ص76.
[5] المرجع نفسه، ص76.
[6] السيد نجم، النص الرقمي وأجناسه، العربي الحر، مجلة الكلمة، ع19 يوليو2008، اطلع عليه بتاريخ 23 ماي 2023 على الساعة 13:27 الرابط: http://www.alkalimah.net/Articles/Read/1435
[7] محمد حسين حبيب، نظرية المسرح الرقمي
[8] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص104.
[9] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص101.
[10]محمد حسين حبيب، نظرية المسرح الرقمي
[11] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص100.
[12] حسب الله صميم، المسرح والتقنيات الرقمية وفرضيات الهيمنة على المسرح المعاصر، الحوار المتمدن، ع4157، نشر بتاريخ 17/7/2013، اطلع عليه بتاريخ: 20/ 06/2023 على الساعة 20:38، الرابط: https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369164
[13] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص100.
[14] محمد حسين حبيب، نظرية المسرح الرقمي
[15] ناصر محمد العمري، الثورة الرقمية حقيقة ثابتة نعيشها وتلقي بظلالها على كل مناحي الحياة، https://www.al-madina.com/
[17] محمد حسين حبيب، المسرح الرقمي بين النظرية والتطبيق، مجلة الكلمة، ع30 يوليو 2009، اطلع عليه بتاريخ: 11 جوان 2023، على الساعة 15:56 الرابط: http://www.alkalimah.net/Articles/Read?id=232&dossier=true
[18] Voir, charles deemer, watch out, mama, hyperdrama's, goanna mess with your pittock mansion.
[19] سومية معمري، الأدب الرقمي بين المفهوم والتأسيس(مقاربة في تقنيات السرد الرقمي)، رسالة دكتوراه، إشراف د: الخامسة علاوي، كلية الآداب واللغات، جامعة الإخوة منتوري، بقسنطينة، 2016/2017، ص50.
[20] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص109.
[21] المرجع نفسه، ص100.
[22] عادل نذير، عصر الوسيط، ص80.
[23] محمد حسين حبيب، نظرية المسرح الرقمي
[24] محمد حسين حبيب، نظرية المسرح الرقمي
[25] صفية علية، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، ص119.
[26] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص111.
-
المسرح الرقمي، الشاشة الإلكترونية، الفضاء الافتراضي، المتلقي المنتجّ، العقد النصية
-
-
يعتبر المقال من الأجناس الأدبية التي ذاع صيتها في المجال المعرفي والمقال هو "عبارة عن عمل مكتوب يطرح موضوعا واحدا على شكل فكرة أو عدة أفكار مترابطة، ويتكون المقال الناجح على الأغلب من مقدمة تكون جذابة ومشوقة لتجذب انتباه القارئ، وثم العرض وفيه تكون تفاصيل الموضوع وعرض للأفكار المتعلقة به، وبعدها الخاتمة وفيها خلاصة لما جاء في العرض"[1]

ومع دخول العالم إلى مرحلة جديدة من التطور الذي كان سببه الثورة التكنولوجية والرقمية لبست المقالة ثوبا جديا غير مألوف فأصبح لدينا ما يسمى بالمقالة الرقمية، كما عرفت لإقبالا شديدا كون "المقالة من الأجناس المحببة إلى المتلقي لأسباب كثيرة، ربما أهمها هنا نتيجة التفاعل النفسي معها، لسهولتها وموضوع تناولها الذي غالبا ما يهتم بالهموم المباشرة للفرد العادي. ومع رواج التقنية الرقمية بعد عشرات السنين من المرحلة الورقية، زاد المتلقي تفاعلا، للأسباب السابقة ومعها أسباب أضافتها التقنية الرقمية، ففي المرحلة الورقية كان التفاعل يتم بإرسال الردود إلى الصحف والمجلات بمجرد قراءة المقالة، ليُنشر في الصحيفة ذاتها أو غيرها في اليوم التالي، أو بعده، ولعلّ هذا الشكل، وهو الوحيد المتاح خلال الطور الورقي هو أقصى ما يمكن أن يمثل التفاعل القائم بين القراء والمقالة.. أما في المرحلة الرقمية فإن صور التفاعل يمكن أن تتخذ أشكالاً أخرى، مع سرعة الرد يمكن أن تصل إلى الدقيقة التالية مباشرة لنشر المقالة في أحد المواقع الإلكترونية"[2]
إن شيوع فكرة النشر الإلكتروني هو الذي ألهم كتاب المقالة الأدبية على اعتماد التكنولوجيا بمختلف الوسائط التي تتيحها كوسيط بينها وبين المتلقي بهدف تحقيق أكبر مقروئية من جه، ومن جهة أخرى لتفعيل دور المتلقي ودفعه إلى المشاركة والتفاعل مع المقال المنشور، وفي هذا السياق يصرح السيد نجم بأن ، "المقالة التفاعلية ظهرت بشكل جديد كليًا منذ سنوات، وذلك من خلال تحويل البرامج التي تبثها القنوات الفضائية المختلفة إلى نصوص مكتوبة، ليقرأها القراء الذين لم يتمكنوا من متابعة البرنامج عند بثّه على الفضائية، وليتمكنوا أيضًا من التعليق والمداخلة كتابيًا، وهذا شكل متطور جدا من الأشكال التي اتخذها فن المقالة، ويعكس قدرًا عاليًا من التفاعلية بين النص والقراء"[3].
استعانت المقالة الأدبية من مختلف الوسائط الإلكترونية والمؤثرات السمعية والبصرية من أجل تحقيق الهدف الأساس وهو التأثير في المتلقي وتحفيزه على إبداء وجهات نظره وتحقيق التفاعل، حيث "توظف المقالة التفاعلية النص (الكلمة) والصوت والصورة والجداول والرسوم الكاريكاتورية وتقنيات التجسيم، بخلاف المقالة التقليدية التي لا تتجاوز الكتابة النصية إلا إلى الصورة الثابتة فقط. والأهم من كل هذا هو إمكانية استخدام تقنية النص المتفرع ـ (Hypertext) في المقالة التفاعلية، وربطها بعدة مقالات أخرى، أو بمواقع مختلفة، أو وضع إحالات وهوامش ومرجعيات تعود إلى نصوص أخرى من خلال الرابط فقط، وهو أمر غير متحقق في المقالة الورقية التقليدية. إن توظيف هذه المعطيات التقنية في المقالة التفاعلية يعد جزءًا رئيسيًا من النص، وليس ملحقًا تكميليًا. وتجعل المتلقي ايجابيا ومتفاعلا مع النص"[4]
 .
.وفي هذا الشأن أيض تشير عبير سلامة إلى أنه من سلبيات المقالة التفاعلية إزالتها الحدود بين الكاتب والقارئ، وهذا أمر إيجابي من جهة، لأنه يفتح قنوات التواصل بين عناصر العملية الإبداعية وأركان الفعل الثقافي الفعّال في المجتمع. ولكنه قد يصبح سلبيًا من جهة أخرى، إذا لم يكن مقترنًا بوعي الأطراف جميعها بأدبيات الحوار والنقاش والتعليق والمداخلة، إذ يترتب على هذا إمكانية تطاول أحد الطرفين (الكاتب والقارئ) على الآخر، مستغلاً سهولة فعل ذلك من خلال الإمكانيات المتاحة في المقالة التفاعلية، التي تتجاوز قوانين النشر الورقي، وموظّفًا الحرية المتوافرة له عبر النشر الإلكتروني أسوأ توظيف"[5].

إن مسألة وعي المتلقي لا تخص النص الرقمي فقط ، فحتى النصوص الورقية طالها نوع من التطاول وكتبت حولها هجومات نقدية، كما أن فئة القراء تختلف من قارئ لقارئ فمثلما فيهم القارئ السلبي نجد أيضا نظيره الذي يقدر النص حق قدره، وبالتالي نقول أن المقال التفاعلي "يبقى له إيجابياته، المتمثلة في تعزيز دور القارئ حيال ما يقرأ، وإعطاؤه انطباعًا بأن رأيه مهم ومرَحَّب به.. إتاحة الفرصة لعدد كبير مفعلا للمتابعة والمشاركة.. تُحَوَّل كثير من نصوص البرامج التلفزيونية إلى مقالات تفاعلية مطوّلة، تستحوذ على اهتمام عدد كبير من القراء، الذين يعوضون عدم حضورهم البرنامج أثناء إذاعته فعليًا.. إثارة نوع من التفاعل بين القراء والنص من جهة، وبين القراء أنفسهم من جهة أخرى"[6]
 .
.
[1] تسنيم معابرة، نصائح في كتابة المحتوى(المقالات)، 3آذار 2013، لوحظ بتاريخ: 15 أوت2023، على الساعة 21:14https://meshkatcommunity.org/media/text/
[2] السيد نجم، النص الرقمي وأجناسه
[3] المرجع نفسه
[4] م نفسه
[5] عبير سلامة، النص لا يخص المرء وحده، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ، مصر، ط1، 2012، ص48.
[6] السيد نجم، النص الرقمي وأجناسه
-
، المقال التفاعلي، االتفاعل النفسي، القنوات الفضائية،المؤثرات السمعية والبصرية، المعطيات التقنية
-
-
يطرح الأدب التفاعلي العديد من القضايا والإشكالات كونه نمط كتابي مستحدث فرضته الثورة التكنولوجية بمختلف معطياتها الرقمية، ولعل اهم إشكالية تثيرها هذا الموضوع هو إشكالية تجنيس الأدب التفاعلي حيث إن "توظيف الأدب الرقمي لإمكانات الوسائط المتعددة قد يؤدي إلى إشكالية عسيرة في تصنيفه ضمن جنس أدبي معين، وهذا الأمر يحدث خللا في نظرية الأنواع الأدبية ذاتها، فبمقدوره أن يهضم الأجناس الأدبية الأخرى ويشكل جنسا أدبيا جديدا ، له طابعه الخاص، وآلياته الخاصة، غير أن هذا الأمر لا يعني البتة تجريد الأدب الرقمي من أدبيته، ولكن نظرية الأنواع الأدبية تحتاج إلى صياغة جديدة، نظرية جديدة ومختلفة تجمع كل الأجناس الأدبية السابقة من رواية وقصة وشعر ومسرح وغيرها لتدمجها في جنس إبداعي جديد، بوعي جديد، لأن لكل عصر وسائله وأسلوبه وطريقته في الإبداع، لذلك نحن بحاجة إلى جنس أدبي جديد وكتابة جديدة عابرة للأجناس الأدبية السابقة"[1]

وهذا الطرح هو نفس ما يذهب إليه محمد سناجلة حيث يؤكد في كتابه رواية الواقعية الرقمية أن "هذا العصر سينتج أدبا جديدا قادرا على هضم كل ما سبق ومزجه مع ما توفره الثورة الرقمية من إمكانيات كبيرة لخلق جنس إبداعي جديد، قادر حقا على حمل معنى العصر الرقمي بمجتمعه الجديد وإنسانه المختلف"[2].
إن تلبس الأدب بالتكنولوجيا خلق لنا ما يسمى بالأدب الرقمي الذي يمكننا أن "نتحدث عن ممارستين مختلفتين حيال الأجناس الأدبية: فهناك من جهة أنواع قديمة(الشعر، السرد، الدراما)، أي الأجناس الكلاسيكية والتي بدأت تتلبس بالآليات الرقمية وتوظفها لفائدتها، متخذة بذلك مظهرا جديدا للأدب ومقدمة صورة جديدة للإبداع الأدبي، وقد تنوعت التجارب في هذه الأجناس وصارت متعددة ومتفرعة، يتداخل فيها اللفظي بالصوري بالحركي، والصوتي بالسمعي والثابت بالمتحرك... كما بدأت تظهر أجناس جديدة من جهة أخرة متصلة بالحاسوب والفضاء الشبكي مثل الروايات المشتركة والكتابات التفاعلية الجماعية التي يشارك العديد من القراء والكتاب في كتابتها"[3]

إن هذه الجدة التي طرأت على الأدب بمختلف أجناسه وألبستها ثوبا مغايرا لما هو معهود هي التي أثارت ولا تزال تثير رغبة النقاد والمتلقين على حد سواء في متابعة هذا الأدب الجديد لسبر أغواره ومعرفة كنهه وآليات تشكيله، "وإن تعدد هذه الأشكال والأجناس التعبيرية يجمع بينها عنصران مركزيان هما: البعد الرقمي الذي يجعلها تتحقق بواسطة الوسيط الجديد من جهة، والبعد التفاعلي الذي يتجلى بصور وأشكال متعددة من جهة ثانية، وهي مرشحة للمزيد من التطور والتنوع، نظرا لما يختزنه هذا الوسيط من إمكانيات وما يوفره من خدمات تساعد على تفتق الإبداع وتطويره"[4]
وللإفادة فإن التشكيلات البنائية التي تتمظهر فيها هذه النصوص الأدبية الرقمية "تختلف من نص أدبي إلى آخر، ومن جنس أدبي إلى جنس أدبي، هذا على افتراض أن مفاهيم الأجناس الأدبية السائدة والمألوفة ما زالت قادرة على التعبير عن الأشكال الإبداعية الرقمية، وقد حاول كثير من النقاد والدارسين تقسيم الأجناس أو الأشكال التي تندرج تحت تصنيفات الأدب الرقمي، ومنهم من اجتهد في حدود النماذج والتجارب المتاحة، ومنهم من أخذ عن غيره، ولم يهتم بالتثبت من هذه التقسيمات"[5]، من بينهم فاطمة البريكي، وعبير سلامة، وغيرهما وهذه التقسيمات متمثلة في (القصيدة الرقمية، الرواية الرقمية، المسرحية الرقمية).
وبطبيعة الحال فإن هذه التقسيمات المطروحة في الساحة النقدية إنما تعتمد على "الأنواع السائدة والمألوفة من الأجناس الأدبية بعد أن ارتدت حلة عصرية، وتلبست بلبوس التكنولوجيا. وقد تكون هذه الأنواع سهلة المأخذ والفهم من قبل المتلقي الذي يفهم دلالة (القصيدة، والمسرحية، والرواية) ويبقى عليه مهمة استيعاب الوسيط الجديد الذي تقدم عبره، واشتراطات (التفاعلية) التي باتت تتطلبها الأشكال الجديدة، ولعل هذا ما دفع بعض النقاد ليرى أن المسألة لا تتجاوز أن تكون " أيقونات جديدة لمحتويات قديمة"[6]، وبالتالي فإن مسألة تجنيس النص تعود إلى المتلقي، وفي هذا الصدد تشير زهور كرام إلى أن المسؤول عن تجنيس نص ما هو القارئ ، وهذا يقودها إلى طرح أسئلة تسمها بالخطيرة، حيث تقول: " هل أجناسية النص المترابط التخييلي مسألة غير ثابتة ، ذات علاقة بتحولات تفاعلية للقارئ ، وحالاته الثقافية والنفسية والمعرفية والجمالية مع النص المترابط ؟.[7]
وقد أرجع إيمان يونس هي الأخرى هذه المسألة ( التجنيس) إلى القارئ الذي يملك مفاتيح النص شكله وجنسه بتفاعله مع النص، ليأتي الوسيط التقني في مرحلة لاحقة عن القراءة للتحديد والتجنيس[8]
إن عدم القدرة على تقديم تحديد أجناسي للأدب الرقمي مرده إلى قصور النظرية النقدية وفي هذا السياق يقول رائد الإبداع الرقمي العربي محمد السناجلة: " كيف يمكن أن تحدد هكذا كتابة بجنس أدبي استنادا إلى نظريات نقدية سابقة لم تعرف التحولات التي أحدثتها الثورة الرقمية على الكون والإنسان والوجود؟"[9]
نفس الطرح تذهب إليه إيمان يونس في دراسة لها بعنوان تأثير الأنترنيت على أشكال الإبداع والمتلقي حيث تقول: إن النظريات النقدية قبل الرقميات لم تعد صالحة لاقتحام كثير من عوالم النص الأدبي الجديد، وكذلك فإن المصطلحات والمفاهيم النقدية الرائجة استعمالا لم تعد بذات الحمولات الدلالية، وعند هذا الحد تصبح الحاجة ماسة للمناداة بنظرية نقدية جديدة كل الجدة، بعد أن ظهر من يقول :" نحن بحاجة إلى جنس أدبي جديد ، ليس هو بالرواية وليس بالشعر وليس هو بالمسرح ولا السينما، ولا أيضا اللغة التقنية الجديدة بل هو مزيج من كل هذا معا ، كتابة جديدة عابرة للأجناس الأدبية السابقة، وعصية على التجنيس إن نحن حاكمناها باستخدام النظريات النقدية السابقة. ذلك أننا أمام لغة (كتابية) جديدة ومختلفة لم تعد الكلمات سوى جزء من كل فيها، كتابة تجد فيها الصورة والحركة والموسيقى والأغاني والمشهد السينمائي وفن الجرافيكس وبرامج تقنية متعددة ومختلفة إضافة إلى الكلمة"[10]
في ظل هذا الوضع النقدي ارتفعت في الساحة النقدية أصوات تطالب بإلغاء كل ما هو سائد ومألوف من النظريات النقدية، والتوجه نحو نقد رقمي يناسب التحولات وحجمها وشكلها، ويلخص ذلك أحد النقاد بقوله:" نحن بحاجة إلى قراءة نقدية إلكترونية تفاعلية، تضاهي طبيعة القصيدة الإلكترونية التفاعلية، وإلا كانت قراءة تقليدية لنص غير تقليدي ولا مألوف ولا مهيأ لمعظم القراء، وسيتعذر على القارئ متابعة ما نقدم إليه إلا في نطاق نخبوي ضيق"[11] ، وقريبا من هذا الرأي يقول محمد المبارك: " المفهوم التقليدي للنقد وآلياته لم يعد يصلح لمقاربة النص الجديد، ...، فنظرية القراءة حتى وإن ارتبطت بالأدب المطبوع فهي لا تزال غضة طرية وما زال الكلام فيها متسعا وقد يحمل بعض نقادها المتحمسون شتاتها ليلقوه إلى ذاكرة القرن الواحد والعشرين"[12]
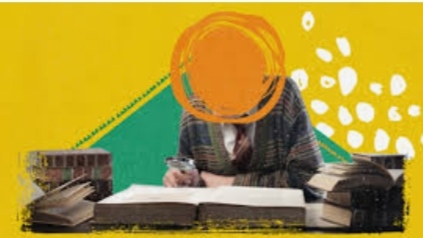
وعليه تقترح الباحثة إيمان يونس وجوب "التفكير باتجاهات نقدية جديدة تعنى بدمج التكنولوجيا والأدب معا والتفكير بنظريات حديثة ومدارس نقدية جديدة تتخذ من الميزات التقنية معايير أساسية لتقييم العمل الفني"[13] بحكم أن للنص الأدبي الرقمي معايير وخصائص لم تتطرق إليها المدارس والمذاهب النقدية الموجودة.
[1] جمال قالم، الأدب التفاعلي وإشكالية تداخل الاجناس، ص93
[2] محمد سناجلة، الأدب الرقمي يكتب ويقرأ ويشهد معا، ص187/196
[3] جمال قالم، الأدب التفاعلي وإشكالية تداخل الاجناس، ص93.
[4] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص196.
[5] أحمد زهير الرحاحلة، المتلقي وإشكالية الأجناس الأدبية الرقمية، نشر بتاريخ، 1 جوان2017، اطلع عليه بتاريخ: 16 أوت2023، على الساعة: 15:47 http://www.qabaqaosayn.com/node/11819
[6] أحمد زهير الرحاحلة، المتلقي وإشكالية الأجناس الأدبية الرقمية.
[7] زهور كرام الأدب الرقمي : أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية ، ص78.
[8] إيمان يونس، تأثير الانترنيت على أشكال الإبداع والتلقي، ص344.
[9] محمد سناجة الرواية الواقعية الرقمية، ص68.
[10] إيمان يونس، تأثير الانترنيت على أشكال الإبداع والتلقي، ص160
[11] عبد الله بن أحمد الفيفي، شعر التفعيلات وقضايا أخرى، دار الفراهيدي للطباعة والنشر، بغداد، الطبعة الأولى، 2011، ص 103.
[12] محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات، لبنان، ط1، 1999، ص123
[13] إيمان يونس، تأثير الانترنيت على أشكال الإبداع والتلقي، ص345.
-
إشكالية التجنيس، نظرية الأنواع الأدبية، الكتابة العابرة للأجناس، الفضاء الشبكي، التشكيلات البنائية
-
-
مرّ النص الأدبي عبر مسارات تطوره ووصوله إلى المتلقي بعدة مراحل انتقالية، وكل مرحلة كان لها أثرها في عملية إنتاج النص الأدبي، فهو لم يأت إلى الوجود كاملا ومتكاملا ولم تكن ظروف إنتاجه بمنأى عن السياقات التاريخية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن هذا فإن طريقه إلى المتلقي لم يكن يسيرا ولم يكن موحدا منذ بدايته إلى يومنا هذا وإنما هو خاضع للقنوات والوسائط التي يتيحها كل عصر، لهذا وقبل الحديث عن الفروقات بين الأدب الورقي والأدب الرقمي نحاول عرض مراحل تلقي الأدب عبر عصوره المختلفة.
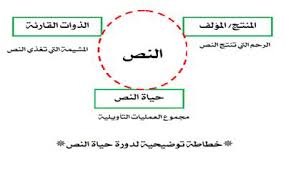
مرحلة الشفاهة:
عرف الشعر في العصر الجاهلي وتداولته الألسنة بالشفاهة والرواية كما كان معروفا في أسواق الجاهلية، وقد ساعدهم الشكل الشعري (الأوزان والقوافي) للقصيدة على حفظها في الصدور، وحتى مع دخول عصر الإسلامي ومعرفة ما يسمى بالكتابة بقي التمسك بتداول الشعر شفاهة إذ كانوا يرون "أن القديم هو الأصيل ولا أصيل غيره، وأن (المحدث) لا يمكن له أن يبلغ شأوه وكل ما يمكنه فعله هو تقليده والنسج على منواله، ولأن الذائقة العربية تعد الصوت أبرز المكونات الفنية، فإنها لم تستطع تقبل الكتابة بوصفها عنصرا فنيا، ولم تر فيها إلا وسيلة لتقييد العمل الأدبي وحفظه من الضياع، ورأى علماء القرن الأول الكتابة منافسا غير شريف للرواية والراوي، فحرّموها واحتقروها"[1]، من بينهم ابن سلام الجمحي الذي يقول في مقدمة كتابه طبقات فحول الشعراء: "في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته ولا غريب يستفاد ولا مثل يضرب ولا مدح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي"[2]، ففي نظره الصحفي لا يؤخذ بكلامه لأنه ليس محل ثقة، "وهذا الحكم الذي وضعه علماء عصر الرواية الشفوية ظل ساريا حتى وقت متأخر، ولقد أصبحت كلمة (صحفي) التي تطلق على الراوي الذي يعرف الكتابة شتيمة يتهرب منها العلماء"[3]
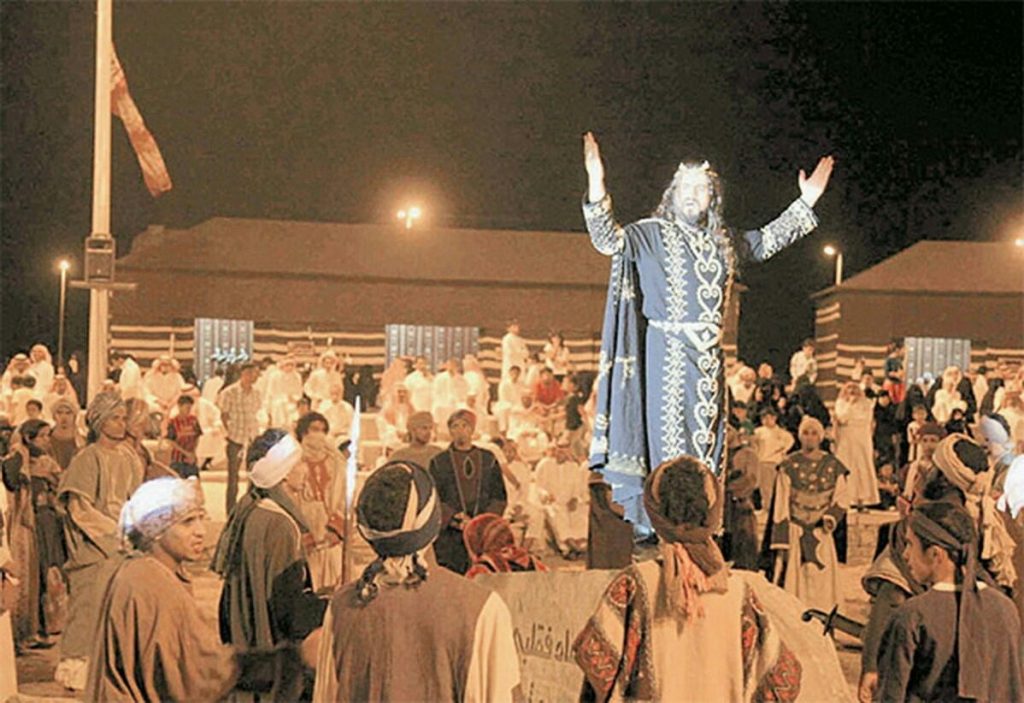
مرحلة الكتابة:
عرفت حياة الإنسان الكثير من التطورات التاريخية خاصة مع التداخل الذي عرفته مختلف الأجناس والأعراق والمجتمعات مما جعل عملية التفاهم فيما بينهم عملية عسيرة نوعا ما "ولذلك بذل قصارى جهده في إيجاد الوسيلة التي يستطيع عن طريقها التواصل والتفاهم مع تلك المجتمعات، ولذلك هداه التفكير إلى اختراع الكتابة التي من خلالها يستطيع أيضا الاحتفاظ بنتاجه الفكري وتراثه الثقافي والعلمي من الضياع والاندثار. وقد مرّت الكتابة بعدّة مراحل زمنية قبل أنْ تبلغ القبول والسهولة في الاستخدام"[4]
يعود تاريخ اكتشاف الكتابة إلى ما يقارب 1200 سنة قبل الميلاد، حين عمل الإنسان البدائي على تدوين أفكاره وإبداعاته على الصخور والألواح الطينية والجلود وأوراق البردي، وغيرها من الوسائل، واستمر ذلك إلى غاية نهاية القرن الخامس عشر أين تم اختراع المطابع، وظهرة ما يسمى بصناعة الكتاب الورقي التي أخذت بعدا تجاريا
اشتقت لفظة Paper (الورق) من لفظة Papyrus (البردي) ومن اسم مدينة جبيل Byblos, وهي الميناء الفينيقي الذي أصبح فيما بعد مركزاً لتصدير البردي، اشتق الإغريق لفظ Biblion وهو اسم الكتاب في لغتهم. ومن كلمة Biblion هذه نشأت كلمة Bible ومعناها الكتاب المقدس. وحوالي العام 400 للميلاد حل الرق Parchment وكان يعد من جلود الحيوانات محل البردي, واتخذ الكتاب شكله الحاضر ذا الصفحات المطوية المضموم بعضها إلى بعض.[5] وفي القرن الثامن للميلاد شرع العرب يستخدمون الورق الذي ابتكره الصينيون عام 105 للميلاد بدلاً من الرق ( الجلود ) بعد فتح مدينة سمرقنـد حيث أسسوا مصنعاً لصناعة الورق عام 751م، ومع اكتساح الورق العالم الإسلامي تطور فن الكتابة وأصبح شائعا بشكل كبير.
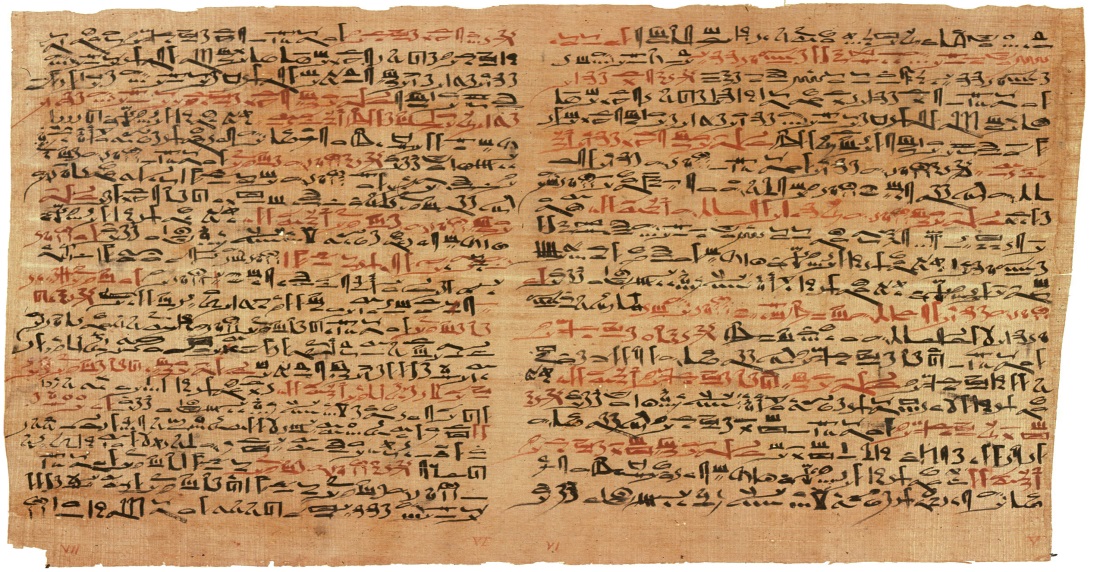
وفي هذا السياق يؤكد محمد سناجلة بأن "الفضل يعود إلى الصينيين في اختراع مادة الورق الذي أنتجوه ابتداءً من القرن الأول بعد المسيح، وذلك انطلاقاً من سيقان نبات الخيزران (البامبو) المجوفة والخرق البالية أو شباك الصيد. كانت هذه المواد تدق، بعد أنْ تغسل وتفقد ألوانها، في مطاحن خاصة حتى تتحول إلى عجينة طرية فتضاف إليها كمية من الماء حتى تصبح شبيهة بسائل الصابون، وبعد أنْ يصفَّى الخليط تؤخذ الألياف المتماسكة المتبقية بعناية لتنشر فوق لوح مسطح لتجففه حرارة الشمس. وبعد التجفيف يمكن صقل فرخ الورق المحصل عليه بعد ذلك بواسطة خليط من النشا والدقيق ويجفف من جديد. وهكذا يحصل على ورق قابل للاستعمال"[6]
تشير العديد من الدراسات التاريخية التي أنه عندما فتح المسلمون سمرقند سنة 751م وطردوا منها الجيوش الصينية أسروا عدداً كبيراً من الصينيين كان من بينهم صنَّاع الورق الذين أطلعوا العرب على أسرار هذه الصناعة، فأدخلها العباسيون إلى بغداد. ومن هناك انتقلت إلى الجزيرة العربية ثمّ إلى اليمن وسوريا ومصر والمغرب العربي والأندلس التي انتشرت عبرها في فرنسا وصقلية وإيطاليا انطلاقاً من القرن الثاني عشر الميلادي، أمّا في المغرب فإنّ الإقبال على الورق كان كبيراً جدّاً لدرجة أنّ بعض الوثائق المخطوطة تبرز أنّ مدينة فاس وحدها كانت تضم في عهد السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين مائة وأربعة معامل. أمّا في عهد السلطان الموحدي يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر (القرن الثاني عشر الميلادي) فقد كانت هذه المدينة تحوي ما يناهز أربعمائة معمل لإنتاج الورق. وقد كانت الأندلس المسلمة أيام الموحدين أهم طريق عبرت منه صناعة الورق إلى أوروبا كما تشهد بذلك نصوص الجغرافي المغربي الشريف الإدريسي[7]
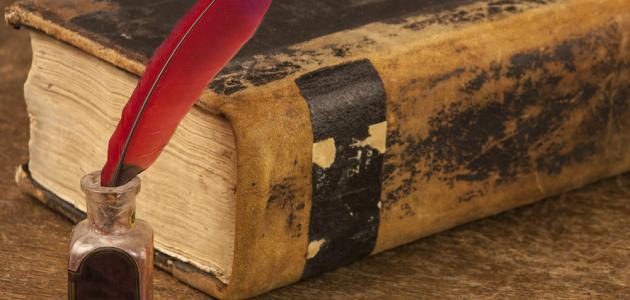
هكذا إذن كانت تطورات عصر الكتابة التي بدأت من الكتابة على الحجر إلى أكتاف الإبل إلى استخدام الرق إلى اكتشاف صناعة الورق، ثم التطورات الهائلة التي حدثت فيها، رحلة تاريخ وتطور عبر العصور، وها نحن الآن ندخل في عصر جديد ورحلة تطور أخرى للجنس البشري تستدعي وجود شكل جديد للكتاب والكتابة[8]، وقد شهدت كل هذه التطورات حضور النص الأدبي الذي يعكس إبداع وثقافة الإنسان في كل مرحلة من هذه المراحل.
لا يخفى على أحد من الدارسين أننا اليوم نعيش على عتبة تفصل بين عصرين مختلفين أيما اختلاف (العصر الورقي والعصر الرقمي)، مما يستدعي مراجعة معتقداتنا المعرفية، حيث "فرضت التقنيات الحديثة على الكاتب والقارئ وسائلها الجديدة للتدوين والاتصال والبحث والتدريس التي تختلف عن كل الوسائل المعتادة، فقديما كان الكتاب وكانت الصحيفة من ورق تحمل القارئ إلى عالم الأفكار وتصل بينه وبين العالم والباحث والشاعر والأديب، كاتب القصة أو المقال دون كبير اهتمام بالفاصل الزمني إلى في حالة الصحيفة التي تحمل الأخبار، اما الآن فهو أمام آلة تحمل له الصورة والصوت، إضافة للنص المكتوب، ويشهد ظهور نوع من الأمية عند الفئة المتعلمة من شعوب العالم الثالث سماها الباحثون بالفجوة الرقمية التي مازالت تتسع كل يوم، لقد أصبح اليوم بالإمكان وخلال وقت قصير أن ينشر الأديب عمله الأدبي ويقرأه كل مهتم بالأدب وفي أي مكان في العالم[9]
إن دخول العصر الرقمي يمتلك من الأهمية مالم يبلغه اكتشاف الكتابة منذ ثلاثة آلاف سنة، وربما "سيتجاور الكتاب الورقي المطبوع مع الكتاب الإلكتروني لمدّة من الزمن قد لا تتجاوز العشرين أو الثلاثين عاماً القادمة ولكن في النهاية لن يبقى سوى ابن العصر وناقل معناه وسيذهب الكتاب الورقي إلى متاحف التاريخ"[10]، وسينظر إليه كما ننظر نحن اليوم إلى النقوش الموجودة في الكهوف والأحجار.

وهذا الطرح يؤكده محمد سناجلة كتابه رواية الواقعية الرقمية حيث يقول: "إنّ عصر الثورة الرقمية هو نهضة جديدة وحضارة جديدة وأصبح التطور في الأدوات أكبر من التطور في المفاهيم والنظريات، لذا بدأ الإنسان يضع سيناريوهات للمستقبل ويتخيله بما في ذلك من ممكن وغير ممكن. فقد انتصر الحديث على القديم. وأصبح الخيال المعرفي سابقاً للخيال السلفي وما كان غير ممكن صار ممكناً وما كان مستحيلاً صار احتمالاً "[11]
إن استحداث هذه الثورة الرقمية فعّل في عملية التواصل ودفع بها أشواطا غير مسبقة، بفضل ما تتيحه الوسائط التكنولوجية(الأنترنيت)، مما جعل المجتمعات على اختلافها تتفاعل مع بعضها البعض كأنها في قرية صغيرة، ولاشك أن الأدب باعتباره فاعلية اجتماعية قد استجاب لهذه التغيرات التي حكمت العلاقات البشرية _ مرتبطة بحركة العولمة التي اجتاحت العالم _ فظهر ما يعرف بالأدب التفاعلي أو الرقمي؛ حيث إن ما أنتجته التكنولوجيا الرقمية هو إحدى تجليات مرحلة ما بعد الحداثة (Post modernism) التي عكست علاقة الاحتواء بين الفكر والتقنية، مما حتم على الأدب أن يغير من طرائق التلقي وأنماط التذوق والأسس الجمالية للفنون، لذا يرى سعيد يقطين "أن هذا الأدب الرقمي هو من جهة سليل الممارسة الإنسانية، ومن جهة ثانية بداية ممارسة أدبية جديدة، ليس فقط لأنه يوظف وسائط جديدة مغايرة لما كان سائدا، ولكن لأنه ينفتح في إنتاجه وتلقيه على علامات غير لفظية، بجعله إياها قابلة لأن تندرج في بنيته التنظيمية الكبرى، وتصبح بذلك بنيات يتفاعل معها مشكلا بذلك نصا متعدد العلامات"[12]
الفرق بين الأدب الورقي والأدب الرقمي:
ü اتساع رقعة الكتاب الأدبية من حيث عدد المشاركين الذي تضاعف بازدياد عدد المواقع الإلكترونية قياسا بعدد لصحف الورقية وعدد المطابع
ü اتساع حجم القراء والمتلقين، والذي يتجاوز بأضعاف عدد من كانوا يقرؤون الصحف والمجلات والكتب المطبوعة
ü ازدياد حجم التفاعل بين المرسل والمتلقي في إطار الموقع الإلكتروني، فمن ناحية التحديث المستمر باستخدام الشريط الضوئي، ما يجعل من دورة إنتاج الصحيفة الرقمية أو الموقع الإلكتروني دورة مستمرة في الزمن، الذي يسم المطبوعة الورقية ويميزها سواء كانت يومية أو أسبوعية أو غير ذلك، ومن ناحية أخرى نجد الاتصال بين المرسل والمتلقي الفوري، حيث يمكن أن يرفق أي نص أو مقال بردود أو تعليقات فورية، وفي كل لحظة، وعلى مدار الوقت، بعد أن كانت الصحف الورقية تتلقى ردود القراء عبر البريد خلال أيام وأسابيع.

ü يتم في الكتابة الأدبية الرقمية تجاوز الحدود الجغرافية، فعلى الصعيد العربي مثلا كانت حواجز الجغرافيا- رغم وحدة اللغة والثقافة- تحول دون تداول المطبوعات الورقية لأسباب أمنية وسياسية، لتتأخر في الوصول بسبب حدود الجغرافيا، أما المواقع الإلكترونية- الإعلامية والثقافية- فتأخذ صفة قومية من طبيعة من يكتبون أو يشاركون في تحريرها ومن يقرؤونها أو يتابعونها.
ü طبيعة النصوص الأدبية المكتوبة أو المتداولة في المواقع الإلكترونية باتت نصوصا مفتوحة بامتياز، فلا يمكن الآن بث خبر على سبيل المثال، دون أن يجد على الفور من يؤكده أو من ينفيه، وكذلك يمكن القول بأن سطوة المؤلف المتمثلة فيما يحصل عليه من امتياز على القارئ قد تضاءلت إلى حدود قصوى، لأنه بات بمقدور كل من يشاء أن يكتب أو يرسل وهو جالس في بيته، كما أن المتلقي قد تجاوز حدود الأدب في أن يتلقى ولا يقو سوى على الاختيار بين كاتب وآخر بل هو يدخل على خط الكتابة بالتعليق والرد والتقييم الفوري
ü أصبح بمقدور النص الأدبي الرقمي أن يستخدم المزيد من التأشير والتوضيح المعرفي، المرفقات البصرية والسمعية بأكثر مما كان يمكن للنص الأدبي الورقي، فقد أضيفت هنا إمكانية إضافة السمعي- أي المؤثرات الصوتية- وكذلك إمكانية أن يكون البصري متحركا وليس مجرد صورة ثابتة.
ü توفر إمكانية إحالة النص الأدبي الرقمي إلى الموضوعات ذات الصلة على الفور دون مجرد إثباتها كمراجع وحسب، من خلال الروابط التي تنقل خط القراءة من مستوى لآخر، ومن ثم العودة إليه كما يشاء القارئ[13]
[1] ثائر عبد المجيد العذاري، الأدب الرقمي والوعي الجمالي العربي، مجلة آداب الفراهيدي، ع2، 2010، 79.
[2] محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، دت، دط، ج1، ص4.
[3] ينظر، جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998، ج1، ص135.
[4] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص172.
[5] المرجع نفسه، ص 173.
[6] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية ، ص177
[7] المرجع نفسه، ص 178.
[8] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص 181.
[9] أنيس حجار، الأدب الرقمي.
[10] محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية، ص 200.
[11] ا المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[12] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص192.
[13] رجب أبو سرية، الكتابة بين عصرين.
-
المراحل الانتقالية في الأدب، حياة النص، الذات القارئة، الشفاهة، الكتابة، الرقمنة،
-
-
إن ظهور الكتابة الرقمية التفاعلية فرض على الممارسات النقدية استحداث مفاهيم نقدية تتواءم مع هذا النمط الكتابي المستحدث من بينها: الكتابة الجماعية التي يقصد بها تعدد المبدع، ويمكن أن يعد هذا المفهوم واحدا من جملة المفاهيم التي أثمرتها علاقة الأدب بالتكنولوجيا والذي يقابل مصطلح collaborative writing في اللغة الإنجليزية، ويقصد به ذلك النمط من الكتابة الأدبية التي يتعاون في إنتاجها عدد من الأشخاص في توجه نحو الجمعية في مقابل الفردية التي سادت في الفترة السابقة[1]

ومع أن أسلوب الكتابة الجماعية أو إمكانية تعدد المبدعين للنص الأدبي الواحد أمر غير طارئ على الأدب إذ توجد محاولات وتجارب سابقة إبان العصر الورقي للنصوص الأدبية لعل مثالها البارز في أدبنا العربي الحديث رواية عالم بلا خرائط للروائيين عبد الرحمان منيف، وجبرا إبراهيم جبرا، ولكن تلك التجارب ظلت تعاني من بعض المعوقات التي حالت دون انتشار هذا النوع من الكتابة الأدبية في أوساط الأدباء والمثقفين منها: أنها ظلت محاولات محدودة ومعدودة ومنها أنها كانت شبه مرفوضة لليقين الراسخ في أعماقنا حول التجربة الإبداعية وما يلفها من خصوصية وما يجب أن تتسم به من فردية مما يجعلها تتعارض مع فكرة التعددية أو الجماعية في الكتابة والتأليف[2].
كما أنها صعبة على مستوى التنفيذ إذ تحتاج إلى مبدعين متجانسين ثقافيا وفكريا ونفسيا حتى يتمكنوا من الاندماج والتلاحم مع النص على مستوى البنية والفكرة ليأتي النص في النهاية كأنه نسيج مبدع واحد لا عدة مبدعين[3]
وفي الطور الإلكتروني للأدب يبدو أن مفهوم الكتابة الجماعية بدأ يشق له طريقا بين المفاهيم السائدة على مستوى التنظير وعلى مستوى التطبيق، فالنصوص الأدبية الإلكترونية التي تعتمد على غير مبدع أكثر من أن تحصى وهذا يعني أنها تخلصت من المعوق الأول وكونها بدأت في الانتشار في الأوساط التكنو- أدبية يشير إلى أنها تخلصت من المعوق الثاني وهو الرفض الذي كانت تعاني منه نتيجة عدم قدرة المتلقي على استساغة نص أدبي يشترك في إنتاجه أكثر من مبدع[4] ، فمع دخول النص الأدبي مجال التكنولوجيا "لم يبق الأمر على حاله، تغيرت جذريا آليات تشكيل النص وتلقيه، فالكاتب ليس الوحيد الآمر الناهي الذي يشكل امتداد النص كيفما يشاء إنما هناك من يشاركه المهمة على قدم المساواة، بل ربما في أحيان تتجاوز صلاحيات هذا الأخير صلاحيات الأول، لذلك ظهرت الآن ما يعرف في أبجديات الكتابة الإلكترونية التفاعلية مصطلحات مثل: كاتب مشارك، والكتابة الجماعية، والتلقي التفاعلي إلى غيرها من المصطلحات التي بدأت دائرتها تتسع يوما بعد يوم"[5]
أما المعوق الثالث وهو صعوبة تنفيذ هذه الفكرة فقد كانت الصعوبة تتمثل في جانب واحد عندما كان الأدب ورقيا، ولكنها الآن تتمثل في أكثر من جانب بعدما أصبح الأدب إلكترونيا ويمكن على سبيل المثال أن تضاف إلى الصعوبة التي سبق ذكرها صعوبة أخرى هي ضرورة أن يمتلك المبدع خبرة تامة في مهارات الحاسوب ويستحسن في بعض لغات البرمجة أيضا.[6]
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الكتابة الجماعية بحر لجي لا يستطيع ركوبه إلا من توافرت فيه عدة صفات تعينه على ذلك، ويشترط توافر هذه الصفات في جميع أفراد فريق العمل المنوط به كتابة نص أدبي جماعي، ومنها[7]:
ü التمكن من الفن أو الجنس الأدبي الذي يكتب فيه بصورة فردية، قبل أن ينبري للكتابة الجماعية، فإذا كان أسلوب الكتابة التقليدي القائم على الفردية يجعله وحده مسؤولا عن مستوى النص الناتج، فإن أسلوب الكتابة الجماعية يوزع مسؤولية النص على الفريق كاملا، وبذلك قد يتسبب الإخفاق في اختيار فرد واحد إلى الاخفاق في النص كاملا، حتى وإن كان مستوى بقية أفراده عاليا جدا.
ü الخبرة في استخدام الحاسوب، وإتقان بعض لغات البرمجة
ü التحرر من النمط التقليدي في الكتابة الأدبية القائم على التمحور حول الفرد المبدع الواحد والإيمان بفكرة الكتابة الجماعية، وبإمكانية تعدد المبدع وبجدوى كل ذلك وبالفائدة التي سيعود بها مثل هذا المفهوم على العملية الإبداعية حيث "يتسم الأدب التفاعلي بكونه يقدم نصا مفتوحا بلا حدود، فلا يعترف بالمبدع الوحيد للنص صاحب السلطة المطلقة، بل يمنح المتلقي فرصة الإحساس بأنه مالك لكل ما يقدم هو أيضا، كما أن البدايات فيه غير محدودة والنهايات غير موحدة، تختلف من قراءة إلى أخرى ومن متلق إلى آخر، بالإضافة إلى أنه يمنح المتلقين فرصة لإثارة الحوار الحي ما يخلق تعددا للأصوات وتفاعلية عالية تزداد درجة تحققها فيه عن الأدب التقليدي(المطبوع)"[8]
ü تغييب الذاتية وتذويب الفردية في قالب الجماعية" فالأدب التفاعلي لا يعترف بالمبدع الوحيد للنص الذي عليه أن يتحرر من وهم النص المكتمل والذي لا ينتمي إلا إلى مؤلفه، وهذا مترتب على جعل جميع المتلقين والمستخدمين للنص التفاعلي مشاركين فيه، ومالكين لحق الإضافة والتعديل في النص الأصلي... ويجعل من المبدع متلقيا ومن المتلقي مبدعا، ليؤدي اتحاد هذين العنصرين إلى إنشاء نص جديد، ملك لجميع رواد الفضاء الافتراضي"[9]
ü امتلاك القدرة على التكيف مع نص يبدأه شخص آخر أو وضع فقرة لإكمال فكرة ما بدأها قبله شخص آخر، وليس هذا وفقط، ففي رواية على بعد ملمتر واحد لمحمد أستيتو على سبيل المثال لا الحصر لعب القراء دوران مهما، تلقي العمل من جهة والمساهمة في تأليفه من جهة أخرى حيث كان القراء يقترحون نهايات وأحداث مختلفة باختلاف القراء، وذلك بعد أن نزلها الكاتب على شكل فصول على صفحته الفيسبوكية.
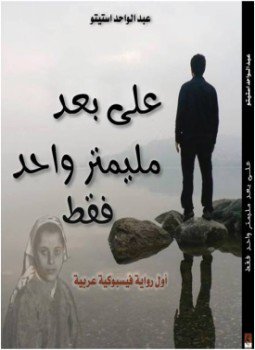
ü امتلاك روح المنافسة العالية التي تدفع إلى الإبداع وتنمي حس الابتكار
ولا يقتصر مفهوم الكتابة الجماعية على فئة المبدعين من الأدباء والكتاب فقط، إنما يمتد ليشمل جميع من يرتبطون بالنص الأدبي الإلكتروني بسبب كالمبرمجين والمصممين وغيرهم فالمبدع الأدبي في العصر الرقمي لا يستطيع العمل بمفرده مهما كان مستوى تمكنه من التعامل مع جهاز الحاسوب ومهما كانت خبرته في البرمجة إذ يظل غالبا في حاجة إلى الاستعانة بالمبرمجين والفنيين كي يخرج عمله متقنا ودقيقا وبهذا لا يتعدد المبدع فقط في الفضاء الافتراضي إنما تتنوع طبيعته وتتعدد وظائفه أيضا[10].
فنظرية التلقي التي تعتمد على إزالة الحدود والحواجز بين المبدع والمتلقي والتي تجعل كل متلق مبدعا تنادي بتعدد القراءات وتعدد القراءات قد يعني في بعض حالاته تعدد المتلقين الذين يثري كل واحد منهم النص بطريقته الخاصة مما يحيل إلى فكرة تعدد المبدعين[11]
كما نجد أن خاصية تعدد الأصوات التي تميزت بها بعض النصوص الروائية الورقية قد تتخذ شكلا جديدا في ظل اتحاد الأدب بالتكنولوجيا وانفتاح المبدعين على آفاق الكتابة الجماعية وقبولهم بفكرة تعدد المبدع ففي حين كان المبدع سابقا هو من يضع الشخصيات ويرسم ملامحها ثم يدع كلا منها تتكلم بصوتها هي فإن المبدعين الآن غير مضطرين إلى القيام بذلك وما عليهم سوى أن يختار كل واحد منهم شخصيات مختلفة وبهذا يظهر التباين والاختلاف بين وجهات النظر بشكل طبيعي وتبدو كل شخصية أكثر تعبيرا عن ذاتها ورغباتها ودوافعها واتجاهاتها[12] .
فمن المؤكد أن العقل الجمعي يختلف عن العقل الفردي في إيجاد مشتركات متلقية لخلق سرد متنامي مبدع مختلف عن الكلاسيكيات، لأن المتعامل معها تنتج حالة توليدية تفترض احتمالات نضوجه( النص ) أكبر من العملية الفردية فالزوايا الثقافية المتحركة تحاصر الثيمات بخلفيات تمتلك مواصفات متباينة في النوعية الثقافية المكتسبة لتخلق هجينا يقترب من الصورة المستوفية لشروط الإبداع، يضاف لها مزية المنح في إعطاء فرصة واحدة متكررة لأكثر من مبدع ليضع بصماته الواضحة على منجز متفرد في خصائصه الوظيفية[13]
إذن يتميز هذا النص أو هذه التقنية بقدر من المرونة تعطي للقارئ الفرصة للمشاركة في تشكيل النص الأدبي ويوفر مساحة من الحرية في اتباع الروابط دون تدخل من أحد، قد يحفز الهايبرتكست (النص المترابط) القارئ ويشجعه على الإبحار في القراءة إذا ما اختيرت الوسائط البصرية والسمعية(الوسائط المتعددة) بإبداع على ألا تكون هذه الوسائط على حساب تهميش دور النص اللغوي ولغة النص وإلا بَطُلَ وجوده كنص أدبي وبات نوعا من لقطات بصرية سمعية تراودها الكلمات بين الحين والآخر[14]
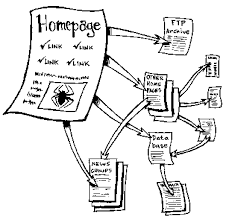
إن سؤال الملكية الفكرية للنص الرقمي لم يطرح فقط حول النصوص التي يشاركها المبدع الأول مع متلقيه الافتراضيين بل يعتبر من الأسئلة المحرجة التي تثار أيضا حول النصوص الورقية التي حولت إلى نصوص رقمية بعد الكثير من التعديلات والتغييرات مثال ذلك قصيدة لاعب النرد للشاعر الفلسطيني محمود درويش وقد أخذتها مخرجة الرّسوم المتحرّكة والمصمّمة الإعلاميّة المصريّة نسمة رشدي Nissmah Roshdy وحولتها إلى Animation Poetry[15]، حيث اختارت المخرجة مقاطع منها كما أقدمت على ترجمتها وتلخيصها لتجعلها أكثر طواعية للتصوير البصري وظفت فيه خلفية تحمل صورة ورق البردي القديم والحبر الأسود والخط العربي مع موسيقى العود، وقد قالت عنها الناقدة ريهام حسني "إنّ القصيدة بحلتها الرقمية الجديدة تتضمن مؤثرات سمعية وبصرية تؤثر على تلقي القصيدة وفهمها وتجعلها مختلفة كليًا عن القصيدة الأصل"[16] غير أننا أمام هذا العمل الجديد نتساءل من هو المالك الحقيقي لهذا العمل هل هو محمود درويش؟ أم نسمة رشدي؟ وهل فعلها هذا ويسقط حقوق الملكية الفكرية؟
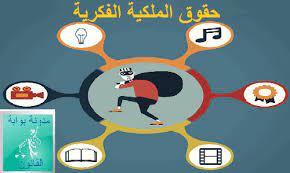
حاول العديد من الدارسين الإجابة على هذه الأسئلة المتداولة من بينهم حسين دحو الذي يقول: "لن تعتبر عدول النص الأدبي وانحرافه عن شكله النمطي ظاهرة أسلوبية فريدة، بل نخاله مطلبا حيويا يجرد النص الأدبي العربي من مفهوم الملكية الخاصة التي يتنازعها الكاتب بحق إنتاجه النص، والقارئ بفرض سلطة بث الحياة في النص عبر قراءته المختلفة له، وتبقى النصانية بينهما وبين خواص النص ذاته في شد وتجاذب لم ينتهيا إلا بتحول النص الأدبي إلى نص إلكتروني، رقمي، تفاعلي وترابطي حسب اختلاف اصطلاحات التسمية، هذا التحول الذي ألغى صك ملكية النص مصيرا إياه ملكية جماعية تقصي مفهوم التفاضل بين أطراف العملية الأدبية الإبداعية وتدعو إلى تكاملها جميعا"[17]

[1] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص 169.
[2] المرجع نفسه، ص 169
[3] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص 169
[4] المرجع نفسه، ص 170.
[5] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص94.
[6] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص170
[7] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص170/171.
[8] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص93
[9]فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص51.
[10] فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص171.
[11] المرجع نفسه، ص171
[12] م نفسه، ص172
[13] صالح جبار محمد الخلفاوي، القصة التفاعلية الحوار المتمدن، ع 5504، نشر بتاريخ، 27/07/2017، www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=556680، اطلع عليه بتاريخ: 16/05/2023
[14] سوسن مروة، نقد الواقعية الرقمية، صحيفة الحوار المتمدن، ع1554، نشر بتاريخ: 18/05/2006، اطلع عليه بتاريخ: 12/07/2023، على الساعة 19:48، رابط. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=65070
[16] Voir, Reham Hosny (2016). E-Lit in Arabic Universities: Status Quo and Challenges, Hyperrhiz, https://doi.org/10.20415/hyp/016.e06
[17] حسين دحو، النص الرقمي في الأدب العربي من الورقية إلى الرقمنة (وجه آخر لما بعد الحداثة)، مجلة الأثر، ع29، 2017، ص105/106.
-
الملكية الفكرية، الكتابة الجماعية، تذويب الفردية، البرمجة، التصميم، التصوير البصري
-
-
لا يخفى على أحد أن الأدب في ظل الثورة الإلكترونية التي شهدها العالم عمل على تطوير وسائل تفكيره من أجل تجديد صورته مما ولد لنا أدبا جديدا يدعى الأدب الرقمي، هذا الأخير يرمي إلى تفجير الطاقات الابداعية على مستوى الحامل الإلكتروني تتجاوز في جمالياتها تلك التي تتوفر في الحامل الورقي، وذلك من خلال استثمار معطيات تقانة الرقمية ونقصد بلك الصوت والصورة والموسيقى والإخراج، واللافت للنظر أن كل الأجناس الأدبية أصبح لها حضورا رقميا غير أن الشعر سجل حضورا كبيرا مقارنة بغيره من الأجناس، كما عرف بناء فنيا وشكلا تعبيريا استثنائيا يسمح بتفاعل التقنيات الحاسوبية سواء السمعية أو البصرية "فبعدما كانت الكلمة في المقدمة أصبح مركزها في مرحلة متأخرة بعد الصورة والصوت والرسم والتلوين، وأصبحت جميعها تتقاسم الدور لإنتاج نصوص أدبية جديدة، ومن طبيعة جديدة لا يمكن تصنيفها ضمن النصوص القديمة، وبالتالي ضمن الأجناس التقليدية، ما ولّد جنسا هجينا، حيث نجد الأدبية الرقمية تقترح اندماجا وتفاعلا بين النص الأدبي واللوحة أو الرسم والموسيقى المصاحبة لكل نص والتقنية الحاسوبية في تناسق وتفاعل تام، ولا يزال الباحثون منهمكون في محاولة معرفة كنهه لأجل ضبط ما يتصل به، وفق ما تمليه رغبات الإنسان وحاجات العصر المتسارعة"[1]
وعلى ضوء هذا التغيير الحاصل في نمط الكتبة الإبداعية "لم تعد الكتابة في الرواية الرقمية مثلا أفقية خطية، بل تعددت أبعادها وروابطها باستخدامها المكثف للنظريات الرياضية والقوانين العلمية، لذلك فكاتب العصر الرقمي لا يحتاج للموهبة الأدبية فقط، وإنما لابد له من الإلمام بمختلف تقنيات وبرامج الحاسوب، إذ ستقوم الرواية الرقمية على توظيف كافة الفنون البصرية، وإدماجها خاضعا لخطة الكاتب في تطوير أدائه السردي، فهو في هذه الحالة لن يعتمد على التصوير اللغوي وحده، ولكنه يستعير المؤثرات الصوتية وسيغترف من الإمكانيات الواسعة لخلق الصورة، ودعمها بالإضاءات المعبرة عن الأجواء القاتمة أو المبهجة حسبما تسير خطة الرواية"[2]
وهذا الأمر من شأنه أن يطبع النص الأدبي الرقمي بجملة من الخصائص منها أن "النص الأدبي الرقمي يمتاز بطواعية كتابته، من خلال دخول الصورة، الحركة، والسماع في طريق تشكيله، كما يمنح منتج النص خيارات عديدة سواء من حيث العناصر المكونة له أو من حيث عدد الروابط والشذرات وطريقة توزيعها في جسد النص، مما يتيح إمكانيات تشكل كثيرة ومتنوعة، كما للأدب الرقمي خصوصيته التي تتلخص في اعتبار التقنيات الرقمية ولغات البرمجة جزءا لا يتجزء من النص الأدبي، فلا يمكن ترجمة النص بفاعلية بعيدا عن هيئته التي جعلت هذا النص يتحدث عن نفسه بالكلمة والصوت والصورة"[3]
وفي هذا السياق يؤكد جمال قالم أن النص الأدبي الرقمي على اختلاف أجناسه "لا يقتصر في التعبير عن مدلولاته على اللغة الطبيعية وحدها(الكلمة المكتوبة)، بل ينضوي داخل النص ما هو لغوي وما هو صوتي، وما هو حركي(الصورة).., إلخ أي أنه يتجاوز البعد اللفظي، كما يتجاوز الاتجاه الخطي للعلامات التي يحتوي عليها، إلى اتجاهات أخرى متعددة الأبعاد من خلال الانتقال شجريا أو هرميا وبطريقة التوازي من نص إلى آخر، أو من فضاء نصي إلى فضاء آخر من الكلمات أو الأصوات أو الصور أو الحركات"[4] :
جماليات المؤثرات السمعية والبصرية في الأدب الرقمي:
إن الحديث عن توفر جماليات في الشعر الرقمي من المسائل الخلافية بين الدارسين على عكس الأدب المقدم عبر الحامل الورقي، ذلك لأن "بنية النص الرقمي تختلف كثيرا عن نظيرتها في النص الورقي، وهو ما جعل قراءته وكتابته أمرا مختلفا تماما، ومسألة تشظية النصوص الرقمية وتشذيرها ولدت رهبة لدى الكثير من الدارسين ودفعتهم للتشكيك في أدبية هذا النص، لكن التعرف على الأدبية الجديدة لهذا النص ستزيل الكثير من العقبات. إن الجمالية المادية تتكامل، والجمالية اللغوية متفق عليها سلفا، وقضية مشاركة المتلقي هي التي تصنع الفارق مع هذا النص الأدبي الجديد، فالمساحة التي أمّنتها هذه النصوص له لم تكن متوفرة مع النصوص الورقية، لكن عدم توفر نموذج حقيقي له جعل فكرة التفاعل غير متجددة بل تكاد لا تخرج عن دائرتها المتفق عليها"[5].
وعلى ضوء هذا نجد بعض الدراسات تنافح عن جماليات النص الشعري الرقمي وجعله يحظى بأهمية لافتة في الفضاءات التواصلية- التفاعلية، وتصويره كنص متجدد ضمن منظومة إستيطيقيا، بحجة أنه بناؤه الجمالي يقوم على جملة من العناصر السيميائية التي تتضافر من أجلها العديد من الأدوات والوسائط المتنوعة المتوفرة في العالم الرقمي كالصوت، والصورة، والحركة، وغيرها كما سنوضح لاحقا.
يعمل الشعر الرقمي التفاعلي على أن يصنع لنفسه علامات خصوصية ينفرد بها دون سواه، إذ "يسعى المحكي التفاعلي في ضوء هذا النزوع إلى مساءلة مفهوم الأدبية، وذلك عبر زحزحة مبادئ الجمالية الأدبية، والانتقال من جمالية اللسان إلى جمالية المادة النصية، وبناء على هذا التحول يمكن للمحكي التفاعلي أن يعيد مساءلة مفهوم النقد عبر تحويل مجال اشتغاله من نقد النص نحو نقد دعامة النص، كما يمكن لمعايير القيمة أن تثمن البعد الإبداعي من خلال استكشاف الأبعاد الدلالية للدعامة الرقمية"[6]، هذه الأخيرة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من بنية النص.
ومهما يكن فإنه لا يمكن الحكم على جمالية النص الشعري الرقمي إلا بالعودة إلى وظيفتان أساسيتان هما: الوظيفة الأدبية والوظيفة الرقمية، ومن جهة أخرى لا يمكن تقويم الأدب الرقمي إلا في ضوء ثلاثة معايير أساسية هي: المعيار التقني، المعيار السيميوطيقي، والمعيار التفاعلي"[7]، ومن هذا المنطلق يمكننا أن نوجز هذه الجماليات التي يحوزها عليها النص الشعري الرقمي فيما يلي:
اللون والصورة والحركة:
يعمل مخرجو القصائد الشعرية على اليوتيوب على تحويل المادة المكتوبة إلى مادة إلكترونية نابضة بالحياة والجاذبية والحركة عن طريق توزيع الوحدات المختلفة على الصفحة الإلكترونية الفارغة إلى لوحات فنية تنبض بالجمال والمعنى بما يتناسب مع قدرات المتلقي في استخدام حواسه المختلفة وخاصة العين، والأذن، ويجب المحافظة على عنصر التوازن سواء كان متماثلا أو متباينا في الصفحة الإلكترونية، ... وعنصر اللون الذي يميز بين المكونات ويبرز العناصر ويسهل إدراك العلاقات، ويسهم في جذب الانتباه والتشويق[8] .
لهذا كان أكثر ما يتكئ عليه الشعر الرقمي هو "ثقافة الصورة" أو ما يسمى بـ: "الثقافة البصرية"، ذلك لأن البصر على خلاف السمع ليس له سوى بُعد واحد، بينما البصر له عدة أبعاد، له وظيفة توثيقية، وله وظيفته في جلاء البصيرة.. تتشكل البصيرة في ما تتشكل به، والثقافة البصرية، تلك التي تعتمد على الرؤية والمراقبة والقراءة. والبصر يتشارك مع غيره على الشاشة)[9]، فالخطاب البصري يجذب المتلقي أكثر من غيره من الخطابات، كون الصورة تلعب دورا هاما في تحريك النص العنكبوتي في الأنترنيت سواء بمصاحبة النص القابل للتحريك، أو من خلال وجودها كعنصر رئيس من عناصر النص، وهي تمتلك الصدقية أكثر من اللغة، كما تمتلك التأثير الواسع على المشاهد/ القارئ، إذ لم تعد الصورة ملحقا تزيينيا بالنص العنكبوتي على عكس وضيفتها في النص المطبوع[10]
عمل تميم البرغوثي على استثمار هذه التقنية في قصيدة "كيف عشقت امرأة لم ألقها؟" حيث شكلت الصورة البصرية بمختلق مكوناتها عنصرا مهما يجسد هيئة القصيدة وفنياتها، من خلال تفاعلها مع باقي المكونات الرقمية لتعطي إيحاءات وأبعاد دلالية كثيفة، من بين الصور الموظف مايلي:

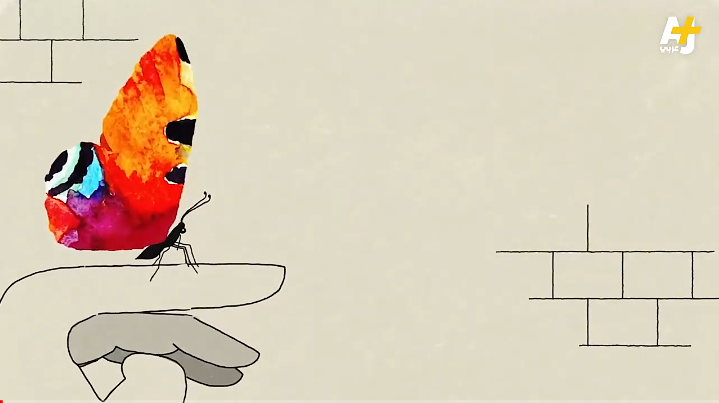

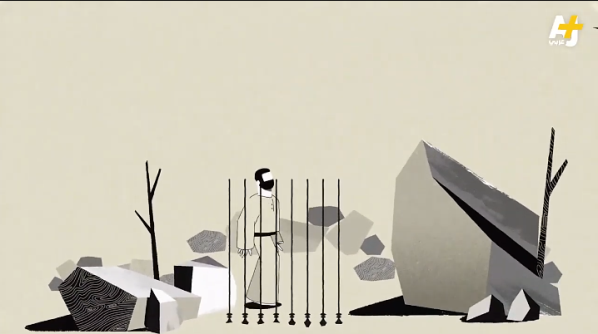
من خلال هاته الصور يتضح أن الشاعر حاول أن يتخير الأشكال والألوان التي تتناسب مع مضمون القصيدة لأن الصور كانت تتحرك بالتناسق مع الأداء الشعري، فقد حاول التعبير عن المرأة بصورة الفراشة ذات الألوان البهيجة التي تعكس حسنها، وهو لأنه كان لم يرها من قبل استعمل رمز الفراشة التي تدل عن الجمال للتعبير عن هذه المرأة، وقد جعلها تتحرك لتحط على يده للتعبير عن حالة الحب التي سكنت قلبه، وتملكت مشاعره، أما في الصورة الثانية، فيحاول الشاعر التعبير عن حالة الانكسار التي غالب ما تصيب من وقع في الحب، فهو يخشى على نفسه من أن يكون هذا الحب غير متبادل، وهذا ما تحمله دلالة اللون الأسود الذي طبع شكل الانكسار الموضح في الصورة، لأن الحب إن أصاب القلب جعل صاحبه أسيرا في يد محبوبه، لا يقو على فراق كما جاء في الصورة الثالثة، أما في الصورة الثالثة فإن الشاعر يعكس الحالة التي يتمنى أن يعيشها مع محبوبته، حيث يتمنى أن يعرف كل منهما قدر الآخر، ويبادله الحب الذي يجعلهما في سعادة لهذا جعل الفراشة تحط في كفّيه وكأنها في رعايته، وأن حبها دخل قلبا آمنا، وهذا كله تماشيا مع ما قاله الشاعر:
كيف عشقت امرأة لم ألقها؟
عشقتها حتى خشيت عشقها
والعشق إن مس القلوب شقها
وإن تكن حرائر استرقها
فما أجلها وما أرقها
إن عرفت حقي عرفت حقها
من خلال هذه الصور يتبين لنا أن التركيز على خطاب الصورة في القصيدة الرقمية "له مبرراته العلمية والجمالية، فقد أضحت الصورة المصدر الأساس في نقل الثقافة، بل وفي نشر المظهر الحضاري نظرا لما تمتلكه الصورة من عناصر التشويق، وسرعة التبليغ، وتجميل الموضوعات المصورة، يضاف إلى هذه الخصائص الفنية الإبداعية والجمالية ضرورة التكامل والتضافر ما بين النصين أو الخطابين: خطاب اللغة وخطاب الصورة"[11]، وكلامنا هذا لا يعني تراجع حضور الكلمة لصالح الصورة وما يترتب عنها من ألوان وحركة وإنما تتشارك هذه العناصر كلها فيما بينها مع الكلمة بشكل يفسر كل منهما الآخر، كما في الصور التالية:
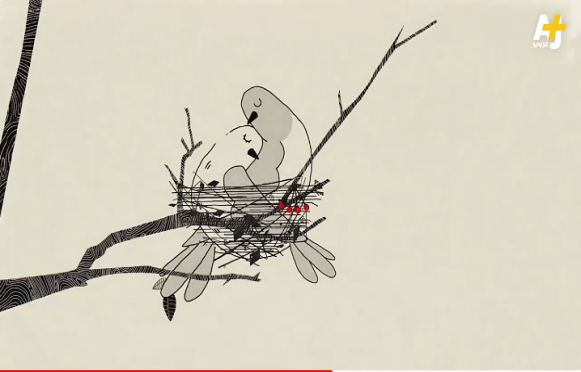


حاول الشاعر من خلال هذه الصور بما تحمل من ألوان باهتة وغير حيوية أن يعكس الحالة الحزينة التي أصبح عليها هذا المحب، إذ يصوره في علبة زجاجية قد وصلت به إلى قاع البحر، فهو أشبه بالسجين وبالغريق الذي نال منه الحب، فضلا عن هذا فإنه يصوره في حالة تمني، إذ يتمنى أن يكون هذا المحبوب يستحق كل هذا الحب الذي يكنه له إذ يقول: "النفس كالطير تحب جنسها"، ويقدم لنا لتقريب هذه الفكرة صورة عصفوران يتبادلان الحب، فهو يتوسم في حبيبته أن تبادله نفس المشاعر، وما هذه الصور المرفقة إلا إسقاط لقوله:
والعشق إن سر القلوب ضرها
وليس يستعبد إلا حرها
إن عرفت قدري عرفت قدرها
النفس كالطير تحب جنسها
قد عرفت بالغيب نفسي نفسها
وأصبحت غربتها وأنسها
فليس يسه القلب عنها إن سها
أعيا هواها إنسها وجنها
حسناء إن لم تنسني لن أنسها
نستنتج من خلال الصور أعلاه أن الخطاب البصري المرفق بالقصيدة يحمل دلالات أوسع من الخطاب اللغوي، فالصور المستعملة بما تحمله من ألوان وحركة تشكل عنصرا نفسيا فيزيولوجيا محددا لعملية التلقي، حيث "أضحت الصورة المتحركة فضاء ينبني على الكثير من عناصر الغواية وتربية الذوق الإنساني الذي تنشده كل نفس تواقة إلى كل جمالي ومبهج، ومن ذلك الجمالي المبهج في الصورة الرقمية المتحركة تناغم وتناسب ألوانها-الألوان المحوسبة- التي تشكل خلفية ترسخ المكاني وتؤطره، فاتحة المشهد على الرؤية البصرية العفوية التي تتلذذ بالكلي بصفته رؤية تنفتح على المحتمل المعادل للواقع، وقد ذهبت التقنية الرقمية الحاسوبية مذهبا رهيبا في هذا، وخاصة على مستوى إيقاع الألوان وموسيقاها البصرية"[12]، فالحياة المتحركة من شأنها أن تجعل النص نابضا بالحياة وبالجمال.
الصوت والموسيقى:
يعتبر المستوى الصوتي من أهم العناصر التي يركز عليها الشعر الرقمي كونه مثقل بالدلالات والمعاني، فضلا عن كونه الركيزة الأساسية للنص من خلال المقطوعات المصاحبة التي تكون في خدمة الخطاب اللغوي، وفي خدمة الصورة المرفقة به، وعلى الرغم من هذه الأهمية إلا أنه كان ينظر إلى الصوت والصورة على أنهما عناصر تكميلية، أي أنها ليست ضرورية في بنية النص، "ولم تبلغ النصوص الأدبية المتوسلة بالآلة التكنولوجية المستوى الذي يعبر عنه حقيقة عن العصر التكنولوجي شبه الكامل الذي نعيشه إلا عندما أصبحت تنظر إلى العناصر التي تستعيرها من الفضاء الالكتروني بوصفها جزءا أساسيا في
بنية النص، وعنصرا مهما من عناصره، يفقد النص بفقدانه أو تعطيله جزءا من قيمته الفنية والمعنوية"[13].
قدم الشاعر تميم البرغوثي خطابه الشعري مرفقا بموسيقى البيانو الهادئة، ليزيد الأداء الشعري تميزا، ويدعم الصورة المدمجة مع الخطاب اللغوي، لتحقق من خلال تفاعلها مع باقي العناصر دلالات وإيحاءات تتصل بالمعاني الخفية، فضلا عن هذا فإنها توحي بالتأثير الفني والجمالي في المتلقي، وتتحكم في عملية استقباله، فموسيقى البيانو المدرجة في المقطع تحمل شحنات عاطفية كثيفة، وتعكس طاقة الحب التي تراود الشاعر والتي تجعله في حالة بوح لمشاعره وأحاسيسه.
الإخراج:
إن تحقق كل العناصر التي سبق صوتها (اللغة، الأسلوب، الصورة، الصوت الحركة...إلخ) لا يعطينا الحق في قول بأدبية هذا النص أو ذاك ما لك يتم إخراج هذه العناصر بشكل يليق بها، لهذا فإنه "من الأمور المهمة في العمل التفاعلي الرقمي الرؤية الإخراجية، لأن منتجه يسعى إلى تقديم عوالم افتراضية يتعايش معها المتلقي بنحو كامل أو شبه كامل، ولا يتحقق ذلك إلا عبر قدرة خلاقة يستمكن من أدواتها المنتجة، وعليه يمكن له أن يستعين بمنفذ تقني أو مخرج فني يعينه على تحقيق رؤيته النهائية للعمل، ولكن شريطة ان يكون التخطيط منه والرؤية الإخراجية أيضا منه، وإلا سيبقى محققا للنص الحرفي فقط، وهو مستوى من مستويات التفاعلية الرقمية، أما إذا استطاع أن يحوز التصميم والتنفيذ فذلك لا محالة أكمل"[14].
وللإفادة فإن "هذا التوليف بين مختلف العناصر البنائية المكونة للنص المترابط، والمتمثلة أساسا في اللغة والصورة والصوت سيكون ناجحا كلما أفضى إلى حركة عارمة في النص، وبالتالي جعله ينبض إبداعا وتجددا، فالأدب الرقمي في نهايته ليس إلا تنسيقا بين مكوناته البنائية بشكل بارع يجعلها قابلة لإعادة بناء وتشكيل"[15]، فلا يمكن النظر إلى خطاب اللغة، وخطاب الصورة، أو خطاب الموسيقى في النص الشعري الرقمي على أنها خطابات منفصلة عن بعضهما البعض، ذلك لأن خطاب الصورة مثلا يلعب "دورا تكميليا توضيحيا مرافقا لخطاب اللغة، وهو ما يحرص الشعر الرقمي أن يفنده، بل وسعى ليطرح نموذجا تتضافر فيه هذه الخطابات (خطاب اللغة، خطاب الصورة، خطاب الصوت...) وتسقط الحدود بينهما لتمتزج في شكل موحد"[16].
وفي الأخير نشير إلى ان استخدام هذا النمط الكتابي الجديد بكل معطياته الرقمية يلزم على المبدع " تطوير إنتاجه الأدبي ليتلاءم مع العصر من خلال استثماره منجزاته التكنولوجية في تطوير إبداعاته فيدمج في إبداعه الأدبي الصورة والصوت بمختلف الصيغ والأشكال التي تفتح له آفاق جديدة في الإبداع والتعبير "[17]، فإذا كانت بلاغة النص سابقا تقاس بمقدرة الكاتب على توظيف الكلمة لتوليد المعاني والافكار والصور الفنية، والمحسنات اللفظية كالاستعارة والمجاز والكناية والجناس والطباق، وقدرته على الإقناع والحجاج، أصبحت اليوم تقاس وفق معايير وآليات أخرى. فلم يعد الكاتب يكتب بالكلمة فقط، بل أصبح بإمكانه أن يتوسل بوسائل أخرى للتعبير. فيوظف اللون كرمز، والحركة كمعنى والموسيقى كإيحاء، والصورة ككناية. والشيء نفسه بالنسبة للروابط، اذ أصبح بمقدور الكاتب أن يضمن نصه بعض الروابط فيجعل منه لوحة فسيفسائية تتداخل وتتشابك فيها نصوص كثيرة، وهو ما بات يعرف اليوم بـ “الهايبريد تكست” (Hybrid text) أي “النص الهجين” أو “الجامع للأجناس”، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك فأطلقوا عليه اسم ((Archiart أي النص الجامع للفنون بحيث تتضافر فيه أنواع الفنون كافة، مثل فن الموسيقى الى جانب فن الاخراج السينمائي إلى جانب فن الرسم إلى جانب فن المسرح، مما أدى إلى تغيير مفهوم التناص كأحد الأساليب البلاغية، فبدأنا نسمع اليوم الحديث عن “التناص التقني[18].
إن دخول الأدب إلى هذا المجال واغترافه من كل الفنون أربك النقاد فيما يخص مسألة تصنيفه هل هو أدب حقا أم فن؟ ذلك لأن الرقمية "نقلت النص من دائرة الادب إلى دائرة أشمل وأعمّ وأكبر هي دائرة الفن، فأصبح الأدب الرقمي أحد فروع الفن الرقمي، ولم يعد النص ينتج ليقرأ فقط، بل ليُرى ويُشاهد ويُسمع أيضًا[19]
[1] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص108.
[2] سمير الفيل، الرواية الرقمية: تصورات وتنبؤات حول صورتها في المستقبل، ملتقى القاهرة للرواية والأبحاث، 17، 20 فبراير، 2008، ص29.
[3] جمال قالم، النص الادبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص98.
[4] المرجع نفسه، ص96.
[5] خديجة باللودمو، الأدب الرقمي العربي الموجه للأطفال (دراسة في المنجز النقدي)، ص152.
[6] عبد القادر فهيم شيباني، المحكي المترابط نحو آفاق رقمية للرواية، مجلة سمات، ع2، ماي2013، ص2287/288.
[7] جميل حمداوي، الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق(نحو المقاربة الوسائطية) ص162.
[8] ينظر، أحمد فضل شبلول، تكنولوجيا أدب الطفل، دار الوفاء دنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، ط2، دت، ص107.
[9] السيد نجم، ثقافة الصورة سحر لا يقاوم(الشاشة.. قمة التحول المعرفي)، جريدة البيان، 12 ديسمبر 2010، ص10.
[10] عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن(نحو منهج عنكبوتي تفاعلي)، ص434.
[11] عميش عبد القادر، قصة الطفل في الجزائر(دراسة في الخصائص والمضامين)، دار الأمل، الجزائر، ط2، ص205.
[12] عبد القادر عميش، شعرية تلقي الصورة الرقمية في قصة الطفل
www.amicheabdelkader.com/index.php?option=com. شوهد بتاريخ: 04/01/2021، على الساعة: 09.33.
[13] السيد نجم، الصورة وواقع الأدب الافتراضي
www.startimes.com/?t=28689808 شوهد بتاريخ: 04/01/2021، على الساعة: 10.11.
[14] ناظم السعود، سحر الأيقونة، مقعد حواري أمام الشاعر الرائد مشتاق عباس معن، دار الفراهيدي، بغداد، 2010، ص76.
[15] خديجة باللودمو، الأدب الرقمي العربي الموجه للأطفال (دراسة في المنجز النقدي)، ص167.
[16] المرجع نفسه، ص164.
[17] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص92.
[18] إبراهيم ملحم، الأدب والتقنية، مدخل إلى الأدب التفاعلي، إربد، عالم الكتب الحديث. (2013)، ص26.
[19] Roberto Simanowski(2010). Reading Moving Letters, London: Transaction Publisher. (2010), p. 17
-
المؤثرات الصوتية، المؤثرات السمعية، الصوت، الصورة، الألوان، الحركة، الطواعية في الكتابة، الكتابة الخطية،
-
لقد دخلت الدراسات الأدبية مرحلة جديدة من البحث وتولدت مصطلحات ومفاهيم جديدة، لكننا ما نزال منأى عن التفاعل معها، أو استيعاب الخلفيات التي تحددها، ظهرت مفاهيم تتصل بالنص المترابط، والتفاعلية، والفضاء الشبكي، والواقع الافتراضي، والأدب التفاعلي، ونحن ما نزال أسيري مفاهيم تتصل بالنص الشفوي أو الكتابي، ولم نرق بعد إلى مستوى التعامل مع النص الإلكتروني "فما يزال دخولنا عصر المعلومات متعثرا بطيئا، ولا يواكبه نقاش معرفي يمكن أن يوجهه ويؤطر مساراته، ويجدد من ثمة رؤيتنا إلى طرائق تفكيرنا وتساؤلنا بصدد مختلف القضايا التي تهمنا، إنه لا يعقل أن ندخل عصرا جديدا بأفكار قديمة وبلغة قديمة"[1]
إن عملية التأليف الأدبي الرقمي تعرف انتشارا مهما في التجربتين الأمريكية والأوروبية بفعل إيجابية الشروط التقنية والمعلوماتية للمجتمعات الأمريكية والأوروبية، والتي تسمح بالانخراط الموضوعي إنتاجا وإبداعا في الثقافة الرقمية، في حين أن التجربة العربية ما تزال تعرف بطأً من حيث إنتاج الإبداع الرقمي، وذلك لأسباب بنيوية ذات علاقة بموقع التكنولوجيا في الحياة العامة والعلمية في المجتمعات العربية، إلا أنه يلاحظ ظهور بعض التجارب الإبداعية القليلة، لكن يسجل على أنه إنتاج وإن كان ضئيلا، فإنه يعبر عن تحد حضاري تقني وإبداعي كبير، يفرض شرط احترامه وتقدير ريادته في الزمن العربي الحالي، ولهذا فإنه إنتاج يحرر النقد العربي أيضا من أسئلته المعتادة[2]
ويرجع سعيد يقطين في كتابه من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي) مسألة تردي الواقع الأدبي العربي إلى مشكلة التخلف التواصلي، وهذا يعود بشكل أو بآخر إلى وحدات التواصل- بحسب رومان ياكبسون- فالعملية التواصلية الإبداعية أو غيرها تقوم على أساس تلك الوحدات الثلاثة، وهي: المرسل والنص والمتلقي، وإذا رجعنا إلى هذه الوحدات سنجد دون شك أن التفاوت حاصل وبخاصة وحدة التلقي، فالعالم ترقّى تواصليا بعد أن تطورت منظومة الاتصال والمعلوماتية عبر الشبكة العنكبوتية وغيرها ومن الوسائل الحديثة، في حين مازال النص يرسل من منتجه بالطريقة التقليدية-أي الورقية- فدور النشر تعاني كثيرا من المنتج الرقمي بكل وسائله المخزنة بالأقراص المدمجة أو المخزونة على الشبكة، لأن أغلب المتلقين عزفوا عن التلقي التقليدي(الورقي) ومالوا بشكل كبير إلى المنتج المنسجم مع التغير الحاصل في المجال التقني، أي منتوج التكنولوجيا وتقنيات المعلوماتية الحديثة"[3]
وفي هذا السياق يصرح عز الدين المناصرة بما يلي: "نحن العرب نعيش مرحلة الدهشة في ظل مرحلة انتقالية يتصارع فيها الورقي مع الإلكتروني، ويتصارع القديم مع الجديد، وبالتالي فإن من خصائص المرحلة الانتقالية العالمية الارتباك والدهشة والقبول والرفض الحاد... فثورة الاتصالات ثورة عالمية لا مثيل لها في التاريخ، وهي التي سوف تحقق التقدم والحداثة، بالإنسان وبدونه"[4] ورغم ذيوع الحاسوب والفضاء الشبكي وانتشارهما في الفضاء العربي، فإن المتابعة والمواكبة والمساهمة الجادة في هذا التطور عربيا ما تزال ضعيفة جدا، وقاصرة وناقصة[5]، لذلك فما تزال كتابة (النص المترابط) في ثقافتنا العربية محدودة جدا بل أشبه بالمنعدمة، ودونها الكثير من القيود التي تقلل من أهمية الانتقال إليها في الوعي والممارسة[6]
ولكن وعلى الرغم من الظروف التي كرست هذا التردي في خلق تراكم من النصوص الأدبية والرقمية "بدأت تلوح في أفق الإبداع الرقمي العربي بعض التجارب الإبداعية الرقمية التي حاول أصحابها ردم الهوة وسد الفجوة التي يعاني منها الإبداع العربي في الوسط الرقمي"[7]، من بينها التجربة القصصية لأحمد خالد توفيق بعنوان "قصة ربع مخيفة" (2005)، وقصة "احتمالات"(2009)، لمحمد أشويكة، والمجموعة القصصية "حفنات جمر" (2015) لإسماعيل البويحياوي، إلى جانب روايات جماعية من قبيل "على قد لحافك"، ورواية "الكنبة الحمرا".

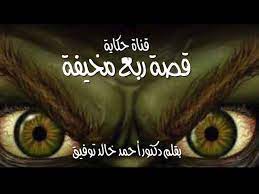
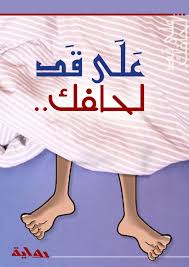

أما في مجال الشعر نستحضر الشاعر المغربي منعم الأزرق الذي كتب العديد من القصائد الرقمية من بينها: "سيدة الماء"، "الدنو من الحجر الدائري"، "نبيذ الليل الأبيض" و"شجر البوغار"، وكلها منشورة في منتديات موقع “المرساة[8]، إلى جانب قصائد لعباس مشتاق، منها: "تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق"، و"لا متناهيات الجدار الناري((2017"[9]
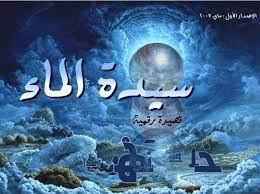
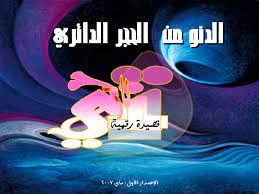


إلى جانب ذلك ظهر ما يعرف بأدب شبكات التواصل الاجتماعي(رواية الفيسبوك) ونذكر منها رواية “على بعد ملمتر واحد” (2013) للكاتب المغربي محمد أستيتو، وكذلك (أدب التويتر) وهو ما يعرف بالانجليزية بـ (Twitter Bobs ) واشتهر فيه الكاتب السعودي محمد حبيبي. وفي هذا السياق نذكر أيضا (رواية المنتديات)، وهي رواية تنزل على شكل أجزاء متسلسلة في منتدى معين، وغالبًا ما تنشر تحت أسماء مستعارة، وتكون أحيانا باللهجة العامية. وقد لاقى هذا النوع من الأدب رواجًا كبيرًا في المجتمع الخليجي على وجه خاص[10]، ونذكر من روايات المنتديات "ملامح الحزن العتيق" و "للأيام قرار آخر" اللتين نشرتا في منتدى "ألم الإمارات"، وغيرهما الكثير.
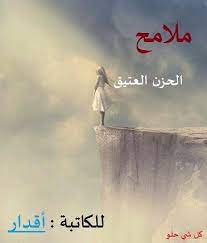

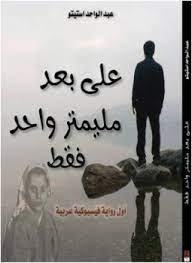
بالرغم من هذه النصوص الرقمية المنتجة في العالم العربي وما تبعها من نقد، إلا أنها وباتفاق جميع الدارسين تبقى ضئيلة مقارنة بالإنتاج الغربي إن على مستوى الإبداع أو النقد، فعدد اليوم يحصى على أصابع اليد، فهي لا تكاد تتجاوز 30 نصا رقميا في حين نرصد في العالم الغربي مئات النصوص الادبية الرقمية مردفة بعدد لا حصر له من القراءات النقدية الجادة، دون ان ننسى عدد المواقع والمجلات التي تهتم بهذا النط الكتابي الجديد، و"تعود حالة الضمور التي يعاني منها الأدب الرقمي في العالم العربي إلى عوامل مختلفة تندرج كلها تحت مظلة واحدة هي الفجوة الرقمية [11](Digital Divide) ، التي تفصل بين الشرق والغرب بتبعياتها المختلفة في جميع مجالات الحياة[12]، وهذه العوامل منها ما هو مرتبط بالأدب الرقمي من حيث صفاته وخصائصه، ومنها ما هو مرتبط بعوامل خارجية اجتماعية وثقافية كما أشرنا في محاضرات سابقة.
[1] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص96.
[2] جمال قالم، النص الأدبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص87.
[3] ينظر، سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، ص23 ومابعدها.
[4] عز الدين المناصرة(علم التناص المقارن(نحو منهج عنكبوتي تفاعلي)، ص423.
[5] سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، ص87.
[6] محسن الزبيدي، الشعرية الرقمية بنسختها العربية على يد الشاعر مشتاق عباس معن، هل تأخر حقا؟ نشر بتاريخ: 2007-09-28، اطلع عليه بتاريخ: 28/02/2023، على الساعة: 12:17، الرابط: https://maakom.link/article/lsh-ry-lrqmy-l-yd-d-mshtq-m-n-d-mhsn-lzbydy
[7] جمال قالم، النص الادبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، ص85.
[8] متوفرة على هذا الرابط http://imzran.org/mountada/
[9] متوفرة على هذا الرابط http://dr-mushtaq.iq/My-poetry-works/Interactive-digital/
[10] سمير قطامي، تأثيرات التكنولوجيا في الرواية العربية، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2009، ص 159.
[11] ينظر، نبيل علي، نادية حجازي، الفجوة الرقمية، ص 26.
[12] المرجع نفسه، ص 32.
-
التجارب العربية، الشعر الرقمي، الرواية الرقمية، القصة الرقمية، النص المترابط، التخلف التواصلي
-
-
المراجع باللغة العربية:
1. إبراهيم أحمد ملحم، الرقمية وتحولات الكتابة(النظرية والتطبيق)، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2015.
2. أحمد زهير الرحاحلة، نظرية الأدب الرقمي، ملامح التأسيس وآفاق التجريب، دار فضاءات، عمان، ط1، 2018.
3. أحمد فضل شبلول، أدباء الإنترنت أدباء المستقبل، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، ط2، دت.
4. أحمد فضل شبلول، أدباء الأنترنيت أدباء المستقبل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، ط2، دت
5. أمجد حميد التميمي، مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي، كتاب ناشرون، لبنان، ط1، 2010.
6. جميل حمداوي: الأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق (نحو المقاربة الوسائطية) كتاب إلكتروني صدر عن شبكة الألوكة، ط1، 2016.
7. جوزف طانيوس لبس، المعلوماتية واللغة والأدب والحضارة(الرقم والحرف)، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط1، 2012.
8. جووست سمايرز، الفنون والآداب تحت ضغط العولمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط1، 2005.
9. حافظ محمد عباس الشمري، إياد إبراهيم فليح الباري، الأدب التفاعلي الرقمي، الولادة وتغيير الوسيط، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، ط1، 2013.
10. حسام الخطيب، الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع، دار الثقافة والفنون، الدوحة، ط2، 2011.
11. داليا أحمد شوقي كامل، القصص التفاعلية القائمة على الكومبيوتر، دار الكتب والوثائق القومية، بولاق، مصر، دط، دت.
12. رحمن غركان، القصيدة التفاعلية في الشعرية العربية، تنظير وإجراء، دار الينابيع، ط1، 2010.
13. زهور كرام، الأدب الرقمي(أسئلة ثقافية وتأملات مفاهيمية)، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط1، 2009.
14. ستي جباري، الأدب الجزائري وفضاء الأنترنيت (آليات الإبداع وتفاعلية القراءة)، فضاءات للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2018.
15. سعيد علوش، تنظير النظرية الأدبية من الوضعية إلى الرقمية، مطبعة البيضاوي، الرباط، المغرب، ط1، 2013.
16. سعيد يقطين، النص المترابط مستقبل الثقافة العربية(نحو كتابة عربية رقمية)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، المغرب، لبنان، ط1، 2008.
17. سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط(مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2005.
18. السيد نجم، النشر الإلكتروني والإبداع الرقمي، الهيئة العامة لقصور الثقافة،ـ القاهرة، مصر، ط1، 2010.
19. عادل نذير، عصر الوسيط أبجدية الأيقونة، دراسة في الأدب التفاعلي، الرقمي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط1، 2010.
20. عادل نذير، عصر الوسيط(أبجدية الأيقونة)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2010.
21. عبد الرحمان بن حسن المحسني، توظيف التقنية في العمل الشعري السعودي منطقة الباحة نموذجا، النادي الأدبي الباحة، السعودية، دط، 2012.
22. عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة(تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة)، المركز الثقافي العربي، لبنا ن، المغرب، ط1، 2012.
23. عبد الله بن أحمد الفيفي، شعر التفعيلات وقضايا أخرى، دار الفراهيدي للطباعة والنشر، بغداد، الطبعة الأولى، 2011.
24. عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن(نحو منهج عنكبوتي تفاعلي)، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2006.
25. عمر زرفاوي، الكتابة الزرقاء، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط1، 2013.
26. فاطمة البريكي، الكتابة والتكنولوجيا، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، لبنان، ط1، 2008.
27. فاطمة البريكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 2006.
28. فاطمة كدو، أدب COM، (مقاربة للدرس الأدبي الرقمي بالجامعة، دار الأمان، الرباط، دط، دت.
29. فايزة يخلف، الأدب في مهب التكنولوجيا، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط1، 2017.
30. فيليب بوتز وآخرون، الأدب الرقمي، ترجمة: محمد أسليم، الدار المغربية العربية، الرباط، ط1، 2016.
31. لبيبة خمار، شعرية النص التفاعلي(آليات السرد وسحر القراءة)، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2014.
32. محمد الماكري، الشكل والخطاب، (مدخل لتحليل ظاهراتي)، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 1991.
33. محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات، لبنان، ط1، 1999.
34. محمد بسطاويس، النص الأدبي بين المعلوماتية والتوظيف، آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر العولمة، دار الفكر، دمشق، 2001.
35. محمد مريني، النص الرقمي وإبدالات النقل المعرفي، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، ط1، 2015.
36. محمد يوسف الهزايمة، العولمة الثقافية واللغة العربية(التحديات والآثار)، الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2012.
37. ناريمان إسماعيل متولي، تكنولوجيا النص التكويني(الهيبرتكست) وتنمية الابتكار لدى الطلاب والباحثين، جامعة الإمارات، 1996.
المراجع المترجمة:
1. فيليب بوتز وآخرون، الأدب الرقمي، ترجمة: محمد أسليم، الدار المغربية العربية، الرباط، ط1، 2016.
المراجع الأجنبية:
1. Memmott, Beyond Taxonomy: Digital Poetics and the Problem of Reading, New Media Poetics, Contexts, Technotexts, and Theories, London: Cambridge, Massachusetts Talan (2006)
2. charles deemer, watch out, mama, hyperdrama's, goanna mess with your pittock mansion.
المجلات العلمية:
1. إيمان يونس، مفهوم مصطلح(هايبر تكست)، في النقد الأدبي الرقمي المعاصر، مجلة المجمع، مجمع اللغة العربية، الأردن، ع6، 2012.
2. جمال قالم، الأدب التفاعلي وإشكالية تداخل الأجناس، معارف، قسم2، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع11، ديسمبر2011.
3. حسن سلمان، الأدب الرقمي يطالب بحقوقه المهدورة، جريدة الشرق الأوسط، ع10627، 2يناير2008.
4. حسين دحو، النص الرقمي في الأدب العربي من الورقية إلى الرقمنة (وجه آخر لما بعد الحداثة)، مجلة الأثر، ع29، 201
5. حمزة قريرة، الرواية التفاعلية(الرقمية العربية آليات البناء وحدود التلقي(قراءة في رواية شات لمحمد سناجلة، مجلة العلامة، م5، ع2، 2020.
6. حنا جريس وآخرون، مستقبل الثورة الرقمية، سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي الكويتية، الكويت، 15 كانون أول- يناير 2004.
7. عمر الزرفاوي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، مجلة الرافد دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ع56، ط1، 2013.
8. العيد جلولي، نحو أدب تفاعلي للأطفال، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ع10، 2011.
9. فاطمة مختاري، خصائص الأدب التفاعلي في رواية ظلال الواحد لمحمد سناجلة، مجلة الباحث، ع14، 2019.
10. فايزة يخلف، الأدب الإلكتروني وسجالات النقد المعاصر، الجزائر، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، ع 9، 2013م.
11. فيليب بوطز، ما الأدب الرقمي؟ ترجمة: محمد أسليم، مجلة علامات المغربية، ع35.
12. نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ع265.
13. نبيل علي، نادية الحجازي، الفجوة الرقمية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، ع318، 2005.
الرسائل العلمية:
1. صفية علية، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، أطروحة دكتوراه، تخصص: أدب جزائري، إشراف: د. علي عالية، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة بسكرة، 2014/2015.
2. جمال قالم، النص الادبي من الورقية إلى الرقمية(آليات التشكيل والتلقي)، رسالة ماجستير، إشراف: أحمد حيدوش، معهد اللغات والادب العربي، المركز الجامعي البويرة، 2008/2009.
3. سومية معمري، الأدب الرقمي بين المفهوم والتأسيس(مقاربة في تقنيات السرد الرقمي)، رسالة دكتوراه، إشراف د: الخامسة علاوي، كلية الآداب واللغات، جامعة الإخوة منتوري، بقسنطينة، 2016/2017.
4. منال بن حميميد، النظرية النقدية المعاصرة والأدب الرقمي، رسالة دكتوراه، إشراف: د/ نور الدين سيليني، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 2017/2018
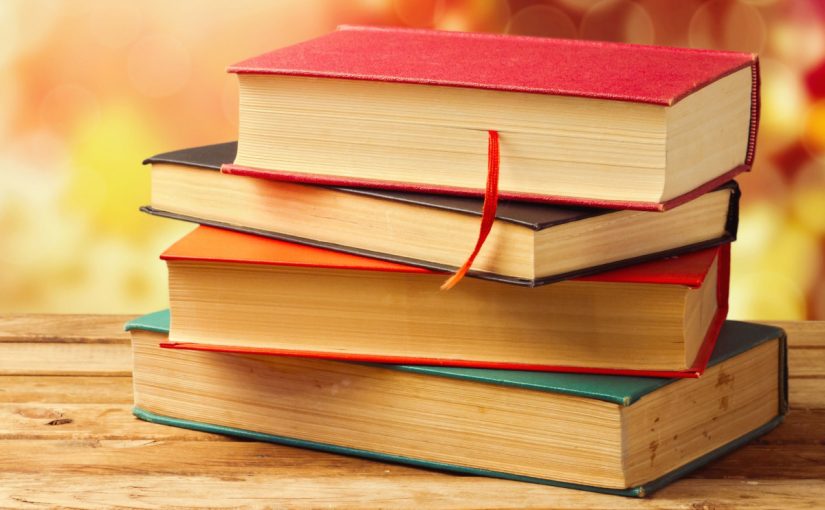 .
. -
بناء على ما درست ، هل يمكن القول إن الأدب الرقمي المتاح عبر الوسائط الرقمية يضاهي الأدب الرقمي من حيث القيمة الفنية والجمالية؟
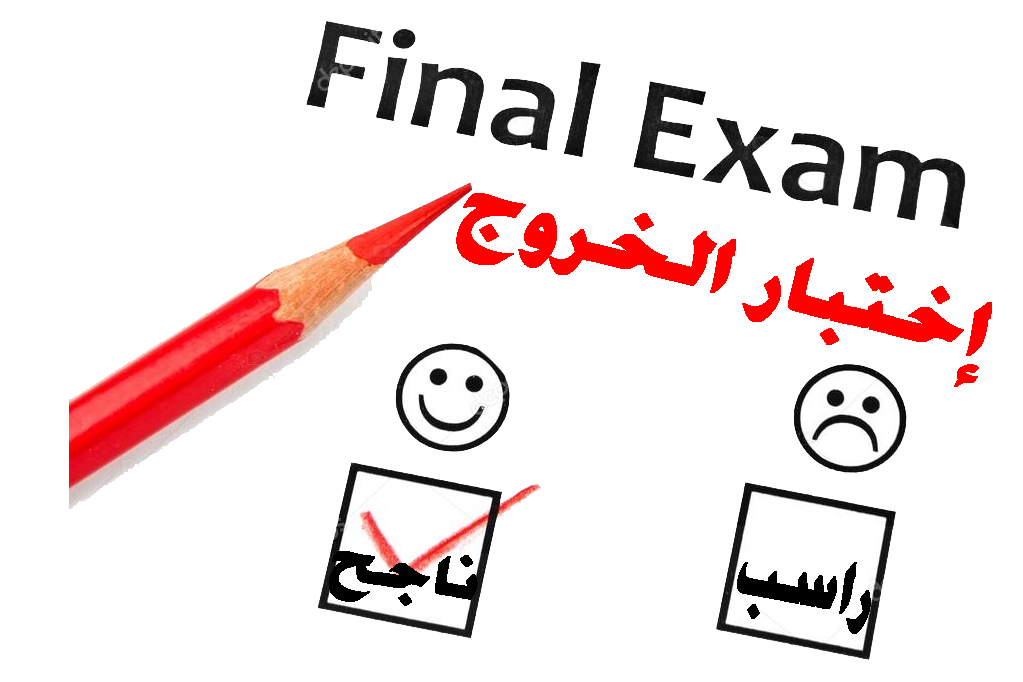


 .
.