الحكامة والمواطنة
Section outline
-
بطاقة التّواصل / المقياس الحكامة والمواطنة / الأستاذ : محمّد نمرة
المقياس : الحكامة والمواطنة
الأستاذ : محمّد نمرة
المستوى : السنة الثالثة ليسانس - تخصص أدب عربي.
الحجم الساعي : ساعة ونصف.
المعامل : 1
الرصيد : 1
أهداف التّعلم : بلورة مفاهيم المواطنة و دور الحكامة في بناء المجتمع المدني.

محاضرات مقياس الحكامة والمواطنة دروس مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ل م د بقسم: اللغة والأدب العربي بتخصصاته الثلاث: أدب عربي، نقد ومناهج، ولسانيات عامة، ضمن متطلبات الوحدة الأفقية.
التّعريف بالمادة:
تندرج هذه المادة ضمن حقل العلوم القانونية، وتشغل حيزا كبيرا منها؛ إذ إنها تستند وبقوة إلى التقنينات المختلفة التي من شأنها أن تضمن التنمية المستدامة للبلاد، فضلا عن النصوص القانونية الدولية العالمية التي تكفل حقوق المواطنين الاجتماعية والثقافية والسياسية، ناهيك عن تفعيل دورهم في تنمية وطنهم والنهوض به، من خلال مختلف المشاركات السياسية والممارسات الانتخابية، وكذا تأدية واجباتهم في مقابل نيل حقوقهم التي ضمنها لهم الدستور.
ولا يتسنى تتبع العلاقة القائمة بين الثنائيتين الحكامة والمواطنة بوصفهما تيمة المادة وأساسها، إلا باللجوء إلى دستور الدولة وغيره من الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان العالمية.
الأهداف العامة للمادة:
- تكوين مواطن صالح يفقه ما له وما عليه، بالتأكيد على أهم الواجبات وأهم الحقوق.
- تهيئة الأرضية الخصبة التي ينطلق من خلالها الطلاب بوصفهم مواطنين، من أجل تسيير حياتهم العلمية والعملية، تسييرا صائبا مستندا إلى الضبط والمساءلة.
- الإسهام في التنمية المحلية والوطنية.
- ربط الطالب بالحياة العملية؛ من خلال تعريفه بالإدارة العمومية ومظاهر الفساد الإداري والمالي وكيفية محاربته.
الأهداف الإجرائية:
- التعرف على المفهومين الدقيقين لمصطلحي الحكامة والمواطنة.
- رصد العلاقة القائمة بين هاتين الثنائيتين.
- تبيان الحدود الفاصلة بين أنواع الحكامة.
- تبيان المرتكزات التي تقوم عليها كل من الحكامة والمواطنة.
- تسليط الضوء على مفهوم الديمقراطية والوقوف عند أهم مرتكزاتها.
- الوقوف عند التنمية المستدامة في علاقتها بالحكامة.
- الإحاطة بمفاهيم متعددة مثل: الإدارة العمومية ومظاهر الفساد فيها وكيفية التخلص منه، الوظيفة العمومية...
- التأسيس لتاريخ المواطنة من القول بالحقوق لدى الخواص إلى عولمتها وعالميتها.
بغية تكوين الطالب تكوينا أكاديميا وعلميا يسمح له بحمل المبادئ العامة للمواطنة، ومقاييس الحكم الرشيد في تدبير المرفق العام بغية تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، والنهوض بمؤسسات دولة الحق والقانون، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يخلق من المجتمع الوطني الجزائري وحدة متكاملة اجتماعية وسياسيا وتاريخيا واقتصاديا يعتز الفرد بالانتماء إليها، ويتمتع بحقوقه ويقوم بواجباته طوعا، ويعتمد على القانون بمختلف تشريعاته كمصدر أساسي للحقوق والواجبات. باعتباره الوسيلة التي تنظم سلوك الدر في المجتمع على وجه الإلزام.
كما يطلع الطالب من خلال محاضرات هذا المقياس على التجارب الرائدة في الديمقراطية التشاركية التي تعتبر المواطن عنصرا فعالا في اتخاذ القرارات السياسية، وإعداد البرامج التنموية على المستوى المحلي، ومراقبة تنفيذها بالاعتماد على مبدأ الشفافية والمساءلة، فيتعود على تحمل المسؤولية على نتائج قارته والسياسات المتبعة بكل موضوعية. ومحاولة الاستفادة من نتائج هذه التجارب وتطبيقها على المجتمع الجزائري، من أجل تحسن نوعية الخدمة المقدمة من طرف المرفق العام، وتحسين آليات تسيير وتدبير الشأن العام الاعتماد على فاعلية المواطن.
-
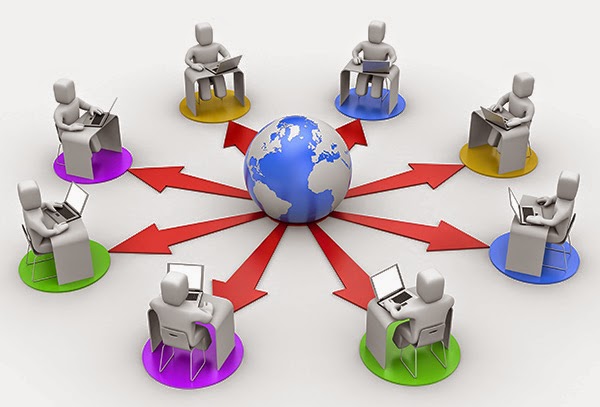
الأستاذ : نمرة محمّد
M.NEMRA@UNIV-DBKM.DZ : البريد المهني
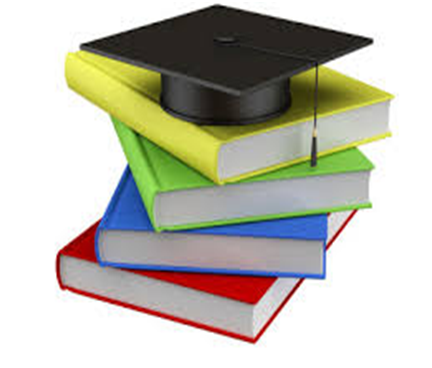
-
-
رابط فيديو المحاضرة الثّانية:
https://www.youtube.com/watch?v=xg0GYayOV-k
-
المحاضرة الأولى: مدخل إلى موضوع المواطنة

مقدمة:
تعدّ المواطنة من المفاهيم السّياسية المعاصرة في الفكر الغربي، وكانت إلى زمن غير بعيد تعني الاشتراك مع الآخرين في حيز جغرافي يسمى الوطن، بحيث يطغى على هذا الاشتراك طابع الشعور العاطفي الّذي يحرك الإنسان في نشاطاته وعلاقاته مع الآخرين، ومع مرور الوقت تغيرت النظرة إلى مفهوم المواطنة، حيث أصبحت هذه الأخيرة مصدرا لنشأة أنواع من العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين. ولم تأخذ المواطنة معناها الحديث إلا بعد ظهور وتكوين الكيانات السياسية، وهو ما ساهم في تطور معناها من اشتراك المواطنين في الشعور العاطفي اتجاه الكيان إلى الاشتراك في مجتمع سياسي وما ينتج عن ذلك من حقوق وواجبات.
1.نشأة المواطنة في الغرب:
استقر مفهوم المواطنة في الفكر السياسي المعاصر كمفهوم تاريخي شامل ومعقد، لأن الفكر السياسي إنما ينتج انطلاقا من حراك اجتماعي معقد تتحكم فيه السيرورة التاريخية، لذا تتخذ إنتاجاته القانونية والثقافية، كما أن ترجمة الانتاج الحضاري عمليا من خلال الدولة، يتخذ أبعادا متشابكة يصعب مها نفي حضور مجموع القيم المشكلة لتلك الحضارة، بما فيها العقائد والمتغيرات السوسيوثقافية، والمتغيرات العالمية. من خلال التجربة السياسية الغربية يمكن رصد ثلاثة تحولات متداخلة ومتكاملة، شهدتها الأوضاع السياسية لهذه التجربة، استطاعت لقوتها أن تحول بعض مرتكزات بناء الدولة، وأن تزرع أسسا سياسية أرست مبدأ المواطنة:
أ.التّحول الأوّل: جاء مع نهاية الحروب الدينية بإقرار معاهدة وستفاليا سنة 1648م، وهو اسم يطلق على معاهدتي السلام بمدينتي أوسنابرك ومونستر بألمانيا التي أنهتا حرب الثلاثين عاما في الإمبراطورية الرومانية، وأخمدتا حرب الثمانين عاما بين إسبانيا ودول المقاطعات السبع المنخفضة المتحدة، أو فيما بعد هولندا. وقعها مندوبون عن كل من الإمبراطور الروماني فرديناند الثالث (1637م-1657م)، ومماليك فرنسا وإسبانيا والسويد وجمهورية هولندا والإمارات الكاتوليكية والبروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية. وتعتبر هذه المعاهدة أول اتفاقية دبلوماسية في العصر الحديث أرست نظاما جديدا في أوروبا الوسطى والغربية مبنيا على مبدأ سيادة الدول. فأصبحت مقررات هذه المعاهدة جزءا من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية.
ب.التّحول الثّاني: فقد تجسد في إقرار المشاركة السياسية، وما شهده بدوره من تطور وتوسع، صاحبه تداولا للسلطة سلميا.
ج.التّحول الثّالث: يتجلى في سمو القانون، وشموله لسائر المواطنين، وما أنتجه الفكر السياسي الغربي من مؤسسات، أو ما أطلق عليه مؤسسة السلطة السياسية في ظل الدولة القومية الحديثة.
2. نشأة المواطنة في الإسلام:
تطرح فكرة المواطنة في السياق الإسلامي إشكال النموذج التصوري للدولة، على الرغم من أن مصطلحي الدولة والمواطن، لم يتم تداولها بالشكل إلا بعد نجاح الثورة الفرنسية سنة 1789م، لأن مفهوم الدولة قبل ذلك كان على أبعاد يحضر فيهما الدين والعرق بقوة. حتى تقلصت سلطة الكنيسة، وسطوتها على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في أوروبا في منتصف القرن السابع عشر الميلادي، فتطور مفهوم المواطنة ليهل الوازع الديني في إشكالية الانتماء لدولة واحدة، لترسيخ الصرح لفَنُّ الديمقراطي الذي أصبح الميزة الأولى في بناء دولة عصرية متطورة.
والمتتبع لأحداث التاريخ الإسلامي يتبين أن الفكر الإسلامي كان سباقا للتأصيل لمبادئ المواطنة، ويظهر هذا في تلك الوثيقة المكتوبة التي عرفت باسم دستور المدينة، أو ما يطلق عليها الصحيفة وهي الأساس في المرحلة الأولى لنشأة الدولة الإسلامية في حقوق الحاكم وحقوق الرعية وتنظيم المجتمع والدولة، وكذلك تتردد في نصوص السنة المطهرة كلمات: الراعي، والرعية، والبيعة، والإمارة، والطاعة للأمير، وفيها تشريعات في حقوق الحاكم ومسئوليته، وحقوق الأفراد، وحرياتهم، والسيادة، والسلم، والحرب، والمعاهدة، والقضاء والشورى، ومركز الأقليات الدينية، وغير ذلك مما يدخل في صميم الأحكام الدستورية، والسياسية بالمصطلح المعاصر. ومعنى ذلك: أن السنة إنما أيضًا مثل القرآن الكريم تعتبر مصدرًا من مصادر الأحكام الدستورية والسياسية في الدولة الإسلامية؛ لأنه كما قلنا: ذكرت أمور هي من صميم النواحي الدستورية والسياسية -كما قلنا- مثل: الإمارة والطاعة للأمير وغير ذلك وحقوق الأفراد وحرياتهم وعلاقة المسلمين بغيرهم في السلم والحرب وغير ذلك.
وهذه الصحيفة في الأصل صحيفتان (وثيقتان): أحدها يختص بالمهاجرين والأنصار، والأخرى بالمسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى، والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، ثم قررت الصحيفة أن هؤلاء أمة دون الناس، والأمة مجموعة أحلاف؛ إذ إن الأفخاذ والقبائل تركت كما كانت وأصبحت أعضاء في الأمة وعد المهاجرين فخذا واحدا، وأما الفرد فيشارك في الأمة مشاركة مباشرة عن طريق الفخذ والقبيلة وعلاقة الفخذ بالأمة تتضح في أنه يدفع النفقات غير الخاصة كالدين وفداء الأسرى كما كان من قبل؛ إذ لم يكن يوجد خزينة مركزية أنذاك؛ ولذا نصت الصحيفة إنهم أمة واحة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم فيتعاقلون بينهم . وكلمة (الأمة) شملت أيضا طوائف المدينة الأخرى كاليهود، وإن كانوا لا ينتمون إليها انتماء وثيقا كالمهاجرين والأنصار؛ ولذلك لم تقع عليهم نفس الواجبات وليس لهم نفس الحقوق. فجعلت هده الوثيقة غير المسلمين المقيمين بالمدينة مواطنين في الدولة الإسلام مواطنين فيها، لهم من الحقوق، وعليهم من واجبات المواطنة.
3- أصول المواطنة في الإسلام: يقوم التأصيل الشرعي لمفهوم المواطنة على المبادئ والقواعد التالية:
أ- الأخوة: الأخوّة والمؤاخاة في الله سبحانه، حيث جعل الإسلام هذا النّوع من الأخوّة فوق كلّ أخوّة إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. وقد جعل الإسلام هذا التّآخي من كمال الإيمان، حيث جعله رابطة قويّة بين المسلم وأخيه المسلم، ومن كمال الإيمان أن يحبّ المسلم لأخيه ما يحبّ لنفسه.و التّآخي في الله مسئوليّة يتقلّدها كلّ مسلم ويحافظ عليها بأمر الله تعالى، وبقدر المحافظة على هذه الأخوّة تكون قوّة الإيمان.
والأخوّة في الإنسانيّة بحكم أنّ الإنسان مهما اختلفت عقيدته هو أخ للإنسان عليه أن يتوجّه إليه بالدّعوة لهدايته وتزكيته. وهذا من أهمّ خصائص المنهج القرآنيّ.وللأخوّة مكانة سامية في الإسلام، تحقّق عدّة فوائد مهمّة للفرد والمجتمع الإسلاميّ والعالميّ، منها:
- تحقيق التّماسك والتّرابط في المجتمع الإسلاميّ، حيث تربط الأخوّة بين الأفراد وتشدّ من أواصر الصّلة والمحبّة والتّعاون والتكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل في المجتمع الإسلاميّ لأنّها تبنى المجتمع على أساس من علاقات اجتماعيّة سليمة..
- حماية المجتمع الإسلاميّ من أشكال الانحراف، ومن أمراض الضّعف الحضاريّ، بحيث يستمرّ هذا المجتمع في قوّته وعطائه.
- تحقيق التّوازن الاجتماعيّ، بتحقيق معنى الأخوّة السّامي، فلا يستشعر الفرد المسلم ألم الفوارق بين المسلم وأخيه المسلم سواء كان ذلك الفارق في المال أو في الجاه أو في غير ذلك، ممّا يحقّق توازنا بين الفئات الاجتماعيّة.
- توفير اشتراك أفراد المجتمع كلّهم في اتّجاه واحد، من أجل القيام بوظيفة معيّنة ذات غايات محدّدة هي الغايات الإسلاميّة. معنى هذا أنّ أغلى وأسلم أخوّة هي تلك الأخوّة الّتي يربط بينها رباط العقيدة الصّحيحة.
- تحقيق صالح المجتمع، حيث لا تتضخّم الذّوات الإنسانيّة على حساب هذا الصّالح، وفي أحداث التّاريخ الإسلاميّ البرهان على ذلك.
ب- وحدة المصالح والآمال والآلام: أكد الإسلام أن نظام الحقوق والواجبات في الدولة الإسلامية ينبغي أن تتم وفق مصالح المسلمين، وواقع المسلمين؛ ولذلك كان من فضل الله علينا أن تركت هذه الأمور، وفيها مجال للاجتهاد من أجل تحقق المصلحة العامة، هذه الأمور المتعلقة بعلاقة الحاكم بالمحكومين، وبتحديد سلطة الحاكم، وبيان حقوقه، وواجباته، وحقوق الرعية، وواجباتها، وبيان السلطات المختلفة، ووظيفة كل سلطة من هذه السلطات هو ما تشمله مادة تسمى -في الفقه الإسلامي- نظام الحكم في الإسلام.
والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، هذه هي أهم الشروط التي قالها الفقهاء، لكن الحقيقة الإمام مالك توسع في هذا الأمر، وقال: ليس بلازم أن تكون المصلحة كلية ضرورية قطعية، يقول: المهم توجد مصلحة؛ فإذا وجدت هذه المصلحة العامة؛ ففي هذه الحالة تقدم على المصلحة الخاصة، ولما كانت الشريعة الإسلامية تجعل المصلحة المرسلة مصدرًا من مصادر التشريع الإسلامي، وذلك لأن المصلحة يمكن أن تغطي الوقائع المتجددة، والمصالح غير المتناهية، وهو ما تقصر عنه النصوص؛ لأنها متناهية.
جـ- العدل: هو عبارة عن جملة من الفضائل، فإنه مهما كان بين الملك وجنده ورعيته ترتيب محمود، بكون الملك بصيرا قاهرا، وكون الجند ذوي قوة وطاعة، وكون الرعية ضعفاء سلسي الانقياد، قيل: إن العدل قائم في البلد. ولن ينتظم العدل بأن يكون بعضهم بهذه الصفات دون كلهم، وكذلك العدل في مملكة البدن بين هذه الصفات. والعدل في أخلاق النفس يتبعه لا محالة العدل في المعاملة والسياسة، ويكون كالمتفرّع منه. ومعنى العدل الترتيب المستحب، إما في الأخلاق، وإما في حقوق المعاملات، وإما في أجزاء ما به قوام البلد. والعدل في المعاملة أن يأخذ ما ليس له، والتغابن أن يعطي في المعاملة ما ليس عليه حمد وأجر. والعدل في السياسة أن ترتب أجزاء المدينة الترتيب المشاكل لترتيب أجزاء النفس، حتى يكون المدينة في ائتلافها وتناسب أجزائها، وتعاون أركانها على الغرض المطلوب من الاجتماع، كالشخص الواحد، فيوضع كل شيء موضعه، وينقسم سكانه إلى مخدوم لا يخدم وإلى خادم ليس بمخدوم، وغلى طبقة يخدمون من وجه، ويخدَمون من وجه آخر،. ولا يكتنف العدل رذيلة الجور المقابلة له، إذ ليس بين الترتيب وعدم الترتيب وسط، وبمثل هذا الترتيب والعدل قامت السموات والأرض حتى صار العالم كله كالشخص الواحد، متعاون القوى والأجزاء.
د- الاجتماع: بطبع الإنسان أنه مفطور على العيش مع بني جنسه للاستئناس والتعاون على المصالح الدينية والدنيوية، وقد دعا الإسلام إلى حسن التعامل مع الإنسان، من أجل الألفة والتعاون والتعارف، فطبع الإنسان مدني، فلا يمكن أن يعيش وحده. قال تعالى: "ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" سورة الحجرات، الآية 13. وقوله أيضا: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" سورة آل عمران، الآية 103.
-
المحاضرة الثّانية: مفهوم الحكامة
(الحكامة أو الحوكمة أو الحكمانية أو الحكم الراشد)
ويعود أصل لفظة الحكامة (Governance) إلى اللّغة الإغريقية والتي تعني وتعبر عن قدرة ربان السفينة في قيادة سفينته وسط أمواج البحر والأعاصير كما أنّها تعبّر عن كل ما يمتلكه من قيم وأخلاق وسلوك يمكنه من المحافظة على أرواح وممتلكات الركاب، فإذا وصل إلى البرّ أطلق عليه الآخرون القبطان المتحكم جدا. وتعرف إذا الحكامة في اللغة العربية على أنها الذي سيطر وأدار وحكم وضبط. وتعني الاحتكام إلى العقل والرّجوع إليه.
مفهوم الحكامة (لغة واصطلاحا):
1- لغة: مشتقة من الفعل حَكَمَ بينهم يَحْكُمُ أي قضى. وحَكَمَ له وحَكَمَ عليه. والحُكْمُ أيضا: الحِكمَة من العلم. والحَكيمُ: العالم، وصاحب الحكمة. والحَكيم: المتقِن للأمور. والحَكَمُ، بالتحريك: الحَاكِمُ. وفي المثل: " في بيته يؤتى الحكم ". وحكمة الشاة: ذقنها. وحكمة اللجام: ما أحاط بالحَنَك. تقول منه: حَكَمْتُ الدابّة حكما وأحكمتها أيضا. وكانت العرب تتخذها من القد والابق، لان قصدهم الشجاعة لا الزينة. قال زهير: القائد الخيل منكوبا داوبرها. ويقال أيضا: حَكَمْتُ السفيه وأَحْكَمْتُهُ، إذا أخذتَ على يده. قال جرير: أَبَني حَنيفةَ أَحْكِمُوا سفهاَءكم إنِّي أخاف عليكم أن أغضبا.
وحكمت الرجل تحكيما، إذا منعته مما أراد. ويقال أيضا: حَكَّمْتُهُ في مالي، إذا جعلتَ إليه الحُكْمَ فيه. فاحْتَكَمَ عَلَيَّ في ذلك. واحْتَكَموا إلى الحاكم وتَحَاكَموا بمعنىً. والمُحاكَمَةُ: المخاصمة إلى الحاكم.
والمحكم بفتح الكاف الذي في شعر طرفة هو الشيخ المجرب، المنسوب إلى الحكمة. وأمّا الذي في الحديث " إن الجنة للمحكمين " فهم قوم من أصحاب الأخدود حكموا وخيروا بين القتل والكفر، فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل.
لفظة (GOVERNANCE) حوكمة مشتقة من (GOVERNEMENT). وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم، وعليه فإنّ لفظ الحكامة يتضمن الجوانب الآتية:
أ.الحكمة: ما تقتضيه من التوجيه والإرشاد.
ب.الحكم: وما تقتضيه من السيطرة على الأمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في السلوك.
كما نقصد بها الحكم وما يتطلبه ذلك من الالتزام والانضباط والسيطرة بوضع القواعد والضوابط التي تحكم السلوك، وبصورة تضمن إدارة وقيادة قوية ورقابة منضبطة حازمة. إنّ كلمة حكم لم ترد في اللغة العربية بمعنى الحكامة، إلاّ أنّ المعنى العام لها هو المنع من الظلم والفساد، وهو الأمر المتفق عليه اصطلاحا لكلمة الحوكمة التي تهدف إلى منع الظلم والفساد في الإدارة، ولقد حاول البعض ترجمتها إلى الحاكمية أو الضوابط المؤسسية الحاكمة، إلاّ أنّ المصطلح الحالي والمتفق عليه هو الحكامة. كما ترادفها بعض المصطلحات التي تفي نفس المعنى وبالأحرى نفس المضمون وهي الحوكمة، الحكم الراشد، الحكم الصالح، وهذه المصطلحات تدلّ على الانضباط والسيطرة.
2- اصطلاحا: يمكن تعريف الحكامة على النّحو الآتي
مدحت أبو النصر: هي فن إدارة الحكومة وتسيير أمورها بسلاسة وفعالية وتحقيقها لأهدافها الاجتماعية على نحو يحقق رضا المواطنين.
وفي تعريف آخر عُرّفت على أنّها قدرة الحكومة على عملية الإدارة العامة بكفاءة وفعالية وبحيث تكون خاضعة للمساءلة ومفتوحة لمشاركة المواطنين، وتدعم النظام الديمقراطي للحكومة.
ومنه الحوكمة والحاكمية أو الحكم الراشد تهدف إلى مكافحة الفساد وتحقيق كل من العدالة والمساواة والشفافية.
إن الحكامة تظهر أهميتها أثناء الأزمات على وجه الخصوص وذلك بتجنبها وكذا محاولة استقرار السوق.
وفي الجانب القانوني يُعرّفها صبري أحمد شلبي على أنّها: مجموعة من القوانين والقواعد التي تحدد العلاقة الشفافة بين الإدارة والعاملين فيها مع محاولات إبعاد وتفادي الانهيار والزوال.
- ويعرّفها الباحثون المتخصصون في أغلب المنظمات الدولية على أنّها: "تعبير عن ممارسة السلطة السياسية، وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده المادية والمالية والبشرية وغيرها. فهي حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة، وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين، وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم".
- أمّا في اللغة الإنجليزية فيقصد بالحكامة التدبير الرشيد والحكيم، وهي مفهوم استعجالي تبناه المجتمع الدولي لتجاوز حالة الخلل الواقعة في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الدولي الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه وموقفه، وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي. كما أنّها ركيزة للوصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامة، التي تتأسّس على ضرورة وإلزامية إزالة الحدود بين القوى المؤثرة، والتي تتجسد فيما يلي:
أ - الدولة هي صانعة القرار الأول، والمشرعة للقوانين التي تمكن أفراد المجمع من الاستفادة الأمثل من قدرات البلد.
ب- القطاع الخاص هو المسؤول الأول عن النمو بمؤشراته الاقتصادية.
ج- المجتمع المدني والسياسي الممثل في الجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها هو ميدان للممارسة، والمشاركة، والتشارك وفق إستراتيجية واضحة الأهداف.
- أمّا الباحثون في ميدان الحكم فكانت لهم إسهاماتهم في وضع مفهوم للحكامة، وهذا من خلال تعريف كاتو وآخرين (2000)، وهي: إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التّنمية. والدول ذات الحكم الرشيد تمارس السلطة بموجب قوانين، من الممكن توقعها من قبل العامة، من خلال مؤسسات الدولة ومنظماتها الخاضعة للمحاسبة والمساءلة بكل شفافية، وبمشاركة الناس في عملية التنمية وإعداد السياسات.
ويتضّح من خلال التّعاريف السّابقة إنّ الحكامة هي: مجموعة القيم الفاعلة والهادفة للإصلاح الكلي الشامل والمتواصل لمنظومة المجتمع بالاستناد لمنظومة قانونية سليمة، وأطر محاسبية واضحة، وإعلام كفء ونزيه يحقق الثقافة التي تعكس العدالة الاجتماعية، بما يحقّق أفضل الأهداف المجتمعية.
-
المحاضرة الثّالثة : مفهوم المواطنة ومقوماتها
1.مفهوم المواطنة:
أ.المواطنة لغة: يشتق مصطلح المواطنة من الوطن، والوطن في معجم لسان العرب هو: "المنزل الذي يقيم به، والجمع أوطان. وأوطان الغنم والبقر مرابطها، وأماكنها تأوي إليها، ومواطن مكة مواقعها". وطن يطن وطنا: أقام به. وطن البلد: اتخذه وطنا. توطن البلد: اتخذه وطنا، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان ولد فيه أم لم يولد، مواطنة: مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولدا.
فقد تطوّر مفهوم الوطن عند العرب، فلم يعد مجرد تاريخ وجغرافيا. بل أصبح مكونا للذات ، ومساهما عضويا في خلق الأنا والنحن، وأصبح واهبا للمفاهيم التي ننظر بها إلى أنفسنا وإلى العالم. أي أصبح مرادفا للثقافة.
ب.المواطنة اصطلاحا: أما المواطنة في الاصطلاح فهي بأبسط معانيها: " إلتزامات متبادلة بين الأشخاص والدولة. فالشخص يحصل على حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة انتمائه لمجتمع معين، وعليه في الوقت ذاته واجبات يتحتم عليه آداؤها".
أما التعريف القانوني للمواطنة هي: "أن تكون عضوا في مجتمع سياسي معين أو دولة بعينها. القانون يؤسس الدولة ويخلف المساواة بين مواطنيها، ويرسي نظاما عاما من حقوق وواجبات تسري على المجتمع دون تفرقة. وعادة ما تكون رابطة الجنسية معيارا أساسيا لتحديد من هو المواطن في الدولة. وتجعل شرط حيازتها سواء أكانت أصلية أم مكتسبة للتمتع بكل الحقوق والحريات المدنية والسياسية".
وتترتب على المواطنة القانونية - أي حمل جنسية دولة ما - ثلاثة أنماط من الحقوق والواجبات : السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية. تشمل الحقوق السياسية الحق في الانتخاب، والترشح، والتنظيم. وأهم الواجبات دفع الضرائب المستحقة على كل مواطن وفق القوانين والإجراءات الضريبية المعمول بها. وتتضمن الحقوق المدنية كلا من الحريات الشخصية، والحق في الأمان والخصوصية والاجتماع، والحصول عن المعلومات، فضلا عن حرية الاعتقاد والتعبير. وحرية تشكيل تنظيمات مدنية مثل: الجمعيات والنقابات والمنظمات الغير حكومية، وحرية الانتقال والحركة والمقاومة السلمية، والحق في محاكمة عادلة. ولا ترتبط الحقوق الاقتصادية الاجتماعية بالحق في الملكية، ولكنها تمتد إلى الحقوق المرتبطة بممارسة العمل مثل: الحصول على أجر عادل، وعطلة دورية، والحق في الإضراب والتفاوض الجماعي.
وذهب البعض إلى أن المواطنة مصطلح مستحدث في اللغة العربية للتعبير عن الكلمة الإنجليزية citizenship. أما عن تعريف المواطنة في الموسوعة العربية العالمية فهي: "اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن". وتعرف دار المعارف البريطانية المواطنة بأنها: "علاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات متبادلة في تلك الدولة ".
وعليه يتوجب وجود سلطة قضائية مستقلة في تلك الدولة قادرة على حماية حقوق الأفراد من أي اعتداء عليها، أو سلبها أو انتقاصها سواء من جانب مختلف أجهزة الدولة، أو على يد الأفراد أنفسهم في علاقة بعضهم ببعض. هذا إلى جانب منظمات فاعلة للمجتمع المدني وبالأخص المنظمات الحقوقية والإعلامية التي تنهض دائما على حماية حقوق الأفراد، وصيانتها، والكشف عن جميع صور الانتهاك الذي قد يتعرضون له.
2. مقومات المواطنة: المواطنة ليست وضعية جاهزة يمكن تجليها بصورة آلية عندما تتحقق الرغبة في ذلك، وإنما هي سيرورة تاريخية، ودينامكية مستمرة، وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف الملائمة، وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد، وفي إطار مؤسسات وآليات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع، وإذا كان من الطبيعي أن تختلف نسبيا هذه المتطلبات من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر بسبب اختلاف الثقافات والحضارات، والعادات والقيم، ومستوى النضج السياسي، فإنه لا بد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية المشتركة، ووجود حد أدنى من الشروط التي يتجلى من خلالها مفهوم المواطنة في الحياة اليومية للأفراد، وفي علاقاتهم بغيرهم، وبمحيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن أهم مقومات المواطنة نخص بالذكر:
أ.المساواة وتكافؤ الفرص: لا تتحقق المواطنة إلا بتساوي جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وتتاح أمام الجميع نفس الفرص، ويعني ذلك التساوي التام أمام القانون، الذي يعد المرجع الوحيد في تحقيق تلك الحقوق والواجبات، وإذا كان التساكن والتعايش والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض توفرها بين المشتركين في الانتماء لنفس الوطن. فإنها تهتز في حالة عدم احترام مبدأ المساواة، مما يؤدي إلفى تهديد الاستقرار، لأن كل من يشعر بالحيف، أو الحرمان دون حق مما يتاح لغيره، وتغلق أبواب الانصاف في وجهه، يصبح متمردا على قيم المواطنة، ويكون بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بأي شكل من الأشكال.
والوطن التي تتعدد أصول مواطنيه العرقية، وعقائدهم الدينية، وانتماءاتهم الثقافية والسياسية، لا يمكن ضمان وحدته واستقراره إلا على أساس مبدأ المواطنة الذي يرتكز على منظومة قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية متكاملة، والمساواة كمقوم رئيسي للمواطنة، تعني أنه لا مجال للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس، أو اللون، أو الأصل العرقي،/ أو المعتقد الديني، أو القناعات الفكرية، أو الانتماء والنشاط السياسي والنقابي والجمعوي. واختلاف الفئات واتماءاتها وصفاتها لا يجعل أيا منها أكثر حظا من غيرها في الحصول على المكاسب والامتيازات، كما لا يكون سببا في انتقاص الحقوق، أو مبررا للاقصاء، والتهميش، وحسن تدبير الاختلاف والتعدد لا يتم إلا في إطار المواطنة التي تضمن حقوق الجميع، وتتيح لكل المواطنين والمواطنات القيام بواجبهم، وتحمل المسؤوليات في وطنهم على أسس متكافئة. فلا يمكن إلغاء الصفات والانتماءات والمعتقدات وغيرها من خصوصيات بعض الفئات، وإنما يقوم على احترامها، وإتاحة لها فرص المشاركة في اغناء الوطن، وتنمية رصيده الثقافي والحضاري.
ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد الوطن الواحد، وفي المجتمع الذي تتناقض فيه المصالح والأغراض، فإنه لا بد من وجود ضمانات قانونية، وقضاء مستقل وعادل يتم اللجوء إليه من قبل كل من تعرضت حقوقه للمس أو الانتهاك.
ب.المشاركة في الحياة العامة: لتمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة الفعلية في الحياة العامة، لا بد من توفر استعدادات حقيقية لذى المشاركين في الانتماء إلى الوطن، وهذه الاستعدادات لا تتوفر إلا في حدود ضيقة في ظروف قمع الحريات، ومصادرة الفكر المتحرر من التبعية والخنوع، وفي ظل الأنظمة التي الأنظمة التي تناهض العمل السياسي الذي يحمل رؤية انتقادية، أو موقف معارض للحكام والسياسات المتبعة، ففي مثل هذه الظروف التي تعرفها المجتمعات عموما، والعربية خصوصا، يلاحظ انزواء كثير من الكفاءات، وبروز الفردانية، والابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة، والنفور من العمل السياسي، وغير ذلك من الظواهر المناقضة للمواطنة. فالأنظمة القمعية ولو اختفت وراء ديمقراطيات شكلية مسؤولة من تقليص فرص المشاركة، ومدمرة لقيم المواطنة، ولا يأتي نمو استعداد المواطنين والمواطنات للمشاركة في الحياة العامة إلا في ظل حرية الفكر والتعبير، وحرية الانتماء والنشاط السياسي والنقابي والجمعوي، وفي إطار الديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو صاحب السيادة، ومصدرا لجميع السلطات.
والمشاركة في الحياة العامة تعني إمكانية لولج جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متاحة أمام الجميع دون أي تمييز، بدءا من استفادة الأطفال من الحق في التعليم والتكوين على المواطنة وحقوق الإنسان، واستفادة عموم المواطنين من الخدمات العامة، مرورا بحرية المبادرة الاقتصادية، وحرية الابداع الفكري والفني، وحرية النشاط الثقافي والاجتماعي، وانتهاء بحق المشاركة في تدبير الشأن العام بشكل مباشر كتولي المناصب العامة وولوج مواقع، أو بكيفية غير مباشرة كالانخراط بحرية في الأحزاب السياسية، وإبداء الرأي حول السياسات المتبعة، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيلية على المستوى المحلي والوطني والمهني. وهذا ما يضمن فعالية النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضفي الحيوية على المشهد الوطني، مما يساهم في خلق واقع ينشد التطور المتواصل والارتقاء المستمر.
ج.الولاء للوطن: يعني أن الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه تسمو على العلاقات القبلية والعشائرية والحزبية، ولا خضوع فيها إلا لسيادة القانون. وأن هذه الرابطة لا تنحصر في مجرد الشعور بالانتماء، وما يطبع ذلك من عواطف، وإنما تتعدى إلى جانب الانتماء الوجداني، وذلك في إدراك واعتقاد المواطن بأن هناك التزامات وواجبات نحو الوطن لا تتحقق المواطنة دون التقيد الطوعي بها. فلا تكفي وجود ترسانة من القوانين والمؤسسات التي تتيح للفرد التمتع بحقوقه والدفاع عنها في مواجهة أي انتهاك، واستردادها إذا سلبت منه. بل يجب تشبع المواطن بقيم المواطنة وثقافة القانون.
ويعني الولاء للوطن شعور كل مواطن أنه معني بخدمة الوطن، والعمل على تنميته والرفع من شأنه، وحماية مقوماته الدينية واللغوية والثقافية والحضارية، والشعور بالمسؤولية عن المشاركة في تحقيق النفع العام، والالتزام باحترام حقوق وحريات الآخرين، واحترام القوانين التي تنظم علاقات المواطنين فيما بينهم، وعلاقاتهم بمؤسسات الدولة والمجتمع، والمساهمة في حماية جمالية ونظافة المدينة أو القرية التي يقيم بها، وحماية البيئة فيها، والمشاركة في النفقات الجماعية، والانخراط في الدفاع عن القضايا الوطنية، والتضامن مع باقي المواطنين والهيئات والمؤسسات الوطنية في مواجهة الطوارئ والأخطار التي قد تهدد الوطن في أي وقت، والاستعداد للتضحية من أجل استقلال الوطن، والارتكاز على مبدأ اعتبار المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار، وأسمى من كل المصالح الذاتية الخاصة والأغراض الفئوية الضيقة.
والولاء للوطن لا ينحصر في المواطنين المقيمين داخل حدود التراب الوطني، وإنما يبقى في وجدان وضمير وسلوك المواطنين الذين اضطرتهم الظروف للإقامة في الخارج، لأن مغادرة لأي سبب من الأسباب، لا يعني التحلل من الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المواطنة، وتبقى لصيقة بالمواطن تجاه وطنه الأصلي حتى ولو اكتسب الجنسية في دولة أخرى.
-
1. مفهوم الحكامة السّياسية:
مجال الحكامة السياسية واسع جدا وتجلى في مظاهر شتى، ابتداء من الدستور والمؤسسات والهياكل الدستورية والقوانين، مرورا باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس دولة الحق والقانون، ووصولا إلى احترام الحريات الأساسية الفردية والجماعية، وإشراك كل الفاعلين في المجتمع المدني سواء كانوا جمعيات أو نقابات وغيرها في اتخاذ القرار.ومن تم تتداخل أبعاد الحكامة السياسية بمفهوم الديمقراطية، إذ كثيرا ما أبرزت المؤسسات الوطنية والجهوية الكبرى العلاقة الموجودة بين مفاهيم الحكامة الرشيدة والديمقراطية والتنمية، كونها تنمي التمثيل السياسي، الحريات المدنية، احترام الدستور، الشفافية...، وهي العناصر المكونة لصرح الديمقراطية، وشرعية الدولة.
إن الارتباط بين مفهومي الحكامة السياسية والديمقراطية كثيرا ما تبلور في توجهات العديد من النظريات منها: نظريات العلاقات الدولية، والنظريات المعيارية. فمنظرو العلاقات الدولية في القرن العشرين استوحوا الأفكار عبر البعد الدولي، وأهملوا المراقبة السياسية المفروضة من أعلى، وركزوا على التفاعل الحاصل بين المجتمعات ومواطنيها، وعلى الدور المنوط بالمجتمع المدني على الصعيد الكوني كشرط مسبق لحكامة سياسية عالمية. أما بخصوص النظريات المعيارية،" فهي تنظر لهذه الأخيرة كشكل للحكامة الديمقراطية، والتي تتمايز نظريا عن الأشكال الأخرى للحكامة.
فالحكامة هنا مظهر للحكم الصالح والرشيد، وذلك من خلال ضمان احترام حقوق المواطنين وكرامتهم، وتلبية طموحاتهم في التقدم والرفاهية، والحفاظ على الحريات، وتحقيق المساواة، فهذا هو الهدف المنشود من الحكامة السياسية الرشيدة والجيدة، فهي أداة يتمكن بواسطتها ضبط وتفسير التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي تطال الجوانب الاقتصادية والمؤسساتية، ومختلف البنى الاجتماعية والثقافية والفكرية.
2. الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحكامة السّياسية الرشيدة:
- إشراك كل الفاعلين من مجتمع مدني وقطاع خاص، وغيرهم في اتخاذ القرار السياسي.
وهنا يبرز دور الحكامة الرشيدة كموجة لتحديث السياسة من خلال القيم الجديدة في القطاع العام والمجتمع، كما تبرز الحاجة إلى توفير مصادر جديدة للخبرة، وخلق شبكات تبادل مستمر للمعلومات، وتقارب وتجاوب جميع الفاعلين في اتخاذ القرار.
- الترسيخ لمشروع سياسي متكامل يدخل في الإصلاحات المؤسساتية للحكامة، وفق منظور شمولي، لضمان استمرار نشاط الدولة، وقدرتها على إرضاء تطلعات الموطنين.
- ترشيد الحكامة السياسية هو ضمان لنجاح حكامات الميادين الأخرى، فهي بمثابة خارطة للحكامات الأخرى تمدها وتحضنها بالطاقة والفعالية والاستمرارية.
-
1- مفهوم دولة القانون:
تعرف الدولة القانونية على أنها الدولة الدستورية، أي الدولة التي تقيد ممارسات السلطات الحكومية فيها بالقوانين، وتقتصر سلطة الدولة فيها على حماية الأفراد من الممارسات التعسفية للسلطة، حيث يتمتع المواطن في هذه الدولة بالحرية المدنية بشكل قانوني، ويتمكن بموجبها من استخدامها في المحاكم.
وتقوم نظرية إيمانويل كانط في دولة القانون على سيادة الدستور المدون في الدولة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق ضمانات تضمن تطبيق ذلك بما يكفل لإسعاد المواطن وازدهاره، وضمان جودة الخدمات المقدمة له في شتى نواحي الحياة. فالدولة في نظره: " عبارة عن مجتمع كبير من المواطنين، يعيشون في ظل الضمانات المشروعة التي يضمنها الدستور"، ولضان هذا لابد أن يستمد الدستور مبادئه وقواعده القانونية بشكل مسبق من اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية والمثل العليا، والإنصاف في حياة الأفراد برعاية القانون العام.
2- أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون:
تقوم دولة الحق والقانون على سيادة الدستور الذي يحمي ويكفل الحريات والحقوق لجميع المواطنين، بتحقيق مبدأ تكافؤ الجميع أمام أحكام القانون، فتكون:
- القوة العمومية خاضعة للقانون.
- تدرج القوانين.
- قوة الدولة محدودة.
- كل قاعدة قانونية تكتسب مصداقيتها بالنظر إلى العلاقة بالقواعد الأسمى منها، فتكون الترسانة التشريعية والتنظيمية غير مخالفة للدستور.
- الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية و القضائية، للحد من تأثير كل سلطة على الأخرى، وجعلها كأجزاء من الحكومة، بعد توفير التوازن والضوابط فيما بينها. وضمان مبدأ استقلالية القضاء. فترتبط سلطتا: القضاء والتنفيذ بالقانون، أما السلطة التشريعية فتقيد بمبادئ الدستور.
- تستمد الشرعية القانونية من الدستور الذي هو أساس خضوع السلطة للقانون. وإيجاد جهة مستقلة لمراجعة أفعال أجهزة الدولة، والقرارات الصادرة عنها، بما في ذلك قضايا الطعون والاستئناف.
- تطبيق مبدأ التناسب في أفعال الدولة.
3- أسس المواطنة في دولة الحق والقانون:
في دولة القانون يكون المواطن والمجتمع هدفا وغاية يكرس من أجلها كل جهد وطني، ويعد الحفاظ على كرامتهما مؤشرا لحضارة الوطن، وهبة الدولة، وبما أن المواطنة عقد اجتماعي يتجلى بين الوطن وأبنائه من خلال المشاركة المؤطرة في الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور على أساس المشاركة الوطنية، والاحترام المتبادل، والحوار الهادف البناء، والمصلحة العليا للوطن، التي تقوم على أساس العدل والإخاء والحرية التابعة من الانتماء النفسي والثقافي الأصيل، بما يضمن الحس بالمسؤولية اتجاه الوطن.
فالمواطنة هي التي تصنع حاضر الأمة ومستقبلها بما يضمن استقلال الوطن وسيادته، وتكريس مبدأ الديمقراطية القائم على إرادة الشعب، والانتخاب والتعددية السياسية والحزبية، وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة ، وحقوق الإنسان، والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أفراد الوطن الواحد بغض النظر عن الفوارق العرقية والانتماء السياسي والديني لهم، وسيادة القانون.
4- المشاركة المدنية والسياسية:
لا يمكن تحقيق دولة الحق والقانون من دون إشراك المواطن مشاركة فعالة وإيجابية وديمقراطية في بناء الدولة، وتطوير المجتمع، والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات. ونظرا للاهتمام الملحوظ الذي يحظى به الشباب في مختلف بلدان العالم من الحكومات والمنظمات المدنية، لما لهذه الفئة من مقدرة على العطاء، ودور فعال في عملية التنمية المستدامة. فحرصت الدولة كثيرا على قضية مشاركة الشباب مختلف مراكز القرار باعتبارهم قادة المستقبل، حيث يتمتعون بقدرات ومهارات لا تتوفر عند غيرهم. فهم طاقة يجب الاستفادة منها في استكمال أسس التنمية الشاملة في كافة الميادين.
والمشاركة المدنية والسياسية هي: "مجموعة النشاطات التي من خلالها يتمكن المواطنون في اتصال مباشر مع السلطة ، عن طريق المشاركة في النشاطات التي تمكن المواطن من المساهمة في اتخاذ القرار السياسي بكل شفافية، لأن المصدر الوحيد للسيادة في الدولة القانونية هو الشعب". فالمواطنة الايجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، بل بحرصه على ممارستها من خلال اختيار شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن، وحتى تكون المواطنة مبنية على وعي لا بد أن تتم بتربية مقصودة تشرف عليها الدولة. يتم من خلالها تعريف الطالب بمفاهيم المواطنة، من أجل تكونه تكوينا علميا للمشاركة في تحقيق أهداف المواطنة، والمشاركة الفعالة في الممارسة السياسة بالانتخاب، أو القدرة على اتخاذ تدبير الشأن العام من خلال النظام الانتخابي ناخبا ومنتخبا للمؤسسات المنتخبة التي تعبر عن دولة الحق والقانون، مما يؤذي إلى بناء نظام سياسي مدني تعددي متنوع في العرق والعقائد واللغة والايديولوجيا..
لقد صادقت الجزائر على مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان، والتي نذكر منها:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- اتفاقية حقوق الإنسان.
-
مقومات المواطنة: بما أن المواطنة تتناول المواطن بالدرجة الأولى باعتباره الهدف الأسمى من عملية الاصلاح وأن استقرار الوطن وتنميته لا يتحقق إلا من خلال إصلاح أول لبنة من لبنات تحقيق الوحدة الوطنية ألا وهو الفرد ومن هنا تأتي أهمية المواطنة في الحياة الإنسانية والمواطنة كمبدأ اجتماعي وقانوني وسياسي ساهم في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير إضافة إلى الارتقاء بالدولة إلى المساواة والعدل وإلى الديمقراطية والشفافية والإنصاف والشراكة الحقيقية وضمان الحقوق والواجبات للمواطنة مقومات تقوم عليها، منها الانتماء، والحقوق والواجبات والمشاركة.
إن شعور الإنسان بالانتماء إلى (الوطن) التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة مثل الحق في الأمن والسلامة والصحة والتعلم كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العامة والدفاع عن الوطن المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية الانتخاب والترشح).
ويمكن أن نوجز أهم المقومات فيما يلي:
1- حب الوطن والانتماء له.
2- تعزيز الثقافة الوطنية.
3 - احترام القيادة السياسية للبلاد.
4- تهذيب السلوك والأخلاق.
5- الإيمان بالوحدة الوطنية.
6- الاعتزاز بالمناسبات الوطنية.
7- التعاون مع أجهزة الدولة.
8- الدفاع عن الوطن. -
إن أوطان اليوم تضم أجناساً بشرية متعددة، ومكونات متعددة قومية ودينية وطائفية، إلا أن الذي يجمعهم جميعا، ويحتضنهم ويوفر لهم الحياة اللازمة هو نظام الوطن والمواطنة واختلافات المواطنين بكل مستوياتها وأشكالها، لا تلغي حقوق المواطنة وواجباتها. ولقد تمكنت المجتمعات المتقدمة بفضل هذا النظام (المواطنة) أن تتجاوز الكثير من انقساماتها وحروبها الداخلية، وبنت أمنها واستقرارها السياسي والاجتماعي على قاعدة هذا النظام الدستوري. من أهم قيم المواطنة المساواة، والحرية، والمشاركة، وتحمل المسؤولية، كما تتمثل في العديد من الحقوق مثل: حق التعليم، والعمل، والجنسية تبرز هذه القيمة في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق المناقشة بحرية تتمثل في: الحق في تنظيم حملات الضغط السلمي علي الحكومة، وممارسة الاحتجاج السلمي. تتضح هذه القيمة في ممارسة : واجب دفع الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية للوطن.
أ.حقوق المواطنة:
أوّلا: الحقوق المدنية والحقوق السّياسية
· حق كل مواطن في الحياة الكريمة.
· في الملكية الخاصة.
· في حرية التنقل.
· في حماية خصوصيته.
· في المساواة.
· في حرية الفكر.
· حق الانتخابات والترشح.
· الحق في تقلد الوظائف العامة.
· الحق في العضوية بالأحزاب.
· الحق في العمل.
· الحق في الحرية النقابية.
ثانيا:الحقوق الاجتماعية
· حد أدني من الرخاء الاجتماعي.
· الحق في الرعاية الصحية والعلاج.
· الحق في المسكن.
ثالثا: الحقوق الثقافية
· الحق في التعليم.
· الحق في ممارسة الثقافة والفنون.
ب.واجبات المواطن :
1- واجب دفع الضرائب للدولة.
2- واجب احترام القوانين.
3- واجب الدفاع عن الدولة.
4- واجب العمل علي تنمية الدولة.
5- واجب احترام الدستور.
6- المحافظة علي ممتلكات الدولة.
7- واجب أداء الخدمات الإلزامية كالخدمة العسكرية.
8- واجب الحفاظ علي البيئة.
9- واجب الالتزام بالواجبات الدينية والاجتماعية. -
يتجلى البعد السياسي للمواطنة في مدى إحساس الفرد بانتمائه إلى الوطن كجسم سياسي يتمثل في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والجمعيات وأفكار حول الشأن العام والمجال العمومي والأفكار التي تتبلور لدى الفرد حول هذا الجسم ومدى سعي الفرد للتأثير فيه عن طريق الولاء أو المعارضة للنظام أو الخوف منه والابتعاد عنه أو الثورة عليه. ويهتم البعد الثقافي بما يوفره الوطن من إحساس بالانتماء إلى جماعة تمثل الهوية وتتجسد هذه الهوية المشتركة فيما يجمع الفرد مع غيره من الممارسات اليومية من عادات وتتجسد كذلك في الرموز المشتركة لما يمثل الهوية الوطنية أو الهويات الجماعية المتعايشة في ظل الوطن الواحد . كما أنّ هناك أبعاد ثقافية وطنية، ولعل أهمها على الإطلاق الدفع بحجة الخصوصية الثقافية للهروب من تطبيق القواعد العالمية لحقوق الإنسان.
1- البعد السياسي للمواطنة:
المقصود بالدولة هنا ، السلطة السياسية الحاكمة، بكل مكوّناتها وأجهزتها المنبثقة عنها والعلاقة بين المواطن والدولة هي علاقة متبادلة، يحكمها مفهوم الحق والواجب، لأن نظرية (العقد الاجتماعي) التي يقول فيها كثير من علماء الاجتماع والسياسة، تقضي بأن المواطنين ارتضوا الخضوع للسلطة الحاكمة، مقابل قيام هذه السلطة بتأمين حقوق هؤلاء المواطنين، وبذلك تصبح مسألة تأمين هذه الحقوق واجبات على الدولة، ومن هنا أتى مفهوم الحق والواجب في العلاقة بين المواطن والدولة.
2- البعد الجغرافي للمواطنة:
الوطن إذا تعددت أصول مواطنيه العرقية وعقائدهم الدينية وانتماءاتهم الثقافية والسياسية، لا يمكن ضمان وحدته واستقراره إلا على أساس مبدأ المواطنة الذي يرتكز على منظومة قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية متكاملة. إن مبدأ المواطنة في منظومة الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد وبينهم مؤسسات الدولة، لا يمكن أن يقوم على إلغاء الصفات والانتماءات والمعتقدات وغيرها من خصوصيات بعض الفئات ، وإنّما يقوم على احترامها، وإتاحة فرص المشاركة في إغناء الوطن وتنمية رصيده الثقافي والحضاري. للمواطنة ثلاثة أبعاد جغرافية، واجتماعية وسياسية، تتحدد بعلاقة المواطن بوطنه، وعلاقة المواطن بالمواطنين، وعلاقة المواطن بالدولة. وسنستعرض كل علاقة من هذه العلاقات بشيء من التفصيل.
الوطن ليس قطعة من الأرض، أو مساحة جغرافية فحسب، بل هو مجموعة العواطف والأحاسيس والانفعالات والمشاعر تجاه هذه الأرض ، التي يعيشها المواطن وتمتد فيه في الماضي إلى بداية الكون، وفي المستقبل إلى آخر الزمن، وفي اللحظة الراهنة إلى قرارة النفس وذروة المطلق.
والوطن بهذا المفهوم هو امتزاج التاريخ بالجغرافية، واقتران كل منهما بالآخر، حيث تغدو كل حبة تراب من أرض الوطن حكاية تاريخ تحفظ وتروي أمجاد الأسلاف من الآباء والأجداد وما صنعوا من حضارة، وما تركوا من تراث. ومن هنا ينبغي أن تكون علاقة المواطن بالوطن علاقة ولاء وانتماء واعتزاز، تصل إلى حد التقديس، وهذا ما يسمى بالوطنية.
وتتطلب الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني والدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله، وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الفردية أو الذاتية أو النفعية.
ولا تقتصر الوطنية على ما سبق بل تتطلب كذلك القيام بالفعل الإيجابي، وهو العمل على تحقيق قوة الوطن ومنعته وازدهاره وتقدّمه، بحيث لا يعيش المواطن على الموروث الحضاري لوطنه، بل عليه أن يضيف جديداً إلى هذا الموروث ، ويعلي البناء الذي أرسى أسسه الآباء والأجداد ، لتبقى مسيرة الوطن مستمرة، وشعلته متقدة.
3- البعد الاجتماعي للمواطنة:
إن الوطن بالمفهوم الاجتماعي هو مجموع المواطنين الذين يعيشون على أرضه، أو الذين ينتمون إليه، وهنا ينبغي أن تقوم علاقة المواطن بالمواطن على أساس الانتماء للوطن دون النظر إلى عرقه أو دينه أو تنظيمه السياسي أو طبقته الاجتماعية .. ويرتب ذلك على المواطن مسألتين:
الأولى: أن يشعر ويؤمن أنه عضو في المجتمع الوطني، وأن انتماءه الأساسي والأول هو إلى هذا المجتمع، مقدّماً هذا الانتماء على أي انتماء آخر، عرقيّاً كان أم دينياً أم قبلياً أم سياسياً.. إلخ.
أولابد من الإشارة هنا إلى أننا لا نقصد أن يتخلّى المواطن عن الانتماءات المشار إليها آنفاً، ولكن المقصود هو تكون علاقة المواطن بالمواطنين الآخرين قائمة على هذه الانتماءات، لأن ذلك سيؤدي إلى تفتيت المجتمع، وزعزعة استقراره، وتسود حالة التعصب والعصبيّات المرفوضة بكل المعايير.
الثانية: احترام عقائد وأفكار المواطنين الآخرين، مادامت لا تتعارض مع مصلحة الوطن، ووحدة المجتمع، حتى وإن عقائده وأفكاره، فيغدو الاختلاف ائتلافاً، ويشكّل التنوع والتعدد لوحة متعددة الألوان، لكنّها منسجمة ومتناسقة.
-
الانتماء هو حاجة الإنسان إلى الارتباط بالآخرين، وتوحده معهم ليحظى بالقبول، وليسر بكونه فردا يستحوذ على مكانة متميزة في الوسط الاجتماعي، وتتمثل أوجه الانتماء في ارتباط الفرد بوطنه الذي يحيا فيه، وبمن يقيمون في هذا الوطن والذين يمثلون أفراد المجتمع، ثمّ انتماؤه إلى مجموعة من الأفكار والقيم والمعايير ، التي تميز هذا المجتمع عن غيره، أو ارتباط داخلي وخارجي للفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه، فالارتباط الداخلي يعني قوة العاطفة التي تربط الفرد بمجتمعه ارتباطا واضحا في مجالات الانتماء الوطنية (السياسية والاجتماعية والقومية والأسرية) والارتباط الخارجي يتمثل في كافة النواحي الشكلية المنعكسة من الارتباط الداخلي على سلوك الفرد وتصرفاته.
1- مفهوم الانتماء:
الانتماء إجرائيا هو الانتساب الحقيقي للدّين والوطن فكرا ، وتجسده الجوارح عملا، والرغبة في تقمص عضوية ما لمحبة الفرد لذلك لاعتزازه بالانضمام إلى هذا الشيء، ويكون الانتماء للدّين بالتزام بتعليماته، والثبات على نهجه. يشير مفهوم الانتماء إلى الانتساب لكيان ما يكون الفرد متوحداً معه مندمجاً فيه، باعتباره عضواً مقبولاً وله شرف الانتساب إليه، ويشعر بالأمان فيه، وقد يكون هذا الكيان جماعة طبقة ، وطن، وهذا يعني تداخل الولاء مع الانتماء والذي يعبر الفرد من خلاله عن مشاعره تجاه الكيان الذي ينتمي إليه.
ولقد ورد في الانتماء آراء شتى للعديد من الفلاسفة والعلماء وتنوعت أبعاده ما بين فلسفي ونفسي واجتماعي، ففي حين تناوله ماسلو (Maslo) من خلال الدافعية اعتبره إريك فروم (Fromm) حاجة ضرورية على الإنسان إشباعها ليقهر عزلته وغربته ووحدته، متفقاً في هذا مع وليون فستنجر (Leon Festinger) الذي اعتبره اتجاهاً وراء تماسك أفراد الجماعة من خلال عملية المقارنة الاجتماعية، وهناك من اعتبره ميلاً يحركه دافع قوي لدى الإنسان لإشباع حاجته الأساسية في الحياة.
وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول الانتماء ما بين كونه اتجاهاً وشعوراً وإحساساً أو كونه حاجة أساسية نفسية – لكون الحاجة هي شعور الكائن الحي بالافتقاد لشيء معين، سواء أكان المفتقد فسيولوجياً داخلياً، أو سيكولوجياً اجتماعياً كالحاجة إلى الانتماء والسيطرة والإنجاز - أو كونه دافعاً أو ميلاً، إلا أنها جميعاً تؤكد استحالة حياة الفرد بلا انتماء، ذاك الذي يبدأ . مع الإنسان منذ لحظة الميلاد صغيراً بهدف إشباع حاجته الضرورية، وينمو هذا الانتماء بنمو ونضج الفرد إلى أن انتماء للمجتمع الكبير الذي عليه أن يشبع حاجات أفراده. ولا يمكن أن يتحقق للإنسان الشعور بالمكانة والأمن والقوة والحب والصداقة إلا من خلال الجماعة ، فالسلوك الإنساني لا يكتسب معناه إلا في موقف اجتماعي، إضافة إلى أن الجماعة تقدم للفرد مواقف عديدة يستطيع من خلالها أن يظهر فيها مهاراته وقدراته، علاوة على أن شعور الفرد بالرضا الذي يستمده من انتمائه للجماعة يتوقف على الفرص التي تتاح له كي يلعب دوره بوصفه عضواً من أعضائها.
2- أبعاد الانتماء:
المواطنة والانتماء للوطن من صفات المواطن الصالح التي تبذل الأمم والشعوب الحية جهودها وتسخر طاقاتها لإعداده؛ لأنّ هذه القيم السامية العليا ضرورة وجود للأوطان ومنعتها ، وهي تتجلى في أوقات الشدة عندما تحيط الأخطار بالأمم والشعوب سواء كانت الأخطار خارجية أو داخلية. والثانية أكثر إيذاءً وتدميرا للأمم والأوطان. يعد مفهوم الانتماء مفهوماً مركباً يتضمن العديد من الأبعاد والتي أهمها:
1- الهوية (Identity):
يسعى الانتماء إلى توطيد الهوية، وهي في المقابل دليل على وجوده، ومن ثم تبرز سلوكيات الأفراد كمؤشرات للتعبير عن الهوية وبالتالي الانتماء.
2 - الجماعية (Collectivism):
إن الروابط الانتمائية تؤكد على الميل نحو الجماعية، ويعبر عنها بتوحد الأفراد مع الهدف العام للجماعة التي ينتمون إليها، وتؤكد الجماعة على كل من التعاون والتكافل والتماسك ، والرغبة الوجدانية في المشاعر الدافئة للتوحد. وتعزز الجماعية كل من الميل إلى المحبة والتفاعل والاجتماعية وجميعها تسهم في تقوية الانتماء من خلال الاستمتاع بالتفاعل الحميم للتأكيد على التفاعل المتبادل.
3 - الولاء (Loyalty):
الولاء جوهر الالتزام، يدعم الهوية الذاتية، ويقوي الجماعية، ويركز على المسايرة، ويدعو إلى تأييد الفرد لجماعته ويشير إلى مدى الانتماء إليها، ومع أنه الأساس القوي الذي يدعم الهوية، إلا أنه في الوقت ذاته يعتبر الجماعة مسؤولة عن الاهتمام بكل حاجات أعضائها من الالتزامات المتبادلة للولاء، بهدف الحماية الكلية.
4 - الالتزام (Obligation)
حيث التمسك بالنظم والمعايير الاجتماعية، وهنا تؤكد الجماعية على الانسجام والتناغم والإجماع، ولذا فإنها تولد ضغوطاً فاعلة نحو الالتزام بمعايير الجماعة لإمكانية القبول والإذعان كآلية لتحقيق الإجماع وتجنب النزاع.
5- التواد :
ويعني الحاجة إلى الانضمام أو العشرة (Affiliation) ، وهو - التواد - من أهم الدوافع الإنسانية الأساسية في تكوين العلاقات والروابط والصداقات. ويشير إلى مدى التعاطف الوجداني بين أفراد الجماعة والميل إلى المحبة والعطاء والإيثار والتراحم بهدف التوحد مع الجماعة، وينمي لدى الفرد تقديره لذاته وإدراكه لمكانته، وكذلك مكانة جماعته بين الجماعات الأخرى، ويدفعه إلى العمل للحفاظ على الجماعة وحمايتها لاستمرار بقائها وتطورها، كما يشعره بفخر الانتساب إليها.
6 - الديمقراطية:
هي أساليب التفكير والقيادة، وتشير إلى الممارسات والأقوال التي يرددها الفرد ليعبر عن إيمانه بثلاثة عناصر :
أ- تقدير قدرات الفرد وإمكاناته مع مراعاة الفروق الفردية، وتكافؤ الفرص، والحرية الشخصية في التعبير عن الرأي في إطار النظام العام، وتنمية قدرات كل فرد بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
ب - شعور الفرد بالحاجة إلى التفاهم والتعاون مع الغير، ورغبته بأن تتاح له الفرصة للنقد مع امتلاكه لمهارة تقبل نقد الآخرين بصدر رحب، وقناعته بأن يكون الانتخاب وسيلة اختيار القيادات، مع الالتزام باحترام النظم والقوانين، مع الغير في وضع الأهداف والمخططات التنفيذية وتقسيم العمل وتوزيعه ومتابعته وهي بذلك تمنع الديكتاتورية، والتعاون وترحب بالمعارض، مما يحقق سلامة ورفاهية المجتمع.
ج - اتباع الأسلوب العلمي في التفكير.
• الولاء متضمن في الانتماء والانتماء أساس الوطنية.
• للانتماء أبعاد حددها البعض بثمانية هي: (الأمان - التوحد - التقدير الاجتماعي – الرضا عن الجماعة – تحقيق الذات – المشاركة - القيادة - الإطار المرجعي). وبينها جميعاً قدر من الانسجام ويمكن من خلالها دراسة دوافع الانتماء.
الانتماء باعتباره قيمة جوهرية متعدد المستويات بتعدد أبعاد القيمة (وعي، وجدان، سلوك)، فهو (مادي) لحظة عضوية الفرد في الجماعة، و(معلن) لحظة تعبير الفرد عنه لفظياً مؤكداً مشاعره تجاه جماعة الانتماء، و(سلوكي) عندما يتخذ الفرد مواقف سلوكية حيال جماعة الانتماء، وقد تكون هذه المواقف إيجابية تعبر عن قوة الانتماء، أو سلبية تعبر عن ضعف الانتماء.
وانطلاقاً من أهمية هذا المفهوم في حياة البشر ، والذي أعطاه العلماء والباحثون جل اهتمامهم، كان من الضروري إعداد وسائل تقيس السلوك والمشاعر المرتبطة بمظاهر الانتماء قوة أو ضعفاً ، مستندة في ذلك إلى نظريات علمية ، ومن ذلك على سبيل المثال محاولة (ريتشارد . م . لي ) و (ستيفن . ب . روبنز) التي استندت إلى نظرية علم نفس الذات للعالم (هل) 1984م- في تطوير مقياس الانتماء من خلال مقياس الترابط الاجتماعي ومقياس التأمين الاجتماعي وجاءت أبعاد الأول (الترابط) - التواد - العشرة ، وأبعاد الثاني (التواد - العشرة، بما تتضمن هذه الأبعاد من قيم إيجابية. وكذلك حاولت إحدى الدراسات العربية تصميم مقياس للانتماء واستندت في تصميمه إلى سبعة عشر عنصراً – تمحورت في أربعة محاور المشاركة - المسؤولية - تقبل أهداف ومعايير المجتمع ، الفخر والاعتزاز بالمجتمع) - وطبقته ميدانيا على سكان أحد الأحياء في القاهرة.
3- أنواع الانتماء:
مما سبق يستخلص الباحث تعريفاً نظرياً للانتماء بالوطن مؤداه:
هو اتجاه إيجابي مدعم بالحب يستشعره الفرد تجاه وطنه، مؤكداً وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطن باعتباره عضواً فيه ويشعر نحوه بالفخر والولاء، ويعتز بهويته وتوحده معه، ويكون منشغلاً ومهموماً بقضاياه، وعلى وعي وإدراك بمشكلاته، وملتزماً بالمعايير والقوانين والقيم الموجبة التي تعلي من شأنه وتنهض به محافظاً على مصالحه وثرواته، مراعياً الصالح العام، ومشجعاً ومسهماً في الأعمال الجماعية ومتفاعلاً مع الأغلبية، ولا يتخلى عنه حتى وإن اشتدت به الأزمات.
وحسب هذا المفهوم تتعدد محاولات تصنيف الانتماء التي أفرزتها كتابات الباحثين والمتخصصين على النحو التالي:
1) تصنيف حسب الموضوع الانتماء للإسلام - الأسرة - (الوطن والمستويين الآخرين متفرعين عن الأول.
(2) تصنيف نوعي (مادي) يعتبر الفرد عضو في الجماعة، ظاهري يعبر عن مشاعره لفظياً، إيثاري يعبر عن الموقف الفعلي).
(3) تصنيف حسب طبيعته إما) قبل عضوية الفرد في الجماعة - أو بعد عضويته فيها).
4) تصنيف في ضوء السوية (سوي يتفق مع معايير الجماعة - وغير سوي يتخذ مواقف عدوانية منها). (5) تصنيف كيفي (شكلي بحكم العضوية تحت تأثير الجنسية واللغة وموضوعي حقيقي يدرك الفرد فيه حقائق الواقع ويكون فيه مشاركاً ، زائف حيث الرؤية غير الحقيقية للواقع).
ويمكن أن نضيف التصنيفات التالية:
1) انتماء حقيقي:
يكون فيه لدى الفرد وعي حقيقي لأبعاد الموقف، والظروف المحيطة بوطنه داخلياً وخارجياً، ويكون مدركاً لمشكلات وقضايا وطنه، وقادراً على معرفة أسبابها الحقيقية وطبيعة هذه المشكلات، وموقفه منها ، والاكتراث بآرائها ونتائجها، ويكون المنتمي هنا مع الأغلبية ويعمل لصالحها، ويؤمن بأن مصلحة الأغلبية والعمل من أجل الصالح العام وسلامة المجتمع ونموه وتطوره، هو الهدف الذي يجب أن يسمو على الفردية والأنانية.
(2) انتماء زائف:
هو ذلك الانتماء المبني على وعي زائف، بفعل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي قد تشوه حقيقة الواقع في عقول المواطنين، وبالتالي قد تصبح رؤيتهم للأمور والمواقف غير حقيقية وغير معبرة عن الواقع الفعلي، ومن ثم يصبح الوعي والإدراك لهذا الواقع وعياً مشوهاً وبالتالي ينبثق عنه انتماء زائف ضعيف.
(3) انتماء لفئة بعينها :
وهنا يعمل الفرد على مصالح الفئة التي ينتمي إليها دون سواها من الفئات داخل المجتمع الواحد، وبالرغم من أن وعيه بها وعي حقيقي وانتماءه لها انتماء حقيقي، إلا أنه قياساً على انتمائه للمجتمع ككل فهو وعي غير حقيقي وانتماء غير حقيقي، لأنه يعمل وينتمي لجزء من الكل فقط، فلا يعي ولا يدرك ولا يعمل إلا لصالح هذا الجزء، ويترتب على ذلك آثار وخيمة من تفتيت لبنية المجتمع وربما كان سببا لوجود الصراع بين فئاته، ويزداد حدةً كلما ازدادت الهوة بين هذه الفئات والمحصلة النهائية تدهور المجتمع وتفككه، إذ ستعمل كل فئة في الغالب الأعم لصالحها هي فقط ، ولو على حساب غيرها من الفئات.
إن التأصيل النظري لمفهوم المواطنة والانتماء يبين أن المواطنة هي الدائرة الأوسع التي تستوعب مختلف الانتماءات في المجتمع كما أنها تضع من المعايير التي تلزم الأفراد بواجبات والتزامات معينة تحقق الاندماج والتشاركية في تحقيق مصالح الأفراد والوطن من ناحية، ومن ناحية أخرى تسم المواطنة وسبل تكريسها بالمسؤولية العامة والأهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال أطر رسمية وبنية وعي مخطط لها ويتم الإشراف عليها وتقييمها من قبل أجهزة الدولة والمحاسبة على الإخلال بمبادئها من خلال مؤسسات الدولة كل حسب تخصصها وطبيعة عملها، في حين أن الانتماء يلعب الدور الأساس في تشكيله العديد من القوى الأيديولوجية والثقافية والاجتماعية التي قد لا يمكن السيطرة عليها، إذ يتم ذلك في الأسر والقبائل والعشائر ، ومن خلال الدوائر الفكرية والدينية الأخرى التي ربما تفضي في بعض الأحيان إلى ممارسات مناوئة لمبدأ المواطنة ذاته.
ومن ثم تعد المواطنة البوتقة التي تضمن انصهار جميع الانتماءات لصالح الوطن ضمن أطر نظامية ومن خلال الالتقاء على أرضية المصلحة الوطنية العامة، ويتم ذلك بناء على معطيات الفكر العالمي اليوم والتي يروج لها في ساحاتنا الفكرية ومنتدياتنا الثقافية من خلال الأبعاد التالية:
1) الهوية.
2) الانتماء.
(3) التعددية وقبول الآخر.
(4) الحرية والمشاركة السياسية.
-
تعتبر التربية الوطنية من أهم المواد في الدراسات الاجتماعية التي تسهم بصورة مباشرة في غرس قيم الانتماء والولاء والقيم الأخرى في نفوس الناشئة، كما تنبع أهمية هذه المادة من أنها تكسب المجتمع المهارات الاجتماعية التي تساعد في النهوض بالحضارات الإنسانية؛ فالحكامة تفرض على الدول تبني مبدأ الديمقراطية مثلا في التعليم بمجانيته والزامية، غير أنّ هذا النوع من التنمويات الكمية في مجال التربية التي تحققها في سياق متميز بالانفجار الديمغرافي وفي نفس الوقت، باختيار مشروع تربوي ذي صبغة ديمقراطية، قد واجهت نقائص واختلالات أثرت على نوعية التعليم الممنوح وكذا مردود المنظومات الإصلاحية في شتى مجالاتها والتحولات الناتجة على المستوى الوطني كظهور التعددات
السياسية.
1- الأسرة والمدرسة والمجتمع
تعتبر المواطنة محضنا للهوية وللخصوصيات الحضارية والموروثات الثقافية، لذا يجب وضعها في المحيط الإقليمي والدولي عن طريق الانفتاح على كلّ الأوطان والاطلاع على تجارب الآخرين فالانغلاق يؤدي إلى الجمود والاضمحلال والاتزان يؤدي إلى التطور والازدهار وغاية المواطن أن يتمكن الإنسان من آليات التنمية الذاتية والانفتاح على المحيط فالمواطنة التي نريدها لا ينبغي أن نختزل في مجرد التوفر التشكيلي في بطاقات الهوية حتى يزرع في النفوس ربط الأبناء بحب أوطانهم وتأصيله في النفوس في أوقات مبكرة.
أ - الأسرة:
تمثل الأسرة المدرسة الأولي لصياغة شخصية المواطن، ويقع علي الأسرة المسؤولية الكبرى في تقويم السلوك فالأسرة عليها دور كبير في ترسيخ مفهوم المواطنة لدي الأبناء وتوجيههم إلي احترام الأنظمة والقوانين، لابد أن يكون الوالدين قدوة حسنة يقتدي.
ويمكن للوالدين اتخاذ عدة وسائل لتعميق حب الوطن والمواطنة الصالحة في نفوس أبنائهم: الحديث مع الأبناء حول مقومات المواطنة.
• تزويد مكتبة المنزل بكتب عن المواطنة.
• أخذ الأبناء في جولات للمواقع التاريخية والتراثية والمتاحف.
• تعريف الأبناء بالرموز الدينية والوطنية.
ب - المدرسة:
• بيان جملة الحقوق والواجبات التي أقرتها كل الأديان السماوية.
• غرس احترام الآخر وقبوله في نفوس الطلاب.
• تفعيل المواقف التعليمية لتعميق قيم المواطنة.
• إعطاء أمثلة واقعية للطلاب تمارس أسلوب ديمقراطي في قيادة المدرسة.
• التأكد علي دور المعلم في تنمية قيم المواطنة.
ج - المجتمع:
يظهر دور مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال المواطنة وفي مجال حقوق الإنسان مطالبة بالاهتمام بالتربية على المواطنة.
2- مفهوم الوعي السياسي
أ - الإدراك العقلي للتجارب والمتغيرات المحيطة:
يصبح للفرد القدرة على تكوين موقف محدد تجاه الواقع الذي يعيشه والوعي هو عكس الغفلة والتي تعني "السلبية مع الواقع بعيداً عن استخدام العقل والمنطق في تبني المواقف".
التعامل معنى كلمة السياسة لغويا :
لغوياً "سياسة" مشتقة من سَاسَ ويَسُوسَ بمعني تسيير الأمور ورعاية الشؤون. بمفهوم السياسة:
فالسياسة هي: الطريقة التي يتم تنظيم حياة الأفراد داخل مجتمع ما اعتمادا على مؤسسات مختلفة يتشكل منها جهاز الدولة.
ج-الوعي السياسي:
قدرة الإنسان على فهم الأوضاع والقضايا والمشاكل السياسية في البلد الذي يعيش فيه، أو على مستوى العالم. وبناء على هذا التعريف فإن الوعي السياسي يشتمل على أربعة مكونات رئيسية هي:
• الرؤية الشاملة.
• الإدراك الناقد.
• الحساس بالمسئولية.
• الرغبة في التغيير.
د - عناصر الوعي السياسي:
معرفة بالواقع السياسي العام لمجتمعه والعالم من حوله، والمقصود معرفة حقيقية لظروف وطبيعة ذلك الواقع (معرفة "ما هو كائن" إلمام الشخص بـ "البدائل" السياسية الممكنة والمتاحة، كأطر ،مجتمعية، وكحلول لما يعتري المجتمع من مشكلات سياسية، ينجم عنها مشكلات مختلفة معرفة منطقية لـ "ما" يجب أن يكون فهم معقول للمفاهيم والمصطلحات والتيارات السياسية الرئيسية السائدة والممكنة.
هـ - أهمية الوعي السياسي
الوعي السياسي يعد مطلباً لتحقيق الديمقراطية والعدالة والمساواة، ويعمق معاني الانتماء والولاء للوطن وتنشيط الوعي السياسي له أهمية في تنوير المواطن بحقوقه لقد ركز الفكر السياسي الإنساني على بناء الديمقراطية وأكد الفلاسفة
عليه ونادى بـ العقد الاجتماعي) "هوبز ولوك وروسو".
و وسائل تكوين الوعي السياسي
1- التوجيه السياسي المباشر.
2- الخبرة السياسية المكتسبة من المشاركة.
3- التعلم الذاتي ومتابعة الأحداث.
4- الخبرات في المجال العام إلي المجال السياسي.
العوامل المؤثرة في الوعي السياسي:
إن لنوع الثقافة السياسية السائدة أحداث كبرى يتحكم فيها مستوى التعليم، وهي ثلاثة أنواع:
أ - ثقافة المشاركة: وتؤدي إلي تكوين اتجاهات إيجابية.
ب-ثقافة التبعية : تؤدي إلي تكوين اتجاهات سلبية (وعي سلبي أو تابع).
ج-محدودية الثقافة: تؤدي إلي تكوين علاقة ضعيفة (وعي محدود) وجود أحداث كبرى مثل التطورات والتغيرات الثقافية والمعارك العسكرية مما يؤدي إلي حدوث تغيير في الوعي السياسي حيث يغلب وجود وعي سياسي لدي المتعلمين عن مقارنتهم بغير المتعلمين مع وجود استثناءات وهي:
أ. وجود زعيم سياسي بارز.
ب. القدرات والمهارات الخاصة للأفراد.
ي - كيفية قياس الوعي السياسي:
توجد طرقاً عديدة لقياس الوعي السياسي من أهمها:
الاستبيان لمواقف المقابلات وطريقة المجموعات النقاشية، بحيث يطبق علي مجموعة من الأفراد مشتملاً علي أسئلة توضيح حجم المعارف السياسية. قياس سلوك الأفراد في بعض المواقف ومنها المشاركة في الانتخابات (بكل أنواعها) وإبداء الرأي. من خلالها يتم قياس الحرص علي متابعة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها (صحافة - فضائيات - إنترنت).
3- وسائل تنمية الوعي السياسي:
نحتاج في حياتنا العلمية والعملية إلى معرفة الكثير عن تعقيدات الحياة السياسية ، وتشابكاتها ، وحركياتها، وتبدلاتها. ذلك أنّنا نحتاج إلى معرفة الطريقة التي يتصرف بها أولئك الأفراد الذين يحتلون مواقع التأثير ، ولماذا يتصرفون كذلك؟، ونحتاج إلى معرفة العناصر التي تجعل جماعة، أو تنظيما ، أو حزبا ما يبرز ، وينمو، ويزدهر، ثمّ ينهار ويضعف. ونحتاج إلى معرفة لماذا تتميز أنظمة بقدر كبير من الاستقرار وتتميز أخرى بقلته أو بكثرة الاضطرابات؟ من المقاربات الضرورية الإدراك أن نكون على معرفة بخلفية - على المساهمين [الشعوب] أن تقبل المشاركة في الأعمال السياسية وتسعى في ذلك في أي مرحلة من المراحل ولماذا يحجم في مراحل وظروف أخرى؟ إنّ المسائلات التي تخطر في الذهن تحتاج إلى وسائط تسهم في إزالة تعقيداتها أو على الأقل تزرع قليلا من الضوء في نفقها المظلم، هذه الوسائط هي مجموعة المناهج والافتراضات والمفاهيم والأدوات التي تتضافر فيما بينها وتقدم للباحث أو الطالب أو المحلل السياسي دليلا إرشاديا يتبعه لإدراك الظواهر السياسية المختلفة، والتعامل معها ، وسبر أغوارها. إنّها مجموعة من المسالك تتيحها هذه المناهج والاقترابات للوصول إلى الحقائق أو إزالة اللبس والغموض عن الكثير من العمليات السياسية وتفاعلاتها إنّ لغياب الوعي السياسي آثارا سلبية، منها:
1- فقدان الرؤية الواضحة لنضوج المجتمع سياسياً وثقافياً، ويجعل قيم الحياة تنهار.
2- عدم التعرف علي مواطن القوة والضعف.
3- غياب الوعي السياسي يضيع الفرص علي الشعب للحاق في صفوف الدول المتقدمة ديمقراطياً
ولذا ينبغي العمل على تنميته، وحتى نحقق النجاح في مهمة تنمية الوعي السياسي لا بد من امتلاك التالي: • القدرة على الوصول إلي الفئة المستهدفة (الناس) لإيصال الرسالة المناسبة والهادفة لبناء وعي جاد وصحيح وهذا يتطلب امتلاك الوسائل (الإعلام بأشكاله).
• القدرة علي تقديم الإجابات المقنعة لكل ما يتعرض له الناس.
• عملية صناعة الوعي هي عملية تفاعلية دقيقة، ويحتاجها الناس بمختلف مستوياتهم الثقافية والعملية والاجتماعية، وهي عملية متجددة.
ومن وسائل تنمية الوعي السياسي:
1- التدرج في توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
2 - تنظيم علاقة المواطن بالدولة من خلال قوانين عادلة.
3- تعميق مبدأ الحوار في حل الخلافات السياسية.
4- إشاعة مفهوم الأغلبية والأقلية بشكله السليم مفهوم سياسي بحت).
5- إشاعة الثقافة والذوق العام وإبراز مفهوم الجمال.
6- إشاعة مبدأ العدالة الاقتصادية (حل مشاكل البطالة والفقر).
7 - اعتماد الحوار كوسيلة لتكوين الوعي السياسي بشكل عام.
8- تكليف الأفراد بإعداد أبحاث في موضوعات سياسية مختلفة.
9 - المشاركة في ورشة عمل لإعداد أوراق حول موضوعات سياسية مختارة تسهم في تبادل المعلومات ورفع
مستوي التفكير وتوسيع الرؤية.
-
المحاضرة الحادية عشرة : المواطنة والمشاركة السياسية والممارسات الانتخابية
تعدّ المشاركة -عموما- من مظاهر الحكم الراشد؛ على اعتبار أن معناها يتمثل في إعطاء حق المساهمة في صنع القرار واتخاذه للجميع دون تمييز، وكونها ترتكز على حرية التعبير وعلى توفر قدرات للمشاركة البناءة خاصة فيما يخص المشاركة السياسية التي حظيت باهتمام بكبير من طرف المفكرين في مجالات العلوم الاجتماعية والسياسية لما لها من ارتباط وثيق بمفاهيم جوهرية كالديمقراطية، والحرية، والانتخابات (المشاركة في صنع القرار )....
1.مفهوم المشاركة السياسية:
هي العملية التي يستطيع من خلالها المواطن ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد عرفها صموئيل هنتنغتون على أنها النشااط "الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير بعملية صنع القرار السياسي سواء كان هذا النشاط فرديا أم جماعيا، منظما أم عفويا، متواصلا أم متقطعا، سلميا أم عنيفا، شرعيا أم غير شرعي، فعال أم غير فعال"
وعند جلال عبد الله معوض " المشاركة السياسية في أوسع معانيها يؤدي المواطن دورا معينا في عملية صنع القرار السياسي وفي أضيقها أن يراقب تلك القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من جانب الحكام"
(المواطنة والمشاركة السياسية من خلال رؤية سوسيوتربوية عاشور مكاوي/ بوجمعة عمارة)
وهي حسب نورمان ناي ( Norman nie)، و سيدني فيربا (Sidney verba) " الأنشطة المشروعة التي يقوم بها المواطنون العاديون بعرض أشخاص للحكم، وما يتخذونه من قرارات" (مبدأ المواطنة والمشاركة السياسية في الجزائر نسيم رشاشي).
وفي تعريف آخر هي "الأنشطة التي يقوم بها أفراد المجتمع بهدف التأثير في العملية السياسية، ومن مظاهر تلك المشاركة؛ التصويت، وحضور الندوات والمؤتمرات، ومطالعة الصحف وبيانات الأحزاب وبرامجها، والاتصال بالجبهات الرسمية، والانخراط في المؤسسات الوسيطة مثل الأحزاب والنقابات، والترشح للمناصب العامة، وتقلد المناصب السياسية" (مطبوعة أمينة تجاني).
· صور المشاركة السياسية: تتخذ المشاركة السياسية عدة صور وأشكال منها: المتابعة السياسية للقضايا والأحداث، العضوية في الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، جماعات المصالح، الاعلام، الانتخاب (المشاركة في التصويت والترشيح)، الاستفتاء، المظاهرات.... وغيرها من جملة النشاطات التي تمكن المواطن من ممارسة السلطة السياسية. (مطبوعة بودرع بلقاسم/ علي أحمد عبد الله المشاركة السياسية: أشكالها.. مقوماتها.. آثارها)
: 2.علاقة الموطنة بالمشاركة السياسية
تقوم المواطنة على الحقوق والواجبات وفق مبدأ وحدة الانتماء للوطن، والمشاركة القائمة على العدل والمساواة في إطار سيادة القانون.
فإذا كانت المواطنة هي التمتع بالحقوق والواجبات فإن المشاركة السياسية هي الممارسة الفعلية لهذه الحقوق والتمتع بها من جانب، والالتزام والواجبات من جانب آخر.
: 3. الممارسة الانتخابية
الانتخاب "هو أسلوب لإسناد السلطة يقوم على اختيار يجري بوساطة التصويت او الاقتراع , ويعد الانتخاب الطريقة الأساسية لإسناد السلطة في الديمقراطية التمثيلية بل أصبح الوسيلة الوحيدة لمنح الشرعية للسلطة فالانتخاب أضحى بمثابة عقيدة الديمقراطية"
وفي تعريف آخر هو" الوسيلة التي يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم على مؤسسات دولتهم، ويختارون بكل حرية من يمثلهم ويعبر عن إرادتهم" وهو أيضا في أبسط تعريفاته " الاختيار الحر لفرد أو مجموعة من الأفراد للقيام بأعباء تسييرالدولة و ؤسساتها و بالتالي تحمل المسؤولية في اختار القائد وينقسم الانتخاب إلى قسمين :
انتخاب سياسي : يكون باختيار الرئيس أي السلطة التنفيذية أو البرلمان أي السلطة التشريعية/ انتخاب إداري :و هو الذي يخص البلديات و الدوائر."
4.العلاقة بين الممارسة الانتخابية والمواطنة والمشاركة السياسية:
تعد المشاركة في العملية الانتخابية من أبرز مظاهر المشاركة السياسية وتجسد صورة الديمقراطية الحقيقية التي لا تعني شيئا دون ربطها بفكرة المواطنة (مقال نسيم رشاشي).
كما تمثل الانتخابات مقياسا جليا لمعرفة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية لما تتضمنه من مشاركة الأفراد في الترشح والتصويت، وإتاحة كل السبل الممكنة لضمان أقصى حد من المشاركة، لأن الشخص المنتخب يعبر عن سلطة الشعب وإرادته العامة.
-
الديمقراطية والتنوع الثقافي والعرقي والديني: المحاضرة الثانية عشرة
تعتبر فكرة الديمقراطية من أكثر المسائل التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واختلافاً كبيرين، وهذا لأننا نجد أن الديمقراطية شعار يرفع على نطاق واسع مع اختلاف وجهات النظر، مما أدى إلى جعل هذه الفكرة يكتنفها الغموض، ويشتد حولها الخلاف والجدل. ولفك اللبس الذي يحيط بهذه الفكرة وتوضيح معناها، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تطبيق فعلي وحقيقي للديمقراطية، ما لم يتم تكريس مجموع المبادئ والمقومات والخصائص التي يتميز بها هذا المفهوم. وعليه يمكن القول أن هناك مجموعة من المبادئ والأسس التي ما لم يتم تكريسها تبقى الديمقراطية مجرد معاني جوفاء، وشعارات دون تطبيق حقيقي.
مفهوم الديمقراطية:
مثلما كانت الفلسفة اختراعاً يونانياً، فكذلك كانت الديمقراطية ابتكاراً يونانياً، فقد أخذت مكانها في اللغة الإغريقية وانتقلت منها مثل الفلسفة إلى اللغات كافة بعد ذلك، وكانت مدينة أثينا محل ميلاد الديمقراطية، فقد لعبت دوراً فعالاً في إنماء ونضج الديمقراطية، إلى جانب الفلسفة، ومن أبرز مظاهر الارتباط بموطن الاختراع، أن الفلسفة اليونانية بلغت أوج ازدهارها في ظل سيادة الديمقراطية في أثينا.
فلفظة الديمقراطية تختلف من لغة إلى أخرى، إلا أنها في الأساس تعود إلى اللغة اليونانية القديمة وهي مكونة من مقطعين "Demos" وتعني " الشعب"، وكلمة "Kratos" أي " حكم " أو "سلطة"، وبذلك تصبح الكلمة: "Demoskratos" أي " حكم الشعب".
وعليه يمكن القول أن لفظة " ديمقراطية" أصلها كلمة يونانية مركبة في لفظين، ونلاحظ أن هذه اللفظة قد تمت استعارتها واستعمالها في باقي اللغات الأخرى ومنها العربية. أما إذا بحثنا في التعريفات التي جاء بها الفقهاء للديمقراطية فلا مجال لتعدادها أو حصرها، ولكننا حاولنا تصنيفها إلى مجموعات تتفق أو تدور حول فكرة معينة، ونتولى كلا منها بالتحليل والمناقشة والنقد، بغية الوصول إلى تعريف جامع مانع لهذه الفكرة.
بحيث نجد أن هناك التعريف الكلاسيكي للديمقراطية أنها " حكم الشعب"، أو حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، فالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية منبثقة من الشعب، وتحكم أيضاً باسم الشعب، والشعب باختياره يقوم بتنصيب حكامه.
وبعبارة أخرى أكثر اختصاراً يعرفها البعض أنها حكومة الشعب بواسطة الشعب، وهو المعنى نفسه الذي قدمه أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن الـــــ 18، وهو الرئيس إبراهام لنكولن بقوله: "الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب".
الملاحظ أن التعاريف السابقة تركز على اعتبار الديمقراطية مصدرها الشعب كونها تمارس من طرفه في مواجهة الشعب من أجل تحقيق أهداف تعود للشعب ذاته، وتجدر الإشارة إلى أن المقصود هنا بحكم الشعب هو الشعب بالمفهوم السياسي، أي مجموع الأفراد التي تتوافر فيهم شروط الناخب، أي مجموع الناخبين في الدولة، فهذا الأخير هو الذي يمارس الحكم من أجل تحقيق أهداف تعود على الشعب بالمفهومين السياسي والاجتماعي.
لكن هذه التعاريف الكلاسيكية واجهت جملة من الانتقادات التي يمكن إيرادها فيما يلي
- النقد الذي يوجه لهذا التعريف أن هذا الأخير يجعل استصدار كافة القوانين والقرارات الخاصة بإدارة شؤون الدولة بإجماع آراء المواطنين، وهذا الكلام إذا كان يبدو مقبولاً من الناحية النظرية إلا أنه عملياً غير قابل للتطبيق، وهذا لأن القوانين والقرارات تحتاج إلى كفاءات وخبرات معينة، قد لا تتوافر في مختلف فئات الشعب هذا من جهة، ومن جهة ثانية هذا الأمر صعب التطبيق من الناحية العملية لصعوبة الحصول على إجماع كافة المواطنين على كل ما يصدر في الدولة في قوانين وقرارات، كما أن هذه الطريقة ستؤدي إلى تعقيد وطول إجراءات إصدار أي قانون أو قرار في الدولة.
بالتالي فالديمقراطية لم تبلغ غايتها المثالية بعد وهي " حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب" بل هي لم تحقق بعد حكم الشعب، بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما هي كما دعاها روبرت دال نظام حكم الكثرة، لذلك فإن الممارسة الديمقراطية حالياً ليست سوى نفي حكم الفرد المطلق، وحكم القلة، وتجاوزهما إلى تحقيق حكم الكثرة، الساعي للوصول إلى حكم الشعب. وعليه فأن تعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب بواسطة الشعب وللشعب لا يطابق الحقيقة، ومن ثم فقد استبدل روسو قاعدة الإجماع بقاعدة الأغلبية، وقاعدة الإجماع وإن كان تطبيقها ضماناً تاماً لاحترام الحريات الفردية إلا أنها مستحيلة من الناحية العملية، ولذلك فإن قاعدة الأغلبية من الأمور المقبولة عقلا وعملا.
-
المحاضرة الثّالثة عشرة: المواطنة والمواطن وقيم المواطنة
يعد مصطلح المواطنة مفهوما جديدا، يدور في فلك معنى اشتراك الفرد مع آخرين من بني جنسه في حيز واحد يطلق عليه اسم " الوطن" ، يجمع الجميعَ شعورٌ موحّدٌ وعاطفة واحدة تحت سقف وطن واحد ، إلا أن هذا المفهوم قد طرأ عليه تغيير بعد تطور الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فصار يرمز إلى العلاقات بين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين المواطنين.
المواطنة والجنسية:
الجنسية هي الركن القانوني الظاهر للمواطنة ، وتمثل نقطة البداية الحتمية للحياة القانونية للفرد ، والتي لا كيان له بدونها.
ولما كانت كل تعريفات " الجنسية " تصبّ في العلاقة السياسية والقانونية بين الفرد والدولة، فإن لذلك آثارا تترتب عليها، تمنح بدورها صفة المواطنة وتفرض على المواطن الولاء للدولة، وبالتالي تكون حمايتها له واجبة ، وتمكينُه من المزايا حقا له تفرضها هذه الرابطة.
المواطنة والانتماء:
يعد الانتماء الركن المعنوي للمواطنة. والمقصود بالانتماء ـ هنا ـ الانتماء الوطني لا العقائدي أو العنصري فحسب . والعلاقة بينهما ( المواطنة والانتماء) طردية ؛ أي كلما زادت درجة الانتماء، زادت درجة المواطنة ، والعكس صحيح.
المواطنة والوحدة الوطنية:
يشكل مفهوم الوحدة الوطنية الإطار الفكري والنظري للمواطنة ، ومن ثم فالوطنية عملية فكرية ، بينما المواطنة ممارسة عملية على أرض الواقع لإبراز مظاهر الوطنية.
المواطنة والمشاركة السياسية:
والمقصود بالمشاركة السياسية إنها عملية تشمل جميع صور إشراك أو إسهامات المواطنين في توجيه عمل أجهزة الحكومة ، أو القيام بمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبها المجتمع تحت طائلة الطابع الاستشاري أو التنفيذي أو الرقابي، مباشرة أو غير مباشرة ، سياسية أو اقتصادية ، أو غيرهما.
وبناءً على ذلك تعد المشاركة السياسية من أهم أبعاد المواطنة ، وحقا من حقوق المواطنين في المشاركة في مؤسسات الدولة السياسية ؛ ومنها المشاركة في الحياة العامة التي تهدف إلى تحقيق المواطنة السياسية.
ومن المفيد ـ هنا ـ أن نشير إلى أن هذه المشاركة السياسية التي نفتقدها في الساحة كُلَّما حَانَ موعد استحقاق معين راجعٌ ـ دون شك ـ إلى افتقاد المواطن إلى الوعي بخطورة إحجامه عن الدخول إلى المعترك السياسي ، أو على الأقل الاستشعار بفكرة الاندماج والمشاركة في المجال السياسي بالقدر المتاح له . ولا يتأتى ذلك إلا بالمرور بمراحل لخصها أحد الباحثين في:
ـ مرحلة الاهتمام السياسي.
ـ مرحلة المعرفة السياسية.
ـ مرحلة التصويت السياسي.
ـ مرحلة المطالب السياسية.
أهمية المواطنة:
تكمن أهمية المواطنة في أنها:
ـ تحفظ للمواطن حقوقه ، وتفرض عليه واجبات.
ـ تضمن له المشاركة في صنع القرار.
ـ تعترف بالتنوع والتعدد عقديا وعرقيا ولغويا وسياسيا وثقافيا....
ـ تبْني نظاما سياسيا مدنيا تعدديا.
ــ تحدد منظومة القيم والسلوك.
ـ تضمن للمواطنين المساواة أمام القانون.
ـ تمكّن المواطن من الإسهام في إدارة الشأن العام من خلال عضويته في الهيئات المختلفة والجمعيات.
مقومات المواطنة وصورها:
قامت المواطنة إثر التغيرات التي حدثت على جميع الأصعدة على مقومات وصور؛ فمن المقومات نذكر:
ـ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:
ويكون ذلك في التعليم والعمل والجنسية و أمام القانون ، كما ورد في الدستور الجزائري ، في فصله الرابع ، في مادته 32 ،في إطار التنصيص على الحقوق والحريات (( كل المواطنين سواسية أمام القانون . ولا يمكن أن يُتذرعَ بأي تمييز يعود سببُه إلى المولد ، أو العِرْق أو الجنس، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. )).
ـ المشاركة في الحياة العامة.
ـ الولاء للوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
ـ حب الوطن وإبداء الشعور بالانتماء إليه.
ـ الإيمان بالوحدة الوطنية.
ـ تهذيب السلوك والأخلاق.
ـ احترام القيادة السياسية للبلاد.
-
المحاضرة الرابعة عشرة : التربية على المواطنة
صور المواطنة وأشكالها:
ـ المواطنة الإيكولوجية والبيئية EcologicalCitizenship وهي التي تتعلق بحقوق والتزامات مواطن الأرض.
ـ MinorityCitizenship مواطنة الأقلية : وتتضمن الدخول في مجتمع ما والانضواء تحت سقفه.
ـ المواطنة الثقافية Cultural Citizenship المواطنة الثقافية: وتعنى بالتنوع الثقافي في المجموعات الاجتماعية بحسب العرق والجنس والسن وحقهم في المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.
ـ CosmopolitanCitizenship المواطنة الكوزموبوليتانية: وتعني كيف ينتمي الناس اتجاها إزاء المواطنين الآخرين والمجتمعات والثقافات الأخرى عبر الكوكب.
ـ CosmopolitanCitizenship المواطنة العالمية: وتعنى باتجاهات المواطنين العالمية تجاه ثقافة الآخرين في العالم.
ـ Consumer Citizenship المواطنة الاستهلاكية: حق المواطنين في التمتع بالسلع والخدمات من القطاعين ؛العام و الخاص.
ـ LinguisticCitizenship المواطنة اللغوية: هي فضاء لغوي ممتد ، تأخذ فيه اللغة الرسمية مكانها في الساحات العمومية وفي المؤسسات المختلفة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتبدأ العملية بالتربية في سن مبكرة على هذه المواطنة اللغوية وباللغة الرسمية ؛ وتكون بتوعية هذا الطفل بتاريخ وطنه وبإنجازاته حتى يكبر على هذه الثقة في مكتسبات بلده.
أسس المواطنة:
ـ المشاركة في الحكم.
ـ المساواة بين المواطنين.
ـ الحرية.
ـ قبول الآخر ونشر ثقافة التعددية.
أبعاد المواطنة:
البعد القانوني: هو ما تكفله الدولة للمواطنين بالتساوي في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين ،
أو غير ذلك ، على أن يقوم هؤلاء المواطنون بالتزاماتهم.
البعد الاجتماعي: كضمان حق الجمعيات في التكوين والمشاركة الفاعلة مع الغير في إطار جمعوي ، من هنا نجد أن المواطنة الاجتماعية تتركز على قضايا اجتماعية مختلفة من شأنها أن توحد الانشغالات وتجيب عن التطلعات التي يحتاجها المواطن ؛ كالأجر المحترم ، والصحة والتغذية والأمن الاجتماعي وحق العمل، وحق الإضراب، والحق في السكن اللائق ، وفي التعليم، وغير ذلك .
البعد المعنوي: والمتمثل في إحساس الفرد بالولاء والانتماء للوطن الذي يعيش بين أكنافه، مما يؤدي إلى الاحترام الطوعي للقانون، والتفاني في خدمته شعورا منه بقيمة الواجب الذي يؤديه تجاهه دون طلب مقابل ولا مصلحة شخصية إلا في إطار القانون الذي يساوي بينه وبين غيره في الحقوق والواجبات.
لقد أجمع علماء الاجتماع السياسي وعلماء التربية بأن هدف التربية هو تحقيق المواطنة.
وتبعا لذلك فالتربية على المواطنة يقصد بها عملية التنشئة الاجتماعية التي تستهدف بناء الفرد المتكامل والمتوازن في جوانب شخصيته فكريا وروحيا واجتماعيا وإنسانيا ، والواعي بحقوقه ، والملتزم بواجباته، والمعتز بانتمائه لوطنه...
والتربیة علـى المواطنـة ـ إذا ـ هـي تربیـة علـى اكتساب ثقافـة أداء الواجبـات قبـل أخـذ الحقـوق بشتى أنواعها، وتربیـة علـى حقـوق الإنسـان والدیمقراطیة عبر منهجیة شاملة التي تربط بین المعرفة والوجدان والأداء، بالإضافة إلى أنها تربیة على ثقافـة التسـامح والحـوار والسـلام والمبـادرة وخلـق فـرص عمـل جدیـدة، كمـا أنهـا تربیـة علـى الأسـلوب العلمـي، والتفكیـر النقـدي البناء فـي المناقشـة والحوارات ، وخُلق تحمّل المسؤولیة تجاه حقوق الأفراد والجماعات بمـا یـؤدي إلـى تماسـك المجتمـع ووحدتـه، بل الأكثر من ذلك عليهم (( أن يكونوا واثقين في أنفسهم ، يواجهون التمييز والاستعباد بشجاعة ، ويكون لهم صوت في تقرير شؤون مدارسهم والحيّ الذي يعيشون فيه والمجتمع بأسره، وأخيرا يكون لهم إسهام في تطوير جودة الحياة في المجتمع سواء بالرأي أو الخبرة أو بالعمل الإبداعي..إلخ .)).
ولم يبقَ مفهوم التربية على المواطنة محصورا بين أفراد البلد الواحد ، بل توسع ليشمل العالم كله، بل والإنسانية جمعاء؛ ها هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تفرد في أحد منشوراتها بحثا بعنوان" التربية على المواطنة العالمية مواضيع و أهداف تعليمية." سنة2015 ، واقترحت أهدافا لهذه التربية ، نشير إلى بعض منها:
ـ تطوير فهم لبنى الحكومة العالمية والحقوق والمسؤوليات والقضايا العالمية والروابط بين النظم والعمليات العالمية والوطنية والمحلية.
ــ الاعتراف بالاختلاف والهويات المتعددة وتقويمها؛ كالثقافة واللغة والدين والجنس.
ـ تطوير سلوكيات الاهتمام بالآخرين والتعاطف معهم ، وكذلك بالبيئة واحترام التنوع.
ـ المشاركة والمساهمة في القضايا العالمية المعاصرة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية كمواطنين عالميين مطلعين وملتزمين ومسؤولين ومتجاوبين.




