المحاضرة7: النقد التاريخي عند أبو القاسم سعد الله
-مقدمة:
من الواضح أن أغلب الباحثين والنقاد في مسار الخطاب النقدي الجزائري الحديث يتفقون على بداية المناهج السياقية التي أعلت سلطة المؤلف وجعلته يتربع على عرش الإبداع الأدبي بوصفه يمتلك مفتاح فهم النص وتفسيره ترجع إلى بدايات السبعينيات من القرن العشرين مع نشوة الاستقلال، وقد تأخر ظهورها مقارنة مع البلدان العربية، ويرجع ذلك لطبيعة الظروف التاريخية أثناء الاحتلال، ولعل من أهم الأسباب التي ساعدت على ظهور هذا الاتجاه السياقي في النقد الجزائري:
- انفجار تلك الثورة الفكرية التي حملت لواءها أوروبا بالدرجة الأولى ثم سرعان ما انتشرت عدواها إلى الوطن العربي ثم الجزائر رغبة من النقاد في التخلص من تلك الأحكام النقدية الانطباعية التي سادت في مرحلة ما قبل الاستقلال.
-سعي النقاد لجعل النقد علما لتفسير النصوص الابداعية وذلك بربط النص الأدبي بسياقاته الخارجية وتبيين العلاقة بينه وبين مبدعه ومجتمعه وتاريخيه، وعلى هذا الأساس برزت الاتجاهات النقدية التاريخية والاجتماعية والنفسية التي مضت قدما على أكتاف النقاد الجزائريين الذين تفتحوا على نظريات النقد السياقية، التي تولت مهمة الكشف عن العالقة بين النص الأدبي ومبدعه ومجتمعه وتاريخه وظروفه النفسية، ويأتي في مقدمة هذه الاتجاهات: الاتجاه التاريخي.
2-النقد التاريخي عند الغرب:
يرى يوسف وغليسي أن النقد التاريخي هو صرح نقدي راسخ واجه أغلب المناهج النقدية الحديثة المتلاحقة ويعرفه قائلا: "...هو منهج يتخذ من حوادث التاريخي السياسي والاجتماعي وسيلة لتفسر الأدب وتعليل ظواهر أو التاريخ الأدبي الأمة ما، ومجموع الآراء التي طيلت في أديب ما أو في فن من الفنون".
ويقول أيضا: "... فهو إذن يفيد في تفسير تشكل خصائص اتجاه أدبي ما، ويعين على فهم البواعث والمؤثرات في نشأة الظواهر التيار الأدبية المرتبطة بالمجتمع انطلاقا من قاعدة "الانسان ابن بيئته"، يتضح لنا من خلال القولين أن النقد التاريخي نشأ قديما وقد اعتبر التاريخ محورا وجزء مهما في تفسير الظاهرة الأدبية، فهو نقد سياقي يهتم بما يحيط بالنص من ظروف وسياقات خارجية تؤثر في الأديب بالدرجة الأولى، فعلى حسب وجهة الدراسين في هذا المجال أن المبدع يرتبط ارتباطا وثيقا بيئته فهو ابنها وجزء لا يتجزء منها وبالتالي يكون ابداعه لصيقا بهذه البيئة بالشكل الإيجابي أو السلبي.
ولقد دخل الاتجاه التاريخي إلى النقد الأدبي الجزائري الحديث يعد واعتبر معلما من معالم التأثر بالمناهج السياقية في الخطاب النقدي الجزائري في بداية فترة السبعينيات من القرن العشرين، وقد أخذه نقادنا من خلال تتلمذهم على أيادي أساتذة في المشرق العربي لأن هذا المنهج ازدهر في حضن الجامعات العربية على أيدي أشهر النقاد العرب أمثال مع شوقي ضيف وسهير القلماوي... في مصر « ، وقد استغرق هذا المنهج حيزا كبيرا من خطاباتهم النقدية وكان نموذجا مثاليا لمحاكاة ظروف عصرهم خصوصا مع تنامي نشوة النصر الذي حققته الثورة الجزائرية المباركة.
3-التعريف بشخصية أبو القاسم سعد الله:
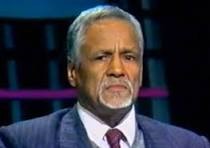
أبو القاسم سعد الله هو باحث ناقد ومؤرخ، ولد عام 1930م في الجزائر بالتحديد في وادي سوف إحدى ضواحي قمار، وهو من عائلة فقيرة جدًا، عرف بشيخ المؤرخين الجزائريين ومن أبرز رجالات الفكر والإصلاح الاجتماعي والديني في البلاد، درس مبادئ العلوم الإسلامية من فقه ولغة ودين، كما أنّ له العديد من المؤلفات، وشهد تاريخه العلمي العديد من الإنجازات، شهد الوسط الجزائري للمؤرخ أبو القاسم سعد الله دورًا كبيرًا في العديد من الأحداث التي مرت بها الجزائر، وبدأ الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله دراسته في جامع الزيتونة عام 1947م وحتى عام 1954م، ولم يدرس في المدرسة الأساسية النظامية نظرًا لأن الفترة التي ولد بها كانت فترة الاستعمار الفرنسي على الجزائر ولم يرد أهله أن يلتحق بأحد هذه المدارس والتي تم رفضها من قبل العديد من الأهالي، و في عام 1954م بدأ العمل ككاتب في صحيفة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتم تلقبيه بالناقد الصغير،[وعمل معلمًا في الجزائر، ثُم في عام 1955م قرر الذهاب إلى القاهرة بتشجيع من شيوخه من أجل دراسة العلوم الإنسانية، وهناك حاز على شهادة الماجستير في التاريخ والعلوم السياسية في عام 1962م. انتقل أبو القاسم إلى جامعة في ولاية مينيسوتا في أميركا، وبقي عدة سنوات فيها، ثُم نال أثناء مكوثه في أميركا شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر والحديث باللغة الإنجليزية عام 1965م، ودرس إلى جانب ذلك العديد من اللغات وأتقنها، كالفرنسية والألمانية والفارسية. بعد نيله شهادة الدكتوراه أراد أبو القاسم الرجوع لبلاده ولكنه تأخر في العودة عقب انقلاب يونيو في نفس العام، الأمر الذي دفعه لدراسة مادة الحضارة الغربية في ولاية وينسكن، ويذكر أنّه رفض الجنسية الأمريكية لأنه اعتبرها خيانة وطنية، ثُم عاد أستاذًا في جامعة الجزائر عام 1967م ومن أعماله : تاريخ الجزائر الثقافي. الحركة الوطنية الجزائرية. أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. الزمن الأخضر. دراسات الأدب الجزائري الحديث ، تجارب في الأدب والرحلة. منطلقات فكرية. هموم حضارية، توفي أبو القاسم سعد الله عام 2013 في الرابع عشر من ديسمبر، في مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائر إثر صراع مع المرض عن عمر يُناهز 83 سنة، تاركًا وراءه 54 مجلدًا توزعت بين العديد الأقسام كالأدب واللغة والتاريخ، وغيرها من المجلدات التي عدت مرجعًا أساسيًا للعديد من المؤرخين من بعده.
4-منهجه التاريخي في الكتابة النقدية:
1-كتاب محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث:
وقد اعتبر الدكتور يوسف وغليسي المنهج التاريخي البوابة المنهجية الأولى التي فتح »الخطاب النقدي الجزائري عيناه عليه، ابتداء من مطلع السبعينيات من القرن العشرين، واعتبر كل حديث عن النقد قبل هذا الفترة -مجرد خرافة،- وحدد سنة 1961 تاريخ ميلاد المنهج التاريخي في النقد الجزائري وهي السنة التي ظهر فيها الكتاب النقدي المشهور في النقد التطبيقي للدكتور أبو القاسم سعدالله بعنوان - محمد العيد آل خليفة –رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث –سنة 1961م، الذي تأثر فيه بمنهج سانت بيف التاريخي، وجمع فيه بين الأدب والتاريخ ،فيقول »عكفت مدة على دراستها وربطها بالأحداث والمناسبات التي قيلت فيها« ، وقد تناول القسم الأول من كتابه: حياة الشاعر، بيئه، نشأته، ثقافته، وتجاربه، أما في القسم الثاني فقد تناول شعره عبر تسعة فصول الاجتماعي، السياسي، الذاتي.....، فيما خصص القسم الثالث لنماذج من شعرية من ديوان الشاعر.
2-كتاب دراسات في الأدب الجزائري الحديث:
أما كتابه دراسات في الأدب الجزائري الحديث الصادر عن دار الرائد للكتاب، ط5 2007، في إطار نقد الشعر الحديث فقد كان فيه مدين للروح التاريخية والثورية التي تمخض عنها: »فقد كتبت تحت ضغط الظروف مسلما بتاريخيته الظاهرة الأدبية وفي هذا الصدد يقول:«... ولدراسة ذلك الشعر دراسة تتماشى مع الآراء السابقة وضعنا له هذا التصميم، وذلك بتقسيمه حسب الفترات التي يكثر فيها الاصطراع الشعبي، وتتدافع أثناءها الأمواج الوطنية في أشكال مختلفة. ومن الممكن أن يكون هذا التصميم على النحو التالي:
1) شعر المنابر من أواخر القرن الماضي إلى 1925.
2) سعر الأجراس 1925-1936.
3) شعر البناء 1936-1945.
4) شعر الهدف 1945-1954
5) شعر الثورة 1954»
وضع الناقد أبو القاسم سعد الله تصميما خاصا لتقسيم الشعر الجزائري وقد صرّح بأن المقصود من هذا التناول هو تتبّع الحوادث التاريخية التي مرّت بها الجزائر ومدى تأثيرها في الشعر، وهنا يظهر جليا تأثر أبو القاسم سعد الله بخصائص المنهج التاريخي ألا وهي الزمن.
1- شعر المنابر1925: يصطبغ هذا الشعر بصبغة الماضي ومخلّفاته، شعر أساسه الوعظ والإرشاد ذو طابع ديني هدفه إصلاحي يرمي إلى انماء الوعي الشعبي عن طريق الدين والمبادئ الخلقية، اعتمد على الصحافة كوسيلة من وسائل الاتصال بالشعب خاصة الصحف التي أنشأتها حركة الإصلاح وغيرها( المنتقد، الشهاب...)، وأيضا انشاء المدارس الحرة، وإحياء المواسم الوطنية والدينية، والحفلات الخيرية التي لعبت دورا هاما لنقل هذا الشعر إلى الجمهور، وكان أكثر الشعراء معلمين لهم اتصال مباشر بتلاميذتهم ومنهم نذكر: عاشور الخنقي، عبد الرحمان الديسي، الطيب العقبي، السعيد الزاهري، محمد اللقاني...، وخير نموذج لهذا الشعر نجد الشاعر محمد اللقاني أحد شيوخ الشعر الجزائري الكلاسيكي في قصيدة نشرها بجريدة الأقدام الوطنية:
بني الجزائر هذا الموت يكفينا لقد أغلت بحبل الجهل أيدينا
بني الجزائر هذا اللهو أوقعنا في سوء مهلكة عمت نوادينا
بني الجزائر هذا الفقر أفقدنا كل اللذائذ حين يقتفي حينا
بني الجزائر استيقظوا فلكم أداقنا اللهو والإهمال تهوينا
2) شعر الأجراس1925-1936: استبدل الشعر في هذه الفترة نغمة جديدة لم تخرجه عن النقطة التي بدأ منها- الإصلاح-و لكنها كانت نغمة تمتاز بالقرع والاهتزازات المباشرة، وهنا تطور الشعر من شعر المنبر إلى شعر الجرس ويرجع هذا التطور إلى التحولات السياسية وميلاد جمعية العلماء المسلمين 1931، وظهور صحيفة البصائر، الشهاب وغيرها من الصحف إنه ميلاد النهضة الأدبية ، اكتسب الشعر من هذا الجو طاقة جديدة وذخيرة تعبيرية، فراح يدق الأجراس ويطلق الصفارات ليتماشى مع ميلاد التيار الوطني، ويرى أبو القاسم سعد الله أن شعر الأجراس كان سلبيا إلى حد كبير لأنه لم يجد أهدافا وركائز واضحة لتلك النهضة ومن ذلك يورد لنا نموذجا لمحمد العيد يخاطب الشعر الجزائري:
أيها الشعب فيم توسع قهرا ليت شعري لأي أمر يقاد
ليت شعري متى تصير عنيدا ولأهليك بالنفوس اعتداد
انها لهجة حائرة بين الواقع الشعبي وبين أمل الذي يظهر مضطربا في نفس الشعر نحو آفاق مجهولة.
3) شعر البناء 1936-1945 يرى أبو القاسم سعد الله أن امارة الشعر آلت إلى محمد العيد آل خليفة، مع وجود أصوات أخرى، حيث أخذ الشعر في هذه المرحلة على عاتقة العوة إلى الوحدة الشعبية والوطنية النقية، وإلى التحرر من الماضي البغيض ونسيان الذات في سبيل المثل العليا، وأخذ شعر البناء يولجه العو بشيء من الصراحة والتسديد كما كان يبشر ما للجزائر من طاقات وما فيها من خصائص تميّزها وتجعلها نموذجية ومن أجل هذه النظرة إلى القضايا الوطنية سماه أبو القاسم سعد الله بشعر البناء ومن ذلك يورد نموذجا لمحمد العيد آل خليفة:
قف حيث شعبك مهما كان موقفه أولا فانك عضو منه منحسم
تقول أضحى شتيت الراي منقسما وأنت عنه شتيت الرأي منقسم
4) شعر الهدف 1945-1954 : بعد مجزرة 8 ماي 1945 التي ذهب ضحاياها أكثر من أربعين ألف جزائري ، اكتسب الشعب الجزائري تجربة جديدة نبّهته إلى الحقيقة المرة وهي أنه لا أمل في التحرر من غير السلاح، هذا ما جعل الشعب ييأس من المحاولة السلبية ويكتشف نفسه التي كانت تائهة عبر سنين، وبفضل تلك المجزرة ظهرت رموز تلوح في الأفق تتطلع لبناء غد مزهر مزيّن بألحان الحرية والضحايا والاستقلال والعلم الرفراف وقد تبناها طليعة من الشعراء أمثال: الربيع بوشامة، عبد الكريم العقون، أحمد الغوالمي، موسى الأحمدي، الأخضر السائحي ومازالت القيادة لمحمد العيد آل خليفة، كما لاننسى أحمد سحنون ومفدي زكريا.
تنوعت الموضوعات في شعر الهدف فكان من بينها قضية فلسطين وأحداث الشرق العربي، وفيما يلي بعض النماذج من شعر الهدف حيث يقول أحمد سحنون:
هات من نسل الحمى خير عتاد وادخرهم لغد جند وجهاد
هات نشئا صالحا ببني العلا ويفك الضاد من أسر الأعادي
ويقول عبد الكريم العقون:
بني وطني أعيدوا مجد قوم أقاموا على أقوى عماد
وأدوا ما عليكم من حقوق لشعبكم وذودوا كل عاد
6) شعر الثورة 1954: انبثق مع اندلاع ثورة التحرير الكبرى ويتميز بالروح الوطنية المشتعلة سواء في تناوله لمواضيع ثورية مباشرة أو مستوحاة من الواقع العربي، كما تميز بالحماس الطائر والعاطفة المجنحة ويفتقر إلى الخيال الموحي والتأمل الخلاق، من شعراء هذه المرحلة: أحمد الباتني، محمد صالح الباوية، صالح خرفي، أبو القاسم الخمار...، فمع تفجر الثورة تفجّرت أقلام الشعراء فراحوا يكتبون شعرا ثوريا عارما يسجّل انتصارات الثورة ويبشر بالاستقلال وبالغد الحر ويتغنى بالوطن والحرية، وأورد الناقد أبو القاسم سعد الله شعرا لصالح خرفي عن فرنسا ونضال الجزائر من قصيدة سلاحنا وسلاحهم حيث يقول:
ملأت الأرض والأجواء حديدا فكان العزم أقوى من حديد
فلسنا في الوغى جددا فتثني عزائمنا أساطيل الجنود
خاتمة: يتبين لنا من خلال أعمال أبو القاسم سعد الله النقدية مدى استفادته من النقد التاريخي خاصة أعمال سانت بيف من خلال الثلاثية( الزمن- البيئة- جنس)، حيث درس الشعر الجزائري عبر فترات تاريخية تحدّد جزئية الزمن، وربطه بالوطن الجزائر، وبالشعب الجزائري يعني المجتمع الجزائري فجاءت دراسته ممنهجة ومنظمة وحقيقة إنه خبر نموذج لبداية التأسيس للفكر النقدي في الجزائر في العصر الحديث.
المصادر والمراجع:
1-يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي ، دار جسور للنسر والتوزيع، الجزائر، "ط1، 2007.
2- أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط5، 2007.

