المحاضرة6: ملامح النقد الجزائري الحديث عند جمعية العلماء المسلمين ( البشير الإبراهيمي أنموذجا)
تهدف عه المحاضرة إلى تسليط الضوء على جهود رواد جمعية العلماء المسلمين ومن بينهم البشير الإبراهيمي من خلال إبراز فكره الإصلاحي.

تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائرين في 5 ماي 1931 بنادي الترقي في الجزائر العاصمة، وذلك بعد سنة من إحياء ذكرى مضي قرن على احتلال الفرنسي للجزائر، وحضر الاجتماع التأسيسي 72 من العلماء الممثلين لمختلف المناطق الجزائرية، وقد سطرت الجمعية أهدافا لها وهي إحياء الشعب الجزائري والنهوض به، وإصلاح مجتمعه، وزرع القيم والأخلاق الإسلامية الرفيعة والمحافظة على هويته الإسلامية والعربية واتخذت شعار: "الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا".
1-التعريف بشخصية البشير الإبراهيمي:
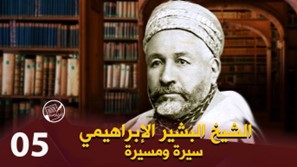
محمد البشير الإبراهيمي عالم من الجزائر وقد كان مفكرا ومصلحا، وهو صديق ملازم للعلامة عبد الحميد بن باديس، ولد في حزيران عام 1889، في قرية رأس الوادي في الجزائر في أسرة معروفة وذات تاريخ بالعلم الشرعي والإفتاء، وبدأ في حفظ القرآن الكريم في سن الثالثة وقد امتلك ذاكرة قوية ومهارة عجيبة بالحفظ، وعند سن التاسعة كان البشير قد أتم ختم القرآن، درس الفقه والبلاغة وفي عام 1940 نفته السلطات الفرنسية للجنوب الغربي للجزائر، وبعد أسبوع من نفيه مات الشيخ بن باديس، وأصبح رئيساً لجمعية العلماء المسلمين، وتولى رئاستها عن بعد لمدة ثلاث سنوات وبعد سنوات في عام 1945 زُجّ بالإبراهيمي في السجن العسكري الفرنسي، وأُطلق سراحه عام 1946 حيث أنشأ جريدة حملت اسم البصائر وتولى رئاستها، ساهم البشير الإبراهيمي في التعريف بالقضية الجزائرية كما خرّجت المدارس ومراكز العلم التابعة لجمعية العلماء التي كان يرأسها قادة للثورة المسلحة لاحقاً، حيث أنشأ حوالي 73 مدرسة في عام واحد فقط، ومع اندلاع الثورة الجزائرية في عام 1954 وجه نداء شهير للشعب الجزائري لدعم الثورة المسلحة، وكان من نشاطاته بعد الاستقلال إلقاء أول خطبة في جامع كتشاوة وسط العاصمة، واضطر بعدها للتقليل من نشاطه بسبب تدهور صحته؛ فلم يعد قادراً على إلقاء الخطابات التشجيعية، وفي نيسان من عام 1964 أصدر بياناً ينتقد تخلي الحكومة الجزائرية عن المبادئ الإسلامية، وضع تحت الإقامة الجبرية إلى أن وافته المنية في منزله 1965.
2-قراءته الشاعر المصري أحمد شوقي (أمير الشعراء):
سنحاول عرض قراءة نقدية في الشعر للشاعر المصري أحمد شوقي (1868-1932). موضحين آراءه واتجاهاته، وتجليات الأثر الإسلامي في هذه القراءة والتي تميل إلى سعة وعمق ثقافته الأدبية والنقدية كم تناول الناقد قراءات نقدية أخرى نذكر منها:
-الشاعر السوري عمر بهاء الدين الأميري: (1916-1992)
-محمد العيد آل خليفة (1904-1979)
اهتم البشير الابراهيمي بالشاعر أحمد شوقي اهتماما كبيرا، وذلك باعتباره شاعر احيائيا لقب بأمير الشعراء سنة 1927، وإن اهتمام الناقد به له مبرراته الفنية والموضوعية وقد أشار إليها كوفرة (الإسلامية) في شعر شوقي، وبراعته في التعبير الجمالي، والتصوير الشعري، يمكن استنباط أو تتبع القراءة النقدية للبشير الابراهيمي للشعر.
أحمد شوقي من خلال المعايير التالية:
1-معيار ضرورة تزاوج الفكر والفن في الأدب:
لقد تأثر البشير الابراهيمي في قراءته لشوقي بنزعة المحافظة وبنى أفكاره وآراءه النقدية تبعا لها، حيث ارتبطت بالمعرفة المرتبطة بالثقافة التراثية التي كرسها (مدرسة الاحياء) إبان النهضة الأدبية، وما أرسته من قواعد فنية.
- ينطلق الابراهيمي من أن تكوين أي ناقد والأديب الشاعر يتكئ إلى ثقافة ينبغي أن تبني على أساس الحفظ المدرك للنماذج الجيدة من النصوص الشعرية في مرحلة أولى، حيث يشكل هذا الحفظ أسلوبا من أساليب التعليم من مناهج التأهيل وطريقا من طرائق التربية الذوقية واللغوية لكل من الناقد والأديبـ، حيث يركز الابراهيمي في قراءته هذه على أساسيتين هو:
1-عنايته بالمحتوى (المضمون) الذي يقدمه الأدب والشعر خاصة حيث يرى بأن الموضوع في النص الأدبي يمكن أن يقدم من وجهات نظر مختلفة ومتباينة، فبذلك يختلف المضمون من أديب لآخر وحسب الانتماءات الفكرية، وعليه استقى من شعر شوقي التصور الإسلامي، وهو وجهة من تلك الوجهات التي شكلت شعره.
2-يعني بالتعبير أو الشكل الأدبي، فالمضمون وحده لا يصنع عملا أدبيا، ولا ينتج نصا بالمقاييس الفنية.
2-معايير التعاطف تجاه الأديب:
يؤكد البشير الابراهيمي على أهمية هذا المعيار التعاطف، حيث يسمح هذا المعيار في قراءة العمل الأدبي وملاحظته باعتدال دون اللجوء إلى الأحكام المسبقة، ويجب أن يضع الناقد والقارئ في حسابه أن الناقد بشر ...، وعمله يدخل في التقييم وتقويم تجربة إنسانية، وليست محاكمة حيث يقول الابراهيمي في جملة تفيض تعاطفا وتسامحا مع الأديب الشاعر شوقي: «ونفس شوقي ينبوع متدفق بالرحمة والحنان قبل أن تكون ينبوعا متدفقا بهذه الروائع من الحكمة والبيان»[1].
3-معيار الثقافة (ثقافة الناقد والأديب):
قرأ البشير الابراهيمي الأدب العربي (الشعري والنثري) مما شكل قريحته النقدية، فأصبح نموذجا للناقد والأديب الأمر الذي مكنه من معرفة مصادر أحمد شوقي ومراجعه الشعرية، ومن ذلك ما تجلى في شعره من الشعر العربي القديم، وهو يدرك بذلك ظاهرة عرفها النقد المعاصر "التناص" وعرفها النقد القديم بأسماء أخرى بعيد عن اصطلاح السرقة الأدبية، وعليه يقول الابراهيمي واصفا الظاهرة بأسلوب متأدب: « وشوقي يلمس في مناحيه الفكرية آراء ومنازع صوفية للقدماء ويكسوها حللا شعرية تذهل بروعتها عن تعرف حقيقة رأيه ويغطي الافتتان بالصور الشعرية على التفكير في أصل الرأيين فضلا عن الفروق والجوامع بينهما، والشعر شوقي من بعض المواقف إشراق كإشراق البرق، يبهر فيه ما يكاد يظهر»[2]، يظهر الابراهيمي راضيا بصناعة شوقي ظاهرا، فيشيد بشعره ويعجب ببراعته وروعته في استدعاء النصوص الغائبة والوامضة وحسن توظيفها، حيث لا ينتبه إلى أصولها ولا يعرف مصادرها إلا قارئ خبير متمرس ضليع في فنه وعمله، فمن دون ثقافة أدبية ومعرفة نقدية قد يساء فهم النصوص، بل يؤول على غير دلالتها، وعلى غير توجيهات سياقاتها.
4-معيار الالتزام تجاه العقيدة والأمة:
ومن مظاهر التزام شوقي بعقيدته للإسلام وإقراره وبتفوق وجدارته، يؤكد الابراهيمي ذلك بالقول: « أما تمجيد الإسلام فلا نعرف شاعرا عربيا يعد شرف الدين البوصيري، دافع عن حقيقة الإسلام كما دافع شوقي»[3]، هنا يقر الابراهيمي بولاء أحمد شوقي للدولة العثمانية وهذا مظهر من مظاهر الالتزام بالأمة.
5-معيار النص (الأدب) بدلا من الناص (الأديب):
النص هو مبدأ من مبادئ النقد الأدبي المعاصر، الذي اعتبر منطلقا ومنتها في الدراسات المعاصرة، حيث تحدث عن إسلامية نص شوقي التي تتجلي في استحضار الموضوعات والمضامين الإسلامية، استدعاء الشخصيات الإسلامية التاريخية، وفضاءاتها المكانية والزمانية.
يرى الابراهيمي أن الناقد لا يجب أن ينظر في شخص الأديب (الناص) لتقييم نصه أو تقويمه كما يبدو وفي دراسته لشعر شوقي وإنما التعويل والتعامل مع الأدب (النص) فهو المرتكز حيث يقول: « والتدين أثر الدين في النفس أو ممارسة شعائره بالجوارح وليس من موضوعنا المحدد البحث عن تدين شوقي بمعنى إقامته لرسوم الدين وشعائره، لأننا في شغل شاغل عن ذلك بهذا الفيض المدرار الذي يفيض به شعر شوقي في التغالي بالإسلام وتاريخه وأمجاده، وبهذا الايمان القوي بالله وقضائه وبهذا التصوير لبدائع مصنوعاته، وبهذا التردد اللذيذ للقرآن والحض على التمسك به، وبهذا التكرار الحلو للمقدسات الإسلامية من ملائكة وأنبياء وصحابة وأماكن وأيام، فيغشي في شعر ذكر الله وجبريل ومحمد وإبراهيم موسى وعيسى وعمر وخالد ومكة والمدينة وبدر والقدس، وأسماء كثيرة لبناة المجد الإسلامي والعربي يكررها فلا تمل، ويصفها في أماكنها فلا تختل، ويسمها ويصفها بخصائصها، ويجلي موضوع العبرة فيها والقدرة بها، فتتألف من ذلك كله في عامة شعره صور بديعة تأخذ النفس أخذة السحر وتفضي إلى الاعتبار ثم الاقتداء»[4]، والابراهيمي بهذه الإشارة المهمة يقترب في تقدير النص ومقاربته من مناهج النقد الحديث التي عدلت عن كل السياقات واهتمت بالنسق (النص) واعتبرته بنية مغلقة مستفيدة من فتوحات اللسانيات الحديثة، وهذا ما يذكرنا بفكرة مهمة (المؤلف) لرولان بارت.
ويستشهد الابراهيمي بقول لأحمد شوقي في رثاء حسين شير وذلك لثبت إسلامية الناص من النص:
أبدا يراه في غلس الدجى في صحن مسجده وحول كتابه
6-معيار الرسالة في الأدب (النص):
يشكل الأدب رسالة يحملها الأديب لمجتمعه وأمته، وهذا ما يجعله ملتزما تجاهه، وليس معيبا أن يحمل الأدب أفكار متنوعة قد يوحي بها الأديب أو يصرح، يشير أو يقرر حيث يملك الشعر قدرة على التأثير بإيحاء أنه وتخيلاته، ومن إسلامية شعر شوقي احتفاؤه بتوحيد الله عزوجل، وهو سمة ضرورية لا يتنازل عنها أي أديب أو ناقد، وهو ما سجله الابراهيمي في شعره حيث يقول: "« أمّا توحيد الله والايمان بقضائه وقدرة وغيبه ونشوره، فإن دارس شعر شوقي يستفيد منه مالا يستفيده من كتب الكلام الجافة بأنواع من الاستدلال الوجداني فتدخل النفوس من أيسر طريق، وتتغلغل إلى مكامن اليقين فيها، فينتهي إلى غاية من الغايات من الايمان الصحيح»[5]، وعليه فالابراهيمي يشير إلى أن للأدب أهمية في ترسيخ التربية الايمانية وفي الدعوة إلى التوحيد والايمان وإذاعة الفكرة الصحيحة بطرق أسلوبية ووسائل تعبيرية بيانية ووجدانية وخيالية ومن أمثلة ذلك موضوعه عن (القضاء) في شعر شوقي.
القضاء معضلة لم يحلها أحد
كلما نقصت لها عقدة بدت عقدة
أتعبت معالجها واشراح معتقد
المصادر والمراجع:
-محمد طالب الابراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي، د

