نظرية الأدب_ أعمال موجهة
Section outline
-
اسم الوحدة : وحدة التّعليم المنهجية
الرصيد : 03
المعامل : 02
الأستاذ المسؤول عن المادة : محمّد نمرة
المادّة : نظرية الأدب / أعمال موجّهة
-
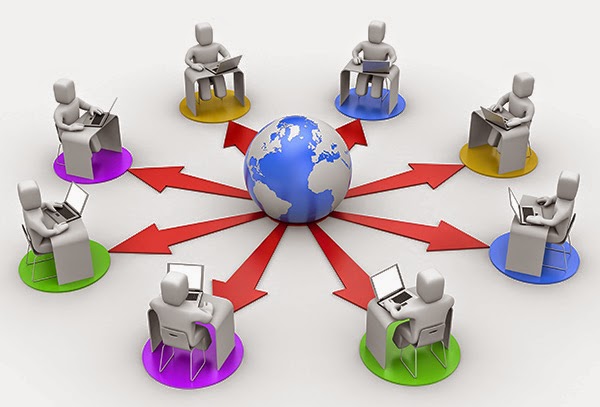
الأستاذ : نمرة محمّد
M.NEMRA@UNIV-DBKM.DZ : البريد المهني
أيام تواجد الأستاذ في الكلية : الأحد والإثنين
-
نظرية المحاكاة
توسع أفلاطون في موضوع المحاكاة، وظل يفسّر حقائق الوجود ومظاهره، وعنده أن الحقيقة، وهي موضوع العلم ، ليست في الظاهرات الخاصة العابرة، ولكن في المثل أو الصور الخالصة لكل لأنواع الوجود ، وهذه المثل لها وجود مستقل عن المحسوسات، وهو الوجود الحقيقي، ولكنا لا ندرك إلا أشكالها الحسية التي في الواقع ليست سوى خيالات لعالم المثل، وعالم الصور الخالصة هو عالم الحق والخير والجمال التي هي مقاييس لما يجرى في منطقة الحس، وجميع ما في عالم الحس محاكاة لتلك الصور.
واللغة بدورها محاكاة لما ندركه من الأشياء التي هي بدورها محاكاة ، فالكلمات محاكاة للأشياء بطريقة تخالف محاكاة الموسيقى والرسم لها ، والحروف التي تتألف منها الكلمات هي أيضاً وسائل محاكاة ، وفي هذا تدل المحاكاة عند أفلاطون على العلاقة الثابتة بين شيء موجود ونموذجه والتشابه بينهما يمكن أن يكون حسناً أو شيئاً أو ظاهراً.
ويجعل أرسطو أهمية كبرى للمحاكاة فهي قوام الشعر، وغريزة في الإنسان تظهر فيه منذ الطفولة ، وهي التي تميزه عن سائر الحيوانات لكونه أكثر استعداداً لها . وبها يستطيع الإنسان أن يكتسب معارفه الأولية ويجد اللذة والشاهد على هذا ما يجري في الواقع . ومن خلال التصنيفات التي حدثت مع أرسطو في تقسيمه الشعر المسرحي إلى نوعين : تراجيديا وكوميديا، فحاول أن يطبق تقسيم الشعر إلى تراجيديا وكوميديا على الشعر العربي ، فيعتمد على ما لاحظه أرسطو من أن الشعراء الأخيار مالوا إلى محاكاة الفضائل، والشعراء الأراذل مالوا إلى محاكاة الرذائل ، وما فهمه من تلخيص ابن سينا من أن التراجيديا محاكاة ، ينحى الى منحى الجد ، والكوميديا محاكاة ، ينحى إلى منحى الهزل والاستخفاف ، فيجعل ذلك أساساً لتقسيم الشعر العربي الغنائي إلى طريق الجد ، وطريق الهزل.
وذهب أفلاطون بعيدا في تاطيره لنظرية المحاكاة، فهو يرى أن لكلِّ شيء محسوس حقيقةً معقولة، والمعقولات هي الأصل في المحسوسات، وإذا كانت المحسوسات تُدرك بالبصر، فالمعقولات ـ أيضاً ـ لها وجود مستقل ويمكن إبصارها بتوجيه النفس نحو إدراكها، وهذا ما يقصده أفلاطون في تعريفه للفلسفة أنها: " رؤية الحق أو البصر بالمثال".
ويمضي أفلاطون في التشبيه إلى نهايته، فالعين ترى المحسوسات التي هي موضوعات للبصر، أما المُثل التي ندركها فهي موضوعات للعقل، وكما يحتاج البصر للضوء كي ينير المحسوسات للمرء، فكذلك الحقائق تحتاج لضوءٍ ينيرها كي يبصرها العقل، وهذا الضوء هو مثال الخير، وكما أن الشمس هي علة النمو في الكائنات وليست هي النمو، كذلك الخير هو علة المعرفة وليس هو المعرفة، ومن أجل ذلك فلن يبلغ الفيلسوف أي معرفة صحيحة عن الحق والجمال بغير أن يكون قد بلغ مثال الخير؛ لأنه علة وجودهما.
وعلى ما سبق فأفلاطون يفسر بالمحاكاة كل حقائق الوجود ومظاهره، وأن الحقيقة في المثل أو الصور الخالصة لكل أنواع الوجود، وهذه المثل لها وجود مستقل عن المحسوسات وهو الوجود الحقيقي، فنحن لا ندرك سوى أشكالها الحسية التي هي في الواقع خيالا ت لعالم المُثل، ويصور لنا ذلك بأسطورة الكهف المشهورة بقصة رمزية، قصة جماعة من الناس عاشت مُكَبَّلَة بالأغلال في كهف تحت الأرض، وتمنعهم أغلالهم من النظر خلفهم لأن وجوههم تقابل جداراً تنعكس عليه صور التماثيل والأشخاص الذين يمرون خارج الكهف، وتنعكس أشباح هذه الأشياء بسبب النار الموجودة خارج الكهف على الجدار الذي تسمرت عيون الجماعة عليه.
فهم لا يعرفون ولا يسمعون إلا أشباح الأشياء المتحركة على الجدار والأصوات التي يعتقدون أنها تبعث منهم، ثم تصور أن هذه الجماعة ولدت وعاشت على هذه الحالة، وهي تعتقد جازمة بأن كل ما تراه أمامها هو الحقيقة التي لا يداخلها شك، والفيلسوف وحده هو الذي يقدر على تخليصهم من الأوهام التي اعتادوها زمناً طويلاً، وهو الذي يجرؤ على كسر أغلالهم وإخراجهم من الكهف المظلم إلى عالم النور والشمس، فالكهف رمز للعالم المحسوس وإدراك الأشباح هو المعرفة الحسية، والخلاص من الأسر يتم بالجدل، والشمس خارج الكهف هي مثال الخير، والفيلسوف هو الذي يرتقي بنفسه وبأقرانه من العالم الزائف إلى العالم الحقيقي.
2- أفلاطون ونظرية المعرفة:
وبناء على نظريته في المثل يبني أفلاطون نظريته في المعرفة إذ وباعتبار أن الوجود الحقيقي هو وجود المثل وأن الوجود المحسوس هو وجود مزيف، تكون المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي تدرك المعقولات، وبالتالي فإن الأداة المعرفية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى العلم(أي المعرفة اليقينية والموضوعية الثابتة) هي العقل، أما الحواس فلا تصل بنا إلا إلى الوهم والزيف إذ لا تتعلق إلا بالمحسوسات المتغيرة والزائلة والتجربة بدورها لا تمكننا إلا من مجرد الظن، أي المعرفة التي لا ترقى إلى المعرفة الحقيقية، وحده إذن العقل هو الذي يرقى إلى هذه المعرفة ووحده الفيلسوف يستطيع التوصل إلى هذه المعرفة.
وقسم أفلاطون المعرفة إلى مراتب: فأدناها الخيال الحسي الذي تبتدئ فيه خيالات الأشياء وظلالها ومظاهرها، كمظهر الحصان أو السرير، وأرقى من المرتبة السابقة مرتبة الإدراك النوعي للموجودات، كماهية الحصان أو المنضدة، وأسمى منها مرتبة الكلية ومعرفة الصور الثابتة الخالدة. ومما سبق يتبين لنا أن أفلاطون يرى أن هناك عالمين اثنين:
العالم الأول: عالم الحس المشاهد، دائم التغيىر، عسير الإدراك، ليس جديرًا بـأن يسـمَّى موجودًا، ولا يسمَّى إدراكه علمًا، بل هو شبيه بالعلم؛ لأنه ظل وخيال للموجود الحقيقي .
العالم الثاني: عالم المجردات، فيه أصول العالم الحسي وهو مثاله الذي صـيغت عليـه موجوداته كلها؛ ففي عالم المثل يوجد لكل شيء مثال هو في الحقيقة الموجود الكامل لأنه مثال للنوع لا للجزء المتغير الناقص؛ ففي عالم المثل إنسانية الإنسان وحيوانية الحيوان، وخيرية الخير، وشكلية الشكل
-
نظرية التعبير
تقوم نظرية التعبير على الفلسفة المثالية الذاتية التي قدمت الشعور و الوجدان و العاطفة على العقل و الخبرة و التجربة.
رفع على الصعيد الاقتصادي شعار " دعه يعمل " دعه يمر " و على الصعيد الأدبي " دعه يعبر عن ذاته " فكان الفرد و الفردية و الحرية و الديمقراطية أساس المجتمع البرجوازي الجديد.فالفرد في هذه الفلسفة الجديدة عالم قائم بذاته و جوهره الحرية و الشعور و الوجدان و العاطفة. و يصطلح على هذه الفلسفة بالفلسفة المثالية الذاتية،حيث رفضت الآلية و قالت بالديناميكية،و قدمت الشعور و الوجدان و العاطفة على العقل و الخبرة و التجربة.
2- أعلام نظرية التعبير:
1-الفيلسوف الألماني إمانويل كانت E.Kant( 1724-1800)
يعد من أوائل المفكرين المنظرين للفكر البورجوازي،و الواضعين للأسس الفلسفية لنظرية التعبير.و قد اعتبر الشعور طريق المعرفة الحقيقية،كما فرق بين المعرفة الحسية و المعرفة العقلية.
2-الفيلسوف الألماني هيجل Hegel(1770-1831)
يرى أن مصدر الفن هو الخبرة الخاصة، وماهية الفن مظهر حسي للحقيقة،و مهمة الفن أرفع صور التعبير البشري عن هذه الحقيقة.كما فسر الفن من زاوية الفنان،حيث يرى أن الفنان يدرك الحقيقة و هي مصورة محسوسة، فالعنصر الحسي يحرك طاقة الخيال لدى الفنان، وبِعَمَلِ الخيال يدرك الفنان الحقيقة.
3- الفيلسوف الانكليزي وليام ووردزورت(1770-1850)
كتب في مقدمة ديوانه " غنائيات " :" إن كل شعر جيد هو فيض تلقائي لمشاعر قوية "
ويقول عن الشاعر : " وما الشاعر ؟ إنه إنسان كسائر الناس، ولكن الله حباه بنعمة الحماس الفاتر والحس المرهف والحنان العذب، إنه يفوق الناس علما بطبيعة الإنسان ويدرك من جوهر الحياة ما لا يدركه غيره.إنه إنسان فرح بما عنده من إرادة ،طرب لما له من عواطف،مغتبط بما يحس من روح الحياة"
إن "ووردزورث اعتبر هدف الشعر هو خدمة الإنسان عقليا وجسديا، ومنح السعادة لروحه، بتوجيه الانفعالات النفسية والتعبير عنها فنيا، مع درجة عالية من الإثارة والمتعة" فالشعر عنده تعبير عن تدفق العواطف والانفعالات، ولغته هي لغة أهل الريف، الذين لم تفسدهم الحضارة، وموضوعاته مستمدة من حياتهم العامة، لأن الأحداث التي تحدث بالأماكن العامة لها طابع سحري و على الشاعر أن يلونها بخياله.
4- الفيلسوف و الشاعر الناقد صموئيل تيلور كوليردج ( 1772-1834)
كان شاعرا و فيلسوفا و ناقدا،و هو صاحب نظرية الخيال التي يذهب فيها إلى أن الخيال خلق جديد،فهو خلق صورة لم توجد ، و ما كان لها أن توجد بفضل الحواس وحدها أو العقل وحده،إنما هو صورة تأتي ساعة تستحيل الحواس و الوجدان و العقل كلا واحدا في الفنان بل كلا واحدا في الطبيعة.
و الخيال عنده نوعان:
- الخيال الأولي:هو خيال يتم عبه كل الناس،و يُمَكِنهم من إدراك الأشياء،و هو طريق الوصول إلى المعرفة و الحقيقة.
- الخيال الثانوي:هو الخيال الشعري الذي يتمتع به الشعراء فقط، فهو يكشف عن العلاقة الخفية بين ذات الشاعر و كيفية تصوره للأشياء الموجودة في الطبيعة.و هذا الخيال يجمع الأجزاء المادية للصورة الموجودة في الطبيعة ثم يصهرها ليخلق صورة جديدة تحل محل الموجودات في الطبيعة.فمثلا عبارة " أصابع الفجر تمتد " هي صورة شعرية لكن عناصرها الأساسية متنافرة في الواقع، لأنه لا توجد علاقة بين الأصابع و الفجر،لكنها بالشعر تصبح متآلفة،لأن الخيال حطم ذلك التنافر و خلق صورة جديدة.
كما يرجع كولوريدج الشعر إلى نوع من الانفعال شبيه بذلك الانفعال الذي ينعش العناصر العقلية،و يمثل زلزالا تندفع معه كل الأجزاء إلى الأمام.كما يرى أن ما يميز الشعر هو حالة الانفعال التي تنشأ لدى الشاعر أثناء عملية الخلق،فالشاعر له قدرة على الانفعال أعمق من غيره،و هي التي تمكنه من التعاطف مع الأشياء و الأحداث التي ينطوي عليها موضوع شعره.و بهذا التعاطف تتحد ذات الشاعر مع الموضوع في الفعل التخيلي الذي تتكشف فيه الحقيقة حدسا إزاء الشاعر،فيستشعر اللذة التي تنشأ عن نشاط ملكاته كلها.
- الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون ( 1809-1941)
يرى أنه لا يمكن للفن أن يقوم دون انفعال،و الانفعال عنده نوعان: أحدهما مجرد اهتزاز للإحساس كرجة تقوم على السطح من غير انتقال ثم تتبدد. و الثاني انفعال ينتج عن درجة من المعرفة،تتحد فيها الذات بالموضوع لتصل إلى حالة الإبداع.و هذه الحالة كزلزال يعصف في الأعماق مندفع نحو الأمام.
- الفيلسوف الأمريكي جون ديوي (1837-1917)
يرى أن كلمة " تعبير " (expression) تعني في جذرها اللغوي " العصر " أو " الضغط " و قد اشتقت من الجذر اللغوي " press " و هذا يفسر لنا عملية الخلق الفني ، فهناك مادة خام قد تشبه العنب، و هناك شيء خارجي قد يشبه معصرة النبيذ ،و خلال تحول المادة الخام إلى عصير " pressure " لا بد من وجود تفاعل بين المادة الخام و الشيء الخارجي،و تتحول المادة الخام خلال هذا التفاعل فتصبح شيئا جديدا هو العصير.
4- مبادئ نظرية التعبير:
وتقوم نظرية التعبير على المبادئ التالية:
1- تقوم نظرية التعبير على الفلسفة المثالية الذاتية.
2- الأديب: عالم قائم بذاته،مبدع و معبر و مبتكر،دون قوانين أو قيود.
3- الأدب: إبداع فردي ،مرتبط بالعواطف و المشاعر و الخيال ،و هو صورة عما يدور داخل الإنسان.
4- المتلقي : منفعل لا دور له في صياغة الصورة،الأدب يؤجج عواطفه و يحرك مشاعره الكامنة.
-
نظرية الخلق
ظهرت نظرية الخلق أواخر القرن 19 بفرنسا وأإنجلترا، وكانت نتاجا لفلسفة (الفن للفن) التي نادى بها "أندرو سيسيل برادلي، فكانت تمثل ثورة وتجاوزا وبديلا لنظريات الإبداع السائدة التي تبجل الطرح البرجوازي؛ إذ طغت نظريات المحاكاة والإنعكاس والتعبير، وظلت تمارس صورها الطبقية في التفكير الإبداعي، وتوجهه إلى مجاهل الكلاسيكية المقيتة، فسقت في فخ الأزمة الفكرية والروحية، وخاصة في عهد الانحطاط السياسي والاقتصادي والأدبي والفكري، فأصبحت نظرية الخلق فراراً من النفعية بقدر فرارها من العالم الخارجي ومحاكاته، وبقدر تحاشيها المعاني المحددة والمقاصد المتبلورة سلفاً. وقد نقول إن في ذلك نوعاً من تَتْفيه القيمة الجمالية لأنها لا تخدم قضايا إنسانية واجتماعية. فكانت نظرية الخلق كرد فعل على تحول الفن إلى سلعة، فهي في أصولها حركة احتجاج ونقد عنيف لوضع الفن والأدب المتردي.
لذلك نادت بالفن الخالص أو الفن الحقيقي الذي يرفض الارتباط بحليف ملوث فاسد أو أي قيمة مقصودة،أو يوظف في خدمة أهداف نفعية، و أن تكون غايته في حد ذاته،و مقياسه هو مدى قدرته على إثارة الحاسة الجمالية للمتلقي.
1- أعلام نظرية الخلق ومقولاتها الكبرى:
تستند إلى الفلسفة المثالية الذاتية بل المفرطة في الذاتية، و من أعلام هذه النظرية:
إيمانويل كانت E.Kant ( 1724-1800) الذي يرفض الفن إذا ارتبط بأي منفعة أو فائدة أو غاية. فهو يقول: " أن لكل شيء غاية إلا الجمال فأمامه تحس بمتعة تكفينا السؤال عن الغاية و لو وجد عالم ليس فيه سوى الجمال لكان غاية في حد ذاته "، فالعمل الإبداعي مرهون بالصورة الجمالية التي تحقق غايته الكبرى.
وقد اهتم "كانت" بخصائص العمل الفني في ذاته وفي داخله فهو يرى أن كل عمل ذو وحدة جوهرية فنية فيها نفسها تنحصر الغاية منه ،فالعمل الأدبي والفني له بنية ذاتية وهي ما تجعل منه عملا أدبيا وفنيا. ويفصل كانت بين الغاية والوسيلة فالجمال هو الشكل بعد تجريده من أي مضمون أو غاية ،فمثلا نظرة الرسام تختلف عن نظرة التاجر إلى التفاحة ،فالأول يرى جمالها غاية في حد ذاته،و يكفيه الاستمتاع بمنظرها و ما تثيره من أحساس بالجمال،بينما التاجر يراها وسيلة للمنفعة و الكسب،و كذلك الأدب.
*هيغل Hegel (1770-1831) يرى أن مضمون الفن يتمثل في فكرة الجمال المستقلة مهما يكن مظهره الاجتماعي أو العملي.
*تيوفيل جوتييه" يرى بان الفن ليس وسيلة بل غاية في حد ذاته لذا فهو مستقل تماما كما يقول: " لا وجود لشيء جميل إلا إذا كان لا فائدة منه وكل ما هو نافع قبيح."
* بودلير(1821-1867) أول من قال بفكرة الفن للفن و الذي يرى بأن موضوع الشعر هو الشعر نفسه ،و أن الشاعر العظيم هو الذي يكتب لمجرد المتعة فقط .
3- مرتكزات نظرية الخلق: تقوم نظرية الخلق على أسس ومحاور تربط بين الصفة الإبداعية ومدى تحققها، وتظهر فيمايلي:
أ- علاقة الشعر بالحياة: يرى برادلي أن الحياة تملك الحقيقة ولا ترضي الخيال أما الشعر فانه يرضي الخيال ولا يمتلك الحقيقة الكاملة لذاك فالشعر ليس هو الحياة بل هما ظاهرتان متوازيتان لا تلتقيان، وإذا حدث تقاطع بينها فسد الأدب،لأنه سيصبح موجهاً لغاية أخرى من غايات الحياة، ويختل الجانب الجمالي فيه، غير انه يعود فيؤكد أن بين الشعر والحياة اتصال خفي ويضيف بأن التجربة الشعرية غاية في ذاتها وقيمتها هي قيمتها الذاتية. والحكم على الشعر يفرض دخول التجربة وتتبع قوانينها وأن ننسى ما يربطنا بعالم الواقع، والفن لا يجب أن يوضع مقابلا للمنفعة الإنسانية لأن العمل الفني الناضج بحد ذاته منفعة.
ب- علاقة الشعر بالموضوع: فلا قيمة للموضوع، أو المحتوى، المهم هو كيف استطاع هذا الشاعر أن يحول هذا الموضوع الذي اختاره من موضوع خارجي إلى عمل فني، فالموضوع لا يمنح العمل الأدبي أية قيمة ،فالفرق بين الشعراء حين يكتبون في موضوع واحد دليل على أن الخلق الفني يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة الأديب وقدراته الفنية ومدى سيطرته على تجربته وتمكنه من عناصر فنه.
وليس بالضرورة أن يكون اختيار التغني بالوطن والبطولات القومية موضوعا لقصيدة ما ابلغ من اختيار موضوع أخر كالتغني بالأزهار مثلا.
ج- علاقة الشعر بالعواطف و الانفعالات : العمل الفني ليس نتيجة للشعور والمشاعر والعواطف وإنما قيمة العمل الأدبي تكمن في قوة الابتكار والخلق الأدبي التي تتمثل في جعل اللغة قادرة على الإيحاء وامتلاك قوة التأثير.
فهناك قصائد تكتب في موضوع واحد وتجربة واحدة ومناسبة واحدة وتصدر عن عاطفة واحدة لكنها تتفاوت في جودتها فواحدة جيدة وأخرى رديئة... والسبب يرجع إلى قدرة الشاعر على الخلق الفني فالعواطف والتجربة والموضوع والمناسبة لا تؤثر في القيمة الفنية للعمل وهذا يعني أن الأدب ليس تعبيرا عن الانفعال كما تزعم نظرية التعبير فلو كان كذلك لكانت التجربة الانفعالية باطن الفن وجوهره.
د- علاقة اللغة بالخلق الفني: العمل الأدبي كائن خلقه الشاعر من ذاته واللغة مادة الأدب أما معنى الخلق الفني فهو سيطرة الأديب على اللغة مما يضيفه عليها من ذاته وروحه، واللغة وسيلة الأديب للخلق الأدبي فاللغة هي موسيقاه وألوانه وفكره والمادة الخام والذي يحدد قيمة العمل الأدبي هو العلاقة التي تنشأ بين اللغة والتجربة الشعورية والفروق الدقيقة التي نشأت من هذه العلاقة.
1- العمل الأدبي خلق حر : يرى كروتشيه بان الفن حدس خالص أو صور خالصة متجردة من الفلسفة أو التاريخ أو العلم بل ومن الأخلاق واللذة وهي مستقلة عن أي غاية عملية أو نفعية فالفن خلق حر ،حيث يقول: ‹ أن الفكر وسيلة للحياة لكن الحياة تصبح في لحظة ما وسيلة وأداة للفكر نفسه.فما من شاعر يخلق أثره حرا من شروط الزمان والمكان ولكن متى تم خلق القصيدة فقد أضيف إلى الوجود عنصر لم يكن موجودا من قبل ›.يقول كروتشيه: ‹‹ أن الفن هو التكافؤ الكامل بين العاطفة التي يحسها الفنان وبين الصورة التي يعبر بها عن هاته العاطفة ونحن لا نستطيع أن نطلب من الفنان الخلاق إلا شيئا واحدا هو التكافؤ التام بين ما ينتج وما يشعر به
2- المعادل الموضوعي/ الفن الموضوعي: ليس الشعر تعبيرا عن المشاعر والعواطف والانفعالات بل هروب منها وليس تعبيرا عن الذات أو الشخصية بل فرار منها.إن الشعر خلق. بهذه المقولات يقدم اليوت مفاهيم جديدة لما يسميه "الفن الموضوعي" ومن ثم "النقد الموضوعي" و يوضح عملية الإبداع الفني فيقول "ليس على الشاعر أن يبحث عن انفعالات جديدة وإنما عليه أن يستعمل الانفعالات الموجودة بالفعل ليخرج منها إحساسات ليست في الانفعال العادي بالمرة.
ويحاول توماس اليوت (1888-1965) أن يبرهن صحة مقولاته حين يرى أن الشاعر ينفعل بتجربة ما ويتعاطف معها غير انه عليه ألا يعبر عن انفعاله بل عليه أن يتخلص من هذا الانفعال بإيجاد معادل موضوعي له يساويه ويوازيه، ويعين الشاعر في ذلك عقله وتعين الشاعر في تجسيد انفعاله فيما يعادل لغته. أي أن على الأديب ان يحول عواطفه وأفكاره وتجاربه إلى شيء جديد أو مركب جديد أي إلى خلق جديد ويتم خلق المعادل الموضوعي للانفعال بانفصال الأديب عن ذاته فكأن للأديب شخصيتين واحدة تنفعل وأخرى تخلق والأديب لا يبلغ درجة النضج في الخلق الفني إلا إذا ازداد انفصاله عن ذاته المنفعلة .
كيف يستطيع الاديب ان يبعد انفعالاته وينفصل عن ذاته ليخلق المعادل الموضوعي لتلك الانفعالات؟يجيب اليوت بان كل ذلك يتم عن طريق عقل الفنان الذي يقوم بدور الوسيط في المعادلات الكيميائية أي أن العواطف والأفكار والتجارب تتحول بواسطة العقل إلى مركب جديد يختلف تماما عن الأصل بينما يظل العقل هو هو. وحتى يتحقق ذلك أيضا يجب على الشاعر أن ينأى بشخصيته عن عقله أي أن يفصلها ويبعدها عنه حتى يستطيع هذا العقل الخالص أن يتفهم مواد هذا الموقف الفني من عاطفة وإحساس وتجربة وأفكار وان يتمكن من تحويلها إلى خلق جديد يختلف عنها في القصيدة. وبهذا ينجو العمل الأدبي من الذاتية وتتحقق له الموضوعية ولكن ما مهمة الناقد إزاء هذا الأدب الجديد أو الفن الموضوعي ؟
يحاول اليوت أن يضع أسسا جديدا لما يسميه أيضا بالنقد الموضوعي فيرى أن الشعر خلق جديد له قوانينه الخاصة وحقائقه ومقياس نقده ينبغي أن لا يكون من خارجه بل لابد ان يلتزم هذا المقياس تلك القوانين والحقائق وهي لديه قوانين وحقائق لغوية وجمالية خالصة. هذا هو أساس النقد الموضوعي الذي قال به اليوت.
والناقد الموضوعي تبعا لذلك يمتلك أداتين: التحليل والمقارنة
أي تحليل القصيدة من جهة التشكيل اللغوي ببيان الاتساق والهيئات والتراكيب والعلاقات ومن جهة التشكيل الفني بتحليل الدلالات والرموز
والمقارنة تتم ببيان اثر التقاليد الشعرية الموروثة في هذا العمل المنقود وتأثير هذه العملية في تلك التقاليد فاثر الموروث أمر بديهي كذلك فان العمل الشعري المعاصر-إذا كان ناجحا- يضاف إلى تقاليد ذلك الموروث.
تستند إلى الفلسفة المثالية المفرطة في الذاتية فالأديب خالق لكن لا دور له بعد اكتمال النص. وكذا الأدب حدس أي معرفة مباشرة،و هو تكنيك لا علاقة له بالخارج.
المتلقي هو الذي يتوجه نحو الأدب،لأن الأدب تجسيد للجمال و التناغم الذي يفتقده المتلقي في عالمه المعيش.
-
نظرية الانعكاس
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، ظهر أدب جديد أصطلح عليه بالأدب الطبيعي الواقعي، له اتجاه يخالف اتجاهات الأدب الكلاسيكي والأدب الرومانسي. و بظهور هذا الأدب ظهرت نظرية جديدة تسمى نظرية الانعكاس،اهتمت بدراسة العلاقة بين الأدب و المجتمع من خلال رصد التأثيرات المتبادلة بينهما.
1- نظرية الإنعكاس ومقولاتها الكبرى:
يرى أصحاب هذه النظرية أن نشأة الأدب انعكاس للواقع الاجتماعي،فكما نتجت الكلاسيكية عن العصر الإقطاعي، والرومانسية عن البرجوازية، فإن نظرية الانعكاس ارتبطت بالواقعية الاشتراكية. ويؤكد أصحاب هذه النظرية ضرورة ارتباط الأدب بالواقع الذي أنتج فيه، وأن وظيفة الأدب تهدف إلى شحذ قوة ادراك المتلقي و فهم العالم و ادراك الواقع الاجتماعي، ومشاركة الأديب في تجربته بشكل يؤدي إلى تغيير البنية التحتية أو تعديلها
وقد سبق ظهور هذه النظرية عدة محاولات حاول أصحابها الربط بين الأدب و البيئة و الحياة الاجتماعية منها:
1- محاولة الفيلسوف الفرنسي هيبوليت تين H.Taine (1829-1893) فيرى أن الأعمال الأدبية وثائق و آثار و سجلات تاريخية تتأثر بالعوامل التالية:
أ- الجنس:أو ما يسمى بالعرق أو النوع،فأدب كل أمة يختلف عن أدب أمة أخرى، و يرجع ذلك إلى تباين الظروف المعيشية و الوطن،حيث يكتسب الجنس خصائصه المميزة من البيئة و العادات و التقاليد المتوارثة،فضلا عن الدوافع و الرغبات الدفينة و الملامح الجسدية.
ب- البيئة: و يقصد بها المناخ و النظم الاجتماعية، فهذه الأوضاع تتحكم بالأدب و الحياة العقلية و المزاج الإنساني.
ج- العصر: و هو الزمن ، فالأفكار و المفاهيم المسيطرة على روح العصر تؤثر في العمل الأدبي.
لم ترق هذه المحاولة إلى نظرية في نظر سانت بيف،لأنها لم تتحدث عن أثر العلاقات الاجتماعية و المجتمع في الإنتاج الأدبي.
2- محاولة الأديب الروسي ليو تولستوي (1828-1910)
ركز دراسته على العلاقة بين الأدب و القراء،و ذهب إلى أن وظيفة الفن هي أن ينقل إحساس الفنان إلى المتلقي،فمهمة الفن مهمة توصيلية،و هو إيصال انفعال الفنان إلى المتلقي و بالتحديد إلى كل الناس البسطاء،و إن لم يستطع أن يفعل ذلك فلا يعد فناً،و ينفي أن يكون للفن علاقة بالواقع الاجتماعي.
تستند نظرية الانعكاس إلى الفلسفة الواقعية المادية،التي ترى بأن الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من وجود الوعي، و أن أشكال الوجود الاجتماعي هي التي تحدد أشكال الوعي.
و قد بلور كارل ماركس فكرة الفلسفة الواقعية في العلاقة بين البنية التحتية ( علاقة الإنتاج و قوى الإنتاج) و البنية الفوقية ( الثقافة و الفلسفة و القوانين و الفكر و الفن ). حيث أوضح أن هذه العلاقة متبادلة و متفاعلة مما يجعلها علاقة جدلية قائمة على التأثير و التأثر، بمعنى أن أي تغير في البناء الاقتصادي و الاجتماعي يؤدي إلى تغير في شكل الوعي أو مجمل البناء الفوقي،الذي يعود فيؤثر في البناء التحتي من خلال تثبيته أو تعديله أو تغييره.فالواقع المادي في تفاعل مستمر مع الأفكار و التغيرات التي تحدث في المجتمع نتيجة التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
كما يؤكد كارل ماركس على أن الأدب و الفن هما سلاح الطبقية، ففي المجتمع المقسم إلى طبقات، يعكس الأدب الفن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معنويات طبقة معينة و أرائها السياسية و ذوقها الجمالي.
ويرى جورج لوكاش G.Luckacs أن للفن و الأدب بعدا طبقيا اجتماعيا،فهناك ثقافة سائدة هي ثقافة الطبقة المسيطرة و ثقافة أخرى هي ثقافة الطبقات المقهورة، وهنا يصبح الانعكاس أنواعا، انعكاس طبيعي (مزيف) وانعكاس واقعي (صادق)، وهذا يعني أن الانعكاس ليس بسيطا وإنما هو عملية متداخلة مركبة.مما يؤكد أن الأعمال الأدبية لها صلة بالواقع، لكن ليست كلها واقعية.
قد اعتبر رونيه ويليك نظرية الانعكاس أنها تعني "دراسة مبادئ الأدب وتصنيفاته ومستوياته، والثانية اعتبرها مدخل استاتيكي، للدراسة الأدبية، أما التاريخ الأدبي فيرى ويليك أنه يدرس الأدب في حركته"، فيرى أن الأدب نظام اجتماعي، وإذا كان الأدب يمثل الحياة، فإن الحياة ذاتها حقيقة اجتماعية، والكاتب المسرحي حينما يصور لنا كائنا إنسانيا كاملا فهو لا يعيد تصوير الإنسان فقط بل يعيد تصوير المجتمع الذي ينتمي إليه هذا الإنسان،و هذا المجتمع ليس إلا ذرة من الكون ، ومن ثمة فالفن الذي خلق هذا الإنسان يعكس لنا الكون كله.
وفسر بول فاليري Paul Valery العلاقة بين الفنان والآخرين، حيث يرى بأن الفنان أثناء عملية الخلق الفني يضع نصب عينيه الذين سيتوجه إليهم بعمله ومدى تأثيره فيهم.
2- مبادئ نظرية الانعكاس:
وتقوم نظرية الانعكاس أساسا على المبادئ التالية:
1- تقوم نظرية الانعكاس على الفلسفة الواقعية المادية.
2- الأديب: مبتكر/فنان / مؤلف، لا يبدأ من الصفر،و هو مبدع نسبيا.
3- الأدب:عمل /إنتاج/ صورة للمجتمع و علاقاته،متطور و متغير،له علاقة مع الزمان و المكان،و أبعاده فردية و اجتماعية.
4- المتلقي : جمهور غير متجانس،فاعل و منفعل

