نقد أدبي حديث_أعمال موجهة
Section outline
-
اسم الوحدة : وحدة التّعليم الأساسية
الرصيد : 04
المعامل : 02
الأستاذ المسؤول عن المادة : محمّد نمرة
المادّة : نقد أدبي حديث / أعمال موجّهة
السّداسي : الثّالث
الفوج الأوّل
-
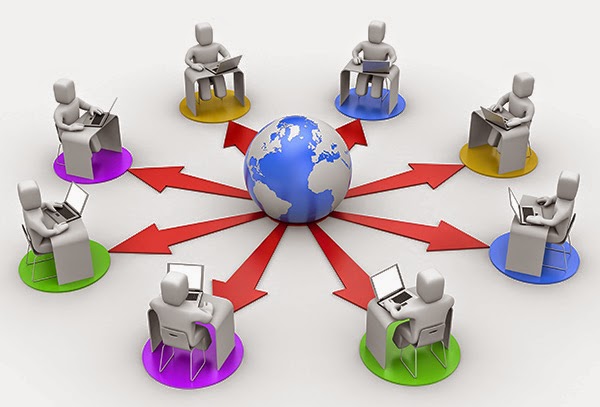
الأستاذ : نمرة محمّد
M.NEMRA@UNIV-DBKM.DZ : البريد المهني
أيام تواجد الأستاذ في الكلية : الأحد والإثنين
-
النّقد الإحيائي:
1- دوافع الأدب الإحيائي:
كل أدب يشهد تجددا أو ظهورا بعد أن مسته سنن الركود والجمود إلا وتتحكم في ذلك التجدد عوامل ، ساعدت على انبعاثه بعد موات إبداع الأدباء في ظل التقليد ، وساهمت في إحيائه بعد تشبث الشعراء بسنن الشعر المتوارثة عن أواخر العصر العباسي، تلك السنن المرتبطة بأغراض محدودة وأساليب مسجوعة، وإذا أتينا إلى تلك الدوافع نجدها كما يلي:
أ- الوعي القومي العربي:
في أواخر القرن التاسع عشر أخذت مصر تتيقظ إلى شخصيتها ، وظهرت هذه الشخصية في حياتها السياسية، وتسلك طريقها إلى انتزاع قوميتها من بقايا حكم الأتراك والعناصر الأجنبية الأوروبية، وحدث ذلك عندما اندلعت الثورة العرابية سنة 1881، بزعامة أحمد عرابي ،ضد الخديوي توفيق ، ومن ثم كانت هذه الثورة الشرارة الأولى التي غيّرت المفاهيم الاجتماعية،إذ ولّدت الشعور القومي العربي عند المصريين، وهذا التغيير لحقه تغيير في الفكر والأدب، بعد أن ركد الأدب العربي خمسة قرون مظلمة ، تراجع عن مستواه الذي يستحقه بمراحل بعيدة حتى كاد يلفظ أنفاسه ، لولا بعض الأعلام صبروا على الضغط العثماني ، فظن المفكرون أن إعادة الحياة إلى جسم الأدب غدت من المستحيلات ، ولكن رياح الثقافة الغربية هبت على المشرق ، فأحيت مواته، وأعادت إلى جذوره الحياة ، وثبتت فروعه بدعائم راسخة.
فكان لزاما على الأدب خاصة أن يساير الحياة الجديدة، فظهر لذلك أثر الثورة العرابية في شعر الشعراء ونثر الكتاب والخطباء، فظهر لفيف من الأدباء في مقدمتهم محمود سامي البارودي ، وحسين المرصفي، وإبراهيم المويلحي وإبراهيم البازجي وجرجر زيدان،وأحمد فارس الشدباق، وعبد الله النديم، وقاسم أمين ، وغيرهم كثير.
ب – الثقافة الأوروبية العلمية:
قامت حركة ترجمة واسعة لكل شيء يتعلق بالثقافة الغربية، حيث ترجمت الكتب العلمية، واشتغل المجتمع بتحصيل العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها ، وذلك بعد "أن لمس حاكم مصر محمد علي ثقافة الفرنسيين الذين دخلوا مصر ، رغب في الاستفادة من علوم الغرب ، فأرسل ثلاثة بعثات علمية في أزمنة متفاوتة ، كانوا فيما بعد نواة للنهضة العلمية والأدبية ، فقد نقلوا الى اللغة العربية عشرات الكتب الجليلة في شتى العلوم ، فأحدث في ذلك في اللغة العربية انقلابا عظيما ، واكتسبت من سعة الأغراض والنعاني والألفاظ العلمية والأساليب الأجنبية وطرق البرهنة والاستنباط وترتيب الفكر ثروة طائلة "
ج - ترجمة الأعمال الأدبية:
اتسع نطاق ترجمة الكتب الأدبية لا سيما ذلك الجنس الأدبي المسمّى بالمسرحية، فترجمت مسرحيات الأدب الفرنسي والأدب الانجليزي، فقد ترجم محمد عثمان جلال مسرحيات الأدب موليير (Molière) وخرافات لافونتين (La Fontaine) كما قام الشيخ نجيب الحداد بترجمة مسرحيات المسرح الإنجليزي شكسبير (She Ksper).
د – التراث الثقافي الديني:
ومن هذه العوامل أيضا، ذلك الشعاع الثقافي والمعرفي للجامع الأزهر الذي كان مصدر إشعاع للعلوم اللغوية والعلوم الشرعية، حيث ظل يقف ندًّا للتراث والفكر الأوروبي المقبل على البلاد العربية، بل كان يمثل موقف المتحدّي أو المنافس.
ه – الصحافة:
ويظهر هذا العامل في الصحافة الوطنية المصرية آنذاك، وقد كان هدفها الأساس هو مقاومة الاستعمار الانجليزي وغيره من الاستعمار الأوروبي - المنتشر في معظم البلاد العربية - بالقلم وفضح أعماله ،لاسيما بعد أن صارت مصر تحت قبضة الإنجليز وغيرها من بلدان الوطن العربي تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي كما هو الحال في بلاد المغرب والشام، وكان من أهم تلك الصحف التي كانت لسان حال الشعب العربي في مصر وغيرها، جريدة " المؤيّد" التي صدع بها الشيخ عليّ يوسف على مسرح الأحداث الوطنية ،وذلك بعد أن فشلت الثورة العرابية ووقعت مصر تحت السيطرة الكاملة للإنجليز سنة 1882م، وقد اقتفى آثاره الزعيم الوطني مصطفى كامل حين أعلن إصدار جريدة أخرى ،حملت اسم "اللواء" وكان ذلك سنة 1900م.
و -هجرة أدباء سوريا ورجالات الصحافة إلى مصر:
وقد كان لهؤلاء الرواد حّظ وافر من الاطلاع على الآداب الأوروبية أكثر من غيرهم من المصريين، لا سيما تفوقهم في اللسانيين الفرنسي والإنجليزي، فنقلوا الأفكار والأغراض الشعرية وترجموا بعض الأنواع الأدبية ، وبهذا أكملوا ذلك النقص وأمدّوا أدباء بلاد وادي النّيل بالكتب الأدبية المترجمة عن اللغات الأجنبية، وأدى ذلك إلى افتتاح الجامعات والكليات العلمية والأدبية ، محاولة الاستفادة من أدبائها وعلمائها بادئ الأمر ، ثم اعتمدت على متخرجيها العائدين من شتى أطراف المعمورة ، فاستقبل الطلاب المدارس الغربية استقبالا عاديا ، بعد أن كان مجرد التفكير بالاتصال بالغرب أمرا مرفوضا أو صعبا "
2 - نتائج العوامل السابقة:
قد كان لهذه العوامل السالفة أثر بالغ في تنشيط الحركة الأدبية، فظهر في خضم هذه اليقظة الفكرية شعراء كانت لهم الريادة الشعرية، وكان لهم ميل إلى أن يعيدوا للشعر جماله الأسلوبي القديم ولغته ذات البيان العالي التي تجعله يضاهي أساليب فحول شعراء عصور العربية المزدهرة التي كانت على أيام دولة بني أمية، ودولة بني العباس ، لذلك كان حقا على الشعر أن يتطور وكان لزامًا على الشعراء أن يقوموا ببعث الشعر من جديد وإحيائه كما تحيا الأرض الأموات.
ولكن من هو الشاعر الذي اتفق مؤرخو الأدب والنقد الحديث على أنه باعث الشعر في العصر الحديث بلا منازع؟ إنه البارودي.
البارودي شاعر ينحدر من أصل شركسي، لكن البيئة العربية صبغته صبغة عربية خالصة، وقد ساهم في نبوغه عوامل منها، أنه قرأ دواوين الشعراء قراءة درس وحفظ ، تلك الدواوين التي كانت تطبع في مطبعة بولاق آنذاك، إضافة إلى العوامل الوراثية التي يتميز بها العنصر الشركسي كقوة العزيمة ومهارة الفروسية، ولذلك انخرط في الجيش وكان أحد القادة الذين قادوا الثورة العرابية. وقد ذاق نتائج فشلها حيث نفي إلى جزيرة" سرنديب"في جنوب شبه القارة الهندية.
3 - شعر البارودي في ميزان النّقد:
لقد صقلت شاعرية البارودي الأحداث النضالية التي شارك فيها، فكان الطابع الغالب على شعره هو الحماسة الممزوجة بالحكمة، فاستحق أن يكون الشاعر الحماسي الأول في عصره، ومن ثم أحيا أساليب فحول الشعراء العربي أمثال أبي فراس الحمداني، والمتنبي، فقد عارض هذين الشاعرين خاصة كما عارض العديد من الشعراء الآخرين عامّة.
وعلى الرغم من أنه كان محاكيا لهم و متبعا لهم في الأغراض والأساليب، إلّا أنّ ذلك التقليد لم ينقص من مكانته الشعرية، وذلك أنه كان يصب معاني أولئك الشعراء في نفسه الشاعرية، وبعد أن يستوعب ذلك تصدر عنه تلك المعاني في صورة شعرية جمالية مشحونة بمعاني البطولة والشجاعة، بحيث يجعلها تناسب أحداث عصره و تنسجم مع السياقات الاجتماعية و السياسية التي ينظم في جوها قصائده، وبهذا فإن معارضته لسلفه من الشعراء القدامى لم تكن تقليدًا صرفا بل كانت حافزًا على أن يضفي على شعره شيئا من شخصيته الشاعرة.
بل ربّما تفوق على سائر الشعراء في تنزيل اللغة وفق السياقات المناسبة لعصره، وكأن اللغة طوعّت له من حيث لا يدري، بدليل أنك أيها الطالب – لو تذوقت قصيدة من قصائده تذوقا لغويا أدبيا ، لوجدت غرض الحماسة يمتزج مع موضوع القصيدة الرئيس، ذلك أن السمة الحماسية لا تتعلق بوصف الحرب وما في معناها فقط ،بل يجدها الناقد تلوح في كل غرض شعري قال فيه البارودي وبز فيه على أقرانه.
فربّ قصيدة قالها في الرثاء أو الغزل، تجد الحماسة تتخلل أبياتها بين الفينة والأخرى، ومن شعره الذي يمثل هذا التمازج بين الحماسة والرثاء قوله في رثاء أبيه:
لا فارس اليوم يحمي سرحة الوادي
طاح الردى بشهاب الحرب والنّادي
مات الذي ترهب الأقران صولته
ويشقى ببأسه الضرغامة العادي
مضى و خلفني في سنّ سابعة
لا يرهب الخصم إبراقي وإٍرعادي
فإن أكن عشت فردًا بين آصرتي
فها أنا اليوم فرد بين أندادي
وبمجرد انتهائك أيها الطالب من قراءة هذه الأبيات، تلمس الحماسة وروح الشجاعة على الرغم من أنّ الشاعر في مقام الرثاء الذي يفرض عليه عبارات وألفاظ الشجن واللّوعة، ونحن نسوق لك مقطوعة شعرية للتدليل على أنّ البارودي يجاري القدماء في جودة الصياغة اللغوية وجمالية الأسلوب، نذكر منها ما يلي :
سواي يتحنّان الأغاريد يطرب
و غيري باللّذات يلهو و يعجب
وما أنا ممن تأسر الخمر لبّه
ويملك سمعيه اليراع المثقب
ولكن أخوهم إذا ما ترجحت
به سورة نحو العلا راح يدأب
نفى النوم عن عينيه نفس أبيّة
لها بين أطراف الأسنة مطلب
و من تكن العلياء همّة نفسه
فكل الذي يلقاه فيها محبّب
في هذه الأبيات نجد البارودي يمارس غرض الفخر بروح المتنبي، من حيث عمق الفكرة وجودة التركيب وحسن اختيار اللفظ المعبّر عن المعنى المقصود، كما أنه يشوبها في الوقت نفسه بشيء من غرض الحكمة المبثوث في القصيدة كلها ، وتلك خاصيّة امتاز بها البارودي لم يشاركه فيها أيّ شاعر آخر.
ولم يكن البارودي هو الشاعر الوحيد الذي رفع لواء الشعر خلال فترة الإحياء، على الرغم من أنه كان صاحب الريادة في ذلك، للأسباب التي ذكرناها، فقد شاركه في هذا الفضل،مجموعة من الشعراء في جزالة تراكيبهم وجودة تصويرهم للمعاني إلا أنهم لم يبلغوا مبلغه ولم يدركوا مرتبته، ومنهم عبد الله فكري والشيخ علي البشر، ونجيب الحدّاد، ومن نافلة القول التي ينبغي ذكره ، أن هؤلاء على مقدرتهم الأدبية إلّا أنهم لم يكونوا مع البارودي في الثورة العرابية وفي مواجهة الإنجليز ،فقد خذلوه ولم يستطيعوا ما استطاعه من مناهضة الخديوي والإنجليز.
بعد هذا التفصيل في حركة البعث الأدبي، فهل من نهضة نقدية أحيت النقد كما أحيت الشعر؟
فكما ظهر البارودي باعثا للشعر بلا منازع ، ظهر الشيخ حسين المرصفي ممثلا لحركة الإحياء والبعث النقدي، فمن هو المرصفي؟
4 - النقد عند حسين المرصفي :
- أولا : التعريف بالشيخ الناقد حسين المرصفي:
هو حسين أحمد المرصفي، المتوفى 1889م، عالم أزهري نشأ في بلدة مُرصُفَا ، تولى التدريس فيه وفي دار العلوم غداة إنشائها، له كتاب "الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية"، وهو عبارة عن محاضرات ألقاها على طلبته في دار العلوم، تناول أكثر من اثني عشر علما، منها اللغة والنحو والصرف والبلاغة والعروض والقوافي وصناعة الترسل وقرض الشعر والنقد وكتاب دليل المسترشد في فن الإنشاء.كان من طلبته شعراء وكتاب بارزون منهم البارودي، وأحمد شوقي، وأحمد حسن الزيات، وطه حسين وغيرهم
ثانيا -أفكار الشيخ حسن المرصفي:
أ – رأيه في حقيقة الشعر:
وقف موقفا معارضا من التعريف المشهور لابن قدامة الذي يرى أن الشعر كلام موزون مقفى، بل يراه يتجاوز القوافي والأوزان ، لأنّ تقييده بهذه القيود يجعله مرتبطا بالدلالة العروضية فقط، ومن ثم يقول عن الشعر بأنه هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستغلا كل جزء منها في غرضه ومقصده، وهو الجاري على أساليب العرب المخصوصة.
ب –الشعر ملكة:
وهو طبع وجبلة، وهذه الصفات تنشأ من كثرة الحفظ والممارسة، والحفظ يقوي الملكة، فيصير الشاعر ينسج على منوالها ، لذلك كان يرى أن من لم يحفظ القصائد الطوال كان شعره قاصرًا رديئًا.
ويستدل على ما ذهب إليه ،بنموذج الشاعر البارودي الذي صار شاعرًا بالحفظ والدربة والاستعداد الفطري، فهو لم يقرأ كتابا في صناعة الشعر، بل أكثر الاستماع وقرأ الدواوين وحفظ منها الكثير، فصار بذلك شاعرا يعد في طبقة الشعراء الفحول.
-
جماعة الديوان
1. نشأة جماعة الديوان:
مدرسة مثلت حركة نقدية أو جماعة نقدية كما أراد أن يسميها بعض النقاد، تلك المجموعة نادت بتجديد الشعر العربي في بداية القرن العشرين، إذ كان يتزعمها ثلاثة شعراء جمعوا بين نظم الشعر وكتابة النثر و النقد، وهم عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وعبد القادر المازني، وقد أخذت هذه التسمية من النسبة إلى الكتاب الذي ألف من قبل هذه الجماعة واسمه "الديوان"، لكن هذا الكتاب صدر منه الجزء الأول فقط ولم يكتب للأجزاء الباقية الصّدور ، وذلك بسبب الخلاف الذي نشب بين المازني وشكري.
3 -الخصائص الفنية للشعر عند جماعة الديوان:
كان لجماعة الأثر البارز في إعطاء الشعر العربي توجها جديدا، حيث ذهبوا إلى المناداة بوضع تصّور فني ينبغي أن يلتزم به الشاعر حين ينظم القصيد، وبذلك أخذ الشعر في نظرهم خصائص فنية، يمكن أن نذكرها كالآتي:
أ - الاتجاه نحو التجديد:
وذلك في المعاني الشعرية والتركيز على الذات والطبيعة والموضوعات النفسية ، والانصراف في شعر المناسبات ، ويبدو ذلك في مخاطبة العقاد، لطائر الكروان المغّرد ، مخاطبا إياه بتوظيف ضمير المتكلم قائلا:
أنا في جناحك حيث غاب مع الدُّجى
وإن استقر على الثرى جثماني
أتاني لسانك حيث أطلقه الهوى
مرًحا و إن غلب السّرور لساني
أنا في ضميرك حيث باح فيما
أرى سِرًّا يخفيه ضمير زماني
أنا منك من القلب الصغير من
أجل خفق الربيع بذلك الخفقان
ب - الوحدة العضوية:
نادت جماعة الديوان بما أطلقوا عليه مصطلح "الوحدة العضوية" ،ويقصدون بها أن تكون الأبيات في القصيدة مقّيدة بموضوع واحد، حيث تكون الأبيات بنية واحدة، لا يمكن تقديم أو تأخير بيت منها، ومن أمثلة ذلك ما قاله العقاد في قصيدة "آه من التراب" التي قالها في رثاء الأديبة "مي زيادة"، ومطلعها :
أين في المحفل مني يا صحاب؟ عودتنا هاهنا فصل الخطاب
ج - طغيان المفاهيم الفلسفية على شعر هم :
وردت في أشعارهم أفكار ومفاهيم ذات نزعة فلسفية ، ومن ذلك قول عبد الرحمن شكري :
يحوطني منك بحر لست أعرفه ومهمة لست أدري ما أ قا سيه
أقضي حياتي لنفسي لست أعرفها وحولي الكون لم تدرك مجاليه.
د - الحديث عن الشكوى والألم والسأم :
حيث صوروا تلك المعاناة النفسية التي كانوا يحيونها ، وربما يعود ذلك للظروف الاجتماعية الخاصة أو ربما لتأثرهم بما يحتوي عليه الشعر الأوربي المضحون بأفكار الرومانسية التي غلب شعراؤها غالبا النزعة التشاؤمية ، ومن ذلك مقاله المازني :
قد وجدت السُّهد أهدى للأسى ووجدت النوم أشجى للحشى
شدّ ما يظلمنا الدهر، أهي يقظة دنيا و أخرى في الكرى
ويلي هذا القلب من صرفهما لا الكرى أمن و لا السهد رحمى
الرّدى إن كان لا شجى للردى إنه للنفس غوث و نجا
ه - اتجاههم نحو قول الشعر المرسل :
وذلك لتأثرهم بالمذهب الرومانسي الذي يزيل كل الحدود ويتيح الحرية الكاملة للشاعر للتعبير، يقول شكري في قصيدة " كلمات العواطف":
خليلي والإخاء إلى جفاء إذا لم يُغذه الشوق الصحيح
يقولون الصحاب ثمار صدق و قد يتلو المرارة في النهار
شكوت إلى الزمان بني إخائي فجاء بك الزمان كما أريد
و - تأثرهم في نظم الشعر بشعراء أوروبا:
لاسيما الشعراء الرومانسيين منهم مثل "هاملت"، وذلك بظهر بشكل جلي في دواوينهم كديوان "ضوء الفجر" للمازني، و"هدية الكروان" و"عابر سبيل" للعقاد، وديوان المازني.
ز - ربط الشعر بالمعجم الطبيعي:
وذلك بربطه أيضا بالذات والشعور، ومن ذلك تداولهم لكلمات معينة، مثل: الطبيعة -الأنهار- الجبال .... وكل هذه الألفاظ غابت في شعر شعراء مرحلة البعث والإحياء.
3 - مواقفهم النقدية:
لقد قام نقاد جماعة الديوان تحت حجة التجديد بالهجوم النقدي على الشعراء المحافظين أمثال شوقي وحافظ إبراهيم، ومن ذلك ما نجده في كتابات المازني النقدية، حيث جنّ جنونه بنقد شعراء عصره، وقد ساعده هذا النقد بتنويع شعره ونثره، وقد حملته هذه الروح الناقدة على نقد شاعر مثل حافظ إبراهيم واعتباره شاعراً تقليديا، مطبقا في ذلك ما جاء في كتاب "الديوان" من آراء نقدية وضعها العقاد، كما تعرض لشيء من ذلك في كتابه "حصاد الهشيم" الذي جعل منه موسوعة أدبية في الأدب العربي والأدب الغربي، وبهذه الجرأة النقدية بنشر مقالات أخرجها في كتاب سماه "فيض الريح" تعرض في الكثير منها بالنقد لآراء طه حسين في الأدب الجاهلي.
أما العقاد فكانت مواقفه النقدية أعمق من المازني في نقد الشعر عند معاصريه، لكونه أشد اطلاعا على ثقافة وعيون الشعر الأوروبي لاسيما الإنجليزي منه، وقد كانت آراؤه الجيدة في النقد ، قد أفادت الشعر المعاصر بطريق غير مباشر ،حيث حولت الكثير من الشعراء المعاصرين من ميدان التقليد إلى ميدان التجديد .
كما أن العقاد يختلف بكونه شاعرا عن كونه ناقدا، إذ كان له آراء نقدية تجديدية، لذلك كان صاحب ثورة نقدية ضد شوقي وشعره، وصاحب الدعوة العريضة إلى التحرر من ربقة التقليد الواضحة في شعر البعثيين والتي تأثر بها شوقي صاحب مدرسة التجديد الكلاسيكي
فالعقاد كشاعر لم يتحقق كل ما دعا إليه من آراء في تجديد الشعر، وربما كان صاحبه شكري أقرب إلى تطبيق هذه الآراء، وأنت حين تتصفح شعره تلمس فيه روح الناقد المفكر أكثر مما تلمس فيه روح الفنان المجدّد.
وينبغي ان نذكر في هذا السياق أن الحملة النقدية التي حملت بها جماعة الديوان على شعر حافظ إبراهيم وشوقي خاصة ، قد وجد من يتصدى له وينتصر لشوقي وينصفه منهم، من ذلك ما كتبه الناقد محمد حسين هيكل في مقدمة ديوان الشوقيات لأحمد شوقي ، ونحن نورد لك - أيها الطالب - بعض ما كتبه إتماما للفائدة وإنصافا للحقيقة النقدية ، يقول :" وقد يكون غلو شوقي أكثر وضوحا في جانب اللغة منه في جانب المعاني ، فهو بمعانيه وصوره وخيالاته، يحيط مما في الغرب بكل ما يسيغه الطبع الشرقي و ترضاه الحضارة الشرقية ، أما لغته فتعتمد على بعث القديم من الألفاظ التي نسيها الناس وصاروا لا يحبونها لأنهم لا يعرفونها ، ولعل سر ذلك عند شوقي أن البعث وسيلة من وسائل التجديد بل قد يكون البعث آكد وسائل التجديد نتيجة ما يوجد من أرباب اللغة ، ممن يفيضون على الألفاظ القديمة روحا تكفل حياتها ....ومن ذا يا ترى من أرباب اللغة قديرا قدرة شوقي على أن يبعث في الألفاظ القديمة ، وما تكفل حياتها في الحاضر ، ويفيض عليها من ثوب الشعر ويجعلها تتسع لملم تكن تتسع له من قبل من المعاني والصور ؟..
أيها الطالب إنك حين تقرأ من ديوان العقاد ما شئت من قصائد، فإنه لا شك أنك تلاحظ الفكرة العميقة والمعنى الدقيق يجذبان انتباهك، أما الصورة الفنية فلا تكاد تنفذ إلى نفسك إلا من وراء الفكرة، فهو مفكر أكثر منه شاعر، وحكيم أكثر منه فنان، والدليل على ذلك هذان البيتان :
دليل على أن الكمال محرم إناث خلقنا بيننا وذكور
فما المرء في جسم وروح بكامل ولكن كل العاملين متطور
فهو في هذين البيتين يقرّر حكمة من الحكم ، ثم يستدل بها بالشاهد والمثل من واقع الحياة، صنيعه في ذلك صنيع العالم الذي يستقرئ الأمثلة ليستدل على سلامة القاعدة أو النظرية.
ولعل عنصر التحليل والمنطق في شعر العقاد ، هو الذي جعل التكامل العضوي في قصائده أشد متانة في شعر صاحبيه، حيث يرى القارئ التسلسل واضحا في معاني القصيدة وفي بناء الأبيات، حيث لا يستطيع أن يقدم بيتا أو تؤخر آخر. وعلة ذلك هو عنصر المنطق والتحليل في شعره.
أما شكري فإننا نلمح روح الرومانسية لاسيما الجانب الحزين من الحياة، فمن ذلك قوله :
يا ريح أيّ زئير فيك يفز عني كما يروع زئير الفاتك الضّاري
يا ريح أي أنين حنّ سامعه فهل بليث يفقد الصّحب والجاز
يا ريح مالك من الخلق موحشة مثل الفارين غريب الأهل والدار
أم أنت شكلي أصاب الموت وحدها تظل تبغي يد الأقدار بالنار
لقد استلهم في هذا المقطع عنصر الخيال في الأدب الإنجليزي، وكأنه يحاكي خيال الشاعر الإنجليزي الرومانسي "شللي" في قصيدته "أغنية الريح الغربية"
4 - الاختلاف النقدي ونتائجه :
على الرغم أن جماعة الديوان جماعة نقدية كان لها الأثر الخالد في النقد، إذ أنهم اتفقوا على مبادئ ومقولات نقدية وطالبوا غيرهم من الشعراء بالالتزام بها، لكن هل كانوا مخلصين لهذه المبادئ النقدية الجديدة؟
يقول حامد حفني داود "إن الإنصاف للحقيقة يحملنا على أن نقول إن الناحية النظرية الناقدة في نفوس هؤلاء الشعراء كانت أعمق وأبلغ من الناحية التطبيقية ، وأن ثقافتهم التي استمدوها من الأدب السكسوني كانت أوسع مدى من شاعريتهم ، لكن هذا الحكم الذي حكمنا به عليهم، لم يمنع إطلاقا من إثباتهم بالجديد في دواوينهم
وبهذا فهم نقاد نادوا بآراء نقدية لظواهر نقدية جديدة في ذلك العهد ، لكن يصعب تطبيقها من قبل شعراء لم تكن لهم درُية ولا مراس شعري ،كما أنهم اختلفوا فيما بينهم حول عنصر الشعور في الشعر، فالعقاد يرى أن الشعر يترنح بين الشعور والفكر، لكن الفكر يغلب على الوجدان، ويرى شكري أنّ التأمل في الذات تأملا يتجاوز الواقع المباشر أما المازني فيرى أن الشعور ، هو كل ما تفيض به النفس من مشاعر وأحاسيس بعيدا عن تدخل العقل.
وقد نتج عن هذا الخلاف ، اختلاف مضامين شعر هؤلاء الشعراء، فكل شاعر يتصور الوجدان بمنظوره الخاص، كما أن تصورهم للوجدان جعلهم يتغلبون على عنصر الذات ويبتعدوا عن الواقع، لاسيما الذات المصرية، كما أدى ذلك إلى الشعور بالتشاؤم، والحزن عند استشراف المستقبل .
-
جماعة أبولو
1. التعريف والنشأة:
نشأت هذه المدرسة في العقد الرابع من القرن العشرين بعد الخلاف بين جماعة الديوان فيما بينهم، وسميت هذه الجماعة بهذا الاسم نسبة إلى مجلتهم "أبولو" التي ينسب اسمها إلى "أبولون" إله النور والفن والجمال عند اليونان، وهذا يدل على تأثرهم بالثقافة والآداب الغربية تأثيرًا كبيرًا.
وقد كان تأسيسها على يد الطبيب أحمد زكي أبو شادي، وكان خليل مطران أبا روحيا لها، وكان قد انضم لها شعراء من مصر ومن خارجها أمثال إبراهيم ناجي وعلي محمود طه، ويوسف السّباعي، ومحمد حسن إسماعيل وصالح جودت، وأحمد محرم.
وعلى الرغم من اتجاهها التجديدي إلا أنها جعلت أحمد شوقي أول رئيس لها تقديرًا لشاعريته، وعقد أول اجتماع لها في بيته ، وكان ذلك قبل وفاته بأربعة أيام سنة 1932.
تولى رئاستها بعده الشاعر خليل مطران، و انضم لها صادق الرافعي وأحمد الشايب ، ومما ينبغي ذكره ، أن شوقي أثنى في قصيدة على مدرسة أبولو بقوله :
أبو لُّلو مرحبا بك يا أبولوّ فإنّك من عُكاظ الشّعر ظِلُّ
عكاظُ و أنت للبلغاء سوق على جنباتها رحلوا وحَلّوا
عسى تأتينا أبوللو بمعلقات بروح على القديم بها ندلّ
لعل مواهبا خفِيت وضاعت تذاع على يديك و تستغل
أصدرت مجلة "أبولو" الذي كانت ملتقى الشعراء والنقاد، وكانت تُخطُّ فيها أقلام شعرية، أمثال: العقاد ومحرم والرافعي وزكي مبارك، وإبراهيم ناجي، وعبد الحميد الديب وسيد قطب ومحمود غنيم، ومحمد مهدي الجواهري، وإيليا أبو ماضي.
وعلى الرغم من أنها لم يتجاوز صدورها سنتين إلا أنها كان ذات تأثير واسع على الأدب والنقد، حيث كانت القصائد والدراسات فيها تترى حتى بلغت أربع مائة قصيدة وأربع مائة دراسة نقدية، وأصدرت دواوين مثل ديوان الينبوع وأطياف الربيع وفوق العباب لأحمد زكي أبو شادي وديوان الغمام لإبراهيم ناجي والألحان الضائعة لحسن كامل الصّيرفي.
2 - مواقف النقاد من جمعية أبولو:
كانت جماعة أبولو ترحب بكل ناقد أو شاعر يريد الانضمام إليها دون النظر إلى توجهه أهو من المحافظين أم من المجددّين؟ وقد وجد العقاد في هذا سبيلا إلى نقدها حين شارك في إصدار العدد الأول في مجلتها ، معترضا على التسمّية واستقبال كافة الكتاب والشعراء على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم الأدبية ، يقول: "مساهمتي في تحرير العدد الأول من مجلة "أبولو" ستكون نقدا لهذه التسمية التي لها مندوحة عنها فيما أعتقد، فقد عرف العرب والكلدانيون من قبلهم ربا للفنون والآداب وأسموه عطارد، وجعلوا له يوما من أيام الأسبوع، وهو يوم الأربعاء، فلو أنّ المجلة سميت باسمه ، لكان ذلك أولى من جهات كثيرة، منها أن أبولو عند اليونان غير مقصور على رعاية الشعر والأدب، بل فيه نصيب لرعاية الماشية والزراعة، ومنها أنّ التسمية الشرقية مألوفة في آدابنا ومنسوبة إلينا، وكذلك أرى أنّ المجلة التي ترصد لنشر الأدب الغربي والشعر الغربي لا ينبغي أن يكون اسمها شاهداً على خلوّ المأثورات العربية من اسم صالح لمثل هذه المجلة، وأرجو أن يكون تغيير هذا الاسم في قدرة حضرات المشاركين في تحريرها، لكن أحمد زكي أبو شادي، تصدى للرد عليه محتجا أن الجمعية لم تنظر إلى اسم "أبولو" كاسم أجنبيّ، بل كاسم عالمي محبوب، وأنه ليس انتقاصا للمأثورات العربية ، وأنّ النقل عن الكلدانيين ليس أفضل من النقل عن الإغريق.
لكن بعد أعوام قليلة انفرط عقد هذه المدرسة برحيل رائدها أحمد زكي أبو شادي إلى المهجر الأمريكي عام 1946 ، بعد أن ضاقت عليه سبل العيش في مصر، وبعد أن ضُيق عليه الخناق من قبل بعض من ينتسبون إلى الأدب .
3- معالم التجديد عند جماعة "أبولو" :
1 - مفهوم الشعر:
من بين الشعراء النقاد في مدرسة أبولو الذي أحمد زكي أبو شادي الذي أعطى مفهوما جديدا للشعر، وذلك حين لخّص حقيقة الشعر في قوله : "فالشعر في أية لغة بأحاسيسه وارتعاشاته وومضاته وخيالاته وبحقائقه الأولية ومثالياته، وإذا قدّرنا ألوان هذا الشعر المجرد أو المرسل أو الحّر أو الرمزي أو السريالي ونحوها، فليس معنى ذلك أننا نبخس الضروب الأخرى من الشعر حقها ، أو ندعو إلى إغفالها، كما يدعو إلى ذلك بعض الأدباء الذين لا يقدرون أن ثروة أية لغة هي مجموع آدابها، وأن الخير في تنوع ضروبها، لا في حصرها، ومذهب الحصر مضاد للحرية، في حين أنّ الحرية هي صديقة الآداب والفنون بل والمعارف عامة، فالإملاء على الشعراء والتحكم فيهم ،هو أولا قتل لمواهبهم ثم قتل للشعر، ثم إفقار للغة وآدابها "
2 -التجديد في شكل القصيدة ومضمونها:
أ -التجديد في البناء الفني:
ويتضمن التجديد في الألفاظ، وابتكار ألفاظ تختلف في دلالاتها عن دلالتها القديمة، وقد أعانهم على ذلك استخدامهم للتعبير الرمزي في معظم الحالات، لذا جاءت ألفاظهم عذبة وقصائدهم مشحونة بمعاني التفاؤل مثل كلمات : الشمس-المطر-الشفق السحري - الليل الأبيض - النور الهادي وغيرها من الألفاظ الرقيقة معنى ومبنى، كما أنهم أدخلوا في بعض قصائدهم ألفاظا أعجمية ، وكان الرائد في ذلك أحمد زكي أبو شادي وتلك الكلمات مثل : صموئيل - زيوش...
ب - التجديد في البناء العروضي :
تمثل هذا التجديد في الشعر الحرّ و يظهر جليا في تنّوع القافية والوزن ،حيث مزجوا بين بحور مختلفة في القصيدة الواحدة ، مع التنويع في الوزن القافية، وقد كتب أحمد زكي أبو شادي قصائد من هذا النوع منها : قصيدة "مناظرة وحنان" و "الشراع"، كما حاول ذلك أبو القاسم الشابي في قصيدة "الصباح الجديد"، وإبراهيم ناجي في قصيدة "عاصفة روح".
وقد أبدعوا حين جددوا في المجال العروضي لما كتبوا في الشعر المرسل ، وهو ما يلتزم فيه الشاعر ببحر واحد، لكن يتحّرر من القافية، وقد كتب في هذا النوع أمد زكي أبو شادي في ديوانه "الشفق الباكيّ"، أما الشعر المنثور وما هو ما لا يتقيد بوزن ولا قافية، وإنما يعتمد على جمال الصورة والألفاظ وجرسها الموسيقي، وتصوير العواطف، وينبغي أن ننبّه هنا على أن التجديد العروضيّ لم يكن مقصودا لذاته، وإنما كان وسيلة لهدف كان يرمي إليه شعراء هذه المدرسة وهو تحرير الشعر من الطابع الغنائي، لكن ينطلق في الوقت نفسه في الظهور ضمن أنواع أخرى لم يشهدها الشعر العربي القديم ، ومن الأمثلة على هذا التجديد أنهم كتبوا قصائدهم في نوع جديد هو الشعر القصصي.
أ -الشعر القصصي:
اقتحم أحمد زكي أبو شادي هذا اللون من الشعر، وقد طوع شعره هذا بالروح العالمية وافتقاره إلى الشاعرية والنظرة الناقدة والفكرة العميقة، ومن أمثلة هذا الشعر عند هذا الشاعر قصيدة "مملكة إبليس".
ب -الشعر التمثيلي:
تعتبر جماعة أبولو من الجماعات النقدية والأدبية الرائدة في محاولة إدخال الشعر التمثيلي في الشعر العربي الحديث، من ذلك "حديث الآلهة" لمحمد سعيد السّحراوي، و"غادة المحيط" لعبد الغني الكتبي، وبعض هذه الأعمال كانت مترجمة مثل ترجمة عامر بحيري لمسرحية "شكسبير "الموسومة بعنوان " ماك باث.
نستطيع القول إن شعراء أبولو جددوا في الألفاظ من خلال مجال الشعر الحرّ، والشعر المرسل وكذلك الشعر المنثور، كما اجتهدوا في إظهار الشعر القصصي والتمثيلي، لكن كل هذه الأعمال لم يُكتب لها النجاح والانتشار، واللون الشعري الوحيد الذي كتب له النجاح هو الشعر الغنائي عند شعراء هذه المدرسة.
3- التجديد في البناء الفني :
التجديد الفني هو التجديد في تنسيق الأفكار والصور الشعرية والأخيلة والعواطف، ومراعاة التناسب بينها وبين الشكل الخارجي، بحيث يخرج العمل الفني متكاملا في الأجزاء، مناسبا للشكل ومن بين الأفكار التي نادوا بها في مجال البناء الفني الوحدة العضوية ، وإن كانت هذه الفكرة ليست من ابتكار جماعة أبولو، لأنه قد سبقت بها جماعة الديوان التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، لكن جماعة الديوان لم ينجحوا في تطبيقها بينما جماعة أبولو تمكن شعراؤها من تحقيقها في أشعارهم ، وبهذا استطاعوا أن يبنوا قصائدهم عليها دون فكرة البيت الواحد، و بذلك أعطوا للقصيدة صورة حّية متكاملة .
وإذا تأملت أيها الطالب في قصائد إبراهيم ناجي وأبي القاسم الشابي وعلى محمود طه، ترى فكرة الوحدة العضوية ماثلة بين يديك، ممزوجة في الوقت نفسه بالصورة الفنية والمعاني المفعمة بالخواطر والتأملات في الحياة.
أما مضمون القصائد عندهم فإنه يتجه نحو الذاتية والتعبير عن الوجدان الفردي، وذلك لاعتمادهم على التجربة الذاتية، حيث تعمقوا في تصوير أعماق النفس الإنسانية يرسمون هواجسها، وأحيانا يغلب على قصائدهم الحزن المؤلم، وأحيانا أخرى يصورون الطبيعة ومروجها وأنهارها... وبهذا تفوّقت هذه المدرسة على جماعة الديوان بفضل هذا التنويع في المضامين
4 - الرسالة الشعرية :
والمقصود بها الهدف الذي من أجله ينظمون شعرهم، ويتمثل في أفكارهم الاجتماعية والقومية والإنسانية، لذلك عبروا عن تجاربهم بحرية تامة واهتموا بتأملاتهم في الحياة من منظور أدبي تارة ومن رؤية فلسفية تارة أخرى.
5 - القصيدة الشعرية عند جماعة أبولو :
أعطى هؤلاء الشعراء نظرة تصّورية للقصيدة الشعرية، إذ جعلوا من نظم الشعر وسيلة لتطبيق أفكارهم الأدبية والنقدية، وبذلك تميّزت القصيدة عندهم بخصائص أدبية، يمكن أن نقول إنها من المنظور النقدي معالم نقدية خاصة بمدرستهم، وتلك المعالم ساهمت في إعطاء القصيدة العربية في العصر الحديث صورة من صور التجديد، في ميدان النقد الأدبي الحديث .
ونحن نذكر لك - أيها الطالب - جملة من تلك الخصائص على سبيل الإجمال والتمثيل لا على سبيل التخصيص والحصر :
أ - بناء القصيدة من حيث مضمونها على الوجدان والخيال، بحيث يصير كل من الوجدان والخيال منسجما مع الأفكار، وبهذا صار هذا المنظور للقصيدة فكرة نقدية لا تغادر قصائدهم ، بل صارت عرفاً أدبيا ونقديا كأنما قُدّت أفكاره من حديد.
ب - اعتمدوا على مخاطبة الطبيعة ومسائلة مظاهرها وربطوها بالوجدان، فصار شعرهم أشبه بالشعر الصوفي من حيث رقة الشعور والأحاسيس النفسية، وأدنى من الشعر الفلسفي المتميز بالرؤية الذاتية في تأمل البيئة والحياة.
ج-اتخاذهم من الرّموز المستوحاة من الطبيعة غاية للتعبير عن أهدافهم الإنسانية أو الاجتماعية أو الوطنية، وقد أحسنوا استعمال الرّمز الممزوج بالخيال العميق، في حديثهم عن كثير من القضايا المتنوعة.
د -رفضهم لتقليد الشعراء القدامى لأنهم رأوا في ذلك جمودا وابتعادا عن الحرية الأدبية، فكان كثير منهم قد أعرض عن التقيّد بالقوافي والأوزان الموروثة من لدن القصيدة العربية القديمة، كما أعرضوا عن طريقة القدماء في وصف الطبيعة ، إذ لم يقتصروا على ذكر الملامح الجمالية للطبيعة، بل أحاطوها بإيحاءات مظاهرها وتفسير جوهر وروح الأشياء فيها.
ه - إطلاق العنان لحرية الشاعر في أن يسلك الشاعر كل ضرب يروق له من ضروب الأساليب ، وطرائق التفكير وأنواع الخيال وأصناف العاطفة والشعور، وأن يستمد من الموروث الشعري أو الفلسفي أو الديني ما شاء، سواء أكان ذلك من التراث العربي أم من التراث الأجنبي.
6 - جماعة أبولو ومكانتها في النقد الأدبي الحديث :
سبق وأن قلنا بأن هذه الجماعة اتخذت اسمها من إله الشعر المزعوم "أبولو" عند الإغريق، إذ هو ربّ كل شعر يقال، لا يفرّق في ربوبيته بين شعر وشعر ولا بين مذهب وآخر، لكن هذا التحرّر لم يمنع بعض الشعراء الكلاسيكيين من أمثال أحمد شوقي أو أحمد محرم أو مطران ، أو ممّن بالغ في التأثر بالآداب الغربية كأحمد زكي أبي شادي وإبراهيم ناجي وعلي محمود طه أن يكون منتميا إليها ، فقد جمعت مذاهب وتوجهات شعرية شتى لشعراء ذوي نزعات أدبية مختلفة ، حتى كان فيها من هو ذو توجه كلاسيكي قديم زمن هو ذو تصور رومانسي مجدد، وفي هذا من الاختلاف الأدبي ما لايخفى، وقد تركنا لك أيها الطالب أن تتصور ذلك التباين بين الاتجاهين
لذلك يقف شوقي ضيف موقفا نقديا في حكمه على هذه المدرسة، قائلا : "فهي جماعة تفقد التخطيط الفني منذ أول الأمر، ليست كجماعة الجيل الجديد السابقة - جماعة الديوان - التي حملت مذهبا أدبيا بعينه ضد شعراء مدرسة البعث ، وظلت تدافع عنه آمادا طويلة، وتنتج تحت شعاره دواوين من ذوق معيّن ووجهة معيّنة
لكن إنصافا للأمانة النقدية ، نقول إن هذا الحكم فيه شيء من الإجحاف في حقّ هذه المدرسة ، حيث حملت هذا الحكم النقدي كثيرا من الشّطط، وذلك أنه أراد من هذه المدرسة أن يلتزم شعراؤها بمذهب معيّن من مذاهب الفنّ المعاصر، وقد فات صاحب هذا الحكم أن طبيعة الفنّ والأدب تقتضي الانطلاق التام وخضوع الشاعر لجميع ما يحيط به من تيارات وأفكار معاصرة ، فالأدب لا يعرف الحواجز بين مذاهبه المختلفة، فالشاعر الرومانسي لا يمنع كونه رومانسيا من أن تظهر في شعره بعض سمات الرمزية أو الواقعية، وكذلك الشأن في الشاعر الرمزي أو الواقعي، فالتداخل بين المذاهب عند الشاعر لا يتعارض مع طبيعة الفنّ، بل على العكس من ذلك يعتبر دليلا صادقا على فنيّة الشاعر.
وقد تولى أحمد زكي أبو شادي الدفاع عن هذه المدرسة في مهارة نقدية قائلا : " ألوان الشعر هي أصلا ألوان الشعور ، سواء أكان بسيطا أم مركبا، وكما أن ألوان الشعور لا عداد لها ولا حدود ، فكذلك ألوان الشعر، والشعر المطبوع في لفظه ومعناه وموسيقاه وفيما يخلقه حوله من أخيلة وخواطر ووحدة منسجمة.... إنه كائن فنّي حيّ، والكائن الفني الحيّ لا يشرح بل يقرأ أو يسمع أو يستوعب، فتحسّ النفس أثره، وبقدر هذا الإحساس تكون استجابتها لذلك الشعر ولصاحبه، ومن ثمّ كان تنوّع الأذواق وتنوّع الأحكام، فالشعر كفنّ جميل ليس مسألة علمية مقرّرة ثابتة، لا تتحمل إلا رأيا واحداً في حدود المعرفة الميسورة ، وإنما هو أمواج أثيرية كأمواج التلفزيون، قد يلتقطها الجهاز المستقبل القوي المتلقي كما لا يلتقطها سواه ، ودرجات الالتقاط لا تختلف باختلاف الأجهزة فحسب، بل باختلاف المحيط أيضا، وهكذا نشأت آراء ومذاهب شتى في الشعر تبعا للإحساس به، وعلينا أن نفترض الإخلاص في كل من هذه الآراء والمذاهب ،وأن نقدر أصحابها على تباين آرائهم وأحكامهم ، أما الذي لا عذر له فهو الانتقاص الذي يزجيه حبّ الهدم، وأما الذي لا يقدر فهو التشريح الذي يعبث بالأثر الفني، كأنما هو جيفة تحت المبضع .
-
الرابطة القلمية
1 – التـأسيس:
مرت مدرسة المهجر بمراحل تاريخية وأخذت مسميات مختلفة، وفق الظروف التاريخية والاجتماعية التي كانت تعيشها في البيئة الأمريكية ، ومن ثم انقسمت مدرسة المهجر إلى مدرستين هما مدرسة الرابطة التعليمية وجمعية العصبة الأندلسية .
أ - جمعية الرابطة التعليمية:
هي جمعية أدبية أسسها شعراء وأدباء هاجروا من الشام (سوريا ولبنان خاصة)، إلى أمريكا و مكثوا بها ،و تحديدا في مدينة نيويورك سنة 1920م، وكان جبران خليل جبران رئيسا لها ، وكان قد انتمى إليها أدباء من أمثال عبد المسيح حداد، ونسيب عريضة، ورشيد أيوب، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، وإيليا عطاء الله، وغيرهم كثير، وقد كان هدفهم الأول هو :" أن الأديب قد يكون مبحث التجربة الأدبية لديه، بل ومما يدخل في تكوين عناصر ها الفنية ما يرجع إلى المعارف والعلوم الإنسانية على نحو يجعل منها مصدرا لمقومات تلك التجربة ... وأن الأدب صور من التعبير والتفكير الإنساني الأخرى ، تكون ذات صبغة فتية مثل الموسيقى والرسم والنحت والتصوير "
وقد دامت الرابطة التعليمية عشرة أعوام، وكان أعضاؤها ينشرون إنتاجهم الأدبي في مجلة الفنون ثم في مجلة السّائح، وقد توقف نشاطهم بوفاة جبران خليل جبران وبعد ذلك تفرق أعضاؤها بالعودة إلى الوطن أو بالوفاة.
ب.- جمعية العصبة الأندلسية:
كان تأسيسها سنة 1932 في البرازيل ، وربما حملت هذا الاسم الجو الإسباني الذي كان يسود الحياة العامة، فأثار ذلك في نفوس أدبائها ذكريات الأندلس المفقودة ، فحاولوا أن يعيدوا ذلك المجد التّليد، وكان لهم مجلة تسمى "الأندلس الجديدة" ثم مجلة العصبة الأندلسية التي صدرت أعدادها عام 1934م ، وقد كان تولى رئاستها الأديب حبيب مسعود ، وقد استمرت إلى عام 1960 مع فترات انقطاع.
وبعد هذه الفذلكة حول تأسيس مدرسة المهجر ، ينبغي أن ننتقل بك – أيها الطالب – إلى التعرف على تصورها للشعر ومنظورها حوله.
3 - منظور شعراء الرابطة التعليمية للشعر الحديث:
كان لأدباء الرابطة التعليمية نظرة خاصة للشعر، وكان أبرز من مثل الجانب النقدي لهذه الجماعة هو ميخائيل نعيمة، في كتابه "الغربال". إذ حدد فيه عدة مفاهيم نقدية، منها مفهوم الشعر ومفهوم الأدب والأديب وغيرها من القضايا النقدية ...، ومن هنا يمكن أن نتساءل، ما مفهوم الشعر عند ميخائيل نعيمة من خلال كتابه "الغربال"؟ لكن قيل الحديث عن الشعر ينبغي الحديث عن مفهوم الأدب ومفهوم الكاتب عند ميخائيل نعيمة .
أ - مفهوم الأدب:
كان الهدف من كتاب الغربال الصادر في طبعته الأولى 1923، هو وضع تصور نقدي مغاير للتصورات النقدية السابقة لمدرسة المهجر، وبالتالي دعوة إلى ادب جديد أيضا، يظهر جليا في الهجوم على كل ما يتصل بالأدب العربي القديم، وما فيه من لغة قديمة ونظام قصيدته القديمة التقليدية التي سن نظامها الخليل بن أحمد الفراهيدي ، وقد كان تصور الأدب من خلال كتاب الغربال بالنظرة الإنسانية المعبرة عن الحياة النفسية والاجتماعية، وكان هذا المنظور ناتجا بسبب احتكاكه بالأدب الروسي ، هذا الأدب الذي يلتزم بما يدور داخل مجتمعه من ثورات وتغيرات، لكنه لما احتك بالمجتمع الأمريكي صار ينظر إلى الإنسان كوحدة مستقلة في الوجود وليس كفرد في المجتمع.
والأدب عند ميخائيل نعيمة هو القدرة على استكشاف باطن الإنسان وحقيقته الباطنية، ومثالها النموذجي مسرحيات الشاعر الإنجليزي شكسبير التي عالج منم خلالها الجوانب الإنسانية في المجتمع والقيم الحضارية التي ينبغي أن يكون عليهما الإنسان عامة في مجتمعه، وبذلك يكون " الأدب الحي هو الذي يتقبل كل جديد ويرحب بالتأثر مادام هذا الجديد ينفعه أو ينعشه أو بدفعه إلى الأمام ، ويجب أن يكون للأدب الحي جذور عميقة وركائز ثابتة ، حتى إذا هبت رياح التأثير لم تقلعه من جذوره"
ب - مفهوم الكاتب:
الشاعر في نظر صاحب كتاب "الغربال" ، هو الذي يبصر بقلبه الحقائق التي لا يمكن أن يراها غيره من الناس، وهو الذي يعطينا من كل شيء في الحياة شيئا مفيدا، ومن ثم فهو الذي وهبته الطبيعة موهبة إدراك الحقيقة قبل غيره، وبهذا فالشاعر ليس كغيره ، فهو يتمتع بقداسة الفيلسوف والمبدع والمصور الذي يرى بروحه ، ويحول ما يقع عليه بصره إلى مشاهد فنية فريدة ، كل ذلك بفضل الخلق والإبداع الفني مع شيء من موسيقى الكلام ، وهو في خضم ذلك الإبداع يدرك الأصوات متناسقة تناسقا جميلا مما يدل على مقدرته الشعرية، بينما غيره لا يدركون هذه الموسيقى التي تقع خلف الكلمات وتقبع وراء الأصوات، " يخلق الكلتب نفسه في كل ما يكتب ولولا ذلك لما كان للكتابة من معنى ، والكتاب في مظري ثلاثة كاتب يجره زمانه وكاتب يجاري زمانه ، وكاتب يجر زمانه ، والأخير أصلبهم عوذا و أندرهم وجودا"
ج - مفهوم الشعر:
تنطلق رؤية ميخائيل نعيمة للشعر الحديث من رؤيته وتأثره بالشعر والأدب الروسي، إذ رأى فيه ثورة على الماضي و أملا في نشدان الحرية التي تنبثق من عبق الشعر القديم، و لميخائيل ثناء على أحد الأدباء الروس هو ّ"تولستوي" قائلا :" سيحيا تولتستوي وسيبقى عظيما لأنه كانت عظيم ولأنه حاول أن يحيا حياة العظماء من المصلحين والأنبياء ، لقد كان عملاقا من عمالقة الروح والقلم وعظمته ليست في حاجة إلى نهايتها ولكننا في حاجة إلى تأدية الشهادة ، لعلنا نتجمل بجمال تلك العظمة ، وبمجدها نتمجد " [1] كما كانت رؤيته متأثرة بالمذهب الرومانسي وشعرائه، لا سيما الإنجليز منهم خاصة. وهكذا كان الشعر عنده يصور أولا أوضاع الإنسان الغربي الاجتماعية وواقعه المتخلف، مستشرفا أنواع التغيير والإصلاح ،كما كان يصور النزعة الروحية داخل الإنسان ، ذلك الكائن الذي يريد التغلب على أهوائه ويعيش في ظل الحرية، الشيء الذي جعله في أواخر حياته يتخلى عن الجانب الواقعي في الشعر ، ويهتم أكثر بالجانب الروحي فقط.
د - مفهوم اللغة:
اللغة هي الأهم عند ميخائيل نعيمة إذ هي الوسيلة التي بها يبدع والأداة التي بفضلها ينماز بأسلوبه على أقرانه، وفي نظره أنه لا يوجد في الحياة لغة كاملة لتأدية كل انفعالات النفس وعواطفها وأفكارها، وكل قاعدة لغوية قيمتها مرهونة يقدر خدمتها في توضيح المعنى من التعبير، فاللغة الجيدة هي اللغة التي تستطيع التعبير عن مضمون القلب ولب الأفكار ، أما لغة اللسان فلا يمكن أن تفعل ذلك ، لأنها لا تزيد على أنها قواعد وصيغ لغوية لا غير، يقول مبينا أهمية اللفظة اللغوية " أعرف أن للكلمة حياة متحركة ، وإنها في أدق معانيها رمز لما هو أكبر منها وأوسع وأعمق ، ولكنني أعرف كذلك أن للكلمة الحية مفاصل وجذورا ، وأنها كغيرها من مظاهر الحياة المتحركة ـ، تخضع لنظام فإذا هي انخلعت من مفاصلها وأفلتت من نظامها ، وفاتت على القارئ معانيها وباتت أحاجي لا يستطيع فكها إلا السحرة والمنجمون ، وما كل قارئ بساحر وما كل قارئ بمنجم"
ه - مفهوم النقد:
كان ميخائيل نعيمة يسعى من خلال كتابه إلى وضع تصور نقدي ، يكون في مجمله مشحونا بأفكار نقدية ، تقف موقف النقيض من أفكار ومضامين الأدب العربي القديم سواء أكان ذلك في الشعر أو في النثر، وقد أحسن في ذلك حيث ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي ، وذلك أنه أدرك أن الأفكار النقدية النظرية إذا لم تجد سبيلا إلى التطبيق فستبق أطرا فارغة ليس لها فائدة تذكر، لذلك قسم كتابه شطرين ، حيث تناول في الشطر الأول أشياء نظرية ، بينما جعل شطره الآخر خاصا بالمقاييس النقدية التطبيقية ، ومن خلال هذا التصور، قام بنقد بعض الكتب النقدية، وإعطاء رؤى نقدية حول محتوياتها الأدبية والنقدية.
وقد كان - في ذلك كله - معترفا ومتأثرا بالأفكار النقدية الغربية، والإقبال على الأجناس الأدبية الغربية ذات الطابع الإنساني، كالمسرح الذي يراه وسيلة مثلى في تحقيق نهضة أدبية نقدية، ولذلك دعا إلى ترسيخ المسرح في قائمة الإبداع العربي في مجال الأدب.
ولا بد أن تعلم – أيها الطالب - إلى أن كتاب الغربال احتوى على إحدى وعشرين مقالة، خص بعضها للهجوم على الأدب القديم مثل مقالة "الحباحب" ومقال "نقيق الضفادع" ومقال "الزحافات والعلل" للهجوم على علم العروض، كما تعرض بالنقد ليعض دواوين عصره مثل ديوان "القرويات " وديوان "الريحاني وعالم الشعر" وغيرها.
لكن يرجح النقاد أن نقده على امتداد كتابه " الغربال" كان في أغلبه ذاتيا، لأنه يعتقد أن لكل ناقد غرباله، ولذلك يرى صفات الناقد من منظوره الخاص ،ومن هذا المنظور الذاتي يضع له شروطا ، يمكن سردها بإيجاز ، وهي الإخلاص وحب صناعة النقد والذوق والشعور الرقيق، والفكر اليقظ، والبيان الحسن.
إضافة إلى هذه الشروط، فقد وضع مقاييس نقدية ، يمكن ذكرها كما يلي:
1. حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتابنا.
2. حاجتنا إلى نور نهتدي به في الحياة.
3. حاجتنا إلى الجميل في كل شيء.
4. حاجتنا إلى الموسيقى، والشعر الجديد البعيد عن الأوزان والقوافي العربية القديمة، وفي ذلك يقول متحدثا عن خصائص هذا الشعر : " ولا أعني أنه لا يمت بصلة إلى البحر المعروف بذلك الاسم من بحور الشعر العربية ، ولكم في الكلمة ما يعني الإطلاق... الحركة تجري إلى هدفها بسهولة وبغير قيد وتلك هي أبرز صفات هذا النوع من الشعر ، فهو لا يتقيد بوزن ولا قافية بل يجري على السجية جريا وليس يخلو من الإيقاع والموسيقى والرنة الشعرية ..."
4 - الأفكار النقدية للرابطة القلمية :
1 - التأثر بالمذهب الرومانسي وذلك يظهر في الموضوعات التي صاغوا بها قصائدهم واللغة التي كتبوا بها شعرهم، حيث ظهرت خصائص المذهب الرومانسي بشكل جلي في مخاطبتهم للطببيعة ومساءلتهم للنفس البشرية مع مصاحبتهم للخيال والتصوير الفني في جل أشعارهم .
2 - نادوا بضرورة التجديد في الأدب سواء كان ذلك في الشعر أم في النثر، وذلك أن أغراض وأنواع الشعر القديم لم تعد توائم الحياة الجديدة التي صارت الأمة تحياها ، وأصبح الشاعر يحس بها ويتأثر لأجلها.
3 - توثيق صلة الشعر بالحياة الإنسانية الواقعية، لأن الشعر في نطرهم رسالة تتصل بواقع الشاعر أولا و بحقيقة الحياة عند عموم الناس ثانيا
4 - إهمالهم ثنائية الشكل والمضمون واعتبارها من موروثات الأدب القديم.
5 - الخروج عن نظام القصيدة العمودية و ذلك بالتنويع في القوافي والبحور، واعتبار ذلك قيود للشاعر وأغلال تعيق انطلاقه نحو الإبداع .
6 - الحنين إلى الوطن، واستذكار الماضي الذي عاشوه أيام الصبا والطفولة في بوادي وأرياف لبنان ، وذلك بذكره في إبداعاتهم الشعرية والنثرية.
7 - النزعة الإنسانية واستعمال اللغة السهلة المعبرة عن روح العصر.
8 - الوحدة العضوية والموضوعيةـ ،وهم في ذلك يضاهون جماعة الديوان وجماعة أبوللو.
9 - الاهتمام بشكل جلي وواضح بالصورة الفنية واعتبارها مدار الإبداع الشعري ، والتمرد - في الوقت نفسه - على الأوزان الخليلية القديمة، من أجل إبداع القصيدة العربية وبنائها وفق هيكل شعري حديث يساير مقتضبات عصرهم ومتطلبات طموحاتهم الوطنية ونزعتهم القومية ونظرتهم الإنسانية.
- استعمالهم للرمزية وذلك يظهر في شعر إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة ، ونحن نختار لك - أيها الطالب – للتدليل على ما قلناه لك قصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي ، استخدم فيه الرمزية ، وعنوانها " التينة الحمقاء" التي يصور فيها عزمها على عدم الإثمار والإيراق كيلا يستفيد منها بشر أو طير ، هذا هو الظاهر ، أما رمزها فهو الرجل البخيل الذي نهايته الإهمال ثم الفناء في الأخير ، كما كانت نهاية هذه الشجرة الاجتثاث ثم الاحتراق ، ونلك نهاية كل من لا يجود بما منحته الحياة من نعم.
-
المنهج الــنّــفــــسـاني
1. مفهوم المنهج النّفساني:
المنهج النّفساني هو منهج نقدي يقوم بدراسة الأنماط أو النّماذج النّفسية في الأعمال الأدبية، ودراسة القوانين الّتي تحكم هذه الأعمال في دراسة الأدب، وربط الأدب بالحالة النّفسية للأديب. ويستمدّ النّقد النّفسي آلياته النّقدية من نظرية التّحليل النّفسي psychanalyse، والّذي أسّسه سيغموند فرويد s. freud (1856-1939) في مطلع القرن الفائت، و الّذي فسّر على ضوئها السّلوك الإنساني بردّه إلى منطقة اللاوعي (اللاشعور).
وخلاصة هذا التّصور أنّ في أعماق كلّ كائن بشري رغبات مكبوتة، تبحث دوما عن الإشباع في مجتمع قد لا يتيح لها ذلك، ولما كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة في لاشعوره، فإنّه مضطّر إلى تصعيدها؛ أيّ إشباعها بكيفيات مختلفة ( أحلام النّوم، أحلام اليقضة، هذيان العصابيين، الأعمال الفنية )، كأنّ الفنّ – إذن – تصعيد وتعويض لما لم يستطع الفنان تحقيقه في واقعه الاجتماعي، واستجابة تلقائية لتلك المثيرات النّائمة في الأعماق النّفسية السّحيقة، والّتي قد تكون رغبات جنسية ( بحسب فرويد )، أو شعورا بالنّقص يقتضي التّعويض ( بحسب آدلر)، أو مجموعة من التّجارب والأفكار الموروثة المخزّنة في اللاشعور الجمعي (بحسب يونغ).
2. مدرسة التّحليل النّفسي عند سيغموند فرويد s. freud :
يرتبط ظهور النّقد النّفسي بمدرسة عرفت باسم مدرسة التّحليل النّفسي ، والّتي عدّت ثورة على النّزوع الجسدي في الدّراسات النّفسية واتجاهها نحو سيكولوجية الأعماق. وهي من المدارس الّتي بدأت منها الانطلاقة الحقيقية والمنظّمة للنقد النّفسي، وذلك في بداية القرن الفائت. ويعتبر فرويد freud: " أوّل من أخضع الأدب للتفسير النّفسي، كان شغوفا بقراءة الآثار الأدبية، شديد الإعجاب بالشّعراء والأدباء، لأنّ الشّاعر رجل تراوده الأحلام في اليقضة كما تراوده في نومه، ولقد وهب أكثر من أيّ إنسان آخر، القدرة على وصف حياته العاطفية، وهذا الامتياز يجعل منه في رأي فرويد ، صلة وصل بين ظلمات الغرائز ووضوح المعرفة العقلانية المنتظمة".
واستطاع فرويد freud أن يصف الجهاز النّفسي الباطني، وقسّمه إلى ثلاثة مستويات، وهي كالآتي:
- الشّعور أو الوعي: ويضم وظيفة الإدراك للجهاز الحسي، وجميع التّصورات والمشاعر الّتي يعيها المرء في وقتها.
- ماقبل الشّعور أو ما قبل الوعي: ويضم جميع التّصورات والمواقف الّتي لم يتم الوعي بها في وقتها، لكّنها قابلة أن توعى في أيّ وقت.
- ما بعد الشّعور أو العقل الباطن: وهي الإضافة الجديدة تميّز بها فرويد، ويتميّز العقل الباطن بأنّ مضامينه لا يمكن أن تصبح واعية، لأنّ رقابة ما قبل الوعي تمنع عنها الوعي، وهذه الرّقابة تضم نواهي مأخوذة من العالم الخارجي، كما تضم مجالات أصبحت بذاتها لا شعورية ولا واعية.
وتقوم مدرسة التّحليل النّفسي على فرضية اللاشعور، والّتي تنقسم بدورها إلى ثلاثة عناصر متصارعة، وهي كالآتي:
- الهو ( le cas) : وهو مزيج من الوعي و اللاوعي.
- الأنا ( le moi ) : وهو الإنحراف أو الرّغبة في إشباع الشّهوة.
- الأنا الأعلى ( le sur moi ) : هو النّزوع المثالي عند الإنسان.
ومن رواد مدرسة التّحليل النّفسي نجد تلميذ فرويد، وهو السّويسري كارل جوستاف يونغ (1875-1961)، والّذي استبدل اللاوعي الفردي - عند فرويد - باللاوعي الجمعي. وأضاف مصطلح ( الوعي الجماعي واللاشعور الجمعي). وجاء بعدهما إدلر، ويرى (يونغ) أنّ الرّواسب اللاشعورية الجمعية وهي ما تسمى( النّماذج الأولية) هي الّتي تبدو لنا في شكل رموز مألوفة، عابرة لحدود الزّمان ونفوس الماضي من الأجداد. وهي الرّموز الّتي يتّخذ منها المبدعون الحدثيون موضوعا لعملهم الإبداعي.إذ يتّخذ الرّمز اللاشعوري الجمعي الماضي قيمة في حضوره الإبداعي الحديث ممّا يفسّر استمرار تشّكل النّموذج ودوامه في الأدب.
3. النّقد النّفسي عند شارل مورون وجاك لاكان:
أ. النّقد النّفسي عند شارل مورون (charles mouron):
وقد تجلّت قيمة أعمال مورون حين ظهر له كتاب هام في عام 1962، تحت عنوان "الاستعمالات الملحة والأسطورة الشّخصية". ومن الجلي أنّ قيمة مورون النّقدية قد سبقت ظهور مؤلّفه هذا، وإن كان من المؤكّد أنّ أصداء نشر الكتاب في مجال التّحليل النّفسي، ومجال الدّراسات النّقدية والأدبية، قد عمل على ذيع صيت مورون، وقد فطن النّقاد والمحلّلون النّفسيون إلى أعماله الّتي تعدّ بحق بمثابة مساهمة جديدة في مجال النّقد النّفسي نظرا لأنّها تدعو إلى ارتياد عالم الأثر باعتباره ظاهرة فنية لغوية، لا وثيقة معرفية. وقد حدّد مورون المراحل الأساسية في نقده النّفسي، وهي كالآتي:
- مواكبة نصوص كاتب واحد بعضها على بعض، من أجل بنية العمل الأدبي اعتمادا على شبكة التّداعيات الحرة.
- إظهار الصّور والمواقف الدّرامية ذات العلاقة مع الاستيهامات.
- الأسطورة الشّخصية للكاتب حيث يشتمل كلّ نتاج أدبي على مجموعة من الصّور الخاصة الّتي تتّخذ مظهرا دراميا وتتكرّر بأشكال متباينة.
- فحص نتائج القراءة المباشرة بواسطة معطيات حياة الكاتب الّتي لا تهمنا إلاّ بقدر ما تترك على نفسيته من آثار سيكولوجية.
ب. النّقد النّفسي عند جاك لاكانjacques lacan) ):
اعتمد جاك لاكان (1901-1981) في نقده النّفسي على طروحات سيغموند فرويد، حاملا شعار "العودة إلى فرويد" ، وهذا من خلال التّأكيد على منظومة اللّغة في علاقتها باللاوعي، ووصفها بمرآة اللاوعي، واكتشاف أهمية الدّال في قيادة الوعي الذّاتي للشخصية الانسانية، وهذا من خلال دراسته التّحليلية لرواية غراديفا ( Gradiva).وانطلاقا منها وضع لاكان مفاهيمه الخاصة في نقده الأدبي، وهي على النّحو التّالي:
- البنية اللّغوية للاوعي: يربط لاكان بين اللاوعي والبنية اللّغوية، ليعبّر عن سلطة اللّغة ضمن اللاوعي، ويقول على غرار فرويد " أنا أفكر حيث لا أوجد، إذن أوجد حيث لا أفكر".
- مرحلة المرآة: تعتبر مرحلة المرآة الانطلاقة الأولى لتعرّف الانسان على ذاته من خلال الآخر، وفي هذه الحالة فالآخر هو تلك الصّورة الّتي يكتشف وجودها، و يجري في نفس الوقت عملية مطابقة بينها و بين ذاته المكتشفة، غير أنّ هذه الصّورة الّتي تتكّشف أمام الطّفل لمعرفة ذاته تكون مجرد صورة رمزية تحليلية، ترسمها الذّات بصورة وهمية مثالية، يسميها لاكان طرفة الصّورة المثالية.
الصّلة بين علم النّفس والأدب وثيقة وعريقة، ولا يحتاج إثباتها إلى تكلّف في النّظريات، وتعسّف في البراهين، بل يغني عن ذلك استحضار حقيقة الأدب، وطبيعة الظاهرة الأدبية من حيث المنشأ والتّشكّل والتّلقي، وكذلك النظر فيما تمارسه الفنون الأدبية من أثر في الحياة، وما تسدّه من ثغرات في واقع الوجود البشري، وما تعالجه من أزمات يستعصي على علم النفس أن يعالجها بمفرده.
فالأدب في حقيقته، حديث نفس إلى نفس، وبوح وجدان إلى وجدان، ورسالة روح إلى روح، بلغة هي في أصلها رموز لخوالج النّفس، ووسيلة لقضاء حاجاتها، نفعية كانت أم عاطفية، والأدب بطبيعته، فعالية نفسية ونشاط وجداني، بواعثه نفسية، وتشكّله نفسي، ومسلكه إلى المتلقي هو الحسّ والغزيرة والوجدان، وهي جميعها تُشكّل المكونات الأساسية لمفهوم النّفس. وما دامت الصّلة بين الأدب وعلم النّفس مؤكّدة، فمن الواضح أنّ هذه الصّلة عرفتها كل المراحل، الأمر الّذي دفع الدّارسين إلى التّمييز في هذا الارتباط بين طورين أساسيين ، وهما كالآتي:
الأوّل: تمّ الاهتمام فيه برصد العلاقة بين الأدب والنّفس على مستوى الإنتاج والتّلقي الأدبيين.
الثّاني: تمّت فيه بلورة تصوّرات نقدية مستمدة من علم النّفس والتّحليل النّفسي لدراسة الظّاهرة الأدبية وتجلياتها النّصية.
وبالتّساوق عمل الباحثون والنّقاد على رصد المسوغات الّتي بررت ارتباط النّقد الأدبي بالدّراسة النّفسية خلال هذا التّاريخ الطّويل، والّتي تُعطي الشّرعية للاستمرار في ذلك، ما دامت تلك المسوغات قائمة، ويمكن تحديد أبرزها في ما يأتي:
- الطّبيعة التّعبيرية والذّاتية للأدب.
- الوظيفة التّفسيرية للنقد الأدبي.
- الوظيفة التّأثيرية للأدب.
- السعي العلمي للنقد الأدبي.
- غلب التّحليل النّفسي العلمي المنهج النّقدي التّحليلي للأدب.
- الحكم على العمل يكون بالقيم النّفسية الّتي يحتويها، لا على أساس توافر القيم الجمالية.
- ساوى المنهج النّفسي بين المبدع وغير المبدع.
- ليس من الصّواب النّظر إلى الأدب على أنّه محصلة شذوذ أو مرضا.
-
النقد الاجتماعي
يعد المنهج الاجتماعي من المناهج النقدية السياقية الحديثة، وقد تولد هذا المنهج من المنهج التاريخي، بمعنى أن المنطلق التاريخي كان هو التأسيس الطبيعي للمنطلق الاجتماعي عبر محوري الزمان والمكان وهو منهج يربط بين الأدب والمجتمع بطبقاته المختلفة، فيكون الأدب ممثلاً للحياة على المستوى الجماعي لا الفردي؛ باعتبار أن المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الإبداعية، فالقارئ حاضر في ذهن الأديب وهو وسيلته وغايته في آن واحد
اهتم المنهج الاجتماعي بالمرجع الخارجي وذلك بربط الأدب بالمجتمع مباشرة مع المادية الجدلية أوبطريقة غير مباشرة فبدأ التنكر للمثالية، من خلال إحلال الواقع محل المثال، وغدا الفن انعكاساً صادقاً للواقع الموضوعي، فهو لا يولد خارج الحياة، ولا يتنزل عليها، وإنما ينبع منها، فهو في جوهره حكم يصدره الفنان بعد تحليل الواقع المتحول باستمرار: "ولو أننا افترضنا أن هذه الفكرة ليست سوى نتيجة لنشاط عقله لما قتلنا الفن وحده. بل قتلنا أيضاً إمكانية الفن نفسها" لقد أجبر الجدل الواقع بين المثل والواقع، الفلسفة المثالية على الاعتراف به كوجود.
ويقول جورج لوكاتش عن المنهج الاجتماعي " إنه منهج بسيط جدا ، يتكون أولا و قبل أيّ شيء من دراسة الأسس الاجتماعية الواقعية بعناية "
فالأدب يصور لنا الحياة الاجتماعية في الفترة التاريخية التي كتب فيها، ويعطينا صورة واضحة عن وقائع اجتماعية محددة
1- المنهج الاجتماعي التأسيس والنظريات:
مع ظهور النظريات الإيديولوجية الحديثة كالنظرية الاشتراكية والشيوعية سيظهر المنهج الإيديولوجي الاشتراكي والمنهج المادي الجدلي في الساحة النقدية الأدبية الحديثة، حيث ظلت تتساوق وما طرحته فلسفة هيجل ( 1770- 1831 ) التي ربطت بين الأنواع الأدبية والمجتمعات، وكانت الواقعية إفرازًا بينًا فيه، كما أن الماركسية تُداخِل فيما بين المنهجين التاريخي والاجتماعي. ومنه فالجذور الأولى للمنهج النقدي الاجتماعي ترجع إلى هيجل، إذ ربط بين ظهور الرواية والتغيرات الاجتماعية، مستنتجاً أن الانتقال من الملحمة إلى الرواية جاء نتيجة لصعود البرجوازية، وما تملكه من هواجس أخلاقية وتعليمية
مع بدايات القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام بدراسة العلاقة بين الناحية الاجتماعية والأدب، فصدر آنذاك كتاب لمدام دوستال تحت عنوان "الأدب في علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية" متناولاً تأثير الدين والعادات والقوانين في الأدب، وتأثير الأدب فيها فقد تبنت مبدأ أن الأدب تعبير عن المجتمع، لقد ظل الاهتمام بالمضامين قائماً لتحديد موقف المؤلف من الصراع الطبقي، ما دام المجتمع يشهد صراعاً طبقياً، بوصف الفن شكلا من أشكال البنية الفكرية للمجتمع.
قد كان للفكر المادي الماركسي أثر في تطور المنهج الاجتماعي، وإكسابه إطاراً منهجياً وشكلاً فكرياً ناضجاً، ومن المتقرر في الفلسفة الماركسية أن المجتمع يتكون من بنيتين: دنيا: يمثلها النتاج المادي المتجلي في البنية الاقتصادية، وعليا: تتمثل في النظم الثقافية والفكرية والسياسية المتولدة عن البنية الأساسية الأولى، وأن أي تغير في قوى الإنتاج المادية لابد أن يُحدث تغيراً في العلاقات والنظم الفكرية.
وقد عملت الماركسية مع الواقعية جنباً إلى جنب في تعميق الاتجاه الذي يدعو إلى التلازم بين التطور الاجتماعي والازدهار الأدبي؛ مما أسهم في ازدهار "علم الاجتماع" بتنوعاته المختلفة، كان من بينها علم نشأ قبل منتصف القرن العشرين أطلق عليه: علم "اجتماع الأدب" أو "سوسيولوجيا الأدب"، وقد تأثر هذا العلم بالتطورات التي حدثت في الأدب من جانب، وما حدث في مناهج علم الاجتماع من جانب آخر.
2- اتجاهات المنهج الاجتماعي.
أ- الاتجاه الأول: الكمي. يطلق عليه علم اجتماع الظواهر الأدبية، وهو تيار تجريبي يستفيد من التقنيات التحليلية في مناهج الدراسات الاجتماعية، مثل الإحصائيات والبيانات وتفسير الظواهر انطلاقا من قاعدة يبنيها الدارس طبقاً لمناهج دقيقة ثم يستخلص منها المعلومات التي تهمه ومن رواد هذه المدرسة "سكاربيه"، ناقد فرنسي له كتاب في علم اجتماع الأدب، وهو يدرس الأدب كظاهرة إنتاجية مرتبطة بقوانين السوق، ويمكن عن هذا دراسة الأعمال الأدبية من ناحية الكم.
ويرى هذا الاتجاه أن الأدب جزء من الحركة الثقافية، وأن تحليل الأدب يقتضي تجميع أكبر عدد البيانات الدقيقة عن الأعمال الأدبية، فعندما نعمد إلى دراسة رواية ما؛ فإننا ندرس الإنتاج الروائي في فترة محددة، وبما أن الرواية جزء من الإنتاج السردي من قصة وقصة قصيرة وغيرها، فإننا نأخذ في التوصيف الكمي لهذا الإنتاج عدد القصص والروايات التي ظهرت في تلك البيئة، وعدد الطبعات التي صدرت منها، ودرجة انتشارها، والعوائق التي واجهتها، ولو أمكن أن نصل إلى عدد القراء، واستجاباتهم، وغيرها من الإحصائيات الكمية؛ حتى يمكن لنا أن ندرس الظاهرة الأدبية كأنها جزء من الظاهرة الاقتصادية، لكنه اقتصاد الثقافة بمعنى أننا نستخدم فيها مصطلحات الإنتاج والتسويق والتوزيع، وكل ذلك نستخدمه لاستخلاص نتائج مهمة تكشف لنا عن حركة الأدب في المجتمع.
ب- الاتجاه الثاني: المدرسة الجدلية. نسبة إلى "هيجل" ثم ماركس من بعده ورأيهما في العلاقة بين البنى التحتية والبنى الفوقية في الإنتاج الأدبي والإنتاج الثقافي، وهذه العلاقة متبادلة ومتفاعلة مما يجعلها علاقة جدلية .
وقد برز "جورج لوكاش" كمنظِّر لهذا الاتجاه عندما درس وحلل العلاقة بين الأدب والمجتمع باعتباره انعكاساً وتمثيلاً للحياة، وقدَّم دراسات ربط فيها بين نشأة الجنس الأدبي وازدهاره، وبين طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية لمجتمع ما تسمى بـ"سوسيولوجيا الأجناس الأدبية"، تناول فيها طبيعة ونشأة الرواية المقترنة بنشأة حركة الرأسمالية العالمية وصعود البرجوازية الغربية.
ثم جاء بعده "لوسيان جولدمان" الذي ارتكز على مبادئ لوكاش وطوّرها حتى تبنى اتجاهاً يطلق عليه "علم اجتماع الإبداع الأدبي"، حاول فيه الاقتراب من الجانب الكيفي على عكس اتجاه "سكاربيه" الكمي . وقد اعتمد "غولدمان" على مجموعة من المبادئ العميقة والمتشابكة التي يمكن أن نوجزها في التالي:
1. يرى "غولدمان" أن الأدب ليس إنتاجاً فردياً، ولا يعامل باعتباره تعبيراًعنوجهة نظر شخصية، بل هو تعبير عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة، بمعنى أن الأديب عندما يكتب فإنه يعبر عن وجهة نظر تتجسد فيها عمليات الوعي والضمير الجماعي، فجودة الأديب وإقبال القرَّاء على أدبه بسبب قوته في تجسيد المنظور الجماعي ووعيه الحقيقي بحاجات المجتمع، فيجد القارئ ذاته وأحلامه ووعيه بالأشياء، والعكس صحيح لمن يملكون وعياً مزيفاً
2. أن الأعمال الأدبية تتميز بأبنية دلالية كلية، وهي ما يفهم من العمل الأدبي في إجماله، وهي تختلف من عملٍ لآخر، فعندما نقرأ عملاً ما فإننا ننمو إلى إقامة بنية دلالية كلية تتعدل باستمرار كلما عبرنا من جزء إلى آخر في العمل الإبداعي، فإذا انتهينا من القراءة نكون قد كوَّنا بنية دلالية كلية تتكون من المقابل المفهومي والمقابل الفكري للوعي والضمير الاجتماعيين المتبلورين لدى الأديب
واعتماداً على ما سبق نجد بين العمل الأدبي ودلالته اتصالاً وتناظراً، ونقطة الاتصال بين البنية الدلالية والوعي الجماعي هي أهم الحلقات عند "جولدمان" والتي يطلق عليها مصطلح "رؤية العالم"، فكل عمل أدبي يتضمن رؤية للعالم، ليس العمل الأدبي المنفرد فحسب لكن الإنتاج الكلي للأديب.
انطلاقاً من هذا المنظور أسس "غولدمان" منهجه "التوليدي" أو "التكويني"، كما قام بإجراء عدد من الدراسات التي ترتبط بعلم اجتماع الأجناس الأدبية كما فعل "لوكاش"، فأصدر كتاباً بعنوان "من أجل تحليل سوسيولوجي للرواية" درس فيه نشأة الرواية الغربية وكيفية تحولاتها المختلفة في مراحلها المتعددة تعبيراً عن رؤية البرجوازية الغربية للعالم .
ثم حدث تطور في مناهج النقد الأدبي مما أدى إلى نشوء علم جديد هو "علم اجتماع النص"، يعتمد على اللغة باعتبارها الوسيط الفعلي بين الأدب والحياة، فهي مركز التحليل النقدي في الأعمال الأدبية، فاتخاذ اللغة منطقة للبحث النقدي في علم اجتماع النص الأدبي هو الوسيلة لتفادي الهوة النوعية بين الظواهر المختلفة.
-
الحصّة الثالثة عشرة والرابعة عشرة : النّقد التاريخي
1- المنهج التاريخي النشأة والتأسيس:
يعدّ المنهج التاريخي أول المناهج النقدية السياقية ظهوراً في العصر الحديث، ارتبط بالفكر الإنساني وتبلور هذا المنهج داخل المدارس الغربية العريقة كالرومانسية والواقعية وانبثق عنها ، إذ هي التي أبانت عن الوعي الإنساني بالزمن، وتصوره للتاريخ ، ووضوح فكرة التسلسل والتطور والارتقاء ،يقول كارلوني وفيللو :"نطبق على الآداب أساليب التاريخ العادية: تمييز الحقبات، وتحقيق نزعاتها، إظهار تسلسل الوقائع، وضع جدول لكل حقبة أو لكل لون أدبي في فترة معينة، جدول لا يتجاهل الصغار، كي نضع الكبار في سياق الكلام، ربط الوقائع الأدبية بحقائق التاريخ الأخرى. وباختصار تقديم الأدب في ديمومته واستمراره الحي، وجعلنا نشعر بمؤلفات الماضي القديم أو الحديث كأننا نعيش في زمن ظهورها، وإن كنا نفهمها أحسن فهم لأننا نعرف ما سيتبعها". هذا المنهج يشكِّل أهميةً كبيرةً في معرفة الأدب ومراحلِ تطورهِ، وفهم حقائقها وسر وجودها وخلودها.
وهذا التصور التاريخي هو الذي عكس النظرة الكلاسيكية التي ظلت تؤمن بأن الأدب والابداع ما هو إلا محاكاة Imitation للأقدمين ، وأن أدبهم يمثل النموذج الأرقى في مجال التطور التاريخي. فالتاريخ يعبر في جوهره عن الذاكرة الإنسانية بمختلف نشاطاتها المادية والفكرية، ويدرس الإنسان بوصفه كائناً مرتبط بالزمان والمكان.
إن النقد التاريخي هو منهج علميّ يدرس الأدب من حيثُ كونه ظاهرة مرت بمراحل عدّة تخضع للتغيرات الزمكانية في مظاهرها المختلفة ووظيفة تكوينها وأهمية عناصرها وأشكالها ومضامينها، وتكمن من وراء التحولات والتغيّرات الأدبية أسباب اجتماعية وبيئية، والقراءة التاريخية هي تلك الجهود الفكرية التي عرفها مطلع هذا القرن إلى منتصفه، والتي حاولت أن "تقص" رحلة الأدب من خلال تراكمات التاريخ، ضعفاً وقوة، فالتحم البحث الأدبي بالبحث التاريخي، وفق شرائط المنهج العلمي، وتولد عن هذا التلاحم ميلاد "تاريخ الأدب"
إن الحضور المكثف للنقد التاريخي الذي اتخذ طابعاً منهجياً مؤسساً، وهو كما يقول عبد السلام المسدي:"سلسلة من المعادلات السببية:فالنص ثمرة صاحبه، والأديب صورة لثقافته والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ، فإذا النقد تأريخ للأديب من خلال بيئته"، فقد ركزت القراءة التاريخية على تحقيق النصوص وتوثيقها باستحضار حياة المؤلف وجيله وبيئته.
فاهتمت بشرح الظواهر الإبداعية، فعمدت إلى إبراز العوامل الجغرافية والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية،كما سعت إلى دراسة الأطوار التي مر بها أي جنس من الأجناس الأدبية، ورصد الأقوال التي قيلت في عمل ما أو مبدعه للترجيح بينها، ومن ثم تعمد على المرجّح من الأقوال لمعرفة العصر والملابسات التاريخية المساهمة في إنتاج ذلك العمل فهذه القراءة "تبدأ بالتحريات ذات الطابع العلمي الواسع، والتي تشبه إلى حد بعيد كيفيات البحث في الظواهر التاريخية. وهي تحريات تفصيلية: تتلخص في جمع المستندات والطبعات المختلفة، والتحقق من صحة نسبة النصوص، وقراءة الحواشي، ورصد التغيرات الرئيسية".
2- نظريات النقد التاريخي وروادها:
من أبرز النّقاد الذين تبنوُّا المنهج التأريخي في دراساتهم النقدية نجد : ( هيبوليت تين، سانت بيف، غوستاف لانسون، فردينان برونتيير..)
1- هيبوليت تين H.Taine"وهو يعتبر من المنظرين الأوائل للنقد التاريخي، فقد كان يعتبر الإنتاج الأدبي انعكاسا للمحيط العام والوسط الاجتماعي، وأخضعه لعوامل الجنس والبيئة واللحظة التاريخية التي كانت تشرط الطاقة التعبيرية المحورية التي يسميها"الملكة الأساسية Faculté maîtresse" وتقسيمه ورد على الشكل التالي:
أ- العرق أو الجنس، يتمثل في الخصائص الفطرية والوراثية المشتركة بين أفراد الأمة الواحدة المنحدرة من جنس معين
ب- البيئة أو المكان والوسط: بمعنى الفضاء الجغرافي وانعكاساته الاجتماعية في النص الأدبي
ج- الزمان والعصر: مجموعة الظروف السياسة والثقافية ومدى تأثيرها على النص
2- وسانت بيف Sainte Beuve الذي كان يرسم شخصيات الأدباء انطلاقا من دراسة حياتهم، ويصنفهم إلى فصائل فكرية عقلية ونماذج نفسية وأخلاقية….
3- غوستاف لانسون G.Lanson الذي ظهر له كتاب بعنوان "منهج البحث في تاريخ الأدب" سنة 1901، حدد فيه خطوات المنهج التاريخي وجعلها بمثابة قوانين تحاور النص في إطاره الخارجي وهي:
أ- قانون تلاحم الأدب بالحياة: الأدب مكمل للحياة
ب- قانون التأثيرات الأجنبية
ج- قانون تشكل الأنواع الأدبية
د- قانون تلاحم الأشكال الجمالية
هـ- قانون ظهور الأعمال الخالدة
و- قانون أثر المؤلف في الجمهور (المؤلف قوة منظمة). فلانسون قيد إجراءاته التأريخية الموضوعية بسلسلة من العمليات العلمية المتراوحة بين تحقيق النص وتوثيقه وتحليله وتقويمه وتصنيفه،كي تتكامل في نظره المعرفة الموضوعية التاريخية مع التأثرالشخصي والذوق الخاص،وتراعي خصوصيات المادة الأدبية موضوع الدرس.
3- النقد التاريخي العربي:
تعد الدراسات التاريخية في النقد العربي من أقدم الدراسات وأعرقها نشأة وتداخلاً مع النقد الفني في كثير من القضايا، إذ نلفي كثيراً من الأحكام النقدية تعتمد في أسسها على التصورات التاريخية، في فن السيرة والمدونات، ثم ما فعله ابن خلدون في قضية التحقيق والتدوين.
استنت القراءة النقدية التاريخية العربية الحديثة لنفسها سنناً جديدة في منهجية الدرس التاريخي للأدب، فنشأت الحاجة إلى إعادة قراءة الموروث الأدبي العربي على ضوء ما يعرف "بتاريخ الأدب العربي" وقد عني بذلك الكثير من النقاد منهم طه حسين، وشوقي ضيف وجرجي زيدان وإيليا الحاوي، وأبو القاسم سعد الله وصالح خرفي... وغيرهم، وقد ساهمت الدرسات النقدية العربية بهذا المنهج بتحرير النصوص وتحقيقها والتأكد من صحة وسلامة نِسْبَتِها إلى أصحابها، وخلوها من التحريف، والزيادة والنقصان، وتحقيق تاريخ النّص وزمان تأليفه، والمرحلة التي ينتمي إليها.
4- المآخذ على المنهج التاريخي:
أوجه القصور والاعتراض، التي مني بها المنهج التأريخي في معالجته للآداب، ما يأتي:
1-إهمال النّص الأدبي من داخلهِ، من حيثُ لغته وأسلوبه، وخصائصه الفنيّة بالدرس والتحليل.
2- طغيان التاريخ على الأدب، وكأنَّه مادة تأريخية أكثر منها درساً أدبياً.
3- تجاهل الخصائص الفردية، والمواهب الشّخصية في العمل الأدبي، وإرجاع الإبداع إلى أسباب جبرية كالبيئة، والجنس، والعصر، ممّا يحقق إغفالاً لعبقريات الأدباء، ومواهبهم الفردية.
4- أصدر المنهج التأريخي كثيراً من الأحكام التعميمية والجازمة على عصور الأدب والأدباء، ومن ذلك القول بأنَّ: التدهور التأريخي يُخلّف أدباً يطغي فيه الحكم الذاتي على أحداث التاريخ وعصره، كما فعل طه حسين في كتابهِ (في الشعر الجاهلي) الذي بالغ فيه كثيراً ورفض الأدب الجاهلي جملةً وتفصيلاً معتمداً على هواجسه الذاتية والظَّنية، واستقرائه الناقص للمعلومات والتاريخ، مبتعداً عن جادة الصّواب والموضوعية العلميّة.
5- أهملَ المنهج التأريخي الكثير من الأدباء والعلماء الذين لم يكن لهم حضور سياسي
أو اجتماعي بارز، ووقف عند الشَّخصيات المشهورة فقط.

