نقد أدبي معاصر_ف01
Résumé de section
-
اسم الوحدة : وحدة التّعليم الأساسية
الرصيد : 04
المعامل : 02
الأستاذ المسؤول عن المادة : محمّد نمرة
المادّة : نقد أدبي معاصر / أعمال موجّهة
السّداسي : الرابع
الفوج الأوّل
-
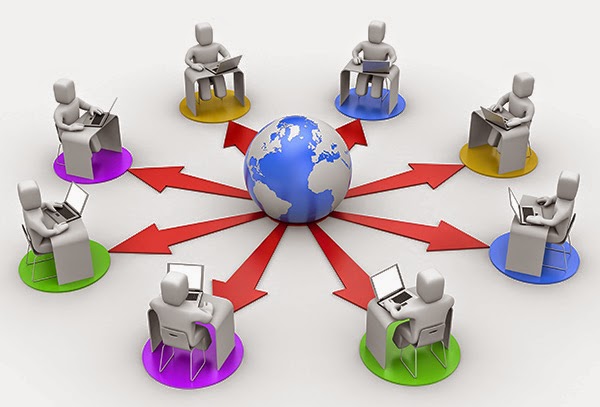
الأستاذ : نمرة محمّد
M.NEMRA@UNIV-DBKM.DZ : البريد المهني
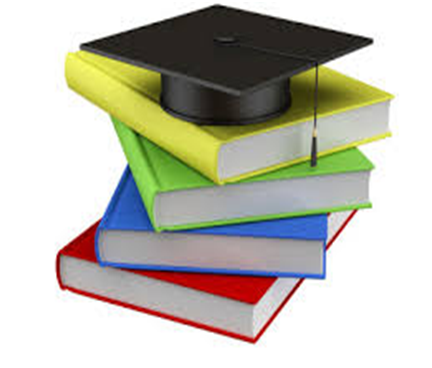
-
النّقد السّيميائي
1. السّيميائيـة: النّشـأة والتّعريـف
السّيميائية أو السّيميولوجية هي: " علم موغل في القدم، أيام الفكر اليوناني القديم مع أفلاطون وأرسطو الّلذين أبديا اهتماما بنظرية المعنى، وكذلك إلى الرّواقيين الّذين وضعوا نظرية شاملة لهذا العلم، بتمييـزهم بين الدّال والمدلول والشّيء، ولم يكن التـّراث العربيّ بعيدا عن مثل هذه المشاغل، فقد أولى المناطقة والأصوليون والبلاغيون والمفسّرون وغيرهم عناية كبرى بكل الأنساق الدّالة تصنيفا وكشفا عن قوانينها وقوانين الفكـر، وقد تجـلى ذلك في أطروحات الفلاسفة الإسلاميين من أمثال: الغزالي وابن سينا..." .
كما أنّها " قد استمدت بعض مبادئها من أطروحة الفلسفة الوضعية في جنوحها إلى الشّكل، وفي اتصافها بالنـّزعة العلمية، فالفلاسفة الوضعيون هم الّذين اعتبـروا اللّغة كلّها رمزا، وهذا الدأب اقتفاه النّقاد السّيميائيون في تصوّرهم للعلامة".
ونجد أنّ: "السّيمياء قد عرفت تجلياتها الأولى في كتابات الفلاسفة الغربيين والعرب، وقد جاء ذلك في سياق حديثهم عن العلامة والدّلالة اللّفظية، وهي تلتصق عند العـرب بالسّحـر و الطّلسمات الّتي تعتمـد أسرار الحروف والرّموز والتّخطيطـات الدّالة، وأحيانا تصبح فرعـا من فروع الكيمياء، وأحيانا تلتصق السّيمياء بعلم الدّلالة، وأحيانا بعلم المنطق وعلم التّفسير والتّأويل، وإن بدا ذلك ليس بعيدا عن حقولها المعاصرة ".
وقد بشّر - سوسير - بميلاد علم جديد سمّاه (السّيميولوجيا) و"يفضّل الأوروبيون مفردة السّيميولوجيا التزاما منهم بالتّسمية السّوسرية، أمّا الأمريكيون فيفضلون السّميوطيقا الّتي جاء بها المفكر والفيلسوف الأمريكي تشارلس ساندرز بيرس".
وقد اعترض – رولان بارت – على مقولة - سوسير - الشّهيرة الّتي ترى أنّ:
"السّيميولوجيا أوسع من اللّسانيات"، لتصبح العكس، أي اللّسانيات أوسع من السّيميولوجيا، ويقترح- بارت - مسمّيات جديدة تختلف عن المسميات السّوسرية، فالعلامة السّوسرية يسميها الدّلالة، والشّكل بديلا لما يسميه - سوسير- بالدّال، والمفهوم بديلا للمدلول.
إنّ السّيميائية (Sémiotique )، والسّيميولوجيا (Sémiologie) مصطلحان يتجذران في اللّغة اليونانية في (Sémeion) وهي العلامة (signe) ، فالسّيميولوجيا هي: "العلم الّذي يدرس حياة العلامات داخل المؤسسة الاجتماعية"، كما يمكن اعتبار السّيميائية من حيث طبيعتها "دراسة نظرية لكل ما هو رموز ونحو وأنظمة وعقود، كذا كلّ ما له علاقة بإرسال المعلومة". إنّ السّيميائية، أوالسّيميولوجيا، أو السّيميوطيقا، أو العلاماتية، أو علم العلامات، أو علم الإشارة...، كلّها ترجمات لعلم واحد يُعنى بدراسة العلامات.
ومن أشهر أعلام السّيميائية نجد:" تشارلس ساندرز بيرس، ورولان بارت، وغريماس، ورومان ياكبسون، وأمبيرتو إيكو، ومايكل ريفاتير، وجوليا كريستيفا، وبربرا هيرنستاين سمث، هذا إذا استثنينا إشارات سوسير...، غير أنّ الفيلسوف الأمريكي بيرس، هو أهم مؤسّسي هذا الطّرح، وقد عرض نظرية سيميولوجية غاية في التّعقيد، لكن نظرته للعلامة وفاعلية وظائفها الدّلالية لا تختلف عن الطّرح البنيوي الألسني".
2.الاتجاهات السّيميائية الحديثة :
أدّى تطور السّيميائيات، وتعدّد منابعها إلى ظهور اتجاهات عدّة، وقد خصّص الباحث - عبد الله إبراهيم - في كتابه الموسوم بــــــــــ : (معرفة الآخر) بالحديث عن الاتجاهات السّيميائية، والّتي قسّمها إلى ثلاث اتجاهات بارزة، وهي: سيمياء التّواصل- سيمياء الدّلالة - سيمياء الثّقافة.
أ. سيميـاء التّواصـل:
يركّز أنصار هذا الاتجاه (بويسنس، برييتو، مونان، كرايس، أوستين، فجنشتاين، مارتينيه) في أبحاثهم على الوظيفة التّواصلية، غير أنّ هذا التّواصل مشروط بالقصدية، "وبناءً على ذلك نحصر موضوع السّيميائية في العلامات القائمة على الاعتباطية، لأنّ العلامات الأخرى ليست سوى تمظهرات بسيطة. ويعني ذلك أنّ تحديد معنى تعبير رهين بتعيين مقاصد المتكلمين والكشف عنها، وبذلك تكون المقاصد ملمحا مميزا". ولسيمياء التّواصل محـوران اثنان:
- محـور التّـواصل : ويقسّم إلى تواصل لساني، وآخر غير لساني.
وينحصر التّواصل اللّساني في عملية التّواصل بين النّاس عن طريق القول، ويكون وفق منظورات ثلاثة (سوسير، بلومفيلد، شينون، وفيفر)،أمّا التواصل غير اللساني فيسميه - بويسنس- لغات غير اللّغات المعتادة، وهو وفق معايير ثلاث (معيار الإشارية النّسقية، معيار الإشارية اللانسقية، معيار الإشارية).
- محـور العـلامـة: ويصنف محور العلامة إلى ثلاث أصناف، وهي: الأيقونة (icon)، المؤشر (index)، الرّمز (symbol).
ب. سيميـاء الدّلالــة :
يرى أيضا هذا الاتجاه وفي مقدمتهم - رولان بارت- أنّ: " اللّغة لا تستنفذ كلّ إمكانيات التّواصل، فنحن نتواصل، توفرت القصدية أم لم تتوفر، بكل الأشياء الطّبيعية والثّقافية سواء أكانت اعتباطية أو غير اعتباطية. لكنّ المعاني الّتي تستند إلى هذه الأشياء الدّالة ما كان لها أن تحصل دون توسّط اللّغة. فبواسطة اللّغة باعتبارها النّسق الّذي يقطع العالم وينتـج المعنى- يتم تفكيك ترميـزية الأشياء"، وتتوزع عناصر هذا الاتجاه- حسب بارت - على ثنائيات أربع، كلها مستقـاة من الألسنية البنيوية، وهي:
- اللّغة والكلام، الدّال والمدلول، المركب والنّظام، التّقرير والإيحاء (الدّلالة الذّاتية والدّلالة الإيحائية).
ج. سيميـاء الثّــقافـة:
يمثل أنصار هذا الاتجاه المستفيد من الجدلية ومنه فلسفة الأشكال الرمزية عند - كاسيرر-، وتنطلق سيميائية الثّقافة من اعتبار الظّواهر الثّقافية " موضوعات تواصلية وأنساقا دلالية، والثّقافة عبارة عن إسناد وظيفة للأشياء الطّبيعية وتسميتها وتذكرها". ونجد لهذا الاتجاه مؤسّسيين، وأنصار في روسيا (يوري لوتمان- إيفانوف- أوسبنسكي- تودوروف، وفي إيطاليا (روسي- لاندي- وأمبيرتو إيكو).
3. مجــالات التّوظيـف السّيميائـي:
أصبح المنهج السّيميائي يوظّف في مجالات متنوعة، وأداة في معالجة العلامات اللّغوية (الشّعر، الرّواية، والقصة)، وغير اللّغوية (الرّسم، والفن التشكيلي،...)، وأصبح هذا التّحليل مفتاحا لفك الرّموز، وصالحا لمقاربة مختلف الأشكال العلاماتية، ومن مجالات التّوظيف وأعلامه نذكر:
· الشّعر: (مولينو- رومان جاكبسون- جوليا كريستيفا- جيرار دولـودال- ميكائيل ريفاتيـر)
· الرّواية القصّة: ( كريماس- كلودبريموند- بارت- كريستيفا- تودوروف- جيرار جنيت- فيليب هامون).
· الأسطورة والخرافة: (فلاديمير بروب).
· المسرح: (هيلبو- كير- إيلام).
· السّينما: (كريستيان ميتز- يوري لوتمان)
· الإشهار: (رولان بارت- جورج بنينو- جان دوران).
· الأزياء والأطعمة والأشربة والموضة: (رولان بارت).
· التّشكيل وفن الرّسم: (بيير فروكستيل- لويس مارتان- هوبرت داميش- جان لويس شيفر).
· التّواصل: (جورج مونان- برييطو).
· الثّقافة: (يوري لوتمان- تودوروف- بياتيكورسكي- إيفانون- أوسبنسكي- أمبرطو إيكو- روسي لاندي).
· الصّورة الفوتوغرافية: (العدد الأول من مجلة التواصل- رولان بارت).
· القصّة المصورة: (بيير فريزنولد دورييل).
· الموسيقى: (مجلة Musique en jeu في سنوات 1970-1971).
· الفن: (موكاروفسكي).
4. الإشكـالات النّظريـة والتّطبيقيـة:
أ.الإشكـالات النّظريـة:
ومن أبرز الإشكالات النّظرية نجد:
- إنّ السّيميائية باتجاهاتها المتباينة تبقى مجرد اقتراحات أكثر من كونها مجالا معرفيا متميزا.
- الاضطرابات المعرفية والمفهـومية في الحقل السّيميائي والمتمظهـرة في تعـدّد المفاهيم أو المبادئ، وتباين الخلفيات المنهجية والمنطلقات النّظرية لدى أقطابها، والّذي حال بين المعرفة السّيميائية والقارئ.
- مشكلة تعدّد المصطلح، فقد أحصى باحث معاصر وهو – عبد الله بوخلخال- هذا التعدّد، فبلغ به ما يقارب تسعة عشر مصطلحا.
- تباين الرّؤى النّقدية عند أقطاب هذا المنهج، واختلافه من ناقد لآخر، وهذا وفق ما تمليه عليهم إيديولوجياتهم المختلفة.
ب.الإشكاليـات التّطبيقيــة:
إنّ إشكالات النّقد السّيميائي لا تنبثق كلية من تلك الإجراءات التّطبيقية، وإنّما تنبثـق أيضا من قصور المفهوم الّذي يشغله النّقد السّيميائي، لأنّ الإجراء التّحليلـي ما هو إلا معلـول أو نتيجة لعلّـة.
وإنّ لجوء النّقاد إلى استعمال منهج إجرائي آخر إلى جانب المنهج السّيميائي دليل واضح على قصوره وعجزه في تحليل النّصوص، والّذين لجؤوا إلى التّركيب المنهجي، ونجد - مرتاض- يطبّق منهجا مركّبا تصدع به عناوين كتبه ( ألف ليلة وليلة - تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمّال بغداد، تحليل الخطاب السردي - معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية رقاق المدق، أ/ي - دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمّد العيد آل خليفة ... )، " إنّ هذا التّضافر بين السّيميائية والتّفكيكية في عملية إجرائية واحدة نعدّه - من دون هوادة - مغالطة نقدية، لأنّها تكشف عن قصور الحقلين ويتمظهر في ذلك التّركيب الاستدعائي بين السّيمياء والتّفكيك، فلو كانت السّيميائية قادرة على استنباط الرّوح الجمالية للنص ما كان مثل هذا الاستدعاء".
-
النّقد البنيوي
1. البنيوية : لغة واصطلاحا
أ.البنيوية لغة:
إنّ كلمة (البنيوية) مشتقة لغة من الفعل الثلاثي (بني)، نجدها في لسان العرب لابن منظور (ت711هـ) تتيح لنا الدلالات التالية:
(البَنْيُ: نقيض الهدم، بَنَى البَنَّاءُ البِنَاءَ بَنْيًا وبِنَاءً وبِنًى، مقصور، وبُنْيَانًا وبِنْيَةً وبِنَايَةً وابْتَنَاه وبنّاه)، (والبناءُ: المبنيُّ، والجمع أَبْنِيَةٌ، وأَبْنِيَاتٌ، جمع الجمع..)، والبِنْيَةُ والبُنْيَةُ: ما بَنَيْتَهُ، وهو البِنَى والبُنَى..)، (يقال بِنْيَةٌ، وهي مثل رِشوة ورِشًا كأنّ البِنْيَة الهيئة الّتي بُنِيَ عليها..)، ( والبُنَى، بالضّم مقصور، مثل البِنَى. يقال: بُنْيَةٌ وبُنًى وبِنْيَةٌ وبِنًى، بكسر الباء مقصور مثل جزيةٍ وجزًى..)، (وأبْنَيُتُ الرجل: أعطيتُه بناءً أو ما يَبْتَنِي به داره..).
كما تدّل (البنيةُ) في المعجم العربي الحديث لاروس على: (البيت: شاده وأقام جدرانه..)، (الأرض: أقام فيها البناء)، (الكلمة: ألزم آخرها ضرباً واحداً من سكون أو حركة..).
وتجدر بنا الإشارة إلى أن القرآن الكريم استخدم هذا الأصل أكثر من عشرين مرّة على صورة الفعل (بنى) أو الأسماء (بناء) و(بنيان) و(مبنى)، يقول الله تعالى: "ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا".
ب.البنيوية اصطلاحا:
تشتق (البنيوية) وجودها الفكري والمنهجي من مفهوم (البنية) أصلا، وعليه قبل الشّروع في الحديث عن (البنيوية)، لا بدّ لنا من تحديد مصطلح (البنية).
لقد واجه مصطلح (البنية) مشكلة حقيقية في الفلسفة المعاصرة، وهذا نتيجة الاختلافات النّاجمة عن تمظهرها وتجليها في أشكال متنوعة، فتعدّدت المفاهيم والتّعريفات العلمية إزاءها، ونجد - جان بياجيه - يعرّفها بقوله: "وتبدو البنية بتقدير أوّلي مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة (تقابل خصائص العناصر) تبقى تغتني بلعبة التّحولات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعين بعناصر خارجية".
ويرى - ألبير سوبول Albert soboul))- في دراسته الموسومة باسم «الحركة الباطنة للبنيات» بتعريف موجز للـ« بنية»، فيقول: "إنّ مفهوم البنية لهو مفهوم العلاقات الباطنة، الثابتة، المتعلقة وفقاً لمبدأ الأولوية المطلقة للكل على الأجزاء، بحيث لا يكون من الممكن فهم أي عنصر من عناصر البنية خارجا عن الوضع الّذي يشغله داخل تلك البنية، أعني داخل المنظومة الكلية الشاملة".
وعلى الرّغم من أنّ (سو سير) يعدّ أبا للبنيوية، إلاّ أنّه لم يستعمل كلمة (بنية) في كتابه (محاضرات في علم اللّغة العام)، بل كان يستعمل كلمة (نسق) أو (نظام).
تنحصر (البنية) حسب - بياجيه - في ثلاثة خصائص، وهي الكلية، ومفادها أنّ (البنية) مكتفية بذاتها، ولا تحتاج إلى وسيط خارجي، بينما خاصية التّحولات فهي توضّح التّغيرات داخلها، والّتي لا يمكن أن تظل في حالة ثبات لأنّها دائمة التّحول، أمّا خاصية التّنظيم الذّاتي فهي تمكنها من تنظيم نفسها للمحافظة على وحدتها واستمراريتها.
ومن الصّعب تحديد مفهوم قار للبنيوية، وعليه لا يمكن إعطاء تعريف شامل ومحدّد لها، إلاّ أنّنا نجد لها تعريفات كثيرة:
ويعرّفها - يوسف وغليسي- بأنّها: "منهج نقدي ينظر إلى النص على أنه بنية كلامية تقع ضمن بنية كلامية أشمل يعالجها معالجة شمولية، تحوّل النّص إلى جملة طويلة، ثم تُجزئها إلى وحدات دالّة كبرى فصغرى، وتتقصى مدلولاتها في تضمّن الدّوال لها (يمثلها سوسير بوجهي الورقة الواحدة)، وذلك في إطار رؤية نسقية تنظر إلى النّص مستقلا عن شتى سياقاته، بما فيها مؤلّفه، وهنا تدخل نظرية ((موت المؤلف)) لرولان بارت، وتكتفي بتفسيره تفسيرا داخليا وصفيا، مع الاستعانة بما تيسّر من إجراءات منهجية علمية كالإحصاء مثلا".
أمّا من النّاحية العلمية أو الفلسفية فيعرّفها - آندري لالاندAndré Lalande - بأنّها مجموعة من العناصر تكون متضامنة فيما بينها، ويكون كلّ عنصر فيها متعلّقا بالعناصر الأخرى، ولا يستطيع أن يكون ذا دلالة إلاّ في نطاق هذا الكلّ، وعليه تكون البنية نسقا من الظّواهر، ومرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا بعلاقات محدّدة.
2. روافد البنيوية:
أ.مدرسـة جـنيـف:
إنّ الأعـلام المـؤسّسيـن لمدرسة جنيف هم " من الّذين تتلمذوا على يد دي سوسير بطريقة مباشرة، وكان لهم الفضل الكبير في جمع دروسه، وإخراجها للإنسانية، ومن أبرز أعلام هذه المدرسة شارل بالي (C. Bally) ،وسيشهاي (Sechehay)، الّلذان جمعا محاضرات أستاذهما ونشراها، وكانت لهما اهتمامات خاصة بقضايا اللّغة، ممّا جعلهما ينفردان بوجهات نظر متميزة"، و"هي الّتي أعطت الشّرارة الأولى للبنيوية (والفكر الألسني عموما)".
ب . مدرسـة الشّكلانييـن الــرّوس:
تعّد مدرسة الشّكلانيين الرّوس الرّافد الثّاني من روافد البنيوية، وتتشكّل هذه المدرسة من حلقة موسكو اللّغوية، والّتي تأسّست سنة 1915، وجماعة الأوبوياز، واسمها الكامل"جمعية دراسة اللّغة الشّعرية".
أوّلا : حلقـة موسكــو اللّغويـة (1915- 1920)
تأسّست الحلقة "في آذار 1915، بجامعة موسكو بزعامة رومان جاكبسون الّذي يعزى إليه تأسيس هذا "النادي اللّساني" رفقة ستّة طلبة. ومن أعضائها عالم الفلكلور السّلافي بيوتر بوغاتريف P.Bogatyrev، والعالم اللّغوي غروغوري فينوكور (G.Vinokur)، ومنظّرا الأدب ومؤرّخاه: أوسيب بيرك(O.Birk)، وبوريس توماشيفسكي(B. Tomashevsky)، وقد نذكر كذلك ميخائيل باختين M. Bakhtine( 1895-1975) الّذي كان من رؤوس هذه الحلقة، ثم تبرّأ منها بعد ذلك نتيجة انتمائه السّياسي واختلافه الفكري؛ حيث يحاول المصالحة بين الشّكلانية والماركسية، مثلما نذكر فلاديمير بروب V. Propp(1895-1970)، صاحب الأثر الخالد (مورفولوجية الحكاية الشّعبية) 1928، بغض النّظر عن حقيقة انخراطه ضمن هذا التنظيم...".
ثانيا : جـماعـة الأوبــوياز "Opoyaz" (1916)
تُعني هذه التّسمية المختصرة (جمعية دراسة اللّغة الشّعرية) الّتي تأسّست سنة 1916 بمدينة سان بيترسبورغ، ومن أعضائها:
نجد - فيكتور شكلوفسكي- v.chklovsky(1893- 1984)، و- بوريس إيخامبوم- B.Eichenbaum ( 1866 -1959) ، و- ليف جاكوبنسكي- L.jakubinsky، وهي في الأصل مُشكّلة من جماعتين منفصلتين: دارسي اللّغة المحترفين وباحثين في نظرية الأدب.
ج. حلقـة بــراغ "Cercle de Prague" (1926 – 1948 ):
حلقة براغ أو "البنيوية التّشيكية"، وهي المصدر الثّالث للبنيوية "تأسّست بمبادرة من زعيمها فيليم ماتيسيوس (V.Mathesius) من أعضائها التّشيكوسلوفاكيين (هافرانيك، تروكا، فاشيك، موكاروفسكي)، فضلا عن رينيه ويليك (من مواليد 1903 بفيينا لأبوين تشيكيين) وكذلك جاكبسون ونيكولاي تروبتسكوي الفارين من روسيا".
ومع أنّ حلقة براغ "اشتهرت بدراساتها الصّوتية الدّقيقة، فإنّها أسهمت أيضا في تحليل لغة الشّعر، فرأت أنّه لا بد لوضع مبادئ وصف لغة الشّعر من مراعاة الطّابع الثّابت المستقل لها، تفاديا لخطأ شائع يتمثّل في الخلط الدّائب بينها وبين لغة التّواصل، والتّفاهم العادية، إذ تتميّز اللّغة الشّعرية بأنّها تكتسب صفة الكلام من حيث هي عمل فردي يعتمد على الخلق والإبداع...". و"كانت هذه الحلقة باعثا على نشوء حلقات لغوية أخرى قدمت ميراثا بنيويا معتبرا، مثل: حلقة كوبنهاغن (يامسليف وبروندال...) سنة1931، وحلقة نيويورك (سابير، بلوم فيلد، تشومسكي، ...) سنة 1934...".
د. جـماعـة " Tel Quel" (1960):
إنّ الحركة البنيوية في فرنسا "لم تزدهر إلا خلال السّتينيات، مع الجهود الرّائدة لجماعة( (Tel Quel، الّتي تنتسب إلى المجلة الّتي تحمل التّسمية نفسها، والّتي أسّسها النّاقد الرّوائي فيليب صولر - Philipe sollers (من مواليد 1936)، سنة 1960، وضمّت عُصبة من رموز النّقد الفرنسي الجديد، كزوجته الفرنسية ذات الأصل البلغاري جوليا كريستيفا Julia Kristeva (من مواليد 1941)، ورولان بارت Roland Barthes (1915-1980)، وميشال فوكو Michel foucault (1926-1984)، وجاك دريدا Jack derrida (من مواليد الجزائر 1930)"...
3.أسـس النّـزعـة البنيـوية الغـربية:
تقوم النّـزعة البنيوية الغريبة كغيرها من المناهج النّقدية الأخرى، على جملة من الأسس الفكرية والفلسفية والإيديولوجية الّتي تميـّزها عن المناهج الأخرى، وهي كالآتي:
أ.النـّزوع إلى الشّكـلانية :
تعتبـر الشّكلانية (formalisme) مذهب أدبيّ ونقديّ، وقد برز هذا التّيار بقوّة في بداية القرن الماضي، أخذت تتطــوّر مع مـرور الزّمن وتُراكم الدّراسات، وقد قامت بـدور ريادي في التّأسيس النّقدي الجديد، وقد مثّلته في العصر الحديث مناهج نقدية متعدّدة وهي:
- مدرسة الشّكليين الرّوس.
- مدرسة النّقد الحديث في الغرب.
- النّقد الألسني: ومثّلته الأسلوبية، والبنيوية، والتّفكيكية، ونظرية التّلقي، ونظرية النّص.
ب.رفـض التــّاريخ:
تقوم النـّزعة الاجتماعية الّتي كان روج لها المفكر الفرنسي هيبوليت تين (1893-1828، hyppolyte taine) الّذي كان يعتقد أنّ الظاهرة الأدبية والفنية يجب أن تخضع في تأويل قراءتها، وتحليل مضمونها: على ثلاثة عناصر تتمحّص للمؤلّف وما يحيط به وهي:
1- العرق (ويريد بها إلى عرق الكاتب وأصله السلالي).
2- الوسط أو المحيط الجغرافي و الاجتماعي للكاتب.
3- الزّمن ( ويقصد بها إلى التّطور التّاريخي الّذي يقع تحت دائرته الكاتب وهو يكتب إبداعه، ومثله في ذلك الفنان أيضا).
ج. رفــض المؤلف:
إنّ فكرة موت المؤلف ترتدّ في مصدرها الغربيّ، إلى جذور فلسفية تمتد إلى بنية الحضارة الأوروبية نفسها: "فقد أعلن « نيتشة » مقولة « موت الإله » ولاقت هذه الفكرة ترحيبا شديدا في الأوساط الأدبية والفكرية، لأنّها كانت تعبيرا عن اللّحظة التّاريخية، الّتي تمرّ بها أوروبا في ذلك الحين". وقد انتقلت إلى الأدب ونقده "فأعلن الأدباء موت الشّخصية في مجال الأدب، وأعلن النّقاد موت المؤلف في مجال النّقد، وغير ذلك من المسمّيات، ترتدّ في جملتها إلى مقولة « نيتشة» الفلسفية وتعكس بنية الحضارة الأوروبية".
د. رفـض المـرجـعـيـة الاجـتـمـاعيـة:
يعتبر المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسية في الدراسات الأدبية والنّقدية، وقد انبثق هذا المنهج - تقريبا - في حضن المنهج التّاريخي، واستقى منه منطلقاته الأولى خاصّة عند هؤلاء المفكرين والنّقاد الّذين استوعبوا فكرة تاريخية الأدب وارتباطها بتطورات المجتمعات المختلفة، أي أنّ المنطلق التّاريخي، كان هو الأساس الطّبيعي للمنطلق الاجتماعي. وقد أسهمت "نظرية الانعكاس الّتي طوّرتها الواقعية في تعزيز هذا التّوجّه الاجتماعي لدراسة الأدب، لكن المشكلة الأولى الّتي واجهت الدّراسات الّتي تربط بين الأدب والمجتمع كانت تتمثّل في فرضية مُؤدّاها أنّه كلما ازدهر المجتمع في نظمه السّياسية والاقتصادية وفي ثقافته وإنتاجه الحضاري نشب نوع من التّوقّع بأنّ هذا لا بدّ أن يصحبه - أو من الطّبيعي أن يصحبه ازدهار أدبي".
ه. رفـض الـمعـنى مـن اللّغـة:
لقد خاض النّقاد والبلاغيون العرب القدامى، حول ما عُرف في النّظرية البلاغية العربية بثنائية اللّفظ و المعنى، و" أنّ مسألة الفصل بين اللّفظ والمعنى لم تبق حبيسة الدّراسات القرآنية إنّما انتقلت إلى مجال النّقد الأدبي، لتصبح من قضاياه الرّئيسية الّتي حظيت باهتمام كبير من النّقاد، لأنّ الدّراسات الجمالية للقرآن في إطار بحث قضية الإعجاز خصوصا، لم تكن منفصلة، في الواقع عن كلام العرب، والشّعر منها خاصة ". ومنذ أن طرح الجاحظ (ت255هـ)، نظريته المعروفة "...والمعاني مطروحة في الطّريق يعرفها العربيّ والأعجمي والبدوي والقروي، وإنّما الشّأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللّفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطّبع، وجودة السّبك، فإنّ الشعر صناعة وضرب من النّسج وجنس من التّصوير... ".
4. مستويات النّقد البنيوي:
يقترح بعض النّقاد ترتيب مستوياته على النّحو الآتي:
· المستوى الصّوتي: حيث تدرس الحروف ورمزيّتها وتكويناتها الموسيقية من نبر وتنغيم وإيقاع.
· المستوى الصّرفي: وتدرس فيه الوحدات الصّرفية ووظيفتها في التّكوينين اللّغوي والأدبي خاصة.
· المستوى المعجمي: و تدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسّية والتجريدية والحيويّة و المستوى الأسلوبي لها.
· المستوى النّحوي: لدراسة تأليف وتركيب الجمل و طرق تكوينها وخصائصها الدّلالية و الجمالية .
· مستوى القول: لتحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها الأساسية والثّانوية.
· المستوى الدّلالي: الّذي يشغل بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والصوّر المتصلة بالأنظمة الخارجية عن حدود اللّغة الّتي ترتبط بعلوم النّفس والاجتماع، وتمارس وظيفتها على درجات في الأدب و الشّعر.
المستوى الرّمزي: الّذي تقوم فيه المستويات السّابقة بدور الدّال الجديد الّذي ينتج مدلولا جديدا يقود بدوره إلى المعنى الثّاني أو ما يسمى باللّغة داخل اللّغة.
-
الـــنّــقــــد الــنّــفــــســـانـي
1. مفهوم النّقد النّفساني:
النّقد النّفساني هو منهج نقدي يقوم بدراسة الأنماط أو النّماذج النّفسية في الأعمال الأدبية، ودراسة القوانين الّتي تحكم هذه الأعمال في دراسة الأدب، وربط الأدب بالحالة النّفسية للأديب. ويستمدّ النّقد النّفسي آلياته النّقدية من نظرية التّحليل النّفسي psychanalyse، والّذي أسّسه سيغموند فرويد s. freud (1856-1939) في مطلع القرن الفائت، و الّذي فسّر على ضوئها السّلوك الإنساني بردّه إلى منطقة اللاوعي (اللاشعور).
وخلاصة هذا التّصور أنّ في أعماق كلّ كائن بشري رغبات مكبوتة، تبحث دوما عن الإشباع في مجتمع قد لا يتيح لها ذلك، ولما كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة في لاشعوره، فإنّه مضطّر إلى تصعيدها؛ أيّ إشباعها بكيفيات مختلفة ( أحلام النّوم، أحلام اليقضة، هذيان العصابيين، الأعمال الفنية )، كأنّ الفنّ – إذن – تصعيد وتعويض لما لم يستطع الفنان تحقيقه في واقعه الاجتماعي، واستجابة تلقائية لتلك المثيرات النّائمة في الأعماق النّفسية السّحيقة، والّتي قد تكون رغبات جنسية ( بحسب فرويد )، أو شعورا بالنّقص يقتضي التّعويض ( بحسب آدلر)، أو مجموعة من التّجارب والأفكار الموروثة المخزّنة في اللاشعور الجمعي (بحسب يونغ).
2. مدرسة التّحليل النّفسي عند سيغموند فرويد s. freud :
يرتبط ظهور النّقد النّفساني بمدرسة عرفت باسم مدرسة التّحليل النّفسي ، والّتي عدّت ثورة على النّزوع الجسدي في الدّراسات النّفسية واتجاهها نحو سيكولوجية الأعماق. وهي من المدارس الّتي بدأت منها الانطلاقة الحقيقية والمنظّمة للنقد النّفسي، وذلك في بداية القرن الفائت. ويعتبر فرويد freud: " أوّل من أخضع الأدب للتفسير النّفسي، كان شغوفا بقراءة الآثار الأدبية، شديد الإعجاب بالشّعراء والأدباء، لأنّ الشّاعر رجل تراوده الأحلام في اليقضة كما تراوده في نومه، ولقد وهب أكثر من أيّ إنسان آخر، القدرة على وصف حياته العاطفية، وهذا الامتياز يجعل منه في رأي فرويد ، صلة وصل بين ظلمات الغرائز ووضوح المعرفة العقلانية المنتظمة".
واستطاع فرويد freud أن يصف الجهاز النّفسي الباطني، وقسّمه إلى ثلاثة مستويات، وهي كالآتي:
- الشّعور أو الوعي: ويضم وظيفة الإدراك للجهاز الحسي، وجميع التّصورات والمشاعر الّتي يعيها المرء في وقتها.
- ماقبل الشّعور أو ما قبل الوعي: ويضم جميع التّصورات والمواقف الّتي لم يتم الوعي بها في وقتها، لكّنها قابلة أن توعى في أيّ وقت.
- ما بعد الشّعور أو العقل الباطن: وهي الإضافة الجديدة تميّز بها فرويد، ويتميّز العقل الباطن بأنّ مضامينه لا يمكن أن تصبح واعية، لأنّ رقابة ما قبل الوعي تمنع عنها الوعي، وهذه الرّقابة تضم نواهي مأخوذة من العالم الخارجي، كما تضم مجالات أصبحت بذاتها لا شعورية ولا واعية.
وتقوم مدرسة التّحليل النّفسي على فرضية اللاشعور، والّتي تنقسم بدورها إلى ثلاثة عناصر متصارعة، وهي كالآتي:
- الهو ( le cas) : وهو مزيج من الوعي و اللاوعي.
- الأنا ( le moi ) : وهو الإنحراف أو الرّغبة في إشباع الشّهوة.
- الأنا الأعلى ( le sur moi ) : هو النّزوع المثالي عند الإنسان.
ومن رواد مدرسة التّحليل النّفسي نجد تلميذ فرويد، وهو السّويسري كارل جوستاف يونغ (1875-1961)، والّذي استبدل اللاوعي الفردي - عند فرويد - باللاوعي الجمعي. وأضاف مصطلح ( الوعي الجماعي واللاشعور الجمعي). وجاء بعدهما إدلر، ويرى (يونغ) أنّ الرّواسب اللاشعورية الجمعية وهي ما تسمى( النّماذج الأولية) هي الّتي تبدو لنا في شكل رموز مألوفة، عابرة لحدود الزّمان ونفوس الماضي من الأجداد. وهي الرّموز الّتي يتّخذ منها المبدعون الحدثيون موضوعا لعملهم الإبداعي.إذ يتّخذ الرّمز اللاشعوري الجمعي الماضي قيمة في حضوره الإبداعي الحديث ممّا يفسّر استمرار تشّكل النّموذج ودوامه في الأدب.
3. النّقد النّفساني عند شارل مورون وجاك لاكان:
أ. النّقد النّفساني عند شارل مورون (charles mouron):
وقد تجلّت قيمة أعمال مورون حين ظهر له كتاب هام في عام 1962، تحت عنوان "الاستعمالات الملحة والأسطورة الشّخصية". ومن الجلي أنّ قيمة مورون النّقدية قد سبقت ظهور مؤلّفه هذا، وإن كان من المؤكّد أنّ أصداء نشر الكتاب في مجال التّحليل النّفسي، ومجال الدّراسات النّقدية والأدبية، قد عمل على ذيع صيت مورون، وقد فطن النّقاد والمحلّلون النّفسيون إلى أعماله الّتي تعدّ بحق بمثابة مساهمة جديدة في مجال النّقد النّفسي نظرا لأنّها تدعو إلى ارتياد عالم الأثر باعتباره ظاهرة فنية لغوية، لا وثيقة معرفية. وقد حدّد مورون المراحل الأساسية في نقده النّفسي، وهي كالآتي:
- مواكبة نصوص كاتب واحد بعضها على بعض، من أجل بنية العمل الأدبي اعتمادا على شبكة التّداعيات الحرة.
- إظهار الصّور والمواقف الدّرامية ذات العلاقة مع الاستيهامات.
- الأسطورة الشّخصية للكاتب حيث يشتمل كلّ نتاج أدبي على مجموعة من الصّور الخاصة الّتي تتّخذ مظهرا دراميا وتتكرّر بأشكال متباينة.
- فحص نتائج القراءة المباشرة بواسطة معطيات حياة الكاتب الّتي لا تهمنا إلاّ بقدر ما تترك على نفسيته من آثار سيكولوجية.
ب. النّقد النّفساني عند جاك لاكانjacques lacan) ):
اعتمد جاك لاكان (1901-1981) في نقده النّفسي على طروحات سيغموند فرويد، حاملا شعار "العودة إلى فرويد" ، وهذا من خلال التّأكيد على منظومة اللّغة في علاقتها باللاوعي، ووصفها بمرآة اللاوعي، واكتشاف أهمية الدّال في قيادة الوعي الذّاتي للشخصية الانسانية، وهذا من خلال دراسته التّحليلية لرواية غراديفا ( Gradiva).وانطلاقا منها وضع لاكان مفاهيمه الخاصة في نقده الأدبي، وهي على النّحو التّالي:
- البنية اللّغوية للاوعي: يربط لاكان بين اللاوعي والبنية اللّغوية، ليعبّر عن سلطة اللّغة ضمن اللاوعي، ويقول على غرار فرويد " أنا أفكر حيث لا أوجد، إذن أوجد حيث لا أفكر".
- مرحلة المرآة: تعتبر مرحلة المرآة الانطلاقة الأولى لتعرّف الانسان على ذاته من خلال الآخر، وفي هذه الحالة فالآخر هو تلك الصّورة الّتي يكتشف وجودها، و يجري في نفس الوقت عملية مطابقة بينها و بين ذاته المكتشفة، غير أنّ هذه الصّورة الّتي تتكّشف أمام الطّفل لمعرفة ذاته تكون مجرد صورة رمزية تحليلية، ترسمها الذّات بصورة وهمية مثالية، يسميها لاكان طرفة الصّورة المثالية.
4. علاقة علم النّفس بالأدب:
الصّلة بين علم النّفس والأدب وثيقة وعريقة، ولا يحتاج إثباتها إلى تكلّف في النّظريات، وتعسّف في البراهين، بل يغني عن ذلك استحضار حقيقة الأدب، وطبيعة الظاهرة الأدبية من حيث المنشأ والتّشكّل والتّلقي، وكذلك النظر فيما تمارسه الفنون الأدبية من أثر في الحياة، وما تسدّه من ثغرات في واقع الوجود البشري، وما تعالجه من أزمات يستعصي على علم النفس أن يعالجها بمفرده.
فالأدب في حقيقته، حديث نفس إلى نفس، وبوح وجدان إلى وجدان، ورسالة روح إلى روح، بلغة هي في أصلها رموز لخوالج النّفس، ووسيلة لقضاء حاجاتها، نفعية كانت أم عاطفية، والأدب بطبيعته، فعالية نفسية ونشاط وجداني، بواعثه نفسية، وتشكّله نفسي، ومسلكه إلى المتلقي هو الحسّ والغزيرة والوجدان، وهي جميعها تُشكّل المكونات الأساسية لمفهوم النّفس. وما دامت الصّلة بين الأدب وعلم النّفس مؤكّدة، فمن الواضح أنّ هذه الصّلة عرفتها كل المراحل، الأمر الّذي دفع الدّارسين إلى التّمييز في هذا الارتباط بين طورين أساسيين ، وهما كالآتي:
الأوّل: تمّ الاهتمام فيه برصد العلاقة بين الأدب والنّفس على مستوى الإنتاج والتّلقي الأدبيين.
الثّاني: تمّت فيه بلورة تصوّرات نقدية مستمدة من علم النّفس والتّحليل النّفسي لدراسة الظّاهرة الأدبية وتجلياتها النّصية.
وبالتّساوق عمل الباحثون والنّقاد على رصد المسوغات الّتي بررت ارتباط النّقد الأدبي بالدّراسة النّفسية خلال هذا التّاريخ الطّويل، والّتي تُعطي الشّرعية للاستمرار في ذلك، ما دامت تلك المسوغات قائمة، ويمكن تحديد أبرزها في ما يأتي:
- الطّبيعة التّعبيرية والذّاتية للأدب.
- الوظيفة التّفسيرية للنقد الأدبي.
- الوظيفة التّأثيرية للأدب.
- السعي العلمي للنقد الأدبي.
5. عيوب النّقد النّفساني:
- غلب التّحليل النّفسي العلمي المنهج النّقدي التّحليلي للأدب.
- الحكم على العمل يكون بالقيم النّفسية الّتي يحتويها، لا على أساس توافر القيم الجمالية.
- ساوى المنهج النّفسي بين المبدع وغير المبدع.
- ليس من الصّواب النّظر إلى الأدب على أنّه محصلة شذوذ أو مرضا.
-
النّقد التاريخي
1- المنهج التاريخي النشأة والتأسيس:
يعدّ المنهج التاريخي أول المناهج النقدية السياقية ظهوراً في العصر الحديث، ارتبط بالفكر الإنساني وتبلور هذا المنهج داخل المدارس الغربية العريقة كالرومانسية والواقعية وانبثق عنها ، إذ هي التي أبانت عن الوعي الإنساني بالزمن، وتصوره للتاريخ ، ووضوح فكرة التسلسل والتطور والارتقاء ،يقول كارلوني وفيللو :"نطبق على الآداب أساليب التاريخ العادية: تمييز الحقبات، وتحقيق نزعاتها، إظهار تسلسل الوقائع، وضع جدول لكل حقبة أو لكل لون أدبي في فترة معينة، جدول لا يتجاهل الصغار، كي نضع الكبار في سياق الكلام، ربط الوقائع الأدبية بحقائق التاريخ الأخرى. وباختصار تقديم الأدب في ديمومته واستمراره الحي، وجعلنا نشعر بمؤلفات الماضي القديم أو الحديث كأننا نعيش في زمن ظهورها، وإن كنا نفهمها أحسن فهم لأننا نعرف ما سيتبعها". هذا المنهج يشكِّل أهميةً كبيرةً في معرفة الأدب ومراحلِ تطورهِ، وفهم حقائقها وسر وجودها وخلودها.
وهذا التصور التاريخي هو الذي عكس النظرة الكلاسيكية التي ظلت تؤمن بأن الأدب والابداع ما هو إلا محاكاة Imitation للأقدمين ، وأن أدبهم يمثل النموذج الأرقى في مجال التطور التاريخي. فالتاريخ يعبر في جوهره عن الذاكرة الإنسانية بمختلف نشاطاتها المادية والفكرية، ويدرس الإنسان بوصفه كائناً مرتبط بالزمان والمكان.
إن النقد التاريخي هو منهج علميّ يدرس الأدب من حيثُ كونه ظاهرة مرت بمراحل عدّة تخضع للتغيرات الزمكانية في مظاهرها المختلفة ووظيفة تكوينها وأهمية عناصرها وأشكالها ومضامينها، وتكمن من وراء التحولات والتغيّرات الأدبية أسباب اجتماعية وبيئية، والقراءة التاريخية هي تلك الجهود الفكرية التي عرفها مطلع هذا القرن إلى منتصفه، والتي حاولت أن "تقص" رحلة الأدب من خلال تراكمات التاريخ، ضعفاً وقوة، فالتحم البحث الأدبي بالبحث التاريخي، وفق شرائط المنهج العلمي، وتولد عن هذا التلاحم ميلاد "تاريخ الأدب"
إن الحضور المكثف للنقد التاريخي الذي اتخذ طابعاً منهجياً مؤسساً، وهو كما يقول عبد السلام المسدي:"سلسلة من المعادلات السببية:فالنص ثمرة صاحبه، والأديب صورة لثقافته والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ، فإذا النقد تأريخ للأديب من خلال بيئته"، فقد ركزت القراءة التاريخية على تحقيق النصوص وتوثيقها باستحضار حياة المؤلف وجيله وبيئته.
فاهتمت بشرح الظواهر الإبداعية، فعمدت إلى إبراز العوامل الجغرافية والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية،كما سعت إلى دراسة الأطوار التي مر بها أي جنس من الأجناس الأدبية، ورصد الأقوال التي قيلت في عمل ما أو مبدعه للترجيح بينها، ومن ثم تعمد على المرجّح من الأقوال لمعرفة العصر والملابسات التاريخية المساهمة في إنتاج ذلك العمل فهذه القراءة "تبدأ بالتحريات ذات الطابع العلمي الواسع، والتي تشبه إلى حد بعيد كيفيات البحث في الظواهر التاريخية. وهي تحريات تفصيلية: تتلخص في جمع المستندات والطبعات المختلفة، والتحقق من صحة نسبة النصوص، وقراءة الحواشي، ورصد التغيرات الرئيسية".
2- نظريات النقد التاريخي وروادها:
من أبرز النّقاد الذين تبنوُّا المنهج التأريخي في دراساتهم النقدية نجد : ( هيبوليت تين، سانت بيف، غوستاف لانسون، فردينان برونتيير..)
1- هيبوليت تين H.Taine"وهو يعتبر من المنظرين الأوائل للنقد التاريخي، فقد كان يعتبر الإنتاج الأدبي انعكاسا للمحيط العام والوسط الاجتماعي، وأخضعه لعوامل الجنس والبيئة واللحظة التاريخية التي كانت تشرط الطاقة التعبيرية المحورية التي يسميها"الملكة الأساسية Faculté maîtresse" وتقسيمه ورد على الشكل التالي:
أ- العرق أو الجنس، يتمثل في الخصائص الفطرية والوراثية المشتركة بين أفراد الأمة الواحدة المنحدرة من جنس معين
ب- البيئة أو المكان والوسط: بمعنى الفضاء الجغرافي وانعكاساته الاجتماعية في النص الأدبي
ج- الزمان والعصر: مجموعة الظروف السياسة والثقافية ومدى تأثيرها على النص
2- وسانت بيف Sainte Beuve الذي كان يرسم شخصيات الأدباء انطلاقا من دراسة حياتهم، ويصنفهم إلى فصائل فكرية عقلية ونماذج نفسية وأخلاقية….
3- غوستاف لانسون G.Lanson الذي ظهر له كتاب بعنوان "منهج البحث في تاريخ الأدب" سنة 1901، حدد فيه خطوات المنهج التاريخي وجعلها بمثابة قوانين تحاور النص في إطاره الخارجي وهي:
أ- قانون تلاحم الأدب بالحياة: الأدب مكمل للحياة
ب- قانون التأثيرات الأجنبية
ج- قانون تشكل الأنواع الأدبية
د- قانون تلاحم الأشكال الجمالية
هـ- قانون ظهور الأعمال الخالدة
و- قانون أثر المؤلف في الجمهور (المؤلف قوة منظمة). فلانسون قيد إجراءاته التأريخية الموضوعية بسلسلة من العمليات العلمية المتراوحة بين تحقيق النص وتوثيقه وتحليله وتقويمه وتصنيفه،كي تتكامل في نظره المعرفة الموضوعية التاريخية مع التأثرالشخصي والذوق الخاص،وتراعي خصوصيات المادة الأدبية موضوع الدرس.
3- النقد التاريخي العربي:
تعد الدراسات التاريخية في النقد العربي من أقدم الدراسات وأعرقها نشأة وتداخلاً مع النقد الفني في كثير من القضايا، إذ نلفي كثيراً من الأحكام النقدية تعتمد في أسسها على التصورات التاريخية، في فن السيرة والمدونات، ثم ما فعله ابن خلدون في قضية التحقيق والتدوين.
استنت القراءة النقدية التاريخية العربية الحديثة لنفسها سنناً جديدة في منهجية الدرس التاريخي للأدب، فنشأت الحاجة إلى إعادة قراءة الموروث الأدبي العربي على ضوء ما يعرف "بتاريخ الأدب العربي" وقد عني بذلك الكثير من النقاد منهم طه حسين، وشوقي ضيف وجرجي زيدان وإيليا الحاوي، وأبو القاسم سعد الله وصالح خرفي... وغيرهم، وقد ساهمت الدرسات النقدية العربية بهذا المنهج بتحرير النصوص وتحقيقها والتأكد من صحة وسلامة نِسْبَتِها إلى أصحابها، وخلوها من التحريف، والزيادة والنقصان، وتحقيق تاريخ النّص وزمان تأليفه، والمرحلة التي ينتمي إليها.
4- المآخذ على المنهج التاريخي:
أوجه القصور والاعتراض، التي مني بها المنهج التأريخي في معالجته للآداب، ما يأتي:
1-إهمال النّص الأدبي من داخلهِ، من حيثُ لغته وأسلوبه، وخصائصه الفنيّة بالدرس والتحليل.
2- طغيان التاريخ على الأدب، وكأنَّه مادة تأريخية أكثر منها درساً أدبياً.
3- تجاهل الخصائص الفردية، والمواهب الشّخصية في العمل الأدبي، وإرجاع الإبداع إلى أسباب جبرية كالبيئة، والجنس، والعصر، ممّا يحقق إغفالاً لعبقريات الأدباء، ومواهبهم الفردية.
4- أصدر المنهج التأريخي كثيراً من الأحكام التعميمية والجازمة على عصور الأدب والأدباء، ومن ذلك القول بأنَّ: التدهور التأريخي يُخلّف أدباً يطغي فيه الحكم الذاتي على أحداث التاريخ وعصره، كما فعل طه حسين في كتابهِ (في الشعر الجاهلي) الذي بالغ فيه كثيراً ورفض الأدب الجاهلي جملةً وتفصيلاً معتمداً على هواجسه الذاتية والظَّنية، واستقرائه الناقص للمعلومات والتاريخ، مبتعداً عن جادة الصّواب والموضوعية العلميّة.
5- أهملَ المنهج التأريخي الكثير من الأدباء والعلماء الذين لم يكن لهم حضور سياسي
أو اجتماعي بارز، ووقف عند الشَّخصيات المشهورة فقط.
-
النقد الاجتماعي
يعد النقد الاجتماعي من المناهج النقدية السياقية الحديثة، وقد تولد هذا المنهج من المنهج التاريخي، بمعنى أن المنطلق التاريخي كان هو التأسيس الطبيعي للمنطلق الاجتماعي عبر محوري الزمان والمكان، وهو منهج يربط بين الأدب والمجتمع بطبقاته المختلفة، فيكون الأدب ممثلاً للحياة على المستوى الجماعي لا الفردي؛ باعتبار أن المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الإبداعية، فالقارئ حاضر في ذهن الأديب وهو وسيلته وغايته في آن واحد
اهتم المنهج الاجتماعي بالمرجع الخارجي وذلك بربط الأدب بالمجتمع مباشرة مع المادية الجدلية أوبطريقة غير مباشرة فبدأ التنكر للمثالية، من خلال إحلال الواقع محل المثال، وغدا الفن انعكاساً صادقاً للواقع الموضوعي، فهو لا يولد خارج الحياة، ولا يتنزل عليها، وإنما ينبع منها، فهو في جوهره حكم يصدره الفنان بعد تحليل الواقع المتحول باستمرار: "ولو أننا افترضنا أن هذه الفكرة ليست سوى نتيجة لنشاط عقله لما قتلنا الفن وحده. بل قتلنا أيضاً إمكانية الفن نفسها" لقد أجبر الجدل الواقع بين المثل والواقع، الفلسفة المثالية على الاعتراف به كوجود
ويقول جورج لوكاتش عن المنهج الاجتماعي " إنه منهج بسيط جدا ، يتكون أولا و قبل أيّ شيء من دراسة الأسس الاجتماعية الواقعية بعناية " فالأدب يصور لنا الحياة الاجتماعية في الفترة التاريخية التي كتب فيها، ويعطينا صورة واضحة عن وقائع اجتماعية محددة
1- المنهج الاجتماعي التأسيس والنظريات:
مع ظهور النظريات الإيديولوجية الحديثة كالنظرية الاشتراكية والشيوعية سيظهر المنهج الإيديولوجي الاشتراكي والمنهج المادي الجدلي في الساحة النقدية الأدبية الحديثة، حيث ظلت تتساوق وما طرحته فلسفة هيجل ( 1770- 1831 ) التي ربطت بين الأنواع الأدبية والمجتمعات، وكانت الواقعية إفرازًا بينًا فيه، كما أن الماركسية تُداخِل فيما بين المنهجين التاريخي والاجتماعي. ومنه فالجذور الأولى للمنهج النقدي الاجتماعي ترجع إلى هيجل، إذ ربط بين ظهور الرواية والتغيرات الاجتماعية، مستنتجاً أن الانتقال من الملحمة إلى الرواية جاء نتيجة لصعود البرجوازية، وما تملكه من هواجس أخلاقية وتعليمية
مع بدايات القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام بدراسة العلاقة بين الناحية الاجتماعية والأدب، فصدر آنذاك كتاب لمدام دوستال تحت عنوان "الأدب في علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية" متناولاً تأثير الدين والعادات والقوانين في الأدب، وتأثير الأدب فيها فقد تبنت مبدأ أن الأدب تعبير عن المجتمع، لقد ظل الاهتمام بالمضامين قائماً لتحديد موقف المؤلف من الصراع الطبقي، ما دام المجتمع يشهد صراعاً طبقياً، بوصف الفن شكلا من أشكال البنية الفكرية للمجتمع.
قد كان للفكر المادي الماركسي أثر في تطور المنهج الاجتماعي، وإكسابه إطاراً منهجياً وشكلاً فكرياً ناضجاً، ومن المتقرر في الفلسفة الماركسية أن المجتمع يتكون من بنيتين: دنيا: يمثلها النتاج المادي المتجلي في البنية الاقتصادية، وعليا: تتمثل في النظم الثقافية والفكرية والسياسية المتولدة عن البنية الأساسية الأولى، وأن أي تغير في قوى الإنتاج المادية لابد أن يُحدث تغيراً في العلاقات والنظم الفكرية.
وقد عملت الماركسية مع الواقعية جنباً إلى جنب في تعميق الاتجاه الذي يدعو إلى التلازم بين التطور الاجتماعي والازدهار الأدبي؛ مما أسهم في ازدهار "علم الاجتماع" بتنوعاته المختلفة، كان من بينها علم نشأ قبل منتصف القرن العشرين أطلق عليه: علم "اجتماع الأدب" أو "سوسيولوجيا الأدب"، وقد تأثر هذا العلم بالتطورات التي حدثت في الأدب من جانب، وما حدث في مناهج علم الاجتماع من جانب آخر.
2- اتجاهات المنهج الاجتماعي.
أ- الاتجاه الأول: الكمي. يطلق عليه علم اجتماع الظواهر الأدبية، وهو تيار تجريبي يستفيد من التقنيات التحليلية في مناهج الدراسات الاجتماعية، مثل الإحصائيات والبيانات وتفسير الظواهر انطلاقاً من قاعدة يبنيها الدارس طبقاً لمناهج دقيقة ثم يستخلص منها المعلومات التي تهمه ومن رواد هذه المدرسة "سكاربيه"، ناقد فرنسي له كتاب في علم اجتماع الأدب، وهو يدرس الأدب كظاهرة إنتاجية مرتبطة بقوانين السوق، ويمكن عن هذا دراسة الأعمال الأدبية من ناحية الكم.
ويرى هذا الاتجاه أن الأدب جزء من الحركة الثقافية، وأن تحليل الأدب يقتضي تجميع أكبر عدد البيانات الدقيقة عن الأعمال الأدبية، فعندما نعمد إلى دراسة رواية ما؛ فإننا ندرس الإنتاج الروائي في فترة محددة، وبما أن الرواية جزء من الإنتاج السردي من قصة وقصة قصيرة وغيرها، فإننا نأخذ في التوصيف الكمي لهذا الإنتاج عدد القصص والروايات التي ظهرت في تلك البيئة، وعدد الطبعات التي صدرت منها، ودرجة انتشارها، والعوائق التي واجهتها، ولو أمكن أن نصل إلى عدد القراء، واستجاباتهم، وغيرها من الإحصائيات الكمية؛ حتى يمكن لنا أن ندرس الظاهرة الأدبية كأنها جزء من الظاهرة الاقتصادية، لكنه اقتصاد الثقافة بمعنى أننا نستخدم فيها مصطلحات الإنتاج والتسويق والتوزيع، وكل ذلك نستخدمه لاستخلاص نتائج مهمة تكشف لنا عن حركة الأدب في المجتمع.
ب- الاتجاه الثاني: المدرسة الجدلية. نسبة إلى "هيجل" ثم ماركس من بعده ورأيهما في العلاقة بين البنى التحتية والبنى الفوقية في الإنتاج الأدبي والإنتاج الثقافي، وهذه العلاقة متبادلة ومتفاعلة مما يجعلها علاقة جدلية .
وقد برز "جورج لوكاش" كمنظِّر لهذا الاتجاه عندما درس وحلل العلاقة بين الأدب والمجتمع باعتباره انعكاساً وتمثيلاً للحياة، وقدَّم دراسات ربط فيها بين نشأة الجنس الأدبي وازدهاره، وبين طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية لمجتمع ما تسمى بـ"سوسيولوجيا الأجناس الأدبية"، تناول فيها طبيعة ونشأة الرواية المقترنة بنشأة حركة الرأسمالية العالمية وصعود البرجوازية الغربية.
ثم جاء بعده "لوسيان جولدمان" الذي ارتكز على مبادئ لوكاش وطوّرها حتى تبنى اتجاهاً يطلق عليه "علم اجتماع الإبداع الأدبي"، حاول فيه الاقتراب من الجانب الكيفي على عكس اتجاه "سكاربيه" الكمي. وقد اعتمد "غولدمان" على مجموعة من المبادئ العميقة والمتشابكة التي يمكن أن نوجزها في التالي:
1. يرى "غولدمان" أن الأدب ليس إنتاجاً فردياً، ولا يعامل باعتباره تعبيراً عن وجهة نظر شخصية، بل هو تعبير عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة، بمعنى أن الأديب عندما يكتب فإنه يعبر عن وجهة نظر تتجسد فيها عمليات الوعي والضمير الجماعي، فجودة الأديب وإقبال القرَّاء على أدبه بسبب قوته في تجسيد المنظور الجماعي ووعيه الحقيقي بحاجات المجتمع، فيجد القارئ ذاته وأحلامه ووعيه بالأشياء، والعكس صحيح لمن يملكون وعياً مزيفاً..
2. أن الأعمال الأدبية تتميز بأبنية دلالية كلية، وهي ما يفهم من العمل الأدبي في إجماله، وهي تختلف من عملٍ لآخر، فعندما نقرأ عملاً ما فإننا ننمو إلى إقامة بنية دلالية كلية تتعدل باستمرار كلما عبرنا من جزء إلى آخر في العمل الإبداعي، فإذا انتهينا من القراءة نكون قد كوَّنا بنية دلالية كلية تتكون من المقابل المفهومي والمقابل الفكري للوعي والضمير الاجتماعيين المتبلورين لدى الأديب.
واعتماداً على ما سبق نجد بين العمل الأدبي ودلالته اتصالاً وتناظراً، ونقطة الاتصال بين البنية الدلالية والوعي الجماعي هي أهم الحلقات عند "جولدمان" والتي يطلق عليها مصطلح "رؤية العالم"، فكل عمل أدبي يتضمن رؤية للعالم، ليس العمل الأدبي المنفرد فحسب لكن الإنتاج الكلي للأديب.
انطلاقاً من هذا المنظور أسس "غولدمان" منهجه "التوليدي" أو "التكويني"، كما قام بإجراء عدد من الدراسات التي ترتبط بعلم اجتماع الأجناس الأدبية كما فعل "لوكاش"، فأصدر كتاباً بعنوان "من أجل تحليل سوسيولوجي للرواية" درس فيه نشأة الرواية الغربية وكيفية تحولاتها المختلفة في مراحلها المتعددة تعبيراً عن رؤية البرجوازية الغربية للعالم .
ثم حدث تطور في مناهج النقد الأدبي مما أدى إلى نشوء علم جديد هو "علم اجتماع النص"، يعتمد على اللغة باعتبارها الوسيط الفعلي بين الأدب والحياة، فهي مركز التحليل النقدي في الأعمال الأدبية، فاتخاذ اللغة منطقة للبحث النقدي في علم اجتماع النص الأدبي هو الوسيلة لتفادي الهوة النوعية بين الظواهر المختلفة.
4- المنهج الاجتماعي في النقد العربي.
نجد في تراثنا النقدي القديم نقداً للمجتمع وسلوكياته ككتاب "البخلاء" للجاحظ، والحرص على الربط بين المعنى الشريف واللفظ الشريف الذي نجده عند بشر بن المعتمر، وبعض الملاحظات المنتشرة في كتب النقد القديم التي تحث على الربط بين المستوى التعبيري ومستوى المتلقين
أما في النقد الحديث، فلم يكن لهذا المنهج رواد بارزون مقتنعون به، يربطون بين الإنتاج المادي والإنتاج الأدبي كما يوجد في روسيا، ولكننا نجد بعض الدعوات إلى الاهتمام بالاتجاه الاجتماعي في النقد الأدبي عند شبلي شميل، وسلامة موسى، وعمر الفاخوري، وقد اقترب هذا المنهج من المدرسة الجدلية عند محمود أمين العالم، وعبد العظيم أنبس، ولوبس عوض، حتى كان تجليه في النقد الأيدلوجي عند محمد مندور
-
الحصّة الحادية عشرة والثانية عشرة :النقد الثقافي
يعد النقد الثقافي نشاطا معرفيا معاصرا، أفرزته تيارات النقد لمابعد الحداثة كردة فعل على المناهج النسقية وعلى رأسها البنيوية اللسانية، التي علمنت مقولاتها النقدية الظاهرة الأدبية، و بالغت في تسييج النصّ الأدبي وعزلـه عن محيطه وسياقاته الخارجية؛ فأهملت بذلك اعتبارات الذات والمتلقي والسياقات المتعددة في نقده، بدعوى؛ أنّ لا أدبية للنصّ خارج حدود نسقه اللغوي أوجانبه الشكلي الجمالي.
ومن ثمّ؛ فإنّ مهمة النقد الثقافي هي"الانتقال بالممارسة النقدية من نقد النصوص والعناية بجمالياتها الأسلوبية والبنائية إلى نقد الأنساق المطمورة فيها، أي نقد محمولاتها الثقافية وكشف ومصادرة أنساقها المتخفية... وبذلك، فقد طرح النقد الثقافي مشروعا بديلا لمشروع النقد الأدبي؛ إذ تنبـــــذ أطروحاتـــه المعايير البلاغيــة الجماليــــة التي احتـكم إليها نقد النصّ الأدبي ردحــــا من الزمن؛ وتهدف مساعي النــــاقد الثقافي من وراء مقولاتـــه إلى تحرير الخطاب من مبـــدأ الخضوع والتأسيس لفكرة " نقد ثقافة المركز و مواجهة هيمنة النسق"، متوسلا بإستراتجيـة تفكيكيــة تنزع إلى التقويض و التشظي لتسليط الضوء على المهمّش في الثقافتين الوطنيـة والإنسانيـة و ردّ الاعتبار إلى القيم غير الجمالية، الكامنة في أحشاء الخطاب الأدبي"
و لئن كانت نشأة هذا التوجه النقدي، غربية؛ حيث ظهرت الإرهاصات الأولى للنقد الثقافي خلال القرن الثامن عشر بأوربا، أمّا الإعلان الرسمي عنه، فقد كان في ثمانينيات القرن العشرين (1985م) بالولايات المتحــدة الأمريكيــة من قبل الناقد الأمريكي "فنسنت ليتش"، الذي دعـــــا إلى مشروع نقدي يحرر النقد المعاصر من نفق النقد الشكلاني، و يمكّن النقاد من تناول مختلف أوجه الثقافة لاسيما التي أهملها النقد الأدبي"...فإنّ النقد العربي المعاصر لم يكن هو الآخـــر بمنأى عن وهج هذا التوجه الجديد ويعدّ الناقد السعودي"عبد الله الغذامي"صاحب السبق في استقدام النقد الثقافي إلى فضاء النقد العربي المعاصر، ثم انتقلت عدواه بعد ذلك إلى ثلة من النقّاد العرب الذين اشتغلوا عليه، تنظيرا و تطبيقا.
2- قراءة في مرجعيات و إشكالات النقد الثقافي :
ظهرت متغيرات ثقافية منذ مطلع القرن العشرين كانت سبباً في ظهور الظاهراتية أو الفينومينولوجيا والتي كما يبدو وجد فيها الألمان توسيعاً لمفهوم الذاتية الرومانسية وتطويراً له وتجاوزاً للانساق الثقافية التي تخضع الذات للموضوع، ، فتشكل نسق ثقافي يؤكد حضور الذات في صياغة وتشكيل العالم الخارجي وفق رؤيتها ، فالمعرفة " الحقيقية للعالم لا تأتي بمحاولة تحليل الأشياء كما هي خارج الذات (نومينا Noumena) وإنما بتحليل الذات نفسها، وهي تقوم بالتعرف على العالم، أي بتحليل الوعي وقد استبطن الأشياء فتحولت إلى ظواهر (فينومينا Phenomena)، ذلك أن الوعي لا يكون مستقلاً، وإنما هو دائماً وعي بشيء ما»
وفي ظل هذا النسق الثقافي تغيرت النظرة إلى علم التاريخ، فلم يعد وضعياً كما هو الحال عند علماء التاريخ الأوربيين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ولم يعد حتمياً كما كان لدى الماركسية ،وإنما أصبح الفرد يسهم في صناعة التاريخ ،من خلال تفاعله مع تلك الاحداث ،فلا وجود للتاريخ دون وعي الكائن أو تلقيه للأحداث وفق ثقافته الراهنة.
هذا الوعي بدور الذات الفردية في صياغة العالم الخارجي كان له تأثير في نظرية الأدب، ومناهج النقد الأدبي، والأدب المقارن، وتبلور هذا الأثر في ما يسمى بنظرية التلقي التي تجاوزت المناهج التاريخية أو الخارجية التي تركز على دراسة الأدب من الخارج، وتجاوزت كذلك الشكلانية وما جاء بعدها من مناهج تتعامل مع النص على أنه نتاج مغلق ومعزول عن خارجه، فقد اتجه أصحاب هذا النسق إلى التركيز على المتلقي؛ لأنه في رأيهم يسهم من خلال قراءته في إبداع أو خلق النص الأدبي، ففهم النص الأدبي يتعدد بتعدد ثقافة قرائه، ولا معنى لوجود النص الأدبي إذا لم يصل إلى متلقٍ، وهذا شيء طبيعي في ظل نسق ثقافي لا يعترف بالظواهر والنصوص إلا من خلال الذات الواعية، ومن هنا يصبح للمتلقي دور مهم في الإبداع الأدبي.
إذا كان التّطور الثقافي نتيجة حتمية للتطور الاجتماعي كما يقول هربرت سبنسر، والثقافة نتاج مجتمعات مفارقة للتشكيل البدائي الذي يكون أقرب إلى التأثر بالعالم الطبيعي، وهي تتطور مع تطور المجتمعات الساعية نحو مزيد من الرقي. و إذا كان الناقد الإنجليزي رايموند وليامز قد وضع أولى التّصورات المنهجية فيما يتعلق بالدرس الثقافي من خلال كتابه «الثقافة والمجتمع »1958 حيث أسهم في تحويل وجهة المقاربة النقدية من مقاربة لغوية إلى مقاربة تتوسل تحديد المواقف والأنساق الثقافية التي تتخلل تلك النصوص باختلاف تمظهراتها.
- النقد الثقافي و نظريات النقد الأدبي
- تلقي النقاد العرب للنقد الثقافي (التحصيل و التأصيل)
-
النّقد الأسلوبي
1- مصطلح الأسلوبية:
ثم مشكل المصطلح إذا أن التردد بين عد الأسلوبية منهجاً نقدياً أم أنها أوسع من ذلك بسبب تعدد ميادينها وتداخلها مع حقول أخرى كثيرة كالنقد الأدبي ، وعلم البلاغة، واللسانيات ، وعلم النص ، حتى أن الأسلوبية نفسها غدت أسلوبيات ، وهو المصطلح الذي يؤثره سعد مصلوح حيث جعله مقابلاً للمصطلح الإنجليزي Linguistic Stylistics وقيده بوصف " اللسانية " مؤكداً المنطلق اللساني في شرح العلاقة بين البلاغة العربية وهذا الفرع من فروع الدراسة اللسانية المعاصرة.
والاحتراز الأخير هو وجود نوع من التداخل بين مصطلحي (الأسلوب) و(الأسلوبية) وعلى الرغم من ذلك التوضيح الذي قدّمه الدكتور أحمد درويش حول المصطلحين وبدايتهما التاريخية وتحديده للعلاقة الرأسية والأفقية بين المصطلحين إلا أن الإشكالية تبقى قائمة بين هذا التداخل وبخاصة طول الفترة الزمنية التي قطعها المصطلح الأول "الأسلوب"، في مقابل حداثة المصطلح الثاني "الأسلوبية " .
2- تعريف الأسلوبية:
لعل تقاطع مجموعة المفاهيم والمناهج والنظريات النقدية قد شجعت الأسلوبية بتطوير التحليل الداخلي والتزامني ، وعززت الاهتمام المخصص لجماليات الكتابة ، وأضافت الترابط بين الشكل والمضمون ، ودخلت إلى أفكار البنية كما سعت إلى مقاربة النص مقاربة محايثة ، واعترفت اعترافاً أساسياً بالمقام والشفرة المرجعية ، فهي تقع في موقع وسط بين المناهج الداخلية التي أغلقت نفسها على النص ، واتجاهات ما بعد البنيوية . ولقد قطعت الأسلوبية أشواطاً كثيرة في تحليل الخطاب الأدبي من أسلوبية لسانية ، إلى أسلوبية وصفية إلى أسلوبية تكوينية إلى أسلوبية إحصائية ، إلى أسلوبية بنيوية ، كاسرة بذلك انغلاق البنيوية ، ومشرّعة أبواب التحليل والتأويل . كما قطعت أشواطاً أخرى في تعريفاتها: فقد عرّف الأسلوب بأنه إضافة أو زيادة بمعنى أنه يعني التحسين والتجميل. وعرف بأنه اختيار من إمكانات اللغة المتعددة ، سواء أكان اختياراً واعياً مقصوداً أم اختيارا لا واعيا تتطلبه شرائط الابداع وتجلياته ، وعرف الأسلوب أيضاً بأنه انحراف Deviation عن المعيار أو انزياح عنه .
ويعرّف معجم أكسفورد الكبير الأسلوب بأنه " طريقة التعبير المميزة لكاتب معين ( أو لخطيب أو متحدث ) أو لجماعة أدبية أو حقبة أدبية من حيث الوضوح والفاعلية والجمال وما إلى ذلك " . وبهذا المعنى فإن الأسلوب وجد منذ وجدت الكتابة ، فكل خطاب يتوفر على ملمح من ملامح الأسلوب ، أومحاولة تمييز هذا الخطاب اللغوي من غيره من أساليب الكلام ، يشكل بداية لتأسيس نظرية أسلوبية أو خطوة نحو الدرس الأسلوبي . ومن هنا نرى أن الدرس الأسلوبي ليس جديداً، وإنما هو نشاط مارسته جميع المعارف التى اتخذت من الخطاب ميداناً لها ، وتجلت ملامحه في الدراسات الأدبية والبلاغية والنقدية والشروح الشعرية ، وإن تكن هذه التجارب لم تتمكن من تأسيس الأسلوبية علماً مستقلاً
ويرجع أحمد درويش مصطلح الأسلوب Style إلى القرن الخامس عشر على حين يرجع مصطلح الأسلوبية Stylistique إلى بداية القرن العشرين مستنداً إلى المعاجم التاريخية الفرنسية . ويرى أنه كان يقصد بالأسلوب النظام والقواعد العامة مثل " أسلوب المعيشة " أو " الأسلوب الموسيقي " أو "الأسلوب البلاغي " ... الخ ، أما المصطلح الثاني " الأسلوبية " فقد اقتصر على مقول الدراسات الأدبية واحتد مع جورج مونان إلى الفنون الجميلة عامة
ويعتقد بعض دارسي الأسلوبية أنها تعد تطوّراً للفكر الشكلاني ، وعلى الرغم من أن أهمية الأسلوبية تقتصر على أنها إحدى الأدوات التى يمكن أن يستخدمها النقاد في الحكم على الأعمال الأدبية ، فإن بعض النقاد العرب يعتقدون أن الأسلوبية منهج نقدي جديد يستهدف إلغاء البلاغة القديمة وإحلال بلاغة جديدة مكانها تقوم دعائمها على الجمالية والوظيفية
لقد كان نقد العمل الأدبي والحكم على نوعيته يقومان أساساً على تقديرات وأحكام ذات طبيعة أسلوبية - لغوية . فالتحليل الأدبي كان يتضمن على الدوام ملاحظات حول أصالة الكاتب في استعمال المفردات والجمل والصور وغيرها من العناصر اللغوية والبيانية . وهذا يعني أن دراسة الأسلوب كانت تمثل دائرة أوسع وأشمل من تلك التي تغطيها كلمة " الأسلوبية"
ارتبط مصطلح الأسلوب فترة بمصطلح البلاغة حيث ساعد على تصنيف القواعد المعيارية التى تحملها البلاغة إلى الفكر الأدبي والعالمي ، منذ عهد الحضارة الإغريقية ، وبخاصة كتابات أرسطو Aristotle. ثم ما لبثت أن اكتسبت كلمة " الأسلوب " شهرة التقسيم الثلاثي الذى استقر عليه بلاغيّو العصور الوسطى ، حين ذهبوا إلى وجود ثلاثة ألوان من الأساليب ، هي : البسيط ، والمتوسط ، والسامي ، وهي ألوان يمثلها عندهم ثلاثة نماذج كبرى في إنتاج الشاعر الروماني " فرجيل " vergil
3- نشأة الأسلوبية:
ويُعتقد أن الأسلوبية انطلقت من رحم البلاغة بأصولها الأرسطية القديمة ولهذا نجد من يصرّح بالقول : " في البدء كانت البلاغة " ولاينسى أن يشير إلى أبوية المؤسس الأول أرسطو Aristotle ولعل جورج بوفون ( 1707 - 1788 ) في " مقال في الأسلوب " ، قد أحدث هزّة قوية لبعض مفاهيم الأسلوب ولبعض قواعده المعيارية وخلاصتة أن الأسلوب هو الرجل ، رابطاً قيم الأسلوب الجمالية بخلايا التفكير الحية والمتغيرة من شخص إلى شخص ، وليس بقوالب التزيين الجامدة التي يستعيرها المفكرون عادة من المبدعين دون إدراك حقيقي لقيمها
ويتضح أن كلمة أسلوبية ظهرت خلال القرن التاسع عشر وبدأت تتأصل مصطلحاً في السنوات الأولى من القرن العشرين، حيث تلقت دفعة قوية على أثر ازدهار علم اللغة الحديث على يد " فرديناند دي سوسير " ( 1855 - 1913م ) . وقد انبـرى أحد تلامذة دي سوسير وهو شارل بالي ( 1865-1947م ) ، لدراسة الأسلوب بالطرق العلمية اللغوية فعمل على إرساء قواعد الأسلوب من خلال بنيوية اللغة مستفيداً من طروحات دي سوسير، وعليه يشير بعض مؤرخي الأسلوبية إلى أن بالي هو من أصّل علم الأسلوب عام 1902م وأسس قواعده ، حين نشر كتابه الأول " بحث في علم الأسلوب الفرنسي " ، ثم أتبعه بعدّة دراسات أخرى نظرية وتطبيقية ، ومن هنا نعت بالي بأنه المؤسس الأول للأسلوبية . وقد عرّف الأسلوبية بأنها : " العلم الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسية "
ويتلخص تعريف بالي للأسلوبية بأنها " دراسة العناصر المؤثرة في اللغة ، وتلك العناصر التى تبرز بوصفها عوناً ضرورياً للمعاني الجاهزة ". بيد أن بالي حدّد ميدان الأسلوبية بدراسة اللغة مستبعداً اللغة الأدبية من ميدان عمله الأسلوبي باعتبار الأخيرة ثمرة الجهد الإرادي بقصد جمالي ، مقتصراً على تناول وقائع تعبير لغة خاصة في حالة محدودة من تاريخ هذه اللغة ، فهى أسلوبية للغة وليست للكلام Parole . ولعل هذا التوجّه فجّر معارضة بعض اللغويين الذين قبلوا من حيث المبدأ مفهوم الأسلوبية ، ولكنهم رفضوا إهمال اللغة الأدبية وأولوها مكانة بارزة ومن هؤلاء (ماروزو ) الذى أدرك أزمة الدراسة الأسلوبية وهى تتذبذب بين موضوعية اللسانيات ونسبية الاستقراءات وجفاف المستخلصات ، فطالب بحق الأسلوبية في شرعية الوجود ضمن أفنان الشجرة اللسانية العامة ، تاركاً الباب مفتوحاً أمام دراسة اللغة الأدبية.
وتلقت الأسلوبية دفعة قوية أنعشتها مع تطور علم اللسانيات والأبحاث التى انبثقت عنها . وهدف الأسلوبية ، كما يفهم حديثا ، هو دراسة الأدبية في مكوناتها الكلامية والشكلية . وهذا التعريف يحدّد بشكل منهجي وموضوعي مادتين اثنتين تتناولهما الدراسة الأسلوبية هما: مادة الأدب ، أي النصوص الأدبية حيث يتم النظر إلى نصوص مكتوبة تنتمي طبيعتها الخاصة إلى الوظيفة الشعرية في المعنى التي أصّل لها ياكبسون ونظرللنص الأدبي في هذا الصدد بوصفه خطاباً يتم إنتاجه وتلقيه، أما المادة الأخرى فإنها ترتبط بوسائل البحث المستعملة : إنها تقتضي العمل حصراً على دراسة التحديدات اللغوية للأدبية دراسة منظمة وفي جميع الاتجاهات وهكذا تظهر الأسلوبية على مفترق "علوم اللغـة" و"علوم الأدب"
ويعتقد أن الأسلوبية ولدت من رحم البلاغة ولهذا يتكرر القول: " في البدء كانت البلاغة " ، ودائماً نعود إلى الأب المؤسس أرسطو Aristotle ، وينبغي الوقوف عند ثلاث محطات من البلاغة : أولهـا وأقدمها بلاغـة أرسطـو التى ترتبط بالمحاجـة Argumentation ، والتطبيق الملائم لها هو فن الخطابة - الفصاحة - الذي يهدف إلى الإثبات والاقناع بواسطة الخطاب .
ولعل هذه النزعة البلاغية المعيارية توجهت قواعدها التقنينية نحو الوضوح والتوازن والمعقول . وهذا المعقول ليس إلا شعوراً جمالياً - ثقافياً ، أي أنه ذوق . وهذا الذوق الذي وضع تحت اسم مخـــادع هـــو " العقل " هيمن على كل آيديولوجية عصر الأنوار ، وهيمن حتى ، بفعل الاستمرارية في المدارس الدينية ثم العلمانية ، على النظرية الكامنة في كل تعليم اللغة الفرنسية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويبقى بعد ذلك أن الطابع المميز للبلاغة – قياساً إلى الأسلوبية – هو درجة التجريد والتنظيم التقني ، وهو تجريد ينبني على التجريب والخبرة بالوقائع ، باعتباره نوعاً من التعميم العلمي يختلف عن التعميمات المنطقية القبلية والأحكام القيمية المسبقة .
ولعلم تراكيب الجمل دور في التطور المذهل الذي حققته ثورة اللسانيات الوضعية واللسانيات السوسيرية ومجموع اللسانيات البنيوية في دراسة اللغة أحدثت انقطاعاً عن التقليد البلاغي ، رغم أنها بقيت ، ظاهرياً ، داخل الميدان الذي يُدعى إجمالياً باسم الأسلوبية . ويقوم علم تراكيب الجمل على دراسة أشكال الجملة الخاصة للغة معينة ، هادفاً إلى وضع لائحة بهذه الأشكال تكون على أشد ما يمكن من الكمال ، ومن ثم يهدف في مرحلة ثانية ، إلى تصنيفها كلها وفق مواقف التواصل أو وفق مستويات تتخطى النوع الأدبي، وخاصة ذلك الذي يتمثل في إعادة التركيز الكامل والمعلن على اللغة غير الأدبية، بالنسبة للحالة التى أضحى عليها التقليد البلاغي ، أى الإلحاح على وقائع لغوية واسعة ، غير فنية وغير فردية ، وكذلك طريقة غير تقييمية بتاتا
6- الأسلوبية في النقد العربي الحديث :
مثلما تعدد الاتجاهات الأسلوبية في الغرب، في أن اللغة هي المحدّد الأول والأخير للظاهرة الأسلوبية، فقد تنوعت كذلك أساليب النظر واتجاهات البحث لدى الأسلوبيين العرب، وهذا أمرٌ طبيعي جدّاً لارتباطه بتعدّد منابعهم الثقافية واختلاف تصوراتهم المعرفية والفكرية والجمالية، ولعله من الصعب رسم بانوراما شاملة لتلك الاتجاهات، وربما أمكن الإشارة السريعة إلى أن بعض الأسلوبيين العرب عدَّ الأسلوبية اتجاهاً بذاته يمثل بديلاً للبلاغة العربية ، واعتبرها منهجاً مناسباً للتعامل مع النصوص الأدبية وتقويم جمالية النص وتقدير ملامحه الوظيفية.
ولا تخلو دعوة بعض الأسلوبيين العرب إلى تأصيل واضح ومستوعب للأسلوبيات اللسانية منطلقين من تجديد البلاغة العربية ، مؤكدين متانة الصلة واستحكامها بين البلاغة والأسلوبية ، لاعتقاد بعضهم أن الأخيرة وليدة البلاغة ووريثها الشرعي ، ومدركين في الآن نفسه كونهما فرعين معرفيين ينتظمان في مسارين تاريخيين مختلفين ، وهذا ما عبر عنه المسدى في قوله : " الألسنية امتداد للبلاغة ونفي لها نفس الوقت "، وقد تراوح هذا الجهد التأصيلي لدى عدد من الأسلوبيين العرب من مثل شكري محمد عياد، وحمادي صمودفي " التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوّره" ، ومحمد الهادي الطرابلسي" خصائص الأسلوب في الشوقيات" ، وسعد مصلوح " في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة "، ومحمد عبد المطلب وغيرهم.
ولعل هذه الجهود التأصيلية التي تزامنت معها أو أعقبتها ممارسات تطبيقية أشرنا في حواشي هذه الدراسة إلى أبرز أعلامها ، تشكل المشروع التحديثي الذي سعى الأسلوبيون العرب إلى إرسائه . وعلى الرغم مما وجه للدراسات الأسلوبية العربية من نقود تتمثل في محدودية نتائج بعض دراساتهم واضطراب رؤية بعض دارسيها ، أو افتقارهم إلى المنهج الصارم وعدم التزام روح البحث الرصين ، واتسام بعض دراساتهم بالغموض الشديد والتعقيد المبالغ فيه ، فإن الدارس المنصف لا ينكر قيمة ما أتاحوه للدرس الأسلوبي من التعريف بالأسس المنهجية التي بنيت عليها الأسلوبية ، والإشارة إلى اعتمادها التحليل العلمي الموضوعي ، وتيسيرها الأدوات المنهجية التي غدت ركناً معرفيا مهما للممارسة التطبيقية . ولعل تلك الدراسات التطبيقية لهؤلاء النقاد والأسلوبيين تكون شاهداً على ما أضافوه من جديد للنقد العربي الحديث .
ال

