المحاضرة الرابعة: أعلام الأنثروبولوجيا في الجزائر
Section outline
-
الهدف من محاضرة أعلام الأنثروبولوجيا في الجزائر:
تهدف المحاضرة لإعطاء الطالب فكرة شاملة حول الأنثربولوجيين الجزائريين وأعمالهم، ومن ثم تثمين هذه الأعمال من طرفه، مساهما بذلك في عملية التراكم العلمي الأنثربولوجي حول المجتمع الجزائري، حيث يتم تقديم الدروس على موقع الجامعة، في إطار مشروع التعليم الإلكتروني عن بعد (E-learning)، ويمكن أن يتواصل الطالب مع الأستاذ عبر الإيميل الخاص بالأستاذ لتوطيد العلاقة الإتصالية المعرفية أكثر فأكثر.
وكذا محاولة تحوير ذلك مع واقع مجتمعنا الجزائري، لأعطي الفرصة للطالب للبحث في ما قال به الباحثون الجزائريون سابقا وحاليا، وكذا للمساهمة معا في التأسيس لطالب جامعي مفكر بدلا من طالب يعتمد على التلقين ونسخ ولصق ما قال به الأخرون دونما تمحيص منه وتحليل وتشغيل للبنته الفكرية والمعرفية.
مخرجات التعلم:
-وصول الطالب في نهاية السداسي إلى فهم معنى فكرة "الإلتحاق بالمستوى العالمي في المعرفة العلمية، لا يكون إلا من الإنطلاق من التحكم في المستوى المحلي لهذه المعرفة العلمية.
إسهامات بعض الباحثین الأنثروبولوحیین الجزائریین في مجال الدين (asjp)
ركز البحث الذي جاء به الباحث الجزائري "غانم إسلام" على دراسة إسهامات أنثروبولوجيا الاستشراق في حفظ التراث الإسلامي "الاستشراق البريطاني نموذجا" فعرض الباحث نشأة الاستشراق البريطاني ووضح العلاقة بين الاستشراق بشكل عام والأنثروبولوجيا، وعلاقة الاستشراق البريطاني وعلم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بشكل خاص وعلاقة علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالاحتلال البريطاني، وقد أوضح البحث أهم اسهامات المستشرفين البريطانيين في حفظ التراث العربي الإسلامي، وأهم المستشرقين البريطانيين الذين عملوا على المحافظة على التراث الإسلامي،[1] وتعقيبا على ما سبق فإني كباحث أنثروبولوجي جزائري متيم بكل ما يمت بصلة إلى مكامن التميز في منظوماتنا السوسيوثقافية، أدعو الباحث في الأنثروبولوجيا إلى ضرورة التمحيص حين قراءة الأبحاث التي جاء بها الغربيون اتجاه مجتمعاتنا الشرقية عامة، كونها لا تخلو من عديد الإيديولوجيات والخلفيات التي ينطلق بها الباحث الغربي قبل دراسته لنا، على غرار الجنرال "دوماس" حيث كانت لي دراسة حول "الخيل والمجتمع الجزائري" فاستوقفني وصفا دقيقا لهذا الجنرال الفرنسي ليس لجانب من تراثنا فحسب، بل امتداد تحليلالته إلى ربط الممارسة التي تربط الأفراد وعلاقاتهم بالخيل، وتحويرها في قالب الصراع بين الغرب والشرق، باعتباره عاصر فترة بدء الغزو الغربي لأمتنا الشرقية وتنبأ بأن الفروسية التي يتميز بها الجزائريون، قد تكون أهم عوامل عرقلة الحملة الإستدمارية الفرنسية لبلادنا الجزائر، واعتبر هذا الموروث جزء من علاقة العربي والمسلم عامة، بفرسه، كونها تتجاوز مجرد فلكلور أو تراث إلى التأسيس لفرسان أقوياء أشداء يصعب مجابهتم من الآخر المختلف.[2]
مما سبق يتضح بأن "دوماس" يقول بضرورة فهم عديد الخصوصيات السوسيوثقافية لكل مجتمع قبل غزوه وهو ما فقهته القوات الفرنسية وسيرت ايديولوجيتها المعرفية خدمة لكولونيالتها، وهو ما يتوجب علينا كباحثين جزائريين في عصر الإستقلال التفطن له والإستفادة من خبرات هؤلاء الإثنوغرافية الميدانية، ومحاولة بناء أنثروبولوجيا قيمية جزائرية، تكون درعا لمقاومة كل ما هو دخيل ولا يتناسب مع استقرار المنظومة السوسيوثقافية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما قال به "دوماس" وهو يتناول موضوع الفروسية يندرج في سياق ضرورة إعداد العدة اللازمة لمواجهة الآخر المتربص، وهو يصب فيما يصير حولنا الآن من أحداث وصراعات سياسية واقتصادية ودينية، فالقضية الفلسطينية التي لم ترى نور الحرية لحد الساعة وتعيش ويلات الحرب الدينية الصريحة من الأمم الغربية التي تعد امتدادا لـ "الجنرال دوماس" حيث يقوم الغرب بإبادة كل أشكال المقاومة ضد إيديولوجيته ويحاول تسخير كل العوامل كي يبقى القوة الواحدة والوحيدة التي تتصرف في الشعوب وتقرر مصيرها.

إسهامات مالك شبل في المجال الأنثروبولوجي:لقد جاء في مقال الباحث الجزائري البروفيسور "أوذاينية عمر" حول "مالك شبل": "يعتبر فيه الأخير واحدا من أهم الأنثروبولوجيين العرب الذي ذاع صيته في الغرب، خاصة أوروبا وأمريكا، وبالضبط بعد أحداث 11سبتمبر 2001 بأمريكا، في حين يرى أن تواجده بالوطن العربي ضعيف ومحتشم، أما بالجزائر بلده فيكاد تواجده ينعدم حسبه، ويقول الباحث بأن المفكر "مالك شبل" واحد من أهم الشخصيات التي تدعو إلى عصرنة الإسلام بشكل يتماشى مع العالم الجديد، كما يدعو الى حوار الأديان وحوار الحضارات من أجل التعايش السلمي في العالم الذي أصبح مليء بالعنف تحت مسمى الدين، ومن أهم أعماله التي تناولت المواضيع الأنثروبولوجية نجد كتبه: الجسد في الاسلام، تكوين الهوية السياسية، موسوعة الحب في الاسلام، بيان من أجل إسلام الأنوار، أبناء إبراهيم اليهود والمسيحيون والمسلمون.[3]
ويعقب الباحث الأنثروبولوجي في نفس سياق الفكرة التي قبلها، بأن إسهامات "مالك شبل" تعد تراكما نبني به نظرة جديدة منقحة وفق خصوصية التخصص والمجتمع المدروس، والظاهرة المدروسة، ونذكر الناقدين لـ "مالك شبل" بأن حضارتنا الإسلامية لما سقطت ماديا أتبع ذلك السقوط سقوطا معنويا لما استفاد الغرب مما وصلت إليه الحضارة الإسلامية، فكان ذكاؤهم في التعامل مع علوم الحضارة الإسلامية، سببا في ارتفاعهم وهبوطنا، وبذلك فالبحث الأنثروبولوجي يستلزم عدم دفن كل ما توصلت إليه الدراسات الأنثروبولوجية، بل يجعل منها تراكما معرفيا يصل بها إلى الحقيقة، وربما يتساءل الباحث الأنثروبولوجي هل تناول "مالك شبل" لهاته المواضيع يستثني كون الغرب حضارة مادية لا تؤمن بالميتافيزيقيا والأخلاق والدين واللاهوت؟ أم عكس ذلك تماما؟
وقد تجيب الدراسة الأنثروبولوجية في حقل الإنحرافات الفكرية على أن كثيرا ممن توجه للتقارب الفكري تجاوز الفكر إلى العقائد، وإذا كان العالم الغربي يروج للديمقراطية فلا يجب أن يكون متناقضا ويكافح بعض الممارسات الدينية هنا وهناك، ويتجاوز قيم الديمقراطية؟، وربما "مالك شبل" كان أدرى منا بتناقض الغرب في التعامل مع فكرة تقارب الأديان، وهل هي فعلا تقارب الأديان في إطار الإحترام، أم هو امتداد للهيمنة الغربية على الشعوب العالمية، ربما يجيب على هاته التناقضات الواقع الذي نعيشه حاليا واللااستقرار في العلاقات السياسية العالمية بين الشرق والغرب، حيث فضح الشرق عديد الممارسات الغربية بل واتهمها باستبداد كل ما هو شرقي، ولا يمكن أن نغفل كباحثين أنثروبولوجيين حاذقين بأن هاته الحرب السياسية الباردة بين قوى الشرق والغرب، هي في سياق صراع القيم والثقافات وهي محاولة لإثبات الذات في عالم أكل فيه القوي الضعيف بشعارات التقارب والسلام وغيرها، هاته العودة القوية للشرق لم ترتكز على التقارب الذي نادى به "مالك شبل"، كإرتكازها على التنوع العقائدي والقيمي والإجتماعي (الصين البوذية، والروس الأرتذكسية الشيوعية، والهند الهندوسية.....)، وما يمكننا أن نقول به كباحثين أنثروبولوجيين يهمهم مقام مجتمعهم من كل هاته التغيرات العالمية، بأننا نملك كل مقومات العودة إذا ما اشتغلنا على تقويم ما انحرف من ممارسات بإضفاء القدوة الحقيقية للأنساق المشكلة للبناء الكلي، وقد نبهت إلى خطر فقدان القدوة في المجتمع في دراسات سابقة لي، لعديد الولاءات للجماعات المتعددة (الدينية، والإثنية، والعرقية، والجهوية،،،وغيرها) والتي هددت ولا زالت استقرار مجتمعنا الجزائري.

إسهامات عدي الهواري في المجال الأنثروبولوجي
هواري عدي عالم اجتماع وعالم سياسي، ودكتور دولة في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHESS) في باريس عام 1987. وكان أستاذًا لعلم الاجتماع في جامعة وهران (الجزائر) ثم في جامعة ليون، التي يعمل فيها أستاذًا فخريًا على مدار السنوات القليلة الماضية، كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل باحثًا مشاركًا في جامعة جورج تاون.
وهو مُنظّر معروف لـ "الانحدار الخصب" على أساس النموذج التونسي حيث يلتزم الإسلاميون في السلطة بمراعاة واقع المجتمع والدولة ، وقد كتب العديد من الكتب والمقالات حول الإسلاموية والانتقال إلى الديمقراطية، أحدث مؤلفاته كتاب بعنوان "القومية العربية الراديكالية والإسلام السياسي" (مطبعة جامعة جورج تاون ، 2017).
أستاذ زائر و / أو باحث في العديد من الجامعات، وكان مقيماً بشكل ملحوظ في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون في 2002-2003، تم انتخابه كعضو مشارك لرئاسة AUF / IMéRA في "Transformations Structurelles et Dynamiques Institutionnelles in Francophonie" من 9 سبتمبر 2019 إلى 7 فبراير 2020 مع مشروع البحث: الموارد الطبيعية بين الاستخدام السياسي والمتطلبات الاقتصادية.
تكوينه:
التعليم الابتدائي والثانوي والعالي في وهران
بكالوريوس في علم الاجتماع وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة وهران (1973)
DEA في الاقتصاد في غرونوبل (1974) عن الهياكل المصرفية للاقتصاد الاستعماري في الجزائر
دكتوراه في علم الاجتماع في الهياكل الزراعية والإسكان الريفي في الجزائر من 1830 إلى 1939 (تحت إشراف جيولبرت دوراند)
دكتوراه الدولة في EHESS تحت إشرافL. Valensi حول الدولة والسلطة في مجتمعات العالم الثالث: الحالة الجزائرية (1987)
التعليم الجامعي
مدرس في جامعة وهران (قسم علم الاجتماع) منذ عام 1976
1981-1983: مدير معهد العلوم الاجتماعية
1983-1986: انتداب إلى EHESS في باريس
1991: باحث في برنامج فولبرايت بجامعة برينستون (الولايات المتحدة الأمريكية)
1994-1996: أستاذ مشارك في معهد ليون للدراسات السياسية
1996-1997: أستاذ زائر بجامعة يوتا (مدينة سالت ليك)
1997-1998: أستاذ زائر في IEP Lyon
1998 : أستاذ في معهد ليون للدراسات السياسية
2002-2003: عضو معهد الدراسات المتقدمة، برينستون ، الولايات المتحدة الأمريكية
2007-2008: أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية.
المنشورات الحديثة
عدي لحواري، "نظام السلطة في الجزائر، أصله وتطوراته"، Confluences Méditerranée ، 2020 ، vol. 2020/4 ، رقم 115.
عدي هواري، أزمة الخطاب الديني الإسلامي: العبور الضروري من أفلاطون إلى كانط، لوفان، PUL Presses universitaire de Louvain ، Pensées muslimes contemporaines ، 2019 .
عدي هواري، "النظام السياسي والسلم الأهلي في الجزائر"، ملتقى البحر الأبيض المتوسط ، 2017، رقم 100.
عدي هواري، القومية العربية الراديكالية والإسلام السياسي ، أنتوني روبرتس (تقليدي)، واشنطن العاصمة، مطبعة جامعة جورج تاون: مركز الدراسات العربية المعاصرة ، جامعة جورج تاون ، 2017.[4]
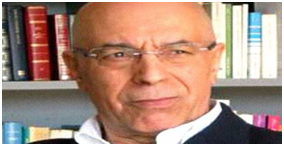
"أحمد بن نعوم" وفكرة المقدس والسياسي:لقد لخص وخلص الباحث الجزائري أحمد بن نعوم في مقاله المنشور بمجلة لسانيات الصادرة عن مركز الكراسك بوهران والمعنون بـ: "Le Sacré et le Politique" إلى ما يلي:
- يقول أنه من السهل، في أيامنا هذه، ملاحظة أن العلاقات التي تربط المقدس والسياسي يظهر في أساسها موقف المتكلم: من أي موقع سياسي ينطلق المتكلم لتأسيس خطاب عن إنشاء "الكينونة-معا" في مجتمع ذي ثقافة وتقاليد إسلامية؟ وهنا أقول معقبا كقارئ أنثروبولوجي بأن السياسة بحد ذاتها هي جانب من جوانب التدين فلا يمكن أن يتخلى السياسي عن مرجعيته الدينية ولو تظاهر بالعلمانية، ولعل أبرز مثال على ذلك ما لاحظناه جميعا من خلال الحرب على فلسطين حاليا منذ شهر أكتوبر 2023 والذي عبر فيها الغرب من منابر سياسية متعددة على دعمه لما قال به وزير خارجية أمريكا بالحرف الواحد "أنا يهودي وجئت إلى اليهود لنصرتهم".
- يقول أيضا بأنه انطلاقا من الموقع الذي يكون منه الكلام، يتعين المنهج والإجراء والمعرفةgnôsis) ) التي انطلاقا منها تقام الخطابات حول المقدس والسياسي وعلاقتهما من داخل المقدس ومن داخل السياسي أو استثناءا من موضع آخر خارجهما، فمن هذا الموضع الثالث تبين عن نفسها العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية التي من بين مواضيعها، يوجد بالطبع موضوع الخطاب حول المقدس وحول السياسي، من داخل كل واحد من هذين الحقلين نفسهما.
- منذ عصر النهضة ومنذ عصر الأنوار (أو التنوير كما يحلو لنصر أبي زيد أن يسميه)، بدأت أوروبا بإزالة كنائسها عن السلطة السياسية والدولة، مكسبة المجتمعات الإنسانية السيادة على نفسها، معتبرة أياها مصدرا لكل شرعية سياسية، إن هذه الوضعية هي التي مكنت من ظهور العلوم الإجتماعية وتطورها، وربما تبقى هاته النظرة للمفكر "أحمد بن نعوم" تحتمل عديد التفسيرات كون العلوم الإجتماعية انبثقت فعلا من أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية، لكنها أيضا وهي تؤسس لنفسها لا يمكنها أن تكون خارج هاته الأوضاع بل تتأثر وتؤثر باعتبار المنظرين أنفسهم لهم خلفياتهم وإيديولوجياتهم قد لا تتضح للوهلة الأولى لكنها تظهر لما يستوجب إظهارها، وهو ما أكد عليه ماكس فيبر في كتابة العالم والسياسي أين تتبخر الموضوعية ازاء الإيديولوجية.
- يستمر "أحمد بن نعوم" قائلا: منذ نهاية القرن التاسع عشر والعالم الإسلامي يحاول تأسيس حداثة مستلهمة ومفروضة بتطور الرأسمالية في أوروبا، متجنبًا إقحام سلطة رجال الدين ومؤسساتهم الدنيوية في مصادر الشرعية القانونية، والسلطة السياسة والدولة، فباستثناء تركيا، وإلى حد ما العراق، يدرج أي مجتمع إسلامي بصورة كاملة مصدر سيادته ومؤسساته ضمن إطاره الخاص، وهذا ما يفسر ضعف التفكير الموضوعي في مصادر القانون وفي أصل الدولة في المجتمع الإسلامي.
- منذ بداية القرن العشرين يتبنى الجامعيون بصورة ضمنية سلوكا يكرس المراقبة الذاتية، متمثلة في السكوت عن التواطؤ بين رجال الدين ورجال السياسة في عملية إقرار الشرعية التي يتبادلونها حينما يرغبون في اعتلاء كرسي الحكم، إن هذا التبادل وهذا التواطؤ للسعي وراء السـلطة والحفاظ عليها له تاريخ ينبغي كتابته بسرعة، لأنه جزء لا يتجزأ من المأساة المتجددة باستمرار، (مأساة الطلاقthe tragedy of divorce ) الذي لم يتحقق أبدا بين هذين العنصرين، والذي يوجد في فعل الرابطة نفسه وفي تاريخ المجتمعات الإسلامية منذ وفاة النبي محمد (صل الله عليه وسلم) وحادثة سقيفة بني ساعدة الطقوسية (الوطن – العربية)، التي انتهت بتعيين أبي بكر الصديق كأول خليفة للمسلمين، والحال أن المراقبة الذاتية بهذا الخصوص، قد تجلت في وظيفة الباحثين في الـعلوم الإجتماعية نفسها، بحكم أن الحركات الوطنية كانت تدمج الدين في المؤسسات المنتجة للخطاب حول الاختلاف والهوية الوطنية، عازلة نفسها من خلال جوهر مسعاها نفسه، عن المجتمعات الاستعمارية،[5] ولعلي وضعت سطرا على ما أطلق عليه "أحمد بن نعوم" الطقوسية وهو مصطلح استخدمه الباحث وهو يعلم المعنى الحقيقي للطقوس التي لا تتصل بعهد الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، قدر اتصالها بالمجتمعات الأولية البدائية أين تسيطر الممارسات الطوطمية مما أنتجته وتنتجه تفاعلاتهم الشعائرية، في حين كل ما يتعلق بزمن الخلفاء الراشدين هو استمرارية لعهد الرسول صل الله عليه وسلم وفق ما دستره القرءان والسنة النبوية المطهرة، ففي 12 ربيع الأول السنة11ه، توفي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم، عظم الخطب، ونجم النفاق، وارتدت قبائل العرب، ولم تبق تقام الجمعة إلا في مكة والمدينة، وزحفت القبائل المرتدة إلى المدينة، وأصبح وجود الإسلام كله على المحك، ولكن لم تمض الشهور الباقية من العام 11 للهجرة حتى أدى (مقام الصديقية) دوره في خلافة النبوة، فتم إنفاذ جيش أسامة إلى بلاد الروم رغم الخطر الوشيك، وعقد الصديق رضي الله عنه (11) لواء لحرب المرتدين، فانطلق الصحابة في كل اتجاه، ومنهم سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وبمجرد فراغه من مسيلمة أواخر العام جاءه الأمر بالاتجاه إلى الإمبراطورية الفارسية، فخرج من نجد الى العراق مباشرة، وسارت جيوش أخرى إلى الإمبراطورية البيزنطية في الشام، كل ذلك في غضون شهور، وتوفي الصديق ري الله عنه، والجيوش الإسلامية مجتمعة في اليرموك لاجتثات الروم، وكانت ملحمة الشام الكبرى التي ودع بعدها قيصر الشام (وداعا لا لقاء بعده) كما قال، وجاء الفاروق العظيم فدفع بالجيوش إلى القادسية فألحق الفرس بالروم، ولم يمض وقت على بشارة فتح العراق حتى استدعاه صاحبه الأثير أبو عبيدة عامر بن الجراح قائد أركان الجيوش الشامية ليستلم مفاتيح القدس بيده.

"مريم سابو" و"السبيبة" بـ جانت بالجنوب الجزائري:يقول الباحث الجزائري "عبد الحميد بورايو" بأن كتاب “تَنْ كِيلْ سَبَّيْبَه”، الذي نشره المركز الوطني للبحوث في ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، يعالج ظاهرة شعيرة السبيبة باعتبارها ممارسة طقوسية، تعود لعصور موغلة في القدم، ظلت تُمَارَسُ من قبل سكّان حيّين كبيرين يمثّلان قسما هامّا من سكّان هذه المنطقة المتميزة بثراء ممارساتها الثقافية وبطبيعة مجتمعها المحافظ على تقاليده المادّية واللامادّية، احتوى الكتاب على مقدّمة وعرض للمسار المنهجي الذي اتبعته الباحثة وطرح لهذه الممارسة الثقافية والفنية من خلال علاقتها بنظريات الاحتفال في الدراسات الأنثروبولوجية، جاء الكتاب في سبعة فصول: تناولت الباحثة فيهم احتفالات عاشوراء المعروفة في البلاد المغاربيّة، في علاقتها بالطقوس القديمة الموروثة قبل الإسلام، والتفسيرات التي أُعْطِيَتْ لها من قِبَلِ الباحثين الأنثروبولوجيّين، وتوقّفت بالخصوص عند التفسير الثقافي منتقدة الاتجاه الطبيعي في تأويل الشعيرة، كما تعرّضت للتقويم الفلاحي عند جماعات العرب والتوارڤ وسكان شمال البلاد المغاربية، نظرا لعلاقة الشعيرة بهذا التقويم. تعرّضت بعد ذلك في الفصل الثاني لدراسة سكان منطقة جانيت؛ من حيث التركيبة والموقع والسكان والطبيعة العمرانية للقصور (الأحياء السكانية المكوّنة لمدينة جانيت)، وما يتعلّق بمميزات هؤلاء السكان من حيث الهوية وطبيعة المعاش والتاريخ الاجتماعي، في الفصل الثالث عالجت الطقوس الأسريّة المتعلقة بمراحل العبور من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة، في الفصل الرابع تناولت مراحل أداء الشعيرة وعلاقتها بشعائر العبور (من سنّ إلى أخرى)، ثم إلى أسباب استمرار ممارسة الشعيرة وعنصر قوّتها وأهميتها في حياة مجتمع المنطقة، كما تطرّقت إلى ما يصاحب الشعيرة من تقاليد متعلقة بالجسد مثل تسريحات الشعر عند النساء ونوعية الحلي واللثام عند الرجل، ولباس كلّ من المرأة والرجل وطرق ارتدائه، وهي جميعا عناصر تسمح بالتفسير الرمزي لهذه الممارسة الثقافية المتوارثة عبر الأجيال، خصّصت الفصل الخامس لأداة الطبل المستعملة بقوة في وقائع الشعيرة وحاولت أن تتطرّق لرمزيتها، في الفصل السادس قدّمت الباحثة تصنيفا للمتن الشعري وملاحظات حول خصائصه، في الفصل السابع عالجت علاقة السبّيبة بالممارسة الدينية التصوّفيّة، وبعد الخاتمة نعثر على ملاحق بخصوص جميع المواد التي استند عليها البحث من أسماء الأعلام والقبائل واللباس والحليّ وتسريحات الشعر وأشكال العمارة والزراعة والمنتوجات الحرفيّة وآلات الموسيقى.
ويستمر الباحث "بورايو" قائلا: وتكمن أهمّية هذا الكتاب في كونه يمثّل خلاصة تجربة بحثية دامت حوالي خمسة عشرة سنة، كانت قد قدمت الباحثة خلالها رسالة دكتوراه دولة حول دور الغناء والموسيقى والشعر في تشكيل عناصر الهويّة لدى سكان الآزجر، وكنت شخصيا قد ترأست لجنة المناقشة التي منحتها درجة مشرّف جدّا مع تهنئة اللجنة والتوصية بالطبع، وكانت الباحثة قد نشرت بعد ذلك بحثا باللغتين العربية والفرنسية يعرّف بالمنطقة وسكانها وتاريخها ويقدّم عرضا لاحتفال السبيبة مصحوبا بالصور والبيانات، تُعَدُّ مسيرة البحث هذه نموذجا نادرا في مسيرة البحث العلمي الأنثروبولوجي الجزائري، لعدّة أسباب من أهمها: أنه جاء في سياق النقص الكبير في العناية بالدراسات الأنثروبولوجية في الجزائر في فترة ما بعد استقلال الجزائر، لما تم استبعاد هذا الميدان الدراسي من الجامعة الجزائرية، لكونه مورِس من قبل علماء استعماريين، وقدم تبريرا لمختلف مراحل التعسف الاستعماري وممارساته، وقد تمت إعادة النظر في هذا الموقف في العشرية الأخيرة من هذا القرن وهناك محاولة الآن تجري لإعادة استنباته في الجامعة نظرا لدوره الهام في فهم الظواهر الاجتماعية ولإمكان ممارسته من وجهة نظر وطنية، ولأن تطوّراته جعلته يتجاوز النظرة الاستعمارية المشار إليها، لأنّ الباحثة مريم بوزيد التي تعمل باحثة دائمة بالمركز الوطني للبحث في ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ تتميز بقدرة هائلة على البحث الميداني الأنثروبولوجي، وكانت قد ساهمت – متعاونة – في السنوات الماضية في تكوين دفعات طلابية في الدراسات العليا في مجال الأنثروبولوجيا والأدب الشعبي في جامعات الجزائر وخنشلة وتبسة، وقامت بتدريب عدد من الطلبة على العمل الميداني يستند البحث إلى قائمة غنية من المراجع، سواء منها المتعلقة بالمنطقة وسكانها وممارساتها الثقافية، أو تلك المتعلقة بالجانب المنهجي والنظري، وتُعَدُّ مريم بوزيد من الباحثين الأنثروبولوجيين القلائل باللغة العربية الذين لهم تكوين متميّز وتجربة عميقة في البحث الميداني، وهي تشقّ طريقها بصمت غير مبالية بالبروز على الساحة الإعلامية ولا في المهرجانات والنشاطات الثقافية، تكشف جميع بحوث مريم بوزيد ومساهماتها في الملتقيات العلمية الدولية والوطنية عن قدرتها الفائقة في استيعاب المناهج المعاصرة في البحث الأنثروبولوجي وتطبيق ما يناسب موادّ بحثها، كما أنها شديدة الحرص على عدم الإنبهار بالطروحات النظرية الغربية وتلقّي المناهج وآراء الآخر بشيء كبير من الحذر والفهم العميق والروح النقدية واستعمال ما هو مناسب من الأدوات المنهجية في دراسة التراث الوطني، وقد ركّزت في بحوثها على البعد الرمزي، وهو الأكثر مقبولية بالنسبة لدراسة التراث الجزائري، وأدعو بعد نهاية كلام الباحث "بورايو" القارئ والطالب إلى مطالعة مقالها الذي حاولت من خلاله تفريغ أعداد مجلة ليبيكا (1953) التي أسسها ليونيل بالو (Lionel Balout) من الجزء الأول الصادر 1953 إلى آخر عدد صدر في عام 1998.[6]
ولا يفوتني أن أذكر السيد بورايو وكذا الباحثة مريم، بأننا سنتعرض للنقد المجتمعي كباحثين أنثروبولوجيين إذا وضعنا قطيعة ابيستيمولوجية ونحن ننقل ما قال به الآخر المختلف عنا، فلقد استوقفت "المستشرق لفيتسكي" مسألة علاقة التجارة الإباضية بالتبشير بالإسلام في بلاد السودان ونشره بين ساكنتها، ولا ينكر باحث أنه قد اجتهد في إيفائها حقها بالنظر إلى ما توافر بين يديه من الشواهد الضرورية للقيام بذلك، فلقد عمل في استنطاق هذه النصوص لإبراز العلاقة المعنية وتبئيرها، وفي هذا الصدد، تناول كتاب "السر" للشماخي، و"طبقات المشايخ" للدرجيني، و"مسالك" البكري، للنظر في ما ذهب صاحب أول هذه المصادر اعتماداً على ثانيهما؛ من كون إسلام أحد ملوك السودان قد تم على يد التاجر الإباضي يحيى بن خلف النفوسي، وأنه هو المعني برواية البكري التي تعرضت لإسلام ملك غانا الذي سمي بين قومه بالمسلماني ([1])، ولقد أسفر نقده لهذه النصوص وموازنته بينها عن رد دعوى الشماخي، وعن الاحتفاظ بدلالة روايتها([2])، وإذ نسجل للفيتسكي هذا الحس النقدي الفيلولوجي، فإنه لا يسعنا إلا أن نأخذ عليه في هذا المضمار ما سكت عنه حول دور أخلاق التجارة الإسلامية في إثارة انتباه السودانيين إلى الإسلام، وفي هذا الصدد، فإن كثيراً من المستشرقين يردون انتشار الإسلام بالسودان إلى سلطة تجار المسلمين الرمزية المتخفية في معاملاتهم التجارية مع الأهالي([3])، ويبدو أن "لفيتسكي" لم يستطع أن يخرق هذا التقليد الذي نهجه سلفه ويتقيد به خلفه من المستشرقين، فهو الذي يعرف ابن حوقل جيداً، قد غض الطرف عما يرويه هذا الأخير عن "حسن كمال في الأخلاق والأفعال، والتقدم في أفعال الخير لكثير التجار الإباضيين بأودغست، وأمانتهم التجارية منقطعة النظير([4])، وهو الذي وقف على منع الإمام الرستمي عبد الوهاب ابنه أفلح من مرافقة قوافله التجارية إلى السودان، بمخطوط الويسياني ومخطوط الدرجيني، فقد التزم السكوت عن سبب هذا المنع الذي يعود في الواقع إلى عدم تفوق أفلح في الامتحان الفقهي الذي امتحنه به أبوه الإمام في مسألة التجارة والربا([5])، بل أكثر من ذلك، فلقد تعمد بتر النص عند استشهاده به لكي يطمس مسوغ هذا المنع([6]).[7]
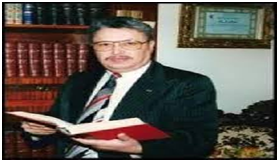
إسهامات أحمد بن نعمان العلمیة في المجال السوسویوثقافي”نظرة على جزء من كتاب نفسـیة المجتمـع الجزائـري“
تساءل الفيلسوف والباحـث الإجتماعي الجزائـري "أحمـد بـن نعمـان" فـي كتابـه "نفسـیة المجتمـع الجزائـري" عن كيفية فهم خصوصية الفرد الجزائري، وارتـأى إلا إلى أن یتفق وينتهج منهج الأنثروبولوجي، حيث كان المدخل الذي اعتمده لدراسة الثقافة والشخصیة، هو الإنطلاق من الثقافة لفهم الشخصیة ولیس العكس، ذلك لأن الثقافة أعمق بعدا من أبعاد الشخصیة، وفي هذا الإتجاه، یــرى "كلوكهون” أنه إذا توصلنا إلى معرفة أنماط الثقافة السائدة، فإننا نحقق بالضرورة كسبا كبیرا وتقدما معتبرا في معرفة الشخصیة.
یقول: "أحمد بن نعمان" "اتبعنا المنهج التحلیلي لمضمون الأمثال الشعبیة وذلك للأسـباب التالیـة:
1. إن الأدب الشــعبي مــن أبرز مظاهر الثقافة في المجتع وأهم ســجل لها رغم حركتها وتغیرها المضطرد، وهو نـابع من واقع البیئة التي یعـیش فیها المجتمـع، ومحفـوظ، "في الذاكرة الشـعبیة" بلغـة المجتمع المدروس، وبالتالي فهو یحافظ على السمات الأساسیة لشخصیة المجتمع، رغم كل التغیرات التي تطرأ علیها نتیجة العوامل المختلفة التي یتعرض لها.
2. للأدب الشـعبي علاقـة قویـة بالنظـام التربـوي السـائد في المجتمـع، والذي بفضـله تنتقل الثقافة بكل مظاهرها المعنویة "كاللغة والدین وأنماط السلوك الخلقي وظواهر الفكر العلیا بتصـوراته ومقولاتـه.."، والمادیة "كالتكنولوجیا والمعارف العلمیة والمهارات الیدویة وكیفیة المعیشة.."، من جیل إلى جیل.
3. وللأدب الشـعبي أیضـا علاقـة عضـویة بلغـة المجتمـع المـدروس، واللغـة كمـا یؤكـد "مالینوسـكي "Malinowski. Bهي أهم الظواهر الثقافیة باعتبارها خاصیة إنسانیة، ومن ثمة فهي مفتاح الثقافة في أي مجتمع، ومعرفة الباحث للغة الأدب الشعبي في الجزائر بلهجاتها المختلفة تجعله یتفادى الخطأ الشائع الـذي یقـع فیـه الكثیـر مـن الأنثروبولـوجیین الـذین یعتمـدون علـى المتـرجمین والشـارحین، ذلـك أن علـم اللغـة یثبـت أن الكلمة لیسـت مجموعـة مـن الحـروف الجامــدة والأصــوات الجوفــاء، وانمـا هي كائن حي یحمل الكثیر من المعاني، ولا یؤدي الإعتماد على الترجمة الحرفیة إلى التوصل إلـى مضـامین الكلمـات، وفحـوى اللهجات المتداولة داخل الوطن، وخاصة البربریة أو الأمازیغیة منها.
4. إمكانیة جمع أكبر رصید ممكن من مادة الأدب الشعبي المتداول فـي المجتمـع المـدروس وتحلیلـه، وإجـراء المقارنـة لملاحظـة مـدى التطـابق فـي الواقـع العلمـي بـین القـیم المتضـمنة فـي الأدب الشـعبي، والقـیم السائدة في أنماط السلوك المختلفة لأفراد المجتمع.
ومن خلال اسـتخدامه تحلیل مضـمون الأمثـال الشـعبیة، والملاحظـة المباشـرة لسـلوك الأفـراد الذین یمثلون هذه السمات، توصل إلى حصر أربع وأربعین سمة یتمیز الفـرد الجزائـري نذكر منها بإضافات بسيطة:
1. الصراحة...... "أخرج لربي عریان یكسیك".
2. حب الوضوح...."ازرع ینبت ."
3. الصدق..."ما یدوم غي الصح ."
4. التمسك بالأصول "العرف المستقر"..... "وطني خیر من شبعة بطني ."
5. الواقعیـة..."وهـي الإبتعـاد عـن الخیـال، والرضـوخ لأمـر الواقـع فـي كـل الأحـوال، "حیینـي الیـومواقتلني غدوة ."
6. مقـت الإدعـاء والتظـاهر...."تعیـا العـین تكبـر والحاجـب فوقهـا" "لوكـان مـانعرفكش یـا خـروببلادي نحسبك بنان ."
7. القناعة...."الكسرة والما والراس فالسما ."
8. سرعة التكیف مع الأحول المستجدة..... "عاند لا تحسد"، "دیر كي جارك ولا بدل باب دارك."
قائمة مراجع المحور:
- MAMMERI Mouloud, Algérie: une expérience de recherche anthropologique, in Jean Guiart (s/d), Etudier sa propre culture, Expériences de terrains et méthodes, Ed. L'Harmattan, Paris, 2009.
- BENNOUNE Mahfoud, Esquisse d'une anthropologie de l'Algérie politique, Ed. Marinoor, Alger,1999.
- BENNOUNE Mahfoud, Education, Culture et Développement en Algérie, Ed. ENAG, Alger,2000.
- MAROUF Nadir, Les fondements anthropologiques de la norme maghrébine, Ed. L'Harmattan, Paris, 2005.- MOUSSAOUI aBDERRAHMANE, Espace et sacré au Sahara: Ksour et oasis de sud-ouest
algérien, Ed. CNRS Anthropologie, Paris, 2002.- DIONIGI Albera et TOZY Mohamed, La méditerranée des anthropologues, Fractures, Filiations, ContiguÏtés, Ed. Maisonneuve & Larose MMSH, Paris, 2005.
- MAROUF Nadir et ADEL Faouzi & Khedidja (s/d), Quel avenir pour l'anthropologie en Algérie actes du colloque de Timimoun les 22, 23 et 24 novembre 1999, Ed. CRASC, Oran, 2002.
([1]) في رواية الشماخي: "وسافر أبو يحيى إلى بلاد السودان. فألقى ملكهم ناحل الجسم، ضعيف القوى. قال له: ما بك؟ قال: خوف الموت! قال أبو
القاسم: فأخبرته من الله وصفاته ـ سبحانه ـ والجنة والنار والحساب، وما أعد الله للمطيع والعاصي. فكذبني، وقال: لو صح عندك ما تقول، لما بلغت إلينا تطلب الدنيا. فما زلت أذكِّرُه نعم الله وآلائه حتى أسيلم، وحسن إسلامه". (أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي، كتاب السير، تحقيق محمد حسن محمد، ص. ذ.، ص. 263). في رواية البكري: "وكان عنده ضيف من المسلمين يقرأ القرآن ويعلم السنة فشكا إليه الملك دهمهم من ذلك، فقال له: أيها الملك لو آمنت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام [...]: فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته [...] وصح إسلامه وإسلام عقبه وخاصته وأهل مملكته مسلمون فوسموا ملوكهم من ذلك بالمسلماني". (أبو عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، وهو جزء من كتاب "المسالك والممالك"، ص. 187؛ Texte Arabe, publié sous les auspices de M. Le Maréchal Comte Randon Gouverneur Général de l’Algérie, Alger, s. d).
([2]) [....] c’est l’Ibadisme qui fut la forme primitive de l’Islam ouest-soudanais », (Lewicki, «Traits d’histoire du commerce transsaharien», op. cit., pp. 297- 298.
([3]) تراجع، على سبيل المثال، مادة "الإسلام في إفريقيا السوداء" من "قاموس الأديان" الذي أشرف على إعداده الراهب الفرنسي بول بوبارد (Dictionnaire des Religions, P. U. F. 1984.)
([5]) أورد لوسياني رواية ذكر فيها أن أفلح بن عبد الوهاب اراد مرافقة قوافل والده إلى بلاد كوكو، فأخذه الإمام عبد الوهاب يختبره في الفقه وخاصة في مسألة الربى، فأجاب عن كافة الأسئلة فيما عدا سؤال واحد. فأمره أبوه بعدم السفر حتى تزداد خبرته بأمور التجارة (مخطوطة "سير أبي الربيع"، س. ذ، ورقة 25، نقلاً عن م. ع. إسماعيل، الخوارج في بلاد المغرب، س. ذ، ص. 282).
[2]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiduaCl4KWDAxVXSKQEHQafBogQFnoECAwQAQ&url=http%3A%2F%2Fpsychologyandeducation.net%2Fpae%2Findex.php%2Fpae%2Fissue%2Fcurrent&usg=AOvVaw2xBtyaVQBlhiaJFRzKcx-o&opi=89978449
[3] أوذاينية عمر، مالك شبل - الأنثروبولوجي الجزائري الحاضر في العالم الغربي الغائب في العالم العربي-، مجلة التغير الاجتماعي، جامعة بسكرة، الجزائر، ع2، م2، 2017، ص ص 300_314.
[7] ينظر: فريدة بن عزوز، أبحاث تادِيوش لفيتسكي في فجر العلاقات التجارية بين ضفتي الصحراء الكبرى.
-
يكتب الباحث الأنثروبولوجي حول مواضيع سوسيوثقافية متعددة أذكروها مع ذكر مالذي يتوجب على الباحث الأنثروبولوجي فعله والقيام به للوصول إلى نتائج علمية أكثر دقة..
أذكر واحدة منها على سبيل المثال أنه وجب عليه أن يملك رصيدا معرفيا تراكميا من مطالعة تلدرسات السابقة حول موضوع بحثه....
وأحيلكم طلبتي الأعزاء إلى الاطلاع على مقال لي بعنوان:
منهجية البحث الإثنوغرافي في ميدان العلوم الإجتماعية - ASJP
-

