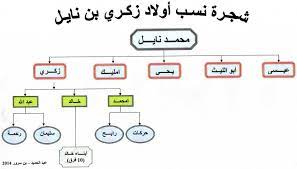المحاضرة الخامسة: أنثروبولوجيا القرابة
Section outline
-
الهدف من المحاضرة:
- إعطاء الطالب فكرة معمقة وشاملة عن تنوع الدراسات الأنثروبولوجية في مجال القرابة والعائلة والجندر.
- التعرف على الإتجاهات النظرية في دراسة القرابة، وعلاقتها بالسياسة والإقتصاد، .....
- التطرق إلى عديد المفاهيم المرتبطة بها كالقبيلة والعائلة والتغير الإجتماعي الذي تعرضت له هاته المفاهيم عبر الأزمنة المتمايزة.
مخرجات التعلم:
- وصول الطالب في نهاية السداسي إلى فهم معنى تمايز الأدوار بين الجنسين وفق ما تمليه الثقافات المتنوعة.
- تحكم الطالب في تحليل العلاقات القرابية من خلال الأبنية المتعددة التي تندرج ضمنها وتحددها.
القرابة ومفهومي السياسة والإقتصاد:
لقد اعتبر "مورغان" بأن نظام القرابة مرتبط إرتباطا وثیقا بالنظام الإقتصادي، ویرى بأن تحول الأنظمة الإقتصادیة في المجتمعات عبر العصور المختلفة، ومذ الإنسان البدائي، أثر تأثیره المباشر على نظام القرابة، ویعتبر بأن نظام القرابة في عصر الإنسان البدائي المتوحش (الحضارة البربریة المتوحشة)، لم یكن فیه شكل للأسرة، بل كان تزاوج الإنسان كبقیة الحیوانات، ثم المرحلة البربریة الأخیرة التي جاء معها مفهوم الزراعة وتشكلت معه بوادر العائلات، حیث ظهر (الزواج، النسب، الأخوال والأعمام)، وتشكلت معه علاقات وروابط دمویة وحق ملكیة الأراضي الزراعیة، والإرتباط بالأرض والإستقرار، ثم المرحلة المدنیة والتي تعتبر بالنسبة لـ "مورغان"، أهم المراحل وأعلى درجات تحضرها، بظهور المدن الصناعیة، حیث انتقلت المجتمعات من المرحلة الزراعیة، إلى المرحلة الصناعیة، والتي یرى فیها أعلى درجات الحریة والمساواة، والعدالة الإنسانیة[i].
انتقد "شتروس"، في كتاباته المجتمعات الحدیثة ونظامها العائلي والإجتماعي، حیث رأى بأن تأثیر التطور التقني الطبي ألقى بظلاله على نظام القرابة، من خلال العلاقات البیولوجیة، التي غلبت الإجتماعیة، وقد تساءل عن تلك العلاقات التي یتم من خلالها تخصیب البویضات، من طرف رجال ونساء من أماكن مختلفة، والتي أنتجت (أمان إثنان وأب واحد، ثلاث أمهات وأب واحد، أم واحدة وآباء مختلفون، بالإضافة إلى الأم والأب العادیان)، وقد أوضح بأن هذا یتواجد في قبائل الهنود بالبرازیل، حیث بإمكان الرجل أن یتزوج دفعة واحدة عدة أخوات، أو أما وبنتها التي أنجبتها مع زوج سابق، ثم إن هؤلاء النسوة یتكفلن جمیعا بتربیة أطفالهن، ومن خلال هذا الطرح یتضح لنا بأن "كلود لیفي شتروس"، یحاول ربط الصلة بین ما توصل إلیه المجتمع الحدیث، بالمجتمعات الإنسانیة القدیمة في مسألة القرابة، فهو استطاع أن یحدث تغیرات أساسیة في التفكیر الأنثروبولوجي وهذا لم ینطبق على فرنسا فقط بل شمل العالم الخارجي كذلك، وأمكنه ذلك من صیاغة نظریة جدیدة في القرابة وتأثر بها الكثیر من العلماء المعاصرین وخصص للنسق القرابي كتابا من أهم كتبه "الأبنیة الأولیة للقرابة"، وقد عرف القرابة على أنها عبارة عن انتماء شخصیة أو أكثر إلى جد واحد أو اعتقادهم أن لهم جدا واحدا، وقد تكون القرابة حقیقیة وقد تكون متخیلة أو قانونیة وتقوم الأولى على صلات الأم في الغالب، وهي العنصر الأساسي في القرابة، كما أن قواعد تحدید القرابة تختلف من مجتمع لأخر اختلافا واضحا، فهناك مجتمعات تجعل من القرابة متصلة بالأب وحده وتسیر في خط الذكور أو ما یطلق علیه (الخط الأبوي)، وفي هذا النطاق تعتبر الأم وأقاربها بعیدون عن القبیلة أو العشیرة أو الأسرة، وهناك مجتمعات ترى العكس تماما، حیث القرابة فیها تسیر نحو الأصل الأموي أو ما یسمى (الخط الأموي)، إلى جانب هذا ثمة مجتمعات أخرى ترى أن القرابة تسیر مع الخطین الأموي والأبوي، أي أن الشخص یعتبر عضوا في عشیرة أبیه وفي عشیرة أمه وأبناء الطرفین أقارب له، وهذا ما اصطلح على تسمیته بقرابة الجانبین، أو إن صح التعبیر (القرابة الثنائیة)، إضافة إلى هذه المجتمعات، یوجد مجتمعات تتبع القرابة فیها عدة خطوط، فمثلا بعض عشائرها تسیر وفق خط الأم وفي بعضها الآخر تسیر وفق خط الأب وفي النوع الثالث وفق المنطقین معا، وتسمى هذه القرابة (قرابة الخطوط المتعددة)، كما أن نسق القرابة یقوم في أساسه على نوعین من العلاقات فالنوع الأول هو العلاقة التي تقوم على رابطة الدم وینشأ عنها الأقارب المقربین والذي تربطهم روابط الأم، أما النوع الثاني فیمثل العلاقة أو القرابة التي تنشا عن طریق المصاهرة او الزواج.[ii]
القرابة والسياسة:
إن ظاهرة السلطة والقهر والتحكم لم تغب عن الفعل الإنساني خلال كل الفترات التاريخية التي مر بها، وهذا ما أكد عليه بن خلدون من خلال نظريته نظرية الوازع حيث رأى وجوب وازع يردع الخلائق عن الظلم مع عدم الإهتمام بالصيغة التي يتم من خلالها الضبط والتحكم داخل المجتمع، سواء كانت دينية تتجسد في دعوة ما أو دنيوية تعبر عن ايدولوجية علمية أو فلسفية، وإن كانت الدولة شكل من أشكال السلطة هذا باعتبار كونها الحاكم الوحيد لأجهزة العنف الشرعي والقهر الإيديولوجي والممثل الوحيد لجميع المؤسسات والسلطات، وباعتبار شرط الرضا والقبول المبدأ الضامن لاستقرارها المنعقد بينها وبين الطرف الأخر المتمثل في الشعب، إلى جانب تطورها التاريخي الذي يخول لها السيادة والطاعة بداعي الأقدمية والتضحية فقد سعت عديد المجتمعات الى مأسسة هياكلها من خلال ما سمي في الأدبيات بمرتكزات الدولة الوطنية، من خلال مؤسسات وبناءات كمؤسسة الجيش والأحزاب والمنظومات الإدارية ..الى غيرها من المؤسسات ذات الصبغات الحداثية، ورغم هذه المعطيات السوسيولوجية الحديثة التي تحلت بها الدول وكذا دولتنا الجزائرية، فلا يزال مجتمعنا على سبيل المثال محافظا على العديد من المميزات الأنتروبولوجية القائمة على القرابة والإنتماء العائلي والجهوية والعرقية، بل تعدت اطارها السوسيوثقافي إلى الإطار الرسمي القائم على سلطة القانون وفقط، لتستغله وفق تصوراتها العروشية والشعورية الضيقة في كثير من الأحيان، لتقف بهذا الشكل كعائق أمام المسار الديمقراطي وتكبح في عديد من الأحيان عملية بناء الدولة وتجسيد فعالية المواطنة في مجتمع شأنه القيام على الحرية والتعددية والمساواة والعدالة الإجتماعية، وبالتالي تأكد الحضور الفعلي للبنى الاجتماعية وخاصة التقليدية منها في الكثير من الأشكال الحداثية ضمن مجالات السلطة في مجتمعاتنا المحلية[iii].
أنثروبولوجية القبيلة:

يتشكل المجتمع البدوي من عدة جماعات وأول جماعة لهذا المجتمع الأسرة التي تشكل الوعاء الذي تلتقي فيها كل روابط البدو الاجتماعية، ويزداد نطاق الأسرة في المجتمع البدوي اتساعا حيث يشمل عميد الأسرة وأبناءه وأحفاده وزوجاته، وتعتمد الأسرة البدوية على النظام الأبوي حيث يرتبط أفرادها بالأب مادام حيا، وقد تمتد المسؤولية في الغالب للأقارب كالجد أو الأعمام في غياب الأب، حيث تتصل القرابة في المجتمع البدوي العربي بالأب دون عائلة الأم، وتشكل مجموعة من الأسر فخذا، و يتكون في الغالب من 6 إلى 23 خيمة تعيش في مكان واحد جنبا إلى جنب، وهي ذات خط قرابي واحد، لكن قطعانها من الأغنام تتوزع على الإقليم لإستغلال أمثل لمناطق الرعي، ومجموعة أفخاذ تشكل البطن ثم تأتي القبيلة التي تشكل رأس التنظيم الإجتماعي للمجتمع البدوي، ويمكن اعتبارها مجتمعا متماسكا يتصف بالتضامن وسيادة روح الجماعة، كما أن القبيلة مسؤولة عن الضبط الاجتماعي داخل المجتمع وفرض العادات والقوانين المتفق عليها، وهي منوطة أٌيضا بشؤون الحرب والدفاع والإشراف السياسي والإداري على مختلف الوحدات التي تشكل المجتمع البدوي[iv].
وهناك مجموعة من الخصائص يجدها الباحث الأنثروبولوجي في القبيلة قد لا توجد في أنماط قرابية أخرى هي:
ارتباط وثيق بقيم البداوة والتي تطغى فيها روح الجماعة (الضمير الجمعي) على روح الفردانية، وهي ميزة فرضتها طبيعة الحياة القاسية حيث ترتحل القبيلة من مكان إلى آخر بحثا عن الأمن (الإقتصادي) وهي متفطنة ككيان لكل (وضع سياسي محيط)، فما يصادف الباحث الأنثروبولوجي وهو يتقصى في علاقات القبائل مع بعضها البعض هو الصراع المتجدد، وهي حتمية فرضتها أولا الترحال الدائم الذي يجعل القبيلة منغلقة في غالبية ممارساتها على أعضائها المكونين لها، وكل تواصل خارجي يحصل وفق حسابات مدروسة قد تكون اقتصادية أوسياسية جعل الكثير منها يزول ويبقى روايات شعبية هنا وهناك كقبائل الجيتول والغرامنتس[v]، هذا ولا يمكننا أن نخفي قيم الشهامة والرجولة والصبر والعهد وغيرها من قيم ايجابية لطالما تمتعت بها أنساق القبائل المتمايزة وإن اختلفت في الزمكان.
القرابة والرباط الإجتماعي

مفهوم رباط أو رابطة:
لغة: رباط اسم مشتق من الفعل ربط والجمع: َرابِطات وروابِط، الرابطَةُ من الدَّواب ونحوها: المربوطة الرابطةُ.
اجتماعيا: الجماعة من الأفراد يجمعُهم أمر يشتركون فيه، كرابطة الدَّم: القرابة، صلة الرحم، والرابطة هي العلاقة والوصلة بين الشيئين، ويقال ربط الشيء بمعنى شده.
إجرائيا: الرباط وهو الخيط الذي يربط ويشد جماعة ما من الأفراد فنسميهم رابطة نسبة للرباط الذي يربطهم، حيث يختلف هذا الرباط من جماعة إلى أخرى، ويتمثل في رباط القرابة، الصداقة، الجيرة....والرباط الاجتماعي أو الرابطة الاجتماعية التي هي جماعة من الأفراد تربطهم علاقات اجتماعية تقوم على رباط معين.
مفهوم رباط القرابة:
لغة: هي الدنو في النسب والقربى في الرحم.
اصطلاحا: فهي علاقة اجتماعية تعتمد على الروابط الدموية الحقيقية أو الخيالية المصطنعة، ولا يعني اصطلاح القرابة في الأنثروبولوجيا العلاقات العائلية والزواج فقط، وإنما يعني أيضا المصاهرة، فالقرابة هي علاقة دموية والمصاهرة هي علاقة زواجية فعلاقة الأب بابنه هي علاقة قرابية، بينما علاقة الزوج بزوجته هي علاقة مصاهرة، كما أنها "مجموعة صلات رحمية وروابط نسَبية تربط الأفراد بوشائج عضوية واجتماعية متماسكة تلزمها بتنفيذ التزامات ومسؤوليات وواجبات تفيد أبناء الرحم الواحد أو النسب الواحد.
إن المقصود بذلك إجرائيا: هو أن رباط القرابة هو كل صلة مباشرة بين شخصين أو مجموعتين ينحدرون من نسب واحد حيث تكون هذه الصلة مستمرة ودائمة حتى نهاية حياة الفرد أو الجماعة، لأن الصلة تتطلب التواصل المستمر وبانقطاع هذا الأخير تنقطع الصلة الرحمية أو تضعف مع الزمن.[vi]
تشكل الروابط:
رابط القرابة:
كل المجتمعات البشرية وبدرجات متفاوتة محكومة بالقرابة كرابط يشكل مجموعة النسل والإرث والطقوس والأدوار بنسب مختلفة، سواء تلك التي يمثل فيها نظام القرابة تعقيدا أقل ودورا أقل كما هو الحال في المجتمعات الغربية، أو تلك المجتمعات التي تميل للاعتماد على نظام القرابة بشكل كثيف لتحديد وتوزيع الأدوار الإجتماعية والاقتصادية لأفرادها كما هو الحال في المجتمعات الشرقية بشكل عام، ولهذا فإن نظام القرابة والعائلة يمكّننا من فهم أوسع لطبيعة المجتمع الذي تتم دراسته من خلال هذه الأنظمة الإجتماعية.
والجدير بالذكر، أن نظام القرابة هو في أساسه عملية عقلية وليس تطبيقية أو منهجية تسير على أسس عالمية ثابتة، فالناس ينظرون لنظامهم القرابي والعائلي، بتداخلات فلسفية، ودينية، واجتماعية وهذا ما يسبب اختلاف النظرات والإعتبارات الإجتماعية والفكرية لهذا النظام، فعلى الرغم من أن أنظمة القرابة تعتمد بشكل أساسي على العلاقة البيولوجية، فإنها ظاهرة اجتماعية وثقافية، فالطريقة التي يصنّف فيها المجتمع نظام القرابة المتبع لديه، هي ظاهرة ثقافية، اجتماعية، وليست بالضرورة أن تكون معتمدة بشكل علمي على الروابط البيولوجية (علاقات الدم)، فلفظة الأب، قد تطلق على الأب البيولوجي "genitorr"، وقد تطلق على من يقوم بتولي مسؤولية الطفل، وتنشئته وهو ما يسمّى بالأب الإجتماعي "Pater"، عندما يتم تأسيس الأبوة بالزواج، فإن الأب هو زوج الأم، وفي المجتمعات التي تمارس النساء فيها تعددية الأزواج، كما هو الحال في "تودا الهند"، الأبوة البيولوجية غير مهمة، فالأبوة يتم تحديدها من خلال طقس، مما يعني أن الأب الإجتماعي هو المهم هنا.
وبما أن الأنظمة القرابية هي خلق اجتماعي، فهناك عدة طرق للنظر للمصاهرة، وقرابة الدم وتصنيفهما حسب المجتمعات المختلفة، كما أن هناك اختلافات في أنواع الروابط الإجتماعية المكونّة من خلال القرابة، والطريقة التي تفترض بهذا النظام، أن يعمل بها اتجاه الأنظمة الأخرى، ففي الأنظمة ثنائية الإنحدار (النسب)، يتم التركيز على القرابات البيولوجية، على عكس القرابات المعرفّة اجتماعيا وثقافيا.
رابط التجاور:
يميل الإنسان بطبيعته للعيش في إطار جماعي مع بني جنسه تربط بينهم الحاجات المشتركة، وينشأ بينهم نمط
من التفاعل والعلاقات المتبادلة القائمة على أساس التعاون والعمل المنسق لإنجاز الأهداف المسطرة، وتتباين قوة هذه العلاقات ومستوياتها وأنماطها من مجتمع إلى آخر وحسب ظروف الزمكان.إن ما يميز هذه المجتمعات وما أجمع حوله علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا هو قوة العلاقة بين الأفراد على أساس القرابة التي تنطوي عليها الحياة الاجتماعية في الأرياف بكافة أنساقها، فالتضامن الاجتماعي بين أعضاء الجماعة القرابية بمختلف صورها كالعائلة والعشيرة، العرش أو القبيلة وبمختلف انحداراتها المبنية على الروابط الدموية الحقيقية أو المتأتية عبر علاقات المصاهرة أو تلك التي تشمل رابطة الولاء التي تغذيها فكرة الانتماء للمجال الجغرافي المشترك، يتجلى وبوضوح في العديد من المناسبات الاجتماعية كالتعاضد والتآزر في الأفراح والأتراح والهبة لنصرة المظلوم في وقت الأزمات والتعصب لذوي القربى في كل المواقف، ما يعكس قوة التماسك والشعور الجمعي عند هذه الجماعات وتمتد القرابة كبنية اجتماعية أساسية في الأرياف لتشمل أبعادا تتجاوز المجال الاجتماعي والاقتصادي إلى المجال السياسي، ورغم اتفاق بعض الباحثين حول تراجع وتقهقر ادوار هذه البنية بحكم أنها تخص المجتمعات التقليدية والبسيطة والأولية والتي فقدت الكثير من تقليديتها جراء سيرورة التحديث التي لحقت بها، إلا انه لا تفتأ حتى تستعيد نشاطها وحيويتها في العديد من المناسبات كالانتخابات مثلا أين تبرز وبوضوح تعبيراتها السياسية، فتوزيع الأدوار والوظائف الحكومية ومراكز السلطة في هذه المناطق غالبا ما تتحكم فيها عوامل القرابة والعشائرية والقبلية ويعتبر المجتمع الريفي الجزائري واحدا من المجتمعات الذي مازالت فيه القرابة باتساع أو ضيق روابطها فاعلا ناشطا لدى سكانه في اختياراتهم المتعددة، وتبرز تجلياتها أكثر في الانتخابات على سبيل المثال كشكل من أشكال المشاركة السياسية وكنموذج يتداخل فيه القرابي مع السياسي، لذا ووقوفا عند هذا الطرح وجب علينا كدارسين البحث في الحقل السوسيولوجي عن إيجاد مبررات موضوعية وعقلانية لفهم عميق وأدق للظاهرة، والعمل في نفس الوقت على إيجاد الفواعل الاجتماعية الأخرى التي توسع من مساحة الولاء للوطن وتقلص من حيز الولاءات القرابية الضيقة والهشة، لأنه كثيرا ما تشكل اختياراتنا السياسية المبنية على أساس العاطفة والقرابة والمناطقية والعروشية وتهميش معايير الكفاءة والعدالة والنزاهة والبرامج السياسية الواقعية عائقا وظيفيا أمام العمليات والبرامج التنموية التي تستهدف مجتمعاتنا الريفية، بفعل السياسات التسييرية الفاشلة للمنتخبين المحليين، خاصة على مستوى المجالس الشعبية البلدية أين يتجلى الأثر الكبير للروابط القرابية.[viii]
وأعقب على ما سبق بأن الباحث الأنثروبولوجي لا يكتفي بهذا القدر (الجانب السياسي)، بل يتوجه إلى فهم العلاقات المكنونة داخل ما يشكل القرابة ويبحث في معانيها التي تتأسس على المعنويات والشعور وما يتبعها من ممارسات، فكثير منا تعرض لهاته العلاقات المعنوية بين أمه وخاله مثلا، وكيف تقوم الأخت في مسألة الميراث بالسماح لأحد إخوتها إذا ما كان هناك تقسيم لإرث ما، وقد يفقه الباحث الأنثروبولوجي هاته الممارسة بإسقاطها على وازع الحقوق المتعددة وعن الدور الذي يلعبه مفهوم (السماح)، فهل كل من سمح في شيئ لأخيه يندرج في سياق المعنى الإيجابي، أم يؤسس لعلاقات مستقبلية براغماتية يرى فيها الأخ حق أخته، حقه هو بالذات، ولقد عرضت علينا مثل هاته المسائل في عديد المرات وكيف تحولت العواطف الجياشة إلى عواصف تعصف بالعلاقات، وكيف يقود التسامح إلى اللاتسامح.، وأقول وأنا أكتب هاته الأسطر بأني شخصيا تعرضت لهذا الموقف لما تجادلت مع والدي حول إن كانت أمي رحمها الله تعالى سمحت في قطعة أرض لأحد أخوالي، وكانت إجابة أبي أن أمي مرتبطة بخالي ليومنا هذا بقطعة الأرض الفلاحية، حتى بعد وفاتها بسنوات، والسبب هو وفاتها بعد أبيها (جدي) ما يخول لها الحق في الأرض (لزوجها وأبنائها)، خاصة وأنها سمحت شفهيا فقط ما يجعلنا شركاء مع خالي في الأرض، وبالتالي فالباحث الأنثروبولوجي تحيط به عديد العوامل والأسباب وهو يتناول مسألة القرابة والعائلة ولا يمكنه أن يغفل عن كل صغيرة وكبيرة ليصل إلى فهم الواقع السوسيوثقافي للعائلة الجزائرية، لأني في اللحظة التي كنت أقول فيها لأبي بأن أمي سمحت، ونحن بدورنا كأبناء نسامح خالنا، نسيت أني أهضم بذلك حق أبي الشرعي الذي يرتبط بنصيب أكبر مما نرتبط به نحن كأبنائها، باعتبار الزوج يرث أكثر من الأبناء، هذا على سبيل المثال لا الحصر، والأمثلة لا تعد ولا تحصى، والقرابة والعائلة حقل خصب يستلزم عديد الدراسات الإثنوغرافية الصادقة.
المرأة الجزائرية بين القيم المحلية والعولمة
المرأة والسيداوية:
تركز قنوات الإعلام العالمية في معظم مواضيعها على المرأة باعتبارها نصف المجتمع، مسلمة بوثيقة "القضاء على جميع أشكال التمييز"المعروفة اختصاراً باسم "سيداو" "CEDAW":
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women""
وقد اعتمدت هذه الوثيقة الجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م، وحددت مبادئ وتدابير معترف بها دولياً لتحقيق مساواة المرأة بالرجل في كل مكان، وتضمنت "30 مادة" بصيغة ملزمة قانونية، وجاء اعتماد الجمعية العامة لها تتويجاً لمشاورات أجرتها طوال فترة خمسة أعوام فرق عاملة متنوعة أشرفت عليها لجنة المرأة في هيئة الأمم والجمعية العامة.
وتدعو هذه الإتفاقية الشاملة في 16 مادة منها إلى المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بغض النظر عن حالتها الزوجية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وتدعو أيضاً إلى سنّ تشريعات وطنية لحظر التمييز ضد المرأة، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة وباتخاذ خطوات لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفاً دولياً، وتنص تدابير أخرى على منح المرأة حق المساواة في الحياة السياسية والعامة، وعلى تكافؤ فرص التحاقها بالتعليم وحق اختيارها نفس البرامج المقررة للرجل، وعلى عدم التمييز في فرص التوظيف والأجر، وعلى ضمانات العمل الاجتماعية في حالتي الزواج والأمومة، وتركز الإتفاقية على ما للرجل والمرأة من مسؤوليات متساوية في إطار حياة الأسرة، وهي تبرز أيضاً ما تدعو إليه الحاجة من خدمات اجتماعية، ولاسيما مرافق رعاية الأطفال لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة[ix].
إن الناظر إلى هاته الوثيقة نظرة سطحية يجدها خيرا، لكن ما ينطبق عليها هو ظاهر في رحمة وباطن من ورائه العذاب والجحيم، يؤكد هذا تفسير أحد الإعلاميات لمضمون هاته الوثيقة، تقول "ديل أوليري" "Dale O'Leary" في بحث لها في هذا الخصوص تحت عنوان "الصحة والحقوق الجنسية والتناسلية" معلقة على الوثيقة: "تنص الوثيقة على أن حق حرية الاختيار في أمور التناسل وأسلوب الحياة يعتبر حقاً أساسياً للمرأة، كما يعتبر التمتع بالحقوق الجنسية والتناسلية مطلباً ضرورياً لكي يكون لديها حق حقيقي في تقرير المصير" وعلقت بقولها: "إن حرية الإختيار في التناسل" يقصد بها الحصول على حق الإجهاض عند الطلب، وأسلوب الحياة يقصد به الشذوذ الجنسي وجميع الأشكال الأخرى للجنس خارج نطاق الزوجية.
وهي كلها مصطلحات تستخدمها القنوات الفضائية في زمننا، "تفضيل جنسي أو ميل جنسي" عِوضاً عن الشذوذ الجنسي، ولفظ "شريك Spouse" بدلاً من زوج أو زوجة، حتى يتم زواج المرأة بمن شاءت دعماً لتعددية أنواع الزواج الشاذ، ولفظ "طفل الحب والجنس" عوضاً عن الطفل غير الشرعي أي ثمرة العلاقة غير الشرعية، وهي كلها تسمية المسميات بغير مسمايتها، ويستخدمون لفظ "جندر" والمقصود به "النوع" ليتم إلغاء مصطلح ذكر وأنثى ليتم لهم بذلك إضفاء الصفة الشرعية لكل الأشكال الأخرى الشاذة.
وكان من المفترض في صياغة الوثيقة أن تلتزم بضبط المصطلحات والألفاظ، خاصة وأنها دولية، حتى تكون واضحة ومفهومة لدى الجميع، فهي من الأمور المنهجية الهامة التي تحتل أولوية متقدمة في تأسيس المرتكزات، لأن المصطلحات هي الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار، فإذا ما اضطرب ضبط هذا الوعاء أو اختلّت دلالته التعبيرية أو تميعت، اختل البناء الفكري وخفيت حقائقه وأدى إلى نتائج فكرية ومنهجية خطيرة، وهذا ما حصل تماماً.
المرأة الجزائرية والقيم المجتمعية المحلية المتميزة:

إن مجتمعنا الجزائري يحوي ضمنه عديد المؤهلات الثقافية التي تميزة عن المجتمعات العالمية، وحتى لا نكون نسخة طبق الأصل عن المجتمعات الغربية، وفي ظل العولمة ومحاولات التغريب المتعددة داخليا وخارجيا، يتوجب على المرأة الجزائرية، الوعي والحرص اللازمين على تلقين الموروث الثقافي المحلي للنشئ، بصفتها الشخص الأول الذي يتفاعل معه الإنسان في حياته، والمدرسة التربوية الأولى في الحياة الإنسانية، ومن القيم المجتمعية التي يتميز بها مجتمعنا الجزائري، ومن خلال دراسة سالفة لي اتضح لي بعد النزول إلى الميدان والتجاوب مع عينات من أفراد مجتمعي المدروس بالجنوب الجزائري، أننا نملك تراثا قيميا غنيا قيميا تساهم في استمراره المرأة الصحراوية، أذكره في ما يلي:
- إكرام الضيف: في المنازل الخاصة ودور الزوايا(فهي المسؤولة عن الطبخ، ومن بين المأكولات آنور/ الملة/ الطعام،...وغيرها.
- تساهم في تحقيق استمرارية (توقير الأولياء والمشايخ): فمن خلال إقامة الإحتفالات للمشايخ، الأموات كالسبوع في زاوية الحاج بلقاسم بتيميمون وحتى الأحياء، كزيارة الشيخ البكاري في قصر بني مهلال، تكون المرأة مسؤولة عن طهي الطعام والمأكولات للضيوف من شتى المناطق والأنحاء، وهي بذلك تغرس قيم الإيثار وحب الآخر في بنيها وبناتها.
- تساهم في قيمة التعاون والعدل: من خلال التويزة بشتى أنواعها، سواء المتعلقة بالفقارة، أو البناء أو الأعراس، فهي بجانب الطهي تقوم بعملية الجني جنبا إلى جنب مع زوجها وأبنائها.
قيمة أدب المعاملة: فمن خلال تعمقي في الإحتفالات الدينية، اتضح لي أن الزوايا، تخصص أماكن للرجال وأخرى للنساء، متجنبة الإختلاط، وهو ما يحث عليه قيم احترام خصوصية الجنسين، ويندرج في سلم قيم المجتمع المحافظ، بل يتعدى الأمر ذلكم إلى إقامة بعض الزيارات إلى اضرحة بعض الصالحات كزيارة "اما عيشة" بضواحي تيميمون دائما، وهو ما يدل على مكانة المرأة في مجتمع تيميمون خاصة، وسائر أنحاء الجزائر عامة.
قائمة المراجع :
- معن خليل عمر، علم إجتماع الأسرة.
- محمد الحسن، الأسرة ومشكلاتها.
- مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائرية - التطور و الخصائص الحديثة، ترجمة : دمري أحمد، سلسلة المجتمع ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر،1984.
- Ariès P., 1960, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Plon.
- Attias-Donfut C. et Segalen M., 1998, Grands-parents. La famille à travers les générations, Paris. Odile Jacob.
- Avenel C. et Cicchelli V., 2001, Les familles maghrébines en France,
Confluences Méditerranée, n° 39.- Bawin-Legros B. (1996). Sociologie de la famille. Le lien familial sous questions. De Boeck, Bruxelles.
- Bonvalet C., Gotman A. et Grafmeyer Y., (dir.), 1999, La famille et ses proches.
- Cadolle S., 2000, Être parent, être beau-parent. La recomposition de la famille, Paris, Odile Jacob.- Calmann-Levy. Commaille J. et Martin C., 1998, Les enjeux politiques de la famille, Paris, Bayard.
Castel R., 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard.
- Cicchelli V., 2001, La construction de l’autonomie. Parents et jeunes adultes face aux études, Paris, Presses universitaires de France, collection Sciences sociales et sociétés.
- Cicchelli-Pugeault C. et Cicchelli V., 1998, Les théories sociologiques de la famille, Paris, La Découverte.
- Damon J., 2001, «30 ouvrages sur les questions familiales » , Dossiers d’Études. Allocations familiales, CNAF, n° 25.
- Martin C., 1997, L’après-divorce. Lien familial et vulnérabilité, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
[i] عامر لطفي عبد الكریم، الصورة التولیدیة والنظریة البنیویة لدراسة القرابة (بحث مقدم في أنثروبولوجیا القرابة)، تونس، 2015، ص08.
[ii] كلود لیفي شتروس، الأنثروبولوجیا البنیویة، ت.مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوریا، ج2، 1973، ص63.
[iii] أنظر: مقال الباحثين بلحميتي مهدي/ زموري زين الدين، البنى الاجتماعية و ظاهرة السلطة داخل المجتمع المحلي في الجزائر.
[iv] أنظر: مسلم محمد ساسي، السلطة في المجتمعات البدوية.
[v] أنظر: عبد النور العمري، القبيلة البدوية المغاربية قبل وأثناء الفترة الرومانية.
[vi] أنظر: كرابية أمينة، التغير الاجتماعي وانعكاسه على الرباط الاجتماعي في المجتمع الحضري، دراسة ميدانية لرباط القرابة ببلدية السانيا بوهران.
[vii] أنظر: موسى إسماعيل شماخي، آليات تحقيق التماسك الإجتماعي: رؤية أنثروبولوجية دينية، مجلة أنثروبولوجيا، مركز فاعلون، الجزائر.
[viii] أنظر: كرابية أمينة، مرجع سابق.
[ix] أنظر: فاطمة عمر نصيف، الأسرة المسلمة في زمن العولمة.
-
- يعتبر المجتمع الجزائري من المجتمعات التي تحافظ على عديد الممارسات التي يتخللها التفاعل بين أنساق القرابات المتعددة، برايكم ماهي هاته الأنساق المكونة للنظام القرابي، أعط أمثلة من منطقة انتمائكم.
-
- يساهم النظام القرابي القرابي في مجتمعنا الجزائري في تشكل عديد القيم ؟
-